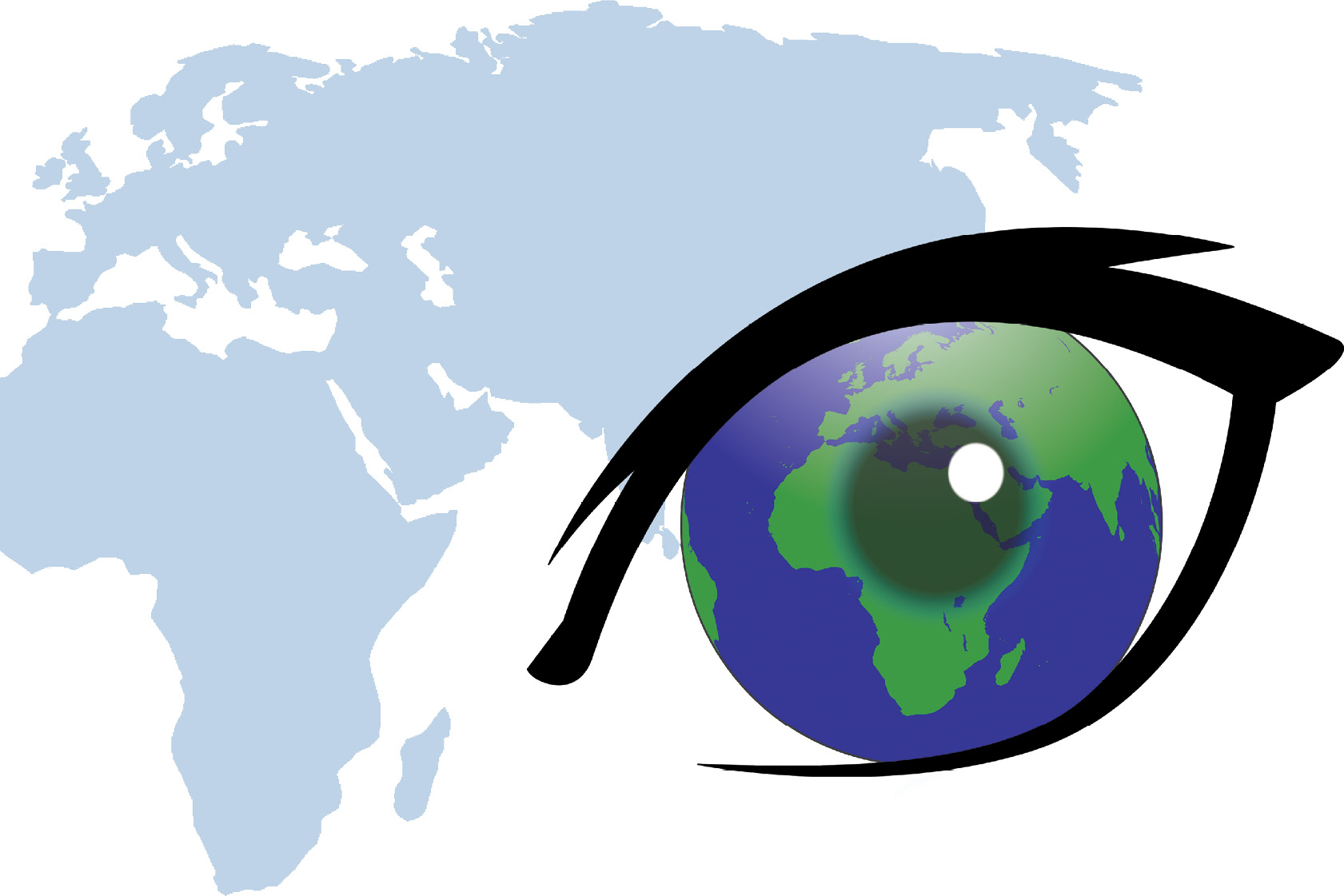عندما نزل الكتاب المبين لم يُلغ ما تعلمه الإنسان ودوّنه لينتقل من غياهب الجهل إلى أنوار المعرفة، بل قال له -توكيدًا- إياك أن تتوقف، فأنت موصول بأعظم حقيقة: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ) (العلق:١-٢). ثم ذكّره بالقلم خاصة، كأداة ترمز إلى وسائل المعرفة المادية التي تسجل جهده العلمي، بتدوينه لما تصوّره من حقائق، ليقرأ ما كتب، ويكتشف أنه لا يعرف إلا القليل، فيهبّ إلى تعلّم ما لم يكن يعلم؛ (اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلّمَ الإنْسانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) (العلق:٣-٥).
أتى التنزيل الحكيم لكي يقول لكل قارئ متأمل في هذا العالم الفسيح: إنك في رحلتك البحثية الاستكشافية، لن تعرف إلا بعض الأدلة المادية، وأنك لا تستطيع أن توظفها -مع معرفتك بها- إلا في جانب محدود لا يفي بحق النفخة الغائبة الكُنْه فيك، التي بها امتلكتَ الإرادة والقدرة على الاختيار، واكتسبتَ الجرأة على السؤال، والانطلاق نحو رحلة الاكتشاف والتجربة، بدءًا من تجربة النظر، وتجربة تفسير الكون والتاريخ والحياة.. ولكن دون إعراض عن تجربة البحث عن الحقيقة الكبرى؛ (إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِين) (الصافات:٩٩).
- “اقرأ” خاصةٌ بك أنتَ
هل يعرف الإنسان أن “اقرأ” شرّفته أيما تشريف؛ فالخالق عندما خاطب السموات والأرض قال: (اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا) (فصلت:١١)، مع أن خلقهما أكبر وأعقد: (لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) (غافر:٥٧).. وعندما خاطب مجتمع النحل قال: (وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ) (النحل:٦٨)، لأن الأمر ههنا يتعلق بالجماد والحيوان، لا المخلوق المخير الذي استثناه الخالق من تِلْكُم الجبْرية المطلقة. ألا ترى أن الصيغة الأمرية في أول تنزيل قد عدَلتْ عن صيغة الكونية الجبرية “كُنْ”، إلى الاختيارية القرائية “اقرأ” تكريمًا للإرادة الإنسانية؟!
إن خطر القراءة باسم غير الله، لا يهدد سيرورة الكشف العلمي في عالم المادة فحسب، ولكنه يهدد ما من أجله يريد الإنسان أن يعلم ويعرف، بلوغ المدى في السعادة، سعادة الاهتداء إلى الحقيقة. ولذلك اعترض الخطاب المبين على تحقق السعادة مع الإصرار على الاستغناء عن صاحب الحقيقة الكلية: (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أن رآه اسْتغنى) (العلق:٦-٧). فمع ذهول الإنسان أمام ما توصل إليه من كشوف سيصيبه الغرور، ليس لأنه صنع ما يمكن أن يؤدي إلى دمار الإنسان وخراب إنسانيته، بل -والأدهى- لأنه راوده الشعور بالاستغناء عن القراءة “باسم الخالق”، فاطمأن إلى ذلك. إذ كيف تريد أن تستمر في الاكتشاف ورحلة البحث عن الحقيقة وأنت لا تريد الاعتراف بالمرجع الأسمى؟! أي منهج يجيز هذا؟! ألست أيها الإنسان، حينما ستسخّر وسائل المعرفة المرصودة لأجلك، سيظهر لك أن خلْقك كان “من علَق”، وهو عيْنُه ما تخبرك به رسالة الملك جل وعلا كي تنبهك إلى وجهة القراءة “باسم الله”. أنت ستكتشف وستعرف وستتعلم كما فعلت ذلك من قبل، بل وأفضل. ولكن، لأنك محكوم في آخر المطاف بالرجوع إلى الذي خلقك وربّاك (إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى) (العلق:٨)، كيف يعقل أن تصر على إغفال المعرفة العلوية التي يمنحها الرب؟ كيف ستواجهه؟ أي مبرر ستقدمه بين يديه وأنت الذي كنت تقبَل جميع المراجع، بينما قرّرْتَ الإعراض عن أقْوم المصادر؟! خاصة وأن غايته أنه يريد أن ينقذك من الجهل، ويعرّفك بامتدادك في المستقبل، ويريد تخليصك من درك الانغماس في تجربة المادة مع الذين (يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الحَيَاِة الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُون) (الروم:٧).
في المختبر، يريد الباحث أن ينتهي بالتجربة إلى نتيجة، كي يحصل على الاعتراف بالذات والانتشاء بالانتصار على الجهل، لأن العلم من طبعه أن يُشعر بالسعادة. لكن، ما لا يعرفه الغافل، أن حقيقة علم الإنسان وكشفه أنه لم يكن مخترعًا، بل فقط استطاع أن ينظم المعارف والأشياء، ويرتب الشروط الظاهرة لنجاح التجربة، دون الانتباه إلى الآيات الخفية التي تسهر على سيرورة النظام.. إن رسالة القرآن ههنا إليك أيها المكتشف جدُّ صريحة، بل صادمة، وهي أن الطبيعة التي تشتغل عليها قد تفوقك معرفة، لأنها تعترف بمصدر الخلق وتمجّده: (وَإِن مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) (الإسراء:٤٤). فالذرّة، تَنْجح تجربَتُك عليها، لأنها مضطرة إلى الانتماء إلى نظام “الذي خلق”، وخروجها عن هذا النظام سيعقّد الأمر، وسيجعلك غير قادر على لمس المادة والسيطرة عليها: (إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا) (فاطر:٤١). ولذلك الجاهل بأن لعالم المادة قوانينه وسننه، لا تنفعه أماني الفوضى والهوى واللانظام؛ (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ) (المؤمنون:٧١).
إن الانتقال من وضعية مُجرّب على المادة، إلى وضعية عيش التجربة الإنسانية في ظل نظام الخلق الذي تريده أن يبقى لكي تنجح تجربتك على الذرة، لا يتحقق إلا بالاعتراف بسيد هذا النظام، والاصطفاف مع الساجدين؛ (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ) (الحج:١٨).
- من تجربة الكشف إلى تجربة السجود
إن الذي ربّاك، يخبرك أن تجربتك الكبرى لا يمكن أن تعيشها بدون تعرّف إلى الله، فهو نفسه الذي وضع نظام المعرفة وشروط نجاح التجربة، التجربة المادية والتجربة الإنسانية.. إنه الواحد الأحد، والنظام سيد الشهود: (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا) (الأنبياء:٢١)، ولأن “ربك الذي خلق” هو “ربك الأكرم”، فبدهيّ أن يخبرك بصيغة التأكيد: (إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى) (العلق:٨)، لأنه الوحيد الذي يحيط بالتفاصيل: (أَلَمْ يَعْلَمْ بأنّ الله يَرَى) (العلق:١٤).
أنت تُخضع المادة لشتى أنواع النظر والرؤية بالعين والمجهر والمنظار، ولكنك أنت بظاهرك وباطنك تحت أدق مجهر على الإطلاق: (عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ) (سبأ:٣). أنت فيك شيء من عالم الغيب يجعلك تتجاوز التراب الذي تسير عليه. وهذه المخلوقات مسخّرة، وأنت المجرّب الفاعل، لكن عقدك القديم مع الذي اخترعك وصنعك؛ أول ما ينبهك عليه، هو هذا النظام الذي أنت فيه نفسًا وأفقًا، أينما يمّمت النظر لا تجد غيره شاهدًا ومشهودًا، وإذا حاولت ادعاء العكس (يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ) (الملك:٤). بل أنت نفسك، كيانك الجسماني لا يستطيع أن يخرق النظام، لأن الخلايا توحّد اضطرارًا كي تستمر إلى غايتها. فالكل يصطف علامات دالة على الله: (سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الْآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ) (فصلت:٥٣).
وبعد أن تجد نفسك محاطًا بنداء الفطرة الجواني، وآيات نظام الخلق الملكوتي، يحاصرك التوحيد من كل المداخل، حتى عندما تجرؤ على افتراض أكثر من إله، تواجهك صورة مرعبة للصراع تهدم كل هذا النظام الذي به تتذوق معنى الحياة. وإذا أصررت، يبقى النظام، بينما تتسلل الفوضى إلى الروح: (وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ) (الحج:٣١).
- اسجد واقترب
ولما كان الله يرى الظواهر، ويطلع على البواطن، علم قدْر صدق إقبالك على التجربة المكرّمة بالمعرفة العلوية، وهل فعلاً تريد أيها المستخلف، أن تعلم وترتقي في مدارج المعرفة بالفرار إلى واهب العلم وجميع النعم، أم أنك فاعل كاذب يدعي علم ما لم يكتشف سوى ظاهر نظامه، ثم عندما يُدْعَى إلى العلم الأكبر، يمتنع عن الظفر بالحقائق الكبرى التي ترشده وتُجلّي له العوالم الخفية. فهل يليق بك الانغماس الكلي في هذا المعلوم المادي لمعرفة بعض الحقيقة، ولا تفسح لنفسك الانغماس في تجربة تقودك إلى كل الحقيقة: (وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى) (لقمان:٢٢)؟!
وإذا كنت أيها الإنسان، فقط بسبب معرفتك للأسماء قد كُرّمت، وبسببك عوقب إبليس لرفضه السجود لك، كيف بك عندما تؤمر أنت بالسجود ليكتمل علمك بأسرار التوحيد تُجادل وتُماري؟! كيف بك تريد أن تتعلم الطبيعة لكي تعرف الخطأ فتضيء خطوة في طريق العلم، ولا تريد أن تتعلم التوحيد الذي يهبك النور الذي يزيل كل الظلام؟! ولذاك السبب، قبْل أن يذكّرك في سورة العلق بأن “الله يرى”، حذرك من خطر التكبر الذي يعمي البصيرة: (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرَى) (العلق:٩-١٤). إنها صراحة القرآن في مخاطبة الروع الواعي بالحقيقة، فلا داعي للإنكار والجحود، والتظاهر بأن سؤال التوحيد لا يطرق فؤادك وسمعك وبصرك: (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا) (النمل:١٤). ولذلك تعاقب الناصية بسبب كذبها وجحودها بالحق، وتناقضها حينما تقبل العيش في النظام الإلهي ولا تريد الاعتراف به في الوقت نفسه: (كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ) (العلق:١٥-١٦). ويوم المصير يفرض سؤال مؤلم نفسه: أين المصفقون على المعرفة المنفصلة عن الله؟.
إن القراءة باسم الرّب الذي خلق، تدل صاحبها على الطريق الموصل إلى الحقيقة الكبرى في الوجود، وتجعله مذعنًا لتجربة الاتصال بمقام القرب، وهذه التجربة التي لا يمكن عيشها دون رفض الازدواجية بكل صراحة وقوة: (كَلَّا لَا تُطِعْهُ) (العلق:١٩)، وبدون تواضع المخلوق من علق بين يدي الحي القيوم للاقتراب أكثر: (وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ) (العلق:١٩).