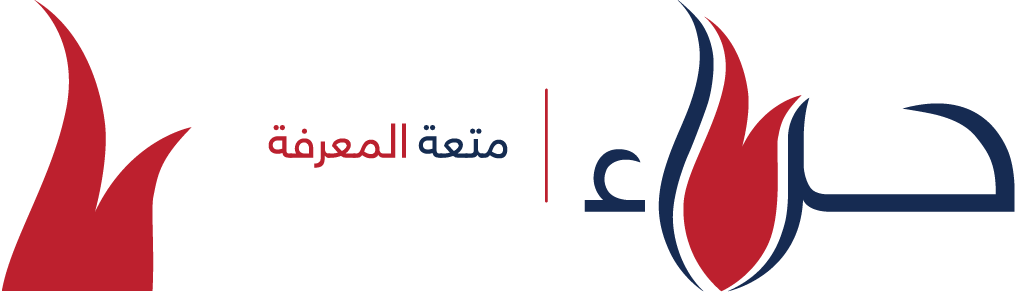ليس المثير نجاح الكاتب البريطاني “لويس كارول” (Lewes Carroll) مؤلف رواية “أليس في بلاد العجائب”، في وصف التشوهات في حجم وأبعاد الأجسام التي تراها “أليس” بمنتهى الدقة والبراعة، المثير أن ما رأته “أليس” في الرواية الخيالية بات تشخيصًا حقيقيًّا لأعراض غريبة يصفها مرضى “الشقيقة” التي -للمفارقة- كان مؤلف الرواية مصابًا بها، وعُرفت هذه الحالة العصبية النادرة بمتلازمة حملت اسم روايته التي أصبحت أكثر كتب الأطفال شهرة وانتشارًا حول العالم، و تناولتها أعمال فنية وسينمائية عدة.
فما هي متلازمة أليس في بلاد العجائب؟ وهل برع مؤلفها في وصف الأحجام المُصغرة والمُكبرة التي رأتها بطلة الرواية لأنه استخدم مهاراته في الكتابة الإبداعية؟ أم لأنه كان يعاني بالفعل من تلك الهلاوس البصرية؟ هل كانت تحولات “أليس” الفيزيائية مستمدة من خيال وموهبة الكاتب؟ أم من اضطراب الإدراك الحسي الذي كان يصيبه قبيل وأثناء نوبات الشقيقة؟
هالات الشقيقة
“الهالة” في اللغة العربية هي الدائرة المضيئة التي تحيط أحيانًا بالقمر أو بالشمس، بسبب انكسار النور الذي يخترق بلّورات الجليد المعلقة في الغيوم العالية البعيدة. وكثيرًا ما يمثَّل الملائكةُ والقديسون في الدراما، بطوق من نور ذو إطار بيضاوي يحيط بالرأس. وتُعرف الهالة في اللغة اللاتينية والإغريقية القديمة باسم”أَوْرَة” (Aura) وهي كلمة تعني الريح الخفيفة أو النسمة. وكانت تعني في الإنكليزية الوسطى “النسيم العليل”. واستُخدمت في نهاية القرن التاسع عشر في بعض الأوساط الروحانية لتشير إلى استبصار سطوع خفي حول الجسد.
ولكن توظيف المصطلح طبيًّا بدأ قبل ذلك بكثير، حيث استخدم قبل ألفي سنة تقريبًا لوصف الهلاوس التي تسبق نوبات الصرع مباشرة. ومنذ 100 عام تقريبًا تم اعتماد مصطلح “هالات الشقيقة” (Migraine Aura) لوصف مجموعة التغيرات في الرؤية التي تسبق أو تصاحب نوبات الشقيقة أو الصداع النصفي.
الذين يعانون هالات الشقيقة، كثيرًا ما يصفونها بأشكال مشوهة الأحجام تشوهات الحجم، بحيث تبدو الهالة البصرية للمريض أثناء تحركها كما لو كانت تكبر أو تصغر في الحجم، ويبدو بعضها مصغرًا والآخر مضخمًا. وتُعد “هالات الشقيقة” واحدة من مجموعة تغيرات -بصرية أو شمية أو سمعية- تسبق أو ترافق نوبات الصداع، حيث يعاني 20-30 % من المصابين بالشقيقة، تلك التغيرات ومن بينها رؤية هالات ضوئية حول الأجسام. وقد تعوق الأعراض البصرية بعض الأنشطة مؤقتًا مثل القراءة وقيادة السيارة، لكنها مؤقتة وليست خطيرة، وعادة ما تستغرق من 10 إلى 30 دقيقة فقط.
حين يمتزج الواقع بالخيال
من خلال جحر صغير، تدخل “أليس” إلى عالم غريب ومدهش في الوقت ذاته، عالمٍ تتجول فيه بين مجموعة من المخلوقات العجيبة التي صوَّرها خيال كاتب الرواية الشهيرة “أليس في بلاد العجائب” (Alice in Wonderland Syndrome)، بينما يتغير حجمها مرات عدة، فتارة يكبر وتارة يتقلص، مما جعلها تقول: “كنت أعرف من أكون عندما استيقظت هذا الصباح، ولكن أعتقد أنني قد تغيرت عدة مرات منذ ذلك الحين”.
وبعد سلسلة من الحكايات المليئة بالألغاز والخيال والمغامرة في عالم العجائب والحيوانات، تدخل “أليس” غرفة أنيقة تجد فيها قارورة وتشرب منها، وفجاة يصبح جسدها أكبر حجمًا وأكثر خفة، فترى الأشياء من حولها صغيرة جدًّا. ثم تأكل قطعة فطر، فيقلص حجمها مرة أخرى إلى عشرين سنتيمتر، وترى الأشياء من حولها ضخمة جدًّا. فتعجز عن تفسير ما يحدث لها وتقول: “يا للغرابة، كم هو عجيب ما يحدث لي اليوم! كانت أمور الأمس تسير كالمعتاد.. أتساءل ما الذي تغيّر فيّ؟ دعوني أفكر: هل كنتُ على ما أنا عليه حين نهضت هذا الصباح؟ أكاد أتذكر أنني شعرت بالاختلاف قليلاً، لكن لو لم أكن على ما أنا عليه، فالسؤال الأهم هو: من أكون في هذه الدنيا؟”.
ومن بين أحاسيس أخرى غير عادية يصفها مريض الشقيقة، أنه يشعر كأنه يرى العالم في غرفة المرايا المشوّهة: فتارة تكون الأشياء أصغر من حجمها (Micropsia)، وتارة أكبر (Macropsia)، وتارة أبعد (Teleopsia)، وتارة مشوّهة الأبعاد (Plagiopsia). لذا يقال إن “لويس كارول” إما أنه كان يعاني من هالات الشقيقة، أو أنه تعاطى دواء مُهلوسًا كي يستطيع الوصول إلى ذلك الوصف الدقيق لبطلة الرواية حين تختبر جسدها وقد أصبح أكبر حجمًا وأكثر خفة.
فيما بعد، تبين أن تجربة “أليس” في الرواية الصادرة عام 1865م، كانت مشابهة جدًّا لحالة غريبة يختلط فيها إدراك المريض اختلاطًا عجيبًا، بحيث ينتابه شعور مرعب بتبدد الواقع (Derealization)، والخفّة (Levitation)، ويشعر كأن جسده ونفسه “قد اختلطا” في صورة واحدة. وتجتاح المريض هلوسات بصرية تُظهر له صورًا تتغير فيها الأحجام والأبعاد والمحيط البصري، فيرى نفسه أكبر أو أصغر من حقيقته.
وقد يشعر أيضًا أن المساحة التي يتواجد فيها أو الكائنات من حوله تتحرك وتظهر بعيدًا أو أقرب مما هي عليه. وعُرفت هذه الحالة العصبية النادرة بمتلازمة “أليس في بلاد العجائب”، نسبة إلى الرواية ذائعة الصيت. وتُعرف أيضًا باسم متلازمة “تود” (Todd`s Syndrome) أو هلوسة القزم (Lilliputian Syndrome). وكان الدكتور “ليبمان” (C. W. Lippmann) أول من كتب عنها عام 1952م، تحت عنوان “هلوسة الصداع النصفي” (Certain Hallucinations Peculiar to Migraine).
أعراض غريبة وأسباب غامضة
في عام 1904م، أي بعد 40 عامًا تقريبًا من نشر الرواية للمرة الأولى، لاحظ الدكتور “ويليام سبراتلينغ” أحد علماء الصرع الأمريكيين الأوائل، إصابة عدد من مرضاه بحالة عصبية معقدة ونادرة من اضطراب الإدراك والهلوسة الحسية مشابهة تمامًا لتلك التي وصفها “لويس كارول” في روايته.
كان المرضى يقولون إن كل شيء يبدو بالنسبة لهم أكبر حجمًا، قبل تعرّضهم مباشرة لنوبات الصرع. كانت ملاحظة الدكتور “وليام” تلك، أول عملية رصد لأعراض المتلازمة. وبعد ثلاث سنوات، أبلغ طبيب الأعصاب البريطاني “ويليام جاورز” أيضًا عن عدد من مرضى الصرع، الذين تصوروا أن الأشياء تبدو ضعف حجمها خلال الفترة التي تسبق نوباتهم.
وفي عام 1913م، قابل طبيب الأعصاب الألماني “هيرمان أوبنهايم”، حالةً تعاني من نوبات عنيفة من الشقيقة التي يصاحبها شعور بانفصال جزء أو طرف من الجسم. ثم في عام 1952م، لاحظ طبيب الأعصاب الأمريكي “كارو ليبمان”، خلال بحث نُشر في مجلة الأمراض العصبية والعقلية، وجود تنوع كبير في الهلوسات التي تحدث خلال الفترة التي تسبق نوبات الشقيقة لدى المرضى الذين كان يُنظر إليهم في الكثير من الأحيان على أنهم موهومون؛ حيث تحدث بعض المرضى عن رؤيتهم لأجزاء مختلفة من الجسم تضاف إلى الأشخاص الذين أمامهم، مثل رؤية ذراع قصيرة ملتصقة بوجه الشخص الجالس أمامهم، أو رؤية الأشخاص أو الأشياء تتحرك ببطء أو بسرعة غير طبيعية، أو لا تتحرك على الإطلاق. وأبلغوا أيضًا عن رؤية أشياء أو أجزاء من أجسادهم تتقلص أو تكبر أمام أعينهم؛ ما يجعلهم يشعرون بأنهم يتغيرون من حيث الحجم.
لاحظ الدكتور “ليبمان” أن هناك تشوهًا في الطريقة التي يرى بها المصابون الأشياء من حولهم، وأحيانًا تشوّهًا في الطريقة التي يدركون بها أجسادهم والمساحة التي يشغلونها. ولاحظ أيضًا التشابه الكبير بين تجاربهم وتجربة “أليس” في الرواية، حيث تقول “أليس”: “يبدو جسدي كما لو أن أحدًا رسم خطًّا رأسيًّا يفصل بين نصفيه، ويبلغ النصف الأيمن ضعف حجم النصف الأيسر”. وفي اقتباس آخر: “كنت أعرف من أكون عندما استيقظت هذا الصباح، ولكن أعتقد أنني قد تغيرت عدة مرات منذ ذلك الحين”.
أدهش الطبيب اللماح مدى التطابق بين وصف المرضى في العيادة ووصف “أليس” في الرواية، وأصابته الحيرة، ولكنه تردد في إبلاغ الساحات الأكاديمية عن وجود علاقة بين هلوسات مرضى “الشقيقة” التي سجلها في ملاحظاته، وتلك التي وصفها كاتب شهير في رواية خيالية خالدة قبل أكثر من 80 عامًا.. لكنه كتب في ختام ورقته البحثية: “تحتوي رواية “أليس في بلاد العجائب” على سجل لمثل هذه الهلوسات، والعديد من هلوسات الشقيقة الأخرى”. ورجّح “ليبمان” أن يكون “لويس كارول” مؤلف الرواية نفسه، يعاني من “الشقيقة”.
لاحقًا، في عام 1955م، رصد أيضًا الطبيب النفسي الإنجليزي “جون توود” درجة التشابه القوي بين الأعراض الغريبة التي يصفها مرضى “الشقيقة”، والوصف الدقيق للتغير في الأشكال والأحجام للأعراض، الوارد على لسان بطلة الرواية، لكنه كان أجرأ من الدكتور “ليبمان”؛ فاقترح وصف مجموعة الأعراض تلك، بالمتلازمة، وأطلق عليها اسم “متلازمة أليس في بلاد العجائب”.
وهكذا قفز عنوان الرواية الشهيرة من أرفف الكتب والروايات في المكتبات، إلى أرفف القواميس والمراجع الطبية. وعُرفت فيما بعد أيضًا بـ”متلازمة توود”، نسبة إلى “جون توود” الذي تقدم بشرح مفصل لأعراض هذه المتلازمة في مجلة الرابطة الكندية للأطباء.
الدماغ وليس العين
المشكلة عصبية بالدرجة الأولى، حيث تحدث التشوهات البصرية واضطرابات الرؤية على الرغم من أن الجهاز البصري سليم تمامًا، لكنها نتج عن تعطيل الرسائل التي ترسلها العين إلى مركز الأوامر البصرية في الدماغ، في الوقت الذي يتعرض فيه ذلك الجزء من الدماغ إلى موجة كهربية عنيفة تشبه العاصفة، تؤدي إلى حدوث اضطراب في ترجمة الصور التي ترسلها العين. هذا الخلل في الإدراك البصري، هو ما يجعل الصور تبدو مشوهة وذات أبعاد وأحجام غريبة مختلفة عن حقيقتها.
ولا يوجد فحص موحد يقوم بتشخيص المتلازمة، إنما يتم التشخيص عن طريق استبعاد الأسباب أو التفسيرات المحتملة الأخرى. ومن الفحوصات المساعدة: التصوير بالرنين المغناطيسي الذي يُظهر صورًا تفصيلية للدماغ، والتخطيط الكهربائي للدماغ (رسم المخ)، الذي يقيس النشاط الكهربائي للدماغ، بالإضافة إلى بعض تحاليل الدم لاستبعاد أو تشخيص حالات العدوى الفيروسية التي قد تسبب المتلازمة.
الأطفال أكثر عرضة
تُعدّ متلازمة “أليس في بلاد العجائب” نادرة الحدوث، فمنذ أن أطلق عليها “جون توود” هذا الاسم في عام 1955م، لم يُسجل عنها في الدوريات الطبية سوى أقل من 200 حالة، لكن بحسب موقع “Neurology Live”، فإن توثيق أعداد الإصابات بتلك المتلازمة غير واضح بشكل دقيق، لأنه من غير المرجح أن يقوم معظم الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة بإبلاغ أخصائي طبي عنها، لعدم استيعابهم لأسباب حدوثها، أو مدى دقة ما يعانون منه فعلاً. من جهة أخرى، لا يعرف الكثير من الأطباء هذه المتلازمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخر تشخيصها وعلاجها على نحو صحيح. غالبية الأشخاص البالغين الذين أبلغوا عن إصابتهم بهذه المتلازمة، كانوا من مرضى “الشقيقة” أو الصرع أو رضوض الرأس.
وبالرغم من أن هذه المتلازمة قد تصيب الشخص في أي سن، إلا أنها تعد أكثر شيوعًا بين الأطفال البالغ متوسط أعمارهم تسعة أعوام. كما لوحظ أن الأطفال المصابين بها، أكثر عرضة للإصابة بالشقيقة مع تقدمهم في السن.
ما هو العلاج؟
لا يوجد علاج محدد فعَّال لهذه المتلازمة، إنما تتم المعالجة عبر السيطرة على السبب المؤدي لها. وعادة ما تُطبّق برامج العلاج الخاصة بالأسباب المحتملة، وفقًا لطبيعة الحالة ونوع المسبب؛ للتخفيف من حدة الأعراض. على سبيل المثال، إذا كانت الشقيقة هي المسبب الرئيس، يكون العلاج التقليدي للشقيقة هو أفضل طريقة للتخفيف من أعراض المتلازمة، وبالمثل، إذا كانت المتلازمة ناتجة عن العدوى، فإن علاج العدوى يمكن أن يساعد في وقف الأعراض. ووفقًا لموقع UPMC الصحي، فإن أفضل طريقة لعلاج هذه المتلازمة هي ببساطة، مساعدة المريض على الشعور براحة أكبر وعلى استيعاب أن ما يراه ليس حقيقيًّا، ولكن هذا “البرنامج” أيضًا غير مضمون النتائج بصورة دقيقة.
(*) طبيبة متخصصة في علم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة / مصر.
المراجع:
(1) Carroll, L. (1865), Alice’s adventures in Wonderland, New York, NY: D. Appleton and Co. Lippman, C.W. (1952). Certain hallucinations peculiar to migraine. Journal of Nervous and Mental Diseases, 116, 346–351.
(2) Todd, J. (1955), The syndrome of Alice in Wonderland, Canadian Medical Association Journal, 73, 701–704.
(3) Carmichael, C. (1996). Wonderland revisited. London Miscellany, 28, 19–28.
(4) Kew, J.,Wright, A.,Halligan, P.W. (1998). Somesthetic aura: The experience of “Alice in Wonderland”. The Lancet, 351, 1934.