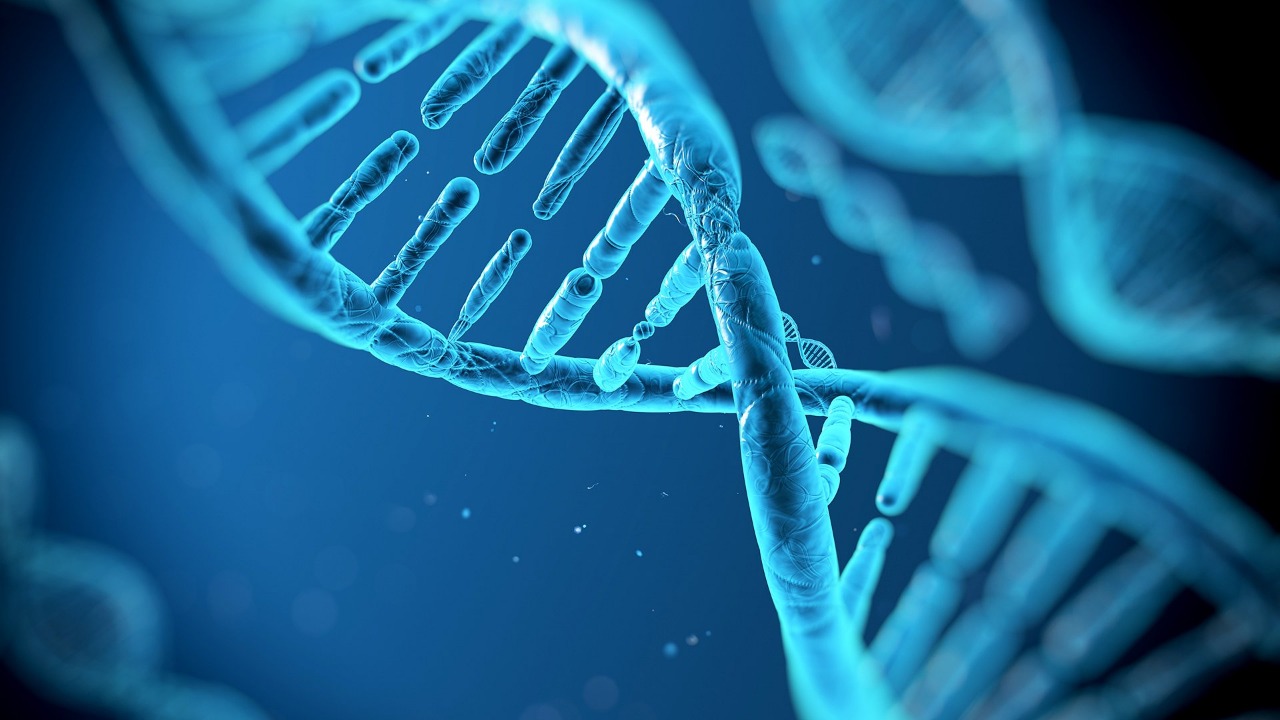الحداثة موقف فكري جديد ورؤية فلسفية للنظر إلى الذات والعالم طبقًا لمنظورات مختلفة عن المرجعيات التقليدية الموروثة والمرجعيات المستعارة من الآخر، وغايتها إعادة ترتيب الواقع والفكر طبقًا لحاجات اللحظة التاريخية المتجددة . وهي لا تقر بالثبات إنما تتطلع دائمًا إلى التجدد، وبذلك تنتج فكرًا يتحول باستمرار متخطيًا فكرة الهوية القارة واليقين الثابت، وبهما تستبدل هوية ثقافية وقيمية متحولة ومنفتحة تقر بنسبية علاقتها مع نفسها وتاريخها وفرضياتها بالدرجة نفسها التي تقر فيها بنسبية الهويات الأخرى، وتشكل مضمونها من نسيج متنوع الموارد يقوم على فكرة الحوار والتواصل والتفاعل، ثم تقليب المفاهيم والنظريات والمرجعيات الموروثة والمستعارة على كل الأوجه والاحتمالات عبر ممارسة نقدية جريئة. فبدون النقد تظل العلاقة مع المؤثرات الأخرى علاقة استتباع وخوف وقلق وتوتر.
لا سبيل لتجاوز سلبيات الأيديولوجيات التراثية إلا بمواجهة الذات أولاً للتعرف على أسباب الضعف التي أدت إلى هذا السبات الطويل من التأخر، وبالاعتراف على “الآخر المتفوق” ثانيًا.
ولذلك نحن نسلم مع الدكتور “أنطوان سيف ” بأن وهن الثقافة العربية الراهنة ليس ناجمًا عن غربتها عن تاريخها، بل ناجم عن غربتها عن “تاريخيتها “، أي عن عدم وعيها شروط موقعها في بنية المرحلة التاريخية ماضيًا وراهنًا.
وقد تزعم الثقافة العربية والإسلامية الآن، أنها متفوقة على جميع الثقافات الأخرى، وقد تدّعي أنها تمتلك أدوات معرفية فوق كل شبهة، ولكن هل هذا سيكون كافيًا ليمكّنها من الانكفاء على ذاتها، ويجنّبها الاحتكاك بثقافات أخرى متفوقة عليها؟ أم أنها ستضطر في الأخير إلى الاعتراف بـ”الآخر المتفوق” وإن كان خصمًا لها أو عدوًّا؟
أوليس من المفارقات أن تتحدث هذه الثقافة بكل فخر عن تلك الحقبة من التاريخ، التي سيطرت فيها على العالم، وساهمت في تكوين ثقافة الآخر، والتي بفضلها خرجت الثقافة الغربية من عصورها المتخلفة والمظلمة، وشهدت نهضة استمرت في التقدم دون انقطاع إلى وقتنا الحاضر، وبالمقابل ترفض أن تدخل مع هذا الآخر في عملية ” مثاقفة” ولكن في الاتجاه المعاكس هذه المرة، رغم أن ظروف العصر تتطلب وبإلحاح ذلك؟ !
ومن هذا المنطلق، يعتقد الباحث “أنطوان سيف ” أن ” انكفاء الوعي على ذاته بعد ارتداده عن الموضوعات الخارجية التي كان يشرف عليها بثقة مفرطة بذاته، هو حافز لارتقائه إلى فكر ناقد لأدوات عمله، وإلى فكر مُسائل مساءلة استعلائية حول ماهيته وهويته”.
ولا سبيل لتجاوز سلبيات الأيديولوجيات التراثية إلا بمواجهة الذات أولاً؛ للتعرف على أسباب الضعف التي أدت إلى هذا السبات الطويل من التأخر، وبالاعتراف على “الآخر المتفوق ” ثانيًا؛ لأن الرهان الأجدى ” هو المبني على معركة فكرية تعرف عناصرها معرفة معمقة”. ويرى الباحث أن هذه المعرفة مستحيلة ما لم ننفتح على الخصم: “إنه منطق تاريخ الثقافة وحياتها ودورها ووظيفتها “، بل ويذهب “سيف” إلى أبعد من ذلك عندما يقرر أن “الخصم ” “هو ضرورة ثقافية، نقيض ضروري، وتزداد ضرورته قيمة مع قيمة طروحاته وتحديها لنا، وقدرته على زحزحة بُنى فكرنا، وتأخذ المثقافة معناها وتعنى بمتطلبات وظيفتها بقدر ما يقترب أطراف التثاقف من التوازن في التحدي المتبادل”.
رهاننا هنا هو الشروع في مواجهة الذات ووعيها، والشروع في نقد أدواتها المعرفية من أجل الاستفادة من إيجابيات “المثقافة” مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن الحاضر متصل بالماضي، وأنه من المستحيل أن توجد “قطيعة ثقافية” بالمعنى الحرفي والمطلق، وأن كل حضارة هي عبارة عن تراكمات تتصل بالماضي. لذا فلا معنى لدعوة من ينادي باستعادة التاريخ من أجل علاج الأزمات والتحديات التي تواجهها الثقافة العربية والإسلامية، ذلك لأننا لم نفقد التاريخ لكي ننادي باستعادته، فالماضي والحاضر تاريخ واحد يتحرك إلى الأمام، وهو غير قابل للارتداد أبدًا.
ومن هنا علينا أن نسلم بأن النخبة العربية الثقافية لم تدرك أهمية دورها، ولم تمارس شيئًا من ذلك الدور، إذ إن نسيج المجتمع التقليدي لم يتعرض للتحليل والتشريح والنقد، فنشأ مع الزمن خوف من الاقتراب إلى هذا الموضوع الذي يكاد يعتبره الجميع قيمًا مقدسة لا يصح نقدها. والحق، ما من مسافة تفصل المثقف العربي عن شيء آخر، أبعد من المسافة التي تفصله عن مجتمعه، وحتى لو ادعى الاقتراب إليه فهو اقتراب محكوم بدرجة عالية من سوء التفاهم وسوء الظن. وهذا الوضع هو الذي قاد – وبصورة لا تقبل اللبس- إلى نبذ المجتمع للمثقف وعدم تقديره دوره، إلا بوصفه كائنًا غريبًا يُحتفى أحيانًا به لكن لا موقع فاعلاًله في الأوساط الاجتماعية.
لا معنى لدعوة من ينادي باستعادة التاريخ من أجل علاج الأزمات والتحديات التي تواجهها الثقافة العربية والإسلامية، ذلك لأننا لم نفقد التاريخ لكي ننادي باستعادته، فالماضي والحاضر تاريخ واحد يتحرك إلى الأمام، وهو غير قابل للارتداد أبدًا.
ومن المؤسف أن أفضل التحليلات الفكرية والأنثربولوجية والتاريخية والاجتماعية والأدبية المعتمدة في الأوساط الأكاديمية التربوية، قام بها دارسون غربيون لمجتمعنا وثقافتنا وديننا وتقاليدنا وأدبنا، وهي تحليلات تعكس رؤيتهم ومرجعيتهم التي يصدرون عنها أكثر مما تعبر عن حقيقة الموضوعات التي درستها، وكثيرًا ما جرى تعسف في إخضاع المادة المدروسة لتوافق الخلفيات الثقافية التي توجههم، وذلك يفضح قصور النخبة الثقافية التي لا يمكن وصفها إلا بأنها تلاعبت بمجتمعها دون أن تضع في اعتبارها أمر تحديثه، ولهذا نبذت وتقطعت روابطها، وانعزلت عن خلفياتها الاجتماعية، واستأثرت بالمكانة النخب الدينية والسياسية والعسكرية.
ومن الواضح أن تواطؤًا قد وقع بين هذه النخب أفضى إلى استبعاد النخبة الثقافية التي لم تنجح من قبل في إنجاز وعودها، إلى درجة صار سؤال التحديث – الذي يفترض أن تثيره النخبة الثقافية سؤالاً محضورًا ومشبعًا بمعاني تثير المخاوف في المجتمع وتبعث استعداء للمثقف، مما جعل سؤال الحداثة اليوم بالنسبة للعرب والمسلمين لا جواب عليه، فهو ضائع في خضمّ التوترات العرقية والمذهبية، ومتقطع بين التطلعات المتناقضة، وعالق بين التيارات المتعارضة، وشبه مفرغ من المعنى في ظل العولمة.
في بحث مطول وتحت عنوان “نحو تحرير الروح العربية الإسلامية من عقالها” كتب هاشم صالح عن أمنيته في حدوث كارثة، لكن كارثة من شأنها أن تدفع إلى انهيار. وهو يشدد على ذلك بقوله:”ينبغي أن يحصل انهيار وأن يتفجر في وجهنا الزلزال” ، فمن شأن الانهيار أن يولد مزيدًا من الأسئلة، بصورة أدق أن يدفع بالأسئلة المحجوبة في أعماق الواقع والمكبوتة في تلافيفه إلى الواجهة .
إن هاشم صالح يدفع إلى الواجهة بنظرية التحدي والاستجابة، ولكن بصورة أكثر فجائعية، بحيث يمكن القول إنها التعبير الأكثر حدة عن أيديولوجيا الإحباط التي تستبطن مسيرة الخطاب العربي المعاصر والتي تدفعه إلى النكوص على عقبيه، والدعاء على مجتمعه بالويل والثبور، بصورة أدق بالقيام بإحراق البجعة المحتضرة (المجتمع العربي التقليدي) وإعادة بنائه من جديد على غرار الغرب كما دعانا بعض المفكرين العرب في أواسط عقد السبعينات من القرن المنصرم.
تجديد القيم التي يجب أن ينشأ عليها العربي منذ الطفولة وما بعدها، ليس بالتلقين وفرض الامتثال، بل بخلق المجالات والأجواء الضرورية للتعلم من خلال الممارسة اليومية وانفتاح الآفاق واتساع الرؤية.
إن فجوة عميقة تفصل بين الواقع والحلم في الحياة العربية والإسلامية الحديثة “وفي الوقت الذي ينزع فيه الشعب نحو التوحد محليًّا أو إقليميًّا، أو على صعيد عربي شامل، وتعلن الطبقات الحاكمة عن تمسكها بالهوية العربية في تصريحاتها وخطبها العامة ودساتيرها التي نادرًا ما تتقيد بها، نجد أن المجتمع العربي يزداد معاناة من التشتت والتنافر والعجز والتراجع أكثر من ارتباطها بنفسها”.
ومن هنا يرى الباحث “حليم بركات” أن الحل يكمن في بروز نوع ثالث ما بين القطري والقومي، ينطلق للعمل المشترك على رؤية حضارية تفهم الهوية على أنها دائرة منفتحة على التاريخ والواقع والحضارات الأخرى، ولكنها تؤكد -في الوقت ذاته- على حقوقها بقدر ما تحترم غيرها. هذا هو النزوع الذي لم يترسخ بعد في الثقافة العربية، لذا ليس من الغريب -إذن- أن يستمر المجتمع العربي والإسلامي في موقعه الهامشي ساعيًا بإحساس مأساوي لتجاوز الحاضر.
لقد انطلق الكاتب حليم بركات في رؤيته للتغيير التجاوزي من عبارة جميلة لجبران خليل جبران قال فيها :”ليس التقدم بتحسين ما كان، بل بالسير نحو ما سيكون”. وهي تشكل ركيزة مهمة لمسألة التغيير التجاوزي بمختلف إشكالياتها. انطلاقًا من هذه الرؤية المنهجية يدعو الباحث إلى “ثقافة التحول الشامل من حالة الانفعال إلى حالة الفعل بالتاريخ، وذلك بتجاوز الأوضاع والأنظمة السائدة التي هي في صلب استمرارية التخلف العربي والإسلامي وتجلياته وإحباطاته ومشاريعه المستقبلية.
ويرى الباحث ” مسعود ضاهر ” أن مبرر هذه الدعوة إلى التغيير التجاوزي الشمولي، يكمن في رؤية المجتمع العربي الراهن على حقيقته “كمجتمع مغلق ومنكفئ على ذاته، ومُصر على التمسك بثقافته ومؤسساته التقليدية التي تقاوم التغيير والتفاعل الجريء مع الحضارات الأخرى من موقع غياب الثقة بالذات ومخاوف الانزلاق في متاهات التاريخ”. لذا تندرج توصيات الباحث في إطار تعزيز دور المثقف المبدع في عملية التغيير، وليس تجسير الفجوة مع الأنظمة السلطوية الحاكمة في الوطن العربي، وأبرز تلك التوصيات هي :
-العمل على أن تنال المؤسسات الثقافية الرسمية وشبه الرسمية الاستقلالية الضرورية للتعبير عن نفسها بحرية، ويرافق هذا العمل تشجيع قيام المؤسسات والجمعيات الثقافية الطوعية.
-تجديد القيم التي يجب أن ينشأ عليها العربي منذ الطفولة وما بعدها، ليس بالتلقين وفرض الامتثال، بل بخلق المجالات والأجواء الضرورية للتعلم من خلال الممارسة اليومية وانفتاح الآفاق واتساع الرؤية.
-إحداث ثورة في التعليم الجامعي بإحداث موازنة خلاقة بين التعليم والبحث وخدمة المجتمع وبين العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانية والفنون، لا بل إنشاء معاهد ومراكز الأبحاث في المجالات كافة بدءًا من تلك التي لها علاقة بالواقع وحاجات المجتمع والشعب.
-التعامل مع النظام الكوني الجديد من موقع الاستقلالية، والاستفادة من الثورات المعلوماتية من دون تجاهل الجانب المظلم من العولمة. لا بد للمثقف العربي من التمرس بالإبداع من دون خوف أو رقابة ذاتية، وبهذا لا يفكر فقط بما اعتدنا التفكير فيه ولا بما يسمح له بالتفكير به، بل بما يمكن التفكير فيه.
-وأخيرًا وبقدر المطالبة من قبل المثقفين بإطلاق حرية التفكير النقدي والتساؤلي، وحرية الصراع الثقافي بحصول الاستقلالية عن سطوة الدولة على الثقافة، لا بد للمثقفين أنفسهم من معالجة مشكلة عزلة المثقف عن الشعب، وفي إقامته علاقة سليمة بين المثقفين والشعب.
(*) رئيس قسم الفلسفة والاجتماع، كلية التربية، جامعة عين شمس / مصر .
المراجع
- وعي الذات وصدمة الآخر، لأنطوان سيف، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت 2001 م.
- نحو تحرير الروح العربية الإسلامية من عقالها، لهاشم صالح، مجلة نزوي، العدد 8، 1996م.
- المجتمع العربي في القرن العشرين، لحليم بركات، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2001 م.