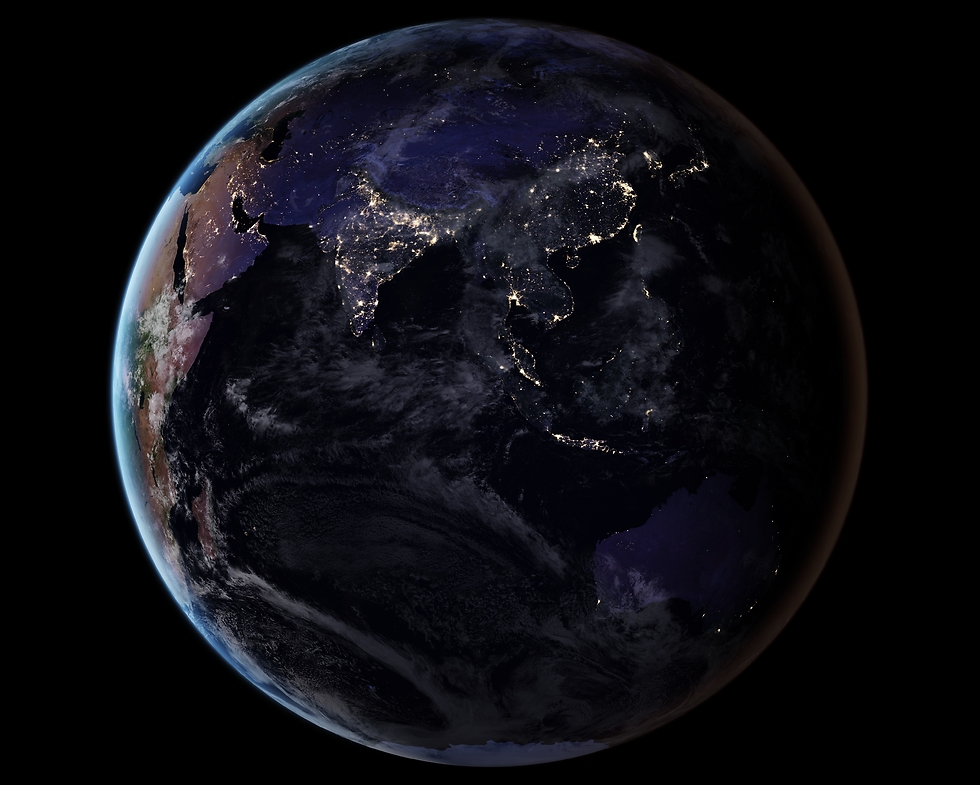يٌعد الإسلام من أسرع الأديان انتشارًا على وجه المعمورة، وذلك من نعم الله تعالى علينا حيث إنه نشأ في بيئة صحراوية. وبالرغم من هذا فقد انتشر سريعًا كانتشار النار في الحطب ويمكننا أن نقارن انتشار الإسلام بفتوحات الإسكندر الأكبر (توفي 323 قبل الميلاد).
فقد حاول بعض المستشرقين تشبيه انتشار الإسلام بفتوحات الإسكندر الأكبر، لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الإسكندر وثقافته الإغريقية لم يؤثروا بشكل مباشر وفعّال في ثقافة وعادات البلاد المفتوحة، بعكس الإسلام فقد أثر تأثيرًا مباشرًا في كل شيء.
ولكن حقيقة الإسكندر أن أعماله لم تتجاوز مجال التعمير الحضاري، أما مجموعات الشعوب والفلاحين الذين قيل عنهم “لا يعد الفتح فتحًا إذا لم يؤثر على عقولهم”، فقد احتفظوا بطابعهم الخاص دون أي تغيير، فاللغة والأخلاق والنظم السياسية والاقتصادية ظلت كما كانت. وحتى في المدن نجد أن الأفكار والعادات اليونانية التي كانت تتمثل في طبقة الموظفين والإداريين لم تتأصل إلا في أقلية من التجار الرأسماليين.
فإن نظرنا إلى تاريخ الإسكندر وسياسته في التعامل مع البلاد المفتوحة نجد أنه لم ينقل معه الفكر اليوناني ولكنه تبنى ثقافة وأديان البلاد المفتوحة. فعلى سبيل المثال نجد أنه عندما جاء إلى مصر ذهب مباشرة إلى معبد أمون ولمّا وصل المعبد ودخله، قوبل بالترحاب من قبل الكهنة المنتظرين، الذين نصَّبوه فرعونًا على مصر وأعلنوه ابنًا لآمون كبير الآلهة المصرية، وألبسوه تاجه، وهذا يعني أن الإسكندر صبغ نفسه بصبغة البلاد المفتوحة وذلك لكي يتم الترحيب والقبول به من أصحاب هذه البلاد.
وأما عن الإسلام فمن الواجب معرفة أن الإسلام لم يتبنَّ الأفكار والثقافات الغربية أو ثقافات البلاد المفتوحة، وأيضًا لم يقتصر الإسلام على الطبقات البرجوازية فقط، ولكن وصل إلى قلوب كل الناس سواء فلاحين أو غيرهم وتغلغل في الأعماق النفسية لهذه الشعوب جميعًا، فاللغات والأفكار والقانون والآمال والعادات وتصور العالم وفكرة الله كل ذلك طرأ عليه تغيير جذري سريع.
نظرة تاريخية عن منشأ الصراع الحزبي في الإسلام
بدأ الإسلام مع نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، ومنذ أن أعلن النبي عن دعوته في مكة بدأ الكفار في شن الحرب على المسلمين واضطهادهم، ولكن في نفس الوقت لم يأذن المسلمون أن يدافعوا عن أنفسهم لذلك جاء الأمر الإلهي لصحابة النبي بالهجرة الى الحبشة، وبعدها بقليل غادر النبي مكة سرًا إلى المدينة ومنها شيد النبي مسجده وبدأ في إنشاء الدولة الإسلامية في المدينة وتكوين جيش قوي يستطيع الدفاع عن المدينة وصد هجمات الأعداء المتكررة.
ولقد أوضحت السنة شروط تعامل النبي مع سكان البلاد المفتوحة وما يجب على المسلمين فعله تجاههم فالنساء، والأولاد والشيوخ والعميان والعجزة والمزارعون في حقولهم والمتعبدون في صوامعهم لا يتعرضون للأعمال الحربية ولا إلى أي أعمال تؤدي إلى التدمير بوجه عام مثل الفيضان والحريق وحتى إلى ملاحقة العدو إذا حاول الفرار، فالهدف الأساسي من تكوين جيش لم يكن لشن الحروب ولكن للدفاع عن الدين والإسلام ضد الغزاة.
الغرض الحقيقي من الحروب
كما أوضحنا فالهدف من إنشاء جيش إسلامي هو إبعاد الخطر، فالإسلام يدين روح التدمير وروح السيطرة، ولا يسعى لفرض أيدولوجية “فكرية” عالمية فكما هو معروف في القرآن الكريم (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ)، إذًا فالرسول الكريم لم يكن من الممكن له أن يحاول تغيير سنة من سنن الله في الكون، ولكن الغرض الأساسي من الحروب الإسلامية أو الغزوات الإسلامية كان لتحديد العلاقة بين جماعة المسلمين وبين الأمم والأديان الأخرى والمعروف بمبدأ “التسامح”.