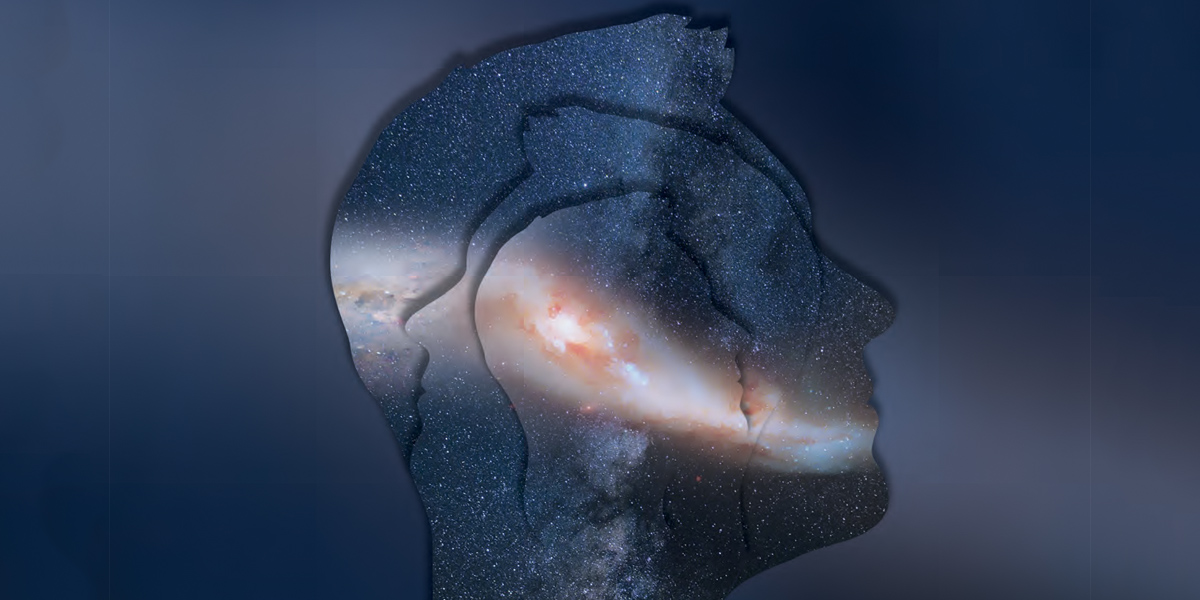إن للإسلام والمسلمين مواقف نبيلة في قبول الآخر والتعايش معه في أمن وأمان وسلام واطمئنان.
فالديانات السماوية مصدرها واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وإن الإسلام جاء ليخاطب البشر جميعًا، ومن ثم فلا بد وأن يتضمن اعترافه بما سبقه من رسالات سماوية، فجوهرها كلها واحد، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم بقول الله تعالى: (مَا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ)(فصلت:43)، وقوله تعالى: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ)(الشورى:13).
ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: “إن مثَلي ومثَل الأنبياء قبلي كمثَل رجل بنى بيتًا فجمَّله وحسَّنه إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين” (رواه البخاري).
التسامح الثقافي يتضمن كفالة الحق في الاختلاف مع الآخر عن طريق الحوار المتكافئ. ولا يجوز لأحد أن يدعي امتلاك الحقيقة المطلقة، أو أنه دائمًا على حق، وغيره دائمًا على الباطل.
وقد كفل الإسلام حرية العقيدة بشكل واضح لا لبس فيه، وهي تعني في أبسط وأوضح معانيها، عدم إلزام المواطن على القبول بعقيدة لا يؤمن بها، أو الخروج من عقيدة دخل فيها، كما تعني أيضًا عدم جواز إكراه الشخص على ممالأة إحدى الديانات تحاملاً على غيرها، سواء بإنكارها أو التهوين من شأنها أو الحط من قدرها: (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)(البقرة: 256). وقد تأكد هذا المعنى عدة مرات في القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى:(وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا)(يونس:99).
أما الحكمة من وراء ذلك فتتمثل في أن الإكراه يقهر النفس الإنسانية ويذلها، ويحطم الشخصية الإنسانية، ويزرع في القلوب الضغائن والأحقاد، وقد يؤدي إلى النفور بدلاً من التوافق، وردود الأفعال المناوئة حينما تسنح الفرص وتتهيأ الظروف، كما قد يبذر بذور الرياء والنفاق في المجتمع فيُبدي المُكره غير ما يُبطِن، فضلاً عن أن الإكراه يسيء إلى الإسلام، وبالتالي فالإيمان عن طريق الضغط والإكراه غير مقبول عند الله تعالى، ولهذا دعا الإسلام إلى الدخول فيه طواعية عن حب وإيمان واقتناع.
احترام الإنسان وكرامته
أرسى الإسلام قواعد قبول الآخر واحترامه على الرغم من الاختلاف معه في العقيدة، ذلك لأنه إنسان. ونستشف هذا مما جاء في القرآن الكريم: (لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ)(التين:4).
فهذه الآية وغيرها عامة شاملةٌ كل إنسان، وعلى الإنسان أن يحافظ على هذه الكرامة أو الخلافة؛ فهو مستخلف من الله لعمارة الأرض، وما أرفعها من منزلة، وما أثقلها من أمانة، كلف الله بها الإنسان وقَبِل الإنسان حملها. فالله تعالى خلق الناس من نفس واحدة مصداقًا لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً)(النساء:1).
ولهذا فينبغي الحرص عند التعامل مع الآخر أو فض الخصومات معه، على قيمةٍ من أنبل قيم الحضارة التي أمر بها الله المسلمين، ألا وهي قيمة العدل: (وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)(النساء:58).
ولقد تكرس مبدأ المساواة بناء على تكريم الله تعالى للإنسان، فهو القائل سبحانه وتعالى:(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)(الإسراء:70)، وعلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث شريفة كثيرة، كما سار على هذا النهج الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم أجمعين؛ وقد أُثِرَ في “نهج البلاغة” قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، حينما أوصى واليه على مصر “مالك الأشتر”: “واعلم أن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق”.
لقد بلغت سماحة الإسلام أن سمح للمسلمين بألا تقتصر تعاملاتهم مع المخالفين لهم في الدين على التعامل الحسن بالقول، بل تعدّّى ذلك إلى الفعل والإهداء إليهم.
ورد في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال: “كنَّا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء مشرك مشعان طويل (أي طويل شعث الشعر) بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “بيعًا أم عَطية؟” (أو قال: أم هِبة)، فقال: لا، بيع، فاشترى منه شاة؛ وفي الحديث دلالة على جواز بيع غير المسلم وقبول الهدية منه.
التسامح مع الآخر
من معاني التسامح التقليدية، أنه جهد يقوم به المتسامح لتفادي التصادم مع الآخر إزاء أفعال وهفوات صدرت منه، والتي تكون عادة موضع مؤاخذة ولوم من جانب المجتمع، لأنها لا تتفق مع قيمه، وما تعارف عليه من تقاليد وأعراف.
أما التسامح الثقافي، فإنه يتضمن كفالة الحق في الاختلاف مع الآخر، لا سيما عن طريق الحوار المتكافئ. ولذا فقد شاعت في أيامنا هذه مقولة جديرة بالاعتبار وهي “الاختلاف في الرأي لا يُفسِدُ للود قضية”. ومن ثم لا يجوز في المفهوم الحضاري للتسامح، أن يضيق المرء بمن يخالفونه في الرأي، حتى لو كانوا على خطأ وهو على صواب من وجهة نظره، ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يدعي امتلاك الحقيقة المطلقة، أو أنه دائمًا على حق، وغيره دائمًا على الباطل.
والتراث الإسلامي مليء بالأمثلة القيمة التي يفوح منها عبير التواضع الجميل، والتي تعبر عن هذا أصدق وأوضح تعبير، ويكفينا مثالاً واحدًا منها؛ فقد أثر عن الإمام الشافعي قوله في هذا الصدد: “رأيُنا صواب يحتمل الخطأ، ورأيُ غيرنا خطأ يحتمل الصواب”.
وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أنبل مَثَل في التسامح -عملاً وقولاً- حينما دخل مكة فاتحًا منتصرًا، راكبًا دابته مطأطئ الرأس، متواضعًا لله مُخبتًا لمولاه، ثم جعل يجري حواره الشهير بينه وبين قومه الذين آذوه من قبل، وأخرجوه بليل من بلده العزيز عليه مكة المكرمة، فابتدرهم بقوله: “ماذا تظنون أني فاعل بكم؟” قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، قال: “لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء”.
لا شك في أنه حوار خالد يتردد صداه بطول التاريخ الإنساني، ليعلن للعالم كله أن محمد بن عبد الله هو إمام أهل العفو، وقدوة المتسامحين إلى أبد الآبدين.