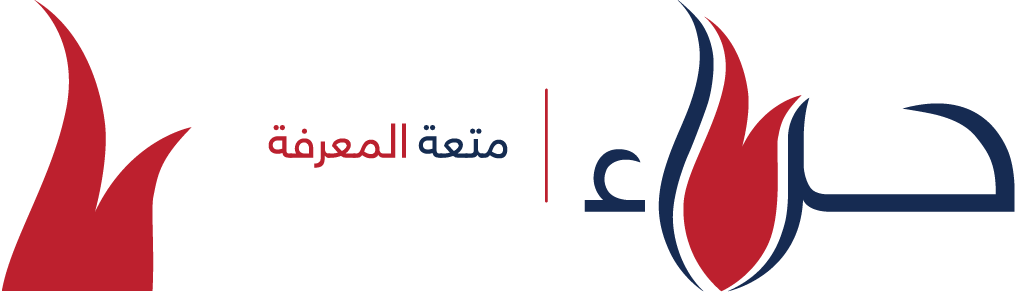الجماعة العلمية هي تجمعات من العلماء والباحثين الذين يعملون معًا لتحقيق أهداف مشتركة في مجالات معينة من البحث العلمي والتكنولوجي. وتتميز هذه الجماعات بتبادل الأفكار والخبرات، مما يساهم في تحقيق اكتشافات وابتكارات جديدة قد يكون من الصعب على الفرد الواحد الوصول إليها بمفرده.
ففي كتابه الشهير “بنية الثورات العلمية” (1962م)، أشار “توماس كون” إلى أن الجماعات العلمية تلعب دورًا محوريًّا في تطور العلم، من خلال ما أسماه “النماذج العلمية” أو “البارادايم”، فهو يرى أن الجماعات العلمية تتكون من علماء يتشاركون في نماذج فكرية ومنهجيات بحثية مشتركة، مما يمكنهم من حل المشكلات العلمية بفعالية.
أما “روبرت ميرتون” عالم الاجتماع الأمريكي المعروف، فقد قدم مفهوم “الأنظمة الاجتماعية للعلم”، حيث اعتبر أن الجماعات العلمية هي بمثابة أنظمة اجتماعية تحتكم إلى قواعد وأعراف مشتركة، مثل الاعتماد المتبادل والمنافسة والتعاون، وقد أوضح أن الجماعات العلمية تتبنى مبادئ النزاهة والأصالة والتقييم المتبادل بين الأقران لضمان تقدم العلم بشكل جماعي. وفي دراستها حول ديناميكيات الجماعات العلمية، اقترحت “ديانا كراين” أن تعمل الجماعات العلمية كشبكات اجتماعية تتبادل فيها المعرفة والمعلومات بطرق تعزز من الكفاءة والإبداع، وقد أكدت أن هذه الجماعات تعتمد على التواصل الفعال والموارد المشتركة لتحقيق الأهداف العلمية.
أما الدكتور “محمد باباعمي” فيرى أن الجماعة العلمية هي كيان اجتماعي يتألف من العلماء والباحثين الذين يتعاونون في البحث وتبادل المعرفة، هذا التعاون ليس مجرد تجميع للأفراد، بل هو علاقة حيوية تؤدي إلى نمو العلم وازدهاره، إذ يعتبر أن قوة العلم تتناسب طرديًّا مع قوة العلاقات بين العلماء، حيث يقول: “إذا كانت هذه العلاقة قوية يقوى العلم وينمو، وبالعكس يفتر العلم ويضعُف”.
ويؤكد “باباعمي” على أن الجماعة العلمية تساهم بشكل كبير في تحقيق التقدم العلمي، من خلال تضافر الجهود وتبادل الخبرات بين العلماء، فالعمل الجماعي -عنده- يعزز من كفاءة البحث العلمي ويسرع وتيرة الاكتشافات، كما يدعم تطوير الحلول للمشكلات المعقدة التي تواجه المجتمع. ويشير إلى أن الجماعة العلمية لا تقتصر على الجامعات والمراكز البحثية، بل تشمل كل المؤسسات التعليمية والثقافية التي تساهم في نشر المعرفة.
والفرق بين رؤية الدكتور باباعمي وغيره من العلماء السابقين، أنه يستلهم هذا المفهوم من التراث الإسلامي؛ حيث يشير إلى أن الإسلام يعزز من أهمية التعاون والعلاقات القوية بين الأفراد لتحقيق الرقي الحضاري، ويتجلى ذلك في نصوص القرآن الكريم وتطبيقات السنة النبوية التي تؤكد على أهمية العمل الجماعي المشترك، كما يؤكد على أن الحب في الله وروح الجماعة يجب أن تكون الدافع الأساسي للعلاقات بين العلماء، مما يعزز من قدرتهم على العمل المشترك وتحقيق الإنجازات العلمية.
الجماعات العلمية في التراث الإسلامي
وهنا يدفعنا التساؤل إلى تاريخ الجماعات العلمية في التراث الإسلامي، وتجلياتها في الحضارة العربية والإسلامية، ففي حين نسمع عن أسماء مفردة أسهمت في صنع الحضارة العلمية الإسلامية، مثل ابن سينا وابن الهيثم وابن رشد وابن حيان وغيرهم، وهم علماء أفراد، نجد أيضًا أن الجماعة العلمية لعبت دورًا حيويًّا في نهضة العلوم والمعارف، خاصة خلال العصر الذهبي للإسلام (القرن الثامن إلى الرابع عشر الميلادي)، فقد شهد هذا العصر طفرة هائلة في البحث العلمي والتطوير بفضل التعاون بين العلماء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وقد تجلى ذلك في بيت الحكمة الذي أنشأه الخليفة العباسي المأمون في بغداد، فقد كان مركزًا علميًّا ومكتبة ضخمة، وجمع بين العلماء من مختلف التخصصات والثقافات، بما في ذلك الفرس والعرب واليونانيون والهنود، حيث عملوا معًا على ترجمة الكتب القديمة من اليونانية والفارسية والسنسكريتية إلى العربية، مما ساهم في نقل العلوم والمعارف من الحضارات القديمة إلى العالم الإسلامي.
وبفضل جهودهم الجماعية تلك في بيت الحكمة، ترجمت عديد من الأعمال الكلاسيكية في الطب والفلسفة والفلك والرياضيات إلى اللغة العربية، على سبيل المثال، فقد ترجمت أعمال أفلاطون وأرسطو وأبقراط وجالينوس، مما أدى إلى إثراء المعرفة العلمية في العالم الإسلامي. ولم يقتصر دور العلماء في بيت الحكمة على الترجمة فقط، بل طوروا وابتكروا في مختلف المجالات العلمية.
وإلى جانب بيت الحكمة، شهد العالم الإسلامي العديد من المراكز العلمية الأخرى التي لعبت دورًا مماثلًا في تعزيز العلم والمعرفة، ومنها دار العلم في القاهرة، التي تأسست في القرن العاشر الميلادي في عهد الفاطميين، وكانت مشابهة لبيت الحكمة في دورها كمركز للبحث العلمي والتبادل الثقافي، حيث جمعت العلماء والمفكرين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وشجعت على البحث والتعلم في مجالات متنوعة، وكذلك كانت الأندلس مركزًا آخر للنهضة العلمية الإسلامية، فمدن مثل قرطبة وطليطلة كانت مراكز علمية هامة، حيث توافد العلماء إليها من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وكذلك ترجمت الأعمال العلمية والفلسفية إلى اللاتينية، مما ساهم في نقل المعرفة إلى أوروبا الغربية وأسهم في انطلاق عصر النهضة الأوروبي.
الجمعيات العلمية خلال عصر النهضة الأوروبي
وخلال عصر النهضة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، بدأت الجماعة العلمية تأخذ شكلها المعاصر في أوروبا، حيث انتشرت الأكاديميات العلمية في إيطاليا وفرنسا وإنجلترا، مما أسس لنظام جديد من التعاون العلمي المنظم. فمن الأكاديميات العلمية المبكرة “أكاديمية دي لينسي في إيطاليا”، التي تأسست في روما عام 1603م، وتعد من أوائل الأكاديميات العلمية في أوروبا، حيث ركزت هذه الأكاديمية على الفلسفة الطبيعية والعلوم التجريبية، وجمعت علماء مثل “جاليليو جاليلي”، الذي كان له دور بارز في تطوير المنهج العلمي التجريبي. وكذلك “الأكاديمية الملكية في إنجلترا”، التي تأسست في لندن عام 1660م، وكانت تهدف إلى دعم وتشجيع البحث العلمي والتكنولوجي، وقد وفرت هذه الأكاديمية منصة للعلماء لتبادل الأفكار والاكتشافات العلمية، مما ساعد في تحقيق تقدم سريع في مختلف المجالات العلمية، ومن أبرز العلماء الذين كانوا جزءًا من هذه الجمعية “إسحاق نيوتن”، الذي نشر فيها أعماله الشهيرة حول الجاذبية وحركة الكواكب.
ولا ننسى “الأكاديمية الفرنسية للعلوم”، التي تأسست عام 1666م بمبادرة من “جان بابتيست كولبير” تحت رعاية الملك لويس الرابع عشر، حيت كانت تهدف إلى تعزيز البحث العلمي وتنظيمه، وقد جمعت كبار العلماء الفرنسيين مثل ديكارت وباسكال. ومع إنشاء هذه الجمعيات العلمية أصبح التعاون العلمي أكثر تنظيمًا ومنهجية، حيث وفرت هذه الجمعيات العديد من المزايا، ومنها أنها كانت منصات لتبادل الأفكار والاكتشافات من خلال الاجتماعات الدورية والندوات العلمية التي كانت تعقدها.
كما بدأت هذه الجمعيات في نشر المجلات العلمية، مثل مجلة “فيلوسوفيكال ترانزكشنز” التي أطلقتها الجمعية الملكية في عام 1665م، مما ساعد في توحيد المعايير العلمية وزيادة الشفافية في البحث. وقد عملت أيضًا على تشجيع التجارب والمشاريع المشتركة؛ حيث قدمت هذه الجمعيات العلمية التمويل والدعم للعديد من المشاريع البحثية والتجارب العلمية. هذا التشجيع كان حافزًا للعلماء للابتكار والتعاون في مشاريع مشتركة، مما أدى إلى تحقيق اكتشافات علمية كبيرة.
ونتيجة لهذه التنظيمات العلمية، شهدت أوروبا تقدمًا كبيرًا في مختلف العلوم، فقد نشر “إسحاق نيوتن” كتابه “المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية” عام 1687م، والذي وضع أسس الفيزياء الكلاسيكية، كما أسهم العلماء في تطوير علم الكيمياء من خلال التجارب المنظمة واكتشاف العناصر والمركبات الكيميائية الجديدة، وشهدت البيولوجيا تطورًا بفضل الأبحاث في علم التشريح وعلم الأحياء الدقيقة، حيث اكتشف العلماء -مثل أنطوني فان ليفينهوك- الكائنات الحية الدقيقة.
بين الحضارة العربية الإسلامية وعصر النهضة الأوروبية
الجماعة العلمية في الحضارة العربية الإسلامية وفي عصر النهضة الأوروبية تتشابهان في بعض الجوانب الأساسية، مثل التركيز على البحث العلمي وتبادل المعرفة، ولكن هناك اختلافات جوهرية نابعة من السياقات الثقافية والتاريخية المختلفة التي ظهرت فيها كل جماعة. نستعرض هنا بعض هذه الفروق:
أ- السياق الثقافي والديني
ففي العالم الإسلامي كان الدين والعلم متداخلين بشكل كبير، حيث كان العلماء المسلمون غالبًا من رجال الدين أو ممن لديهم خلفية دينية قوية، وكانوا يرون أن البحث العلمي وسيلة لفهم خلق الله بشكل أفضل، كذلك كانت المؤسسات العلمية -مثل بيت الحكمة في بغداد- تحت رعاية الدولة، وغالبًا ما كان لها دعم ديني، مما عزز من مكانة العلم والعلماء. وكذلك كانت اللغة العربية لغة العلم والفكر، حيث تمت ترجمة العديد من الأعمال العلمية والفلسفية من اليونانية والفارسية والسنسكريتية إلى العربية، مما أسهم في توحيد الجهود العلمية.
وفي عصر النهضة الأوروبي شهد بداية الابتعاد عن سيطرة الكنيسة على الحياة الفكرية والعلمية، مما سمح بنمو الأفكار العلمية التي قد تتعارض مع التعاليم الدينية “المسيحية”. وهذه الفترة شهدت نمو الفكر الإنساني والعقلاني، وبينما كانت اللاتينية هي لغة العلم في بداية عصر النهضة، بدأت الأعمال العلمية تنشر بلغات أوروبية مختلفة مثل الإيطالية والفرنسية والإنجليزية، مما ساهم في توسيع نطاق انتشار المعرفة العلمية.
بـ- التنظيم والمؤسسات
في الحضارة الإسلامية كانت مراكز العلم -مثل بيت الحكمة في بغداد ودار العلم في القاهرة- مؤسسات مركزية جمعت بين العلماء من مختلف التخصصات والأصول الثقافية، هذه المؤسسات كانت تتميز بتوفير بيئة تعاونية تعمل تحت رعاية الحكام وتدعمها الدولة، وكان التعليم غالبًا يتم من خلال حلقات العلم في المساجد أو منازل العلماء، حيث يتعلم الطلاب من خلال الحضور الشخصي والنقاش المباشر مع العلماء.
وفي عصر النهضة الأوروبي ومع إنشاء الجمعيات العلمية -مثل الجمعية الملكية في لندن والأكاديمية الفرنسية للعلوم- أصبح التعاون العلمي أكثر تنظيمًا ومنهجية. فقد وفرت هذه الجمعيات، منصات رسمية لتبادل الأفكار والاكتشافات وتنظيم الأبحاث، وقد شهد عصر النهضة تأسيس جامعات أوروبية مهمة كانت مراكز للبحث العلمي والتعليم، فالجامعات مثل جامعة بولونيا وجامعة باريس، كانت تلعب دورًا رئيسيًّا في نشر المعرفة وتدريب العلماء.
جـ- المنهجية العلمية
العلماء المسلمون مثل ابن الهيثم والخوارزمي، اعتمدوا على المنهج التجريبي والملاحظة الدقيقة في بحوثهم؛ فابن الهيثم -على سبيل المثال- يُعتبر من مؤسسي المنهج العلمي الحديث في كتابه “المناظر”.. وكذلك كان هناك تكامل كبير بين الفلسفة والعلم، حيث عمل الفلاسفة المسلمون على دمج الفكر الفلسفي مع البحث العلمي.
وفي عصر النهضة الأوروبي شهد تطور المنهج العلمي إلى شكله الحديث، مع تركيز أكبر على التجربة والتحليل الرياضي، فعلماء مثل غاليليو ونيوتن، أسسوا قواعد جديدة للبحث العلمي تعتمد على التجريب والتحليل الرياضي الدقيق، لكن شهد هذا العصر أيضًا فصلاً تدريجيًّا للفلسفة عن العلم، حيث ركز العلماء على البحث العلمي الدقيق، بينما تحول الفلاسفة إلى مناقشة القضايا الميتافيزيقية والأخلاقية.
وفي المجمل سنجد أن التمسك بالدين (الإسلامي) في الحضارة الإسلامية كان باعث نهضتها وسر قوتها، بينما كان الابتعاد عن الدين (المسيحي الكهنوتي) في النهضة الأوروبية هو بداية النهضة وسر انطلاقتها، نظرًا لما كان يمارسه كهنة الدين المسيحي آنذاك من تسلط على الحياة العلمية والفكرية.
مدى الحاجة إلى الجماعة العلمية في حياتنا المعاصرة
لقد أصبحت الجماعة العلمية أكثر أهمية من أي وقت مضى، فالتحديات العالمية مثل التغير المناخي، والأمراض المستجدة، واستكشاف الفضاء، تتطلب تعاونًا دوليًّا وتخصصات متعددة.. ولا شك أن الجماعة العلمية تسهم في تحقيق تقدم سريع ومستدام من خلال تبادل الأفكار والخبرات بين العلماء من مختلف الدول والتخصصات، وإن تحقيق رؤى التقدم والنهوض يتطلب جمع الموارد البشرية والمعرفية في بيئات تعاونية، ما يجعل الجماعة العلمية حجر الزاوية في هذا المسعى.
لقد كان لزامًا علينا أن نطرح أسئلة متعددة أخرى في هذا الموضوع غير التي ناقشناها، مثل: ما الفرق بين الجماعة العلمية، والعالم الفرد؟ وواقع الجماعات العلمية في واقغنا المعاصر خاصة في بلداننا العربية والإسلامية، وأبرز آراء ورؤى أعلامنا الأفراد الأفذاذ المعاصرين في هذه القضية، وغير ذلك من النقاط.. لكن مساحة المقال لا تترك لنا التوسع في هذه النقاط، لذا آمل أن تكون محل بحث واستقصاء في مقالات قادمة.
(*) كاتب وباحث مصري.
المراجع
(١) بنية الثورات العلمية، كون، توماس، ترجمة: شوقي جلال، المنظمة العربية للترجمة، 2007م.
(٢) سوسيولوجيا العلم، ميرتون، روبرت، ترجمة: حسن حمزة، المنظمة العربية للترجمة، 2006م.
(٣) علم الاجتماع العلمي: دراسة في علم اجتماع المعرفة العلمية، الزبيدي، أحمد، دار الفكر العربي، 2015م.
(٤) وسام عالم هذه السنة.. نموذج التحدّي والجماعة العلمية، https://n9.cl/vnou6