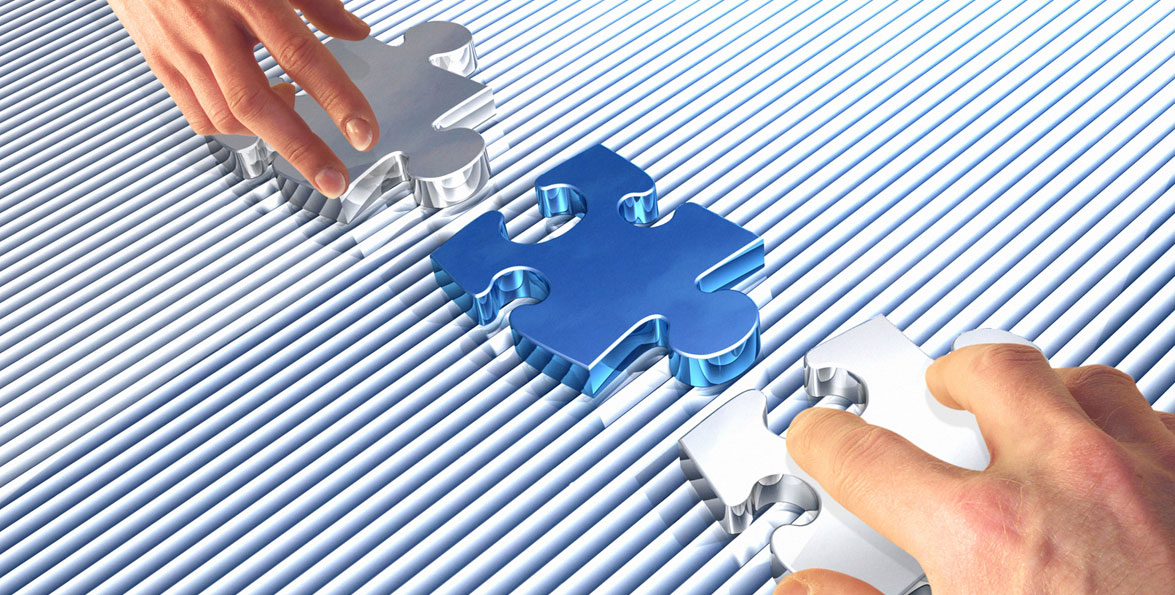يرصد الباحث في هذه المساهمة جدلية العلاقة بين الثقافة والعولمة، وذلك من خلال تعميق القول في العناصر التالية: الثقافة بين الوحدة والتعدد في ظل العولمة، التثاقف بين الإيجابية والسلبية أمام تحديات العولمة، ملاحظات حول مفهوم “التثاقف” في الفكر العربي المعاصر.
توطئة
قد لا ينازع أحد في كون علاقة العولمة بالثقافة هي من أعقد وأخطر أشكال العلاقة بين هذا التيار الكاسح وبين باقي المجالات الأخرى، سياسية واقتصادية وغيرها. وإن بدا في الظاهر، وخصوصا في مراحل التشكل الأولى لـ”نظام العولمة” ومن خلال أشكال الصراع والمقاومة المضادة داخل الدوائر الغربية ذاتها بين قوي وأقوى أو خارجها بين قوي وضعيف، أن الموجه والمتحكم في آليات الصراع والنزاع عوامل اقتصادية وسياسية وإعلامية.. بالدرجة الأولى، فهذا لا يقلل من أهمية العامل الثقافي لا في الآجل ولا في العاجل وذلك لاعتبارات شتى نجملها في عنصرين اثنين:
الأول؛ يتجلى في كون الاقتصاد والسياسة والإعلام.. وغير ذلك، أمور لا تخلو من أن تتأطر بإطار ثقافي يحدد منطلقاتها ومبادئها، كما يحدد أهدافها، وغاياتها، وأيضا وسائل وآليات عملها. ولهذا اعتبر كثير من النقاد العولمة ولو ني شكلها الأول المذكور “ثقافة” ضد الثقافات الأخرى الموجهة لنفس العناصر لدى شعوب أخرى. “ثقافة” تحمل قيم الاستبداد والاستفراد، وبتعبير إريك فروم تلبي “نزعة التملك” ضد ثقافات تحمل، ولو بدرجات مختلفة، قيم التعددية والتعايش أو بتعبير نفس الناقد تلبي “نزعة الكينونة”.
تبقى الثقافة إذن باعتبارها جماع المعرفة والعلم والفكر.. هي البعد الحيوي المؤطر والموجه لكل مجالات الحياة، هي المصنع أو المختبر الذي فيه وبه تتم صناعة وتحليل الاختيارات الاستراتيجية الأساسية لتوجه ما.
تبقى الثقافة باعتبارها جماع المعرفة والعلم والفكر.. هي البعد الحيوي المؤطر والموجه لكل مجالات الحياة، هي المصنع أو المختبر الذي فيه وبه تتم صناعة وتحليل الاختيارات الاستراتيجية الأساسية لتوجه ما.
الثاني؛ إذا صح من خلال العنصر الأول أن نسمي نوع الثقافة الموجهة بـ”الثقافة الكامنة” حيث لا تنكشف بذاتها بقدر ما تنكشف من خلال مظاهر وتجليات متعددة، وقد يتم أحيانا الالتفاف عليها بإحدى هذه التجليات أو المظاهر مما يحدث التباسا لدى كثيرين، كما هو الواقع حاليا، في أيهما أصل وأيهما فرع، فإننا في هذا العنصر الثاني وهو أعمق وأخطر من الأول، يمكن أن نسمي هذا النوع من الثقافة بـ”الثقافة الظاهرة” التي تملك أن تنكشف وتتجلى بذاتها. وهذا النوع الخطر من التشكيل والصياغة الثقافية، هو أحد، إن لم يكن الوحيد، أهداف وغايات العولمة الساعية نحو التنميط والأحادية المركزية ونهاية أشكال التعدد والمغايرة الثقافية.
إن الأمر هنا يتعلق بإخراج شكل ونمط ثقافي جديد وحيد ومهيمن يتحدد فيه مركز ثابت دائم وأطراف وهوامش قارة، يقدم تفسيراته لكل الظواهر الإنسانية والكونية، وينفي ويستبعد كل تفسير مغاير. بتعبير أوضح، يتعلق الأمر لا بثقافات متعددة ذات وجود تاريخي عريق تصوغ اختيارات متعددة، بل بتدمير ذلك كله ولو على حساب القيم التاريخية والتراثية والنفسية والقومية.. حيث تشاد ثقافة جديدة بمنظورات جديدة.. وعلى الرغم من كون “الثقافة الامبريالية”، بتعبير ادوارد سعيد، ذات الجذور الفلسفية العلمانية في طبعتها الانجلو-أمريكية بالخصوص موجودة سلفا، فإن عامل تدويلها وإعطائها نفسا عالميا أو بالأحرى عولميا، هو الذي يضفي عليها طابع الجدة ويمنحها قدرة إضافية خارقة على النفاذ والتأثير.
إذا كانت “ثقافة” العولمة على النحو الذي تقدم إجمالا، وأهلها عاملون بجد على تحقيق مسعاهم، فما دور الثقافات الأخرى أي الخصوصيات المحلية المغايرة أصولا أو فروعا؟ وكيف يمكنها مقاومة هذا الطوفان الهادر كما ونوعا من المفاهيم والأفكار والسلوكات؟ صحيح أن الغرب الأنجلو أمريكي صور في نفسه صورة حالمة حول نمط الحياة المستقبلي، لكن هذا الحلم لا يلغي حقيقتين واقعيتين: الأولى؛ أنه جاد في تحقيقه كما تقدم بتسخير كل مقدراته وإمكاناته. والثانية؛ واقع الضعف والانهيار والتبعية.. لدى الشعوب الأخرى، بما في ذلك ضعف وانهيار الحصن الثقافي المخصص للوقاية والدفاع.
ولا يخفى أن المفاهيم والأفكار والمبادئ.. إنما تستمد قوتها وفاعليتها من قوة وفاعلية الجهة المنتجة لها، ولهذا ففي الوقت الذي تعجز فيه البلدان الضعيفة عن حماية مواليدها المعرفية والدفاع عنها والتمكين العلمي لها، نجد البلدان القوية تستطيع ليس فقط الدفاع عن هذه المواليد، وإنما أيضا إلغاء الآخر باختراقه واستتباعه. يشهد لهذا أن حضارات وثقافات كانت قائمة فقامت معها مفاهيمها وتصوراتها وأدبياتها في مختلف مجالات المعرفة، فلما آلت إلى الضعف والانهيار، انهار معها كل ذلك إلا النادر القليل الذي استطاع الصمود بما يمتلك من قوة ذاتية. يصدق هذا على المعارف والحضارات القديمة والحديثة، ولعل أقواها معارف الحضارات اليونانية والفرعونية والرومانية والإسلامية.. وحضارة أوروبا النهضة والفلسفة الشيوعية المنهارة وغيرها.
ولنبدأ أولا بتعريف الثقافة ومقتضيات التثاقف في ضوء جدل المحلي والكوني.
1-الثقافة بين الوحدة والتعدد في ظل نظام العولمة
إذا أردنا أن نقف على تعريفات للثقافة لها علاقة بأبعاد ومتغيرات العولمة وبجدل الخصوصية المحلية والعالمية الكونية، فإن الكتب المتوفرة والمتداولة لا تسعف إلا بالقليل النادر من هذا النوع من التعريفات لكنها على كل حال، أو بعض منها على الأصح، ينطوي على أبعاد ودلالات عميقة في التعريف من حيث التحقق بشرط الذاتية أو بشرط العالمية أو بكليهما مع إبراز الإيجابي والسلبي في كل انتماء.
إذا كانت “ثقافة” العولمة على النحو الذي تقدم إجمالا، وأهلها عاملون بجد على تحقيق مسعاهم، فما دور الثقافات الأخرى أي الخصوصيات المحلية المغايرة أصولا أو فروعا؟ وكيف يمكنها مقاومة هذا الطوفان الهادر كما ونوعا من المفاهيم والأفكار والسلوكات؟
من هذه التعريفات نذكر ما ذهب إليه مالك بن نبي من كون الثقافة “أسلوب الحياة في مجتمع معين… تخص السلوك الجماعي الذي يطبع تصرفات الفرد في ذلك المجتمع” (1)، بل هي “حياة المجتمع التي بدونها يصبح مجتمعا ميتا”(2) فداخل مجتمع متحرك تتم “عملية تركيب ثقافته بصورة تلقائية تنحصر في تنظيم المقومات الثقافية في وحدة متجانسة تمثل ثقافته”، “فأساس كل ثقافة هو بالضرورة تركيب وتأليف لعالم الأشخاص. وهو تأليف يحدث طبقا لمنهج تربوي يأخذ صورة فلسفية أخلاقية. وإذا فالأخلاق أو الفلسفة الأخلاقية هي أولى المقومات في الخطة التربوية لأية ثقافة”(3). ثم إن “الفرد المنعزل… لا يمكن أن يستقبل الثقافة ولا أن يرسل إشعاعها” و”الأفكار والأشياء لا يمكن أن تتحول إلى عناصر ثقافية إلا إذا تألفت أجزاؤها فأصبحت تركيبا فليس للشيء المنعزل أو الفكرة المنعزلة معنى أبدا”(4).
إن الثقافة، حسب ابن نبي دائما، “نظرية في السلوك أكثر مما هي نظرية في المعرفة” وبهذا تكون الثقافة أعم من التعليم نفسه وأعم من المعرفة والأفكار وأوثق صلة بالشخص. فهي عموما “مجموع الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي تؤثر في الفرد منذ ولادته، وتصبح لا شعوريا العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه… هي المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته”(5). وعند محمد عابد الجابري، أن الثقافة هي “ذلك المركب المتجانس من الذكريات والتصورات والقيم والرموز والتعبيرات والإبداعات والتطلعات التي تحتفظ لجماعة بشرية تشكل أمة أو ما في معناها، بهويتها الحضارية في إطار ما تعرفه من تطورات بفعل ديناميتها الداخلية وقابليتها للتواصل والأخذ والعطاء… إن الثقافة هي المعبر الأصيل عن الخصوصية التاريخية لأمة من الأمم، عن نظرة هذه الأمة إلى الكون والحياة والموت والإنسان، ومهامه وقدراته وحدوده وما ينبغي أن يعمل ومالا ينبغي أن يأمل..”(6).
وعند برهان غليون “لكل ثقافة خاصة كما لكل مؤسسة روحها؛ أي نظام عملها وردود أفعالها وتوجهاتها التي تكون لديها ما يمكن أن نسميه المناعة الذاتية ضد كل نوع من أنواع التغيير الخطيرة التي تهدد انسجامها الداخلي وقيامها بوظائفها…. والواقع أن الثقافة الحية لا تقبل بضم خبرات جديدة إلى مخزونها المعرفي أو الخيالي، إلا إذا لم تكن هذه الخبرات تتعارض مع خبرات سابقة وراسخة تضمن توازناتها الكبرى”(7).
وهذا، كما هو واضح، صحيح بنسب عالية في الثقافات الحية الناهضة والفاعلة، التي تشكل أنظمة وأنساقا مستعصية على الاختراق والذوبان، تحفظ وتؤمن الفرد والجماعة داخلها وتجعلهما في الوقت نفسه منفتحين ومشعين على العالم الخارجي. وتقوم بعملية فرز داخلية للمنقول الوافد فتعمد إلى دمجه واستيعابه أو طرحه وإبعاده. لكن الأمر يكون مختلفا تماما بالنسبة للثقافات التي أصابها الوهن وارتخت خيوط الفاعلية والمقاومة فيها، كما هو شأن كثير من ثقافات “الجنوب”؛ إذ حظ المؤثرات الخارجية فيها قوي وبالغ الأثر. وثقافتنا العربية الإسلامية أصيبت أيضا بهذا الداء بعدما كانت تتحرك بوثيرة وفاعلية كبيرة وقوية جعلتها تعمم مبادئ وقيم ومفاهيم الرسالة الجديدة.
إن الثقافة، حسب ابن نبي دائما، “نظرية في السلوك أكثر مما هي نظرية في المعرفة” وبهذا تكون الثقافة أعم من التعليم نفسه وأعم من المعرفة والأفكار وأوثق صلة بالشخص
وبما أن الثقافة تأليف وتركيب ودمج لعناصر ومكونات تصوغ في النهاية الفلسفة الأخلاقية لأية جماعة، فإنها قابلة لأن تتنوع وتتعدد وتغتني في تجلياتها ومظاهرها، كما هي قابلة أيضا لأن تنفعل وتتأثر وتتفكك.. ف “الهوية الثقافية كيان يصير، يتطور، وليس معطى جاهزا ونهائيا. هي تصير وتتطور إما في اتجاه الانكماش وإما في اتجاه الانتشار، وهي تعتني بتجارب أهلها ومعاناتهم.. وأيضا باحتكاكها سلبا وإيجابا مع الهويات الثقافية الأخرى التي تدخل معها في تغاير من نوع ما..”(8). أما على المستوى الكوني فـ”ليست هناك ثقافة عالمية واحدة، وليس من المحتمل أن توجد في يوم من الأيام، وإنما وجدت وتوجد وستوجد ثقافات متعددة متنوعة تعمل كل منها بصورة تلقائية أو بتدخل إرادي من أهلها على الحفاظ على كيانها ومقوماتها الخاصة..”9 وبقدر ما تملك ثقافة ما قدرة ذاتية على الانفتاح والحوار بقدر ما تساهم في عملية التثاقف الإيجابي مع الثقافات الأخرى.
إذن، فالاقتدار الذاتي، والفاعلية، والحركية.. شروط لابد منها للحياة والوجود. والثقافة التي تتوحد عند أصولها المرجعية وتنفتح في تجلياتها لتستوعب كافة أشكال ومظاهر الحياة، ولتحاور الآخر وتتفاعل معه، هي التي بإمكانها أن تعيش وتؤثر وتساهم في التقويم المحلي والكوني. ومن غير هذه الشروط فمن السهل جدا أن تبتلعها ثقافات أقوى منها في ظل قانون العولمة الآخذ في الهيمنة والتوسع. وليس صحيحا ما يذهب إليه البعض مثلا من كون “العولمة الثقافية لا تنتج ثقافة عالمية ولكنها تنتج بالأحرى كوكبا تختلط فيه الثقافات وتتعايش أو تتصارع، ففي كل مكان تقريبا حيث يذهب المرء من السهل عليه أن يعثر على مطعم صيني أو مكسيكي أو هندي، وعلى بائع السمك والبطاطا أو الهامبورغر الأمريكي. لكننا بعيدون جدا عن عالم تقدم فيه كل المطاعم وجبة واحدة..”(10).
فهذه ليست مؤشرات عميقة على التعدد الثقافي بقدر ما هي مظاهر سطحية وشكلية لا يمكن أن تعكس كل أبعاده وتجلياته، وإن كانت تصلح كنموذج لتفسير بعض من تلك الأبعاد متعلق بنظام أو “ثقافة الأكل”. ومثل هذا أيضا كثير من الإسقاطات التي تختزل مفهوم الثقافة إلى نوع من “الفن” المستهتر، أو الرياضات الطائشة.. فأيما فصل بين الأصول المرجعية الكبرى المحددة لهوية الثقافة ووحدتها وبين مظاهرها وتجلياتها الممثلة لغناها وتنوعها.. هو تحريف خطير يمارس على هذه الثقافة. ولا يخفى الآن أن الآلة الضخمة الموجهة والمتحكمة بعملية العولمة هي الإعلام القائم على أداء الصورة وإيحاءاتها. وأخطر تحريف يمارسه إعلام الصورة على ثقافة المشاهد هو تحويل هذه الثقافة عن أساسها الفكري التربوي التكويني العميق إلى أسس سطحية إلحاقية، تلقن مبادئ التبعية والاستهلاك والإشباع المادي، وتقتل الروح المعنوية والفكر الحر المستقل. إنه باختصار يغتال في الإنسان ثقافته.
ولو التمسنا بدايات لاختزال مفهوم الثقافة وقص أطرافها في الفكر الحديث خصوصا، لوجدنا ذلك مع تنامي نفوذ العامل الاقتصادي وهيمنته على توجيه الحياة بمنطقه في الربح وقيمه في الاستهلاك كان هذا لدى الدول العظمى السباقة إلى تطوير اقتصادياتها سواء بفعل الكشوفات الجغرافية أو الثورات الصناعية أو امتصاص خيرات المستعمرات.. أو غير ذلك، الشيء الذي جعل الاقتصاد لديها يحقق نوعا من “الاستقلال” الثقافي. وانتقل هذا بحكم التبعية والتقليد إلى البلدان المتخلفة من غير أن تعرف بنياتها التحتية الاقتصادية تلك التحولات الجذرية، أو أن تكون إفرازا طبيعيا لها. فتجد تلك البلدان، وعلى رأسها كثير من بلدان العالم العربي والإسلامي، وهي المقصودة لدينا بالدرجة الأولى، تتلمس طريق التحديث على النموذج الغربي، تتملص تدريجيا من ثقافتها التاريخية وتتنكر تدريجيا كذلك لأصولها المرجعية.
ولئن كان الغرب الذي أنتج تطوره الاقتصادي المهووس بالربح السريع على حساب القيم والأخلاق، ثقافة عبر عنها كثير من نقاده، من أبنائه خصوصا، ب “الثقافة المصنعة” أو “الثقافة الآلية” أو “الثقافة الرقمية” أو “ثقافة الاستهلاك”.. إلخ، قادرا بحكم قوة بنياته التحتية على امتصاص مضاعفات هذا المنتوج السلبية ولو إلى حين، وخاصة المضاعفات الاجتماعية “الحريات الفردية والأسرية والجماعية..”، والبيئية “دمار التلوث والتسلح والحروب وجنون التصنيع والعبث العلمي..”.. فإن البلدان الأخرى عاجزة كل العجز عن ذلك، مما يعرضها إلى أزمات وكوارث مضاعفة لا تجد حلا لها إلا في المزيد من الارتماء في أحضان الغرب. بمنطق تحليلي آخر، إن الغرب لا يهيمن ويستعبد في عولمته بالقوة والضغط والتفوق.. وحسب، ولكن أيضا وبقدر كبير بتصدير الأزمات والأوبئة وأشكال الميوعة والانحلال* التي تطال الإنسان والحيوان والجماد.. وهذه الكائنات جميعها لا يمكن أن تجد أمنها الذاتي إلا في ثقافة تؤطرها وتقنن أشكال العلاقة والتسخير فيما بينها نحو قيم الخير والعدل والصلاح.
الثقافة عموما “مجموع الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي تؤثر في الفرد منذ ولادته، وتصبح لا شعوريا العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه… هي المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته
ولنستمع إلى واحد من أبناء الغرب وباحثيه ينتقد هذا المنحى الاختزالي لمفهوم الثقافة في العصر الحديث، فبعد تعريفه للثقافة “بأنها الاستجابة التي أسهمت بها الجماعات البشرية إزاء مشكلات وجودها الاجتماعية” يقول: “… ففي المجتمعات السابقة للعالم الحديث، تغطي الثقافة كافة جوانب نشاط الإنسان. ذلك أن هذه المجتمعات تجهل تماما الاقتصاد بما هو كذلك. حيث أن المجال الاقتصادي يكون “منتظما” في الكل الثقافي وصنوا لهذه الاستجابة الشاملة لتحدي الكينونة. أما المجتمع الحديث فإنه “مخترعا” الاقتصاد، أي مضيفا استقلالا على “مجال” الإنتاج وتوزيع واستهلاك الثروات المادية… فقد اختزل الثقافة إلى الشواغل “الثقافية” للوزارات التي تحمل اسمها. والحقيقة أن هذا الاختزال يجد أصله في الميتافيزيقا الغربية التي تجزئ منذ أفلاطون وحدة الكينونة إلى مادة وروح، وهكذا لا تغدو الثقافة أكثر من الوعي وحتى الوعي الزائف الذي يمتلكه مجتمع بممارساته “المادية” عبر الدين والفن وكافة وسائل التعبير…. فاحترام الثقافات؛ (أي بالمعنى المتقدم) لا يمس إذن نموذج التنمية، ولا يكون البعد الثقافي سوى ترفا يمكن للمرء في نهاية المطاف أن يتقدم به كقربان في طقس اليونسكو عندما يقيم مهرجانا للفنون الأفريقية أو يفتتح متحفا للتقاليد الشعبية..”(11).
يضيف لا توش مؤكدا الطابع الانفتاحي التعددي للثقافة وضرورة الاستناد إلى أصل ومرجع موحد وناظم.. ” إذا كانت الثقافة إجابة على مشكلة الكينونة، فهي تشتمل على مقدار لانهائي من التفريعات كالكينونة ذاتها. إن مستويات الإجابة يمكن أن تكون لانهائية، كما أن تقاطعات المجالات والمستويات يمكن أن تقود إلى عدد لانهائي من التركيبات، فهناك الثقافة الدينية، الثقافة الجمالية، الثقافة الغذائية، الكسائية.. إلخ…. وهناك الثقافة المحلية الإقليمية، القومية.. وهناك منطقة ثقافية مسيحية، منطقة ثقافية إسلامية، منطقة ثقافية بوذية..”(12) وقد “يسمح هذا التنوع الثقافي اللانهائي” بتحويل فولكلوري “للثقافة، فإذا لم يكن هناك “مرجع” متين وواضح للهوية الثقافية فإن وحدة النوع البشري تهتدي إلى حقوقها عبر تجارب عالمية قابلة للتطور، لكن ليس عبر بدائل حقيقية، بدائل العلم والتقنية والاقتصاد وحتى السياسية. وهذه البدائل هي الإجابات الحديثة والوظيفية على الحاجات “الطبيعية” والأبدية للإنسان. غير أنه من المشروع حقا بطبيعة الحال أن نحدد كامل أو حد ” للثقافة ” “الشعب ” أو ” الأمة “..، إن النظر إلى الثقافة القومية على أنها حامية الهوية الثقافية ومعاملة بقية الأشياء الإقليم، الطبقة.. إلخ على أنها مواقع التخلف الثقافي، أمر غير مشروع على الإطلاق. ذلك أن الإجابة على مشكلة الوجود الإجتماعي تتحقق من خلال الوسط العائلي والمحلي والإقليمي واللغة والدين بقدر ما تتحقق من خلال الانتماء القومي”13.
2- التثاقف بين الإيجابية والسلبية أمام تحديات العولمة
إذا أمكننا أن نستخلص مما تقدم أن الثقافة تشكل وتصوغ عمق المجتمع والإنسان وتغذيه وتزوده في الوقت ذاته بكل القيم والمبادئ والمعاني والرموز.. الدينية والتاريخية والعرفية.. مما يشكل إطار خصوصيته وتميزه ويعكس هويته. فإنها إذ تفعل ذلك، تفتح أمامه أيضا بالضرورة آفاقا للتواصل والتفاعل مع مكونات ثقافية مختلفة ومغايرة لا يملك إزاءها إلا أن يكون أداؤه سلبيا منفعلا متلقيا أو إيجابيا فاعلا مساهما. ومعنى الانفتاح الإيجابي هذا، نجد تعبيرا بليغا عنه في القرآن الكريم بصيغ مختلفة: ﴿ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الاَرض﴾ (البقرة: 249) ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا﴾ (الحجرات: 13)، ﴿قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم..﴾ (ءال عمران: 63)، ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴾ (العنكبوت: 46)، ﴿أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن﴾ (النحل: 125)، ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾ (البقرة: 20). إنه التدافع والتعارف والحوار بين الناس والمقربين منهم، أهل الكتاب. القائم على أسس مرجعية ومنهجية لا تعدم أية ثقافة متى كانت إنسانية أو ربانية تحترم الآخر، أصولا له هي دعامة ومستند هذا الانفتاح المتبادل. وقد قدمت الحضارة الإسلامية أرقى نموذج له في عالميتها الأولى، إذ جعلت من أقطارها المفتوحة مهما نأت مراكز وأقطاب فاق بعضها في إنجازه العلمي والحضاري مراكز الخلافة ذاتها. فليس التحصن دائما انكفاء على الذات وانطواء عليها وإمعانا في الانعزال والتفرد. بل يكون، وبدرجة أقوى، بالتعرف على الآخر ومدافعته والإسهام في العطاء الحضاري العام والمشترك الإنساني انطلاقا من تلك الخصوصية.
وبما أن الثقافة تأليف وتركيب ودمج لعناصر ومكونات تصوغ في النهاية الفلسفة الأخلاقية لأية جماعة، فإنها قابلة لأن تتنوع وتتعدد وتغتني في تجلياتها ومظاهرها، كما هي قابلة أيضا لأن تنفعل وتتأثر وتتفكك.. ف “الهوية الثقافية كيان يصير، يتطور، وليس معطى جاهزا ونهائيا.
هذا المعنى أيضا، هو الذي يعبر عنه في فكرنا المعاصر بـ”التثاقف”. والذي بدأ يشكل لدى البعض منحى، أو قل تيارا خاصا بمنطلقات وتفسيرات خاصة سنرجع لمناقشة أهمها بعدقليل. ولنلق الآن نظرة على بعض الإشكالات العميقة التي تطرحها عملية التثاقف وعلى رأسها إشكال هيمنة واستبداد الثقافة الغربية بقيمها ونزعاتها المادية المدعومة بأنماط التحديث العلمانية.. الغرب الذي يصر على أن يكون دائما وأبدا مركزا وقطبا ومحورا، والباقي يدور في فلكه وحواشيه أطرافا وملحقات وهوامش. المنطق الذي يحدد كل صور وأشكال التعامل معها ثقافيا، سياسيا، اقتصاديا، عسكريا، إعلاميا.. إلخ، بما يضمن ويؤمن زعامته، وبما يضمن تبعيتها وخضوعها دون السماح لها أن تتحول في وقت من الأوقات إلى أقطاب أو مراكز. لأن الأمر يعني، بنفس المنطق، نهاية السيادة والاستفراد بالنسبة له.
ولهذا فالمتأثرين بأنماط التحديث الغربي، بما في ذلك النخب ذات المصالح والامتيازات والتي تمارس التجهيل والتزييف على بلدانها وشعوبها، لا يدركون أن تلك الأنماط لا يمكن أن تجعل منهم في النهاية إلا مقلدا ممتازا وتابعا من الدرجة الأولى أو الثانية. مسلوب الإرادة مشلول القرار عاجزا عن الحسم في أخص أموره. وحتى إن أدرك، فإنه لا يملك من أمر نفسه شيئا بعد أن رهن نفسه لرمز استعباده وقهره وجعله نموذجا له يحذو حذوه في الصغيرة والكبيرة، إلا أن يحدث في نفسه انقلابا جذريا أو ثورة شاملة تنقله من حال إلى حال.* إنه المنطق الاستعماري عندما يخترق مبادئ الثقافة فيحولها عن مهام التعارف والتدافع الإيجابي إلى مهام التبرير والتسويغ للنهب والسلب والاستغلال. الأمر الذي استهجنه نقاد غربيون أنفسهم ووصموه بـ”الثقافة الاستعمارية” التي استطاعت أن تسخر لأغراضها أضخم المؤسسات “العلمية” كمؤسسة “الاستشراق” ومؤسسة “التبشير” وكثير من مراكز وخلايا البحث “العلمي”.
كيف يمكن إذن أن تتم عملية التثاقف بمنهج التعارف والتدافع والتحاور.. في ظل وضع محكوم بمنطق الاستعلاء والاستفراد والهيمنة لثقافات ضد أخرى؟؟ علما بأن العملية بحد ذاتها مطلوبة وضرورية خاصة بالنسبة للثقافات ذات النزوع العالمي كثقافتنا الإسلامية التي تعتبر العالمية إحدى فروضها الدينية والدعوية والحضارية.
لننظر أولا إلى ما تقدمه الساحة الفكرية في معالجة هذا الإشكال من خلال تسليط مزيد من الضوء على عملية التثاقف ذاتها والآليات التي تحكمها، أو تلك التي ينبغي أن تحكمها. يذهب س. لاتوش إلى أن كلمة تثاقف تستخدم “للدلالة على تفاعل إيجابي عند الاحتكاك بين الثقافات. وعندما تدخل ثقافتان في اتصال، فإذا كانت السمات الثقافية التي يجري تبادلها تتوازن وتحافظ كل منهما على هويتها وديناميتها الخاصتين بعد إدماج واستيعاب العناصر الأجنبية، يمكن الحديث عن تثاقف ناجح. وعندما، لا يتجسد الاتصال في تبادل متوازن، بل في تدفق في اتجاه واحد مصمت، تغدو الثقافة المتلقية مغزوة ومهددة في وجودها ذاته. ويمكن اعتبارها ضحية عدوان حقيقي. وإذا كان العدوان فوق ذلك ماديا فهذا هو الزوال لا أقل ولا أكثر، أو الإبادة الجماعية. أما إذا كان العدوان رمزيا، فإن الإبادة الجماعية تغدو ثقافية وحسب، أي إبادة إثنية. إن الإبادة الإثنية هي أعلى مراحل محو الثقافة.
إن الأمر يتعلق بتحويل عقدي حقيقي(14). وهكذا نجد أنفسنا، كما يقول مالك بن بني، “من أول خطوة في طريقنا أمام اختيار رئيسي، فإما أن نعرف الثقافة طريقا للإمبراطورية. وإما أن نعرفها طريقا إلى الحضارة. وبعبارة أخرى، يواجه المجتمع مشكلاته بلغة القوة أو بلغة البقاء بقدر ما تصوغ ثقافته أسلوب حياته وسلوك الأفراد فيه…. فنوع الثقافة إذن يتحدد في كل شعب تبعا لحتمية منبعثه من نفسيته(15)”. ومثل الكاتب بالنزو ع الثقافي الإغريقي اليوناني نحو الحضارة، وبالنزوع “الثقافي” الروماني نحو الإمبراطورية. كما تحدث على مستوى التثاقف، باعتباره تركيبا على حدود ثقافتين. كما أحدثته “طبيعة الأشياء من تراكيب هامة… دون أن يسعى الإنسان إليها ودون أن يريدها. فهناك مؤرخون يرون أن نهضة أوروبا في ق (16) تعد تركيبا حققه الزمن والأحداث على الحدود بين الثقافة الإسلامية والعالم المسيحي.
ولئن كان الغرب الذي أنتج تطوره الاقتصادي المهووس بالربح السريع على حساب القيم والأخلاق، ثقافة عبر عنها كثير من نقاده، من أبنائه خصوصا، ب “الثقافة المصنعة” أو “الثقافة الآلية” أو “الثقافة الرقمية” أو “ثقافة الاستهلاك..
والحروب الصليبية على أية حال قد انفجرت على هذه الحدود. ولا ريب أنها نوع من التركيب الذي اتخذ وضعا معكوسا. فللثقافات دار أمنها وإقامتها في مواطن حضاراتها، ولكن الأحداث التي تنتج عنها لها ميدانها بصفة عامة في المنطقة الحرام على حدودها. ففي المنطقة الحرام بالتبت تم تركيب البوذية على حدود ثقافتين عظيمتين هما ثقافة الصين وثقافة الهند. لكننا الآن نرى أن الإنسان قد أخذ شيئا فشيئا يفرض وجوده في مختلف الميادين… فتحليل العناصر الإشعاعية كان يتم من قبل تلقائيا على يد الطبيعة، ولكن الإنسان قد أثبت وجوده في هذه السبيل حين سيطر على هذا التحليل موجها إياه وجهة أهداف معينة”(16). والإشارة الأخيرة هنا للكاتب، هي تنبيه على الدور المتعاظم لنفوذ الإنسان وقدرته المتزايدة على التحكم بتوجيه العناصر الكونية حسية أو معنوية، سلبا أو إيجابيا.
وقد درس الكاتب إمكان تركيب ثقافتين هما: الثقافة الإسلامية والثقافة الهندية من أجل تحديد عمل ثقافي على مستوى أفريقي آسيوي على محور طنجة – جاكرتا، مستلهما في ذلك نموذج محور واشنطن موسكو. وأحيانا طوكيو، “حيث أن المشكلات العلمية والعقلية والاجتماعية متحدة من طرق إلى آخر. بل على الرغم من التوتر السياسي بين الطرفين فإن التبادل الثقافي يتم في نطاق علاقة حضارية واحدة”. ف”إنقاذ الإنسان من البؤس والفاقة على محور طنجة – جكارتا، وإنقاذه من حتمية الحرب على محور واشنطن– موسكو، هما بالنسبة لنا الضرورتان المحددتان للمشكلة كلها: مشكلة بقائه ومشكلة اتجاهه. وهذه الضرورة المزدوجة تسيطر بصورة طبيعية على تحديد ثقافته، وبالتالي تسيطر على تحديد منهجه الأخلاقي…”17.
مجالان متميزان إذن “ينبغي على الثقافة أن تواجه في كل منهما مشكلات ذات طبيعة معينة. فهي في أحدهما يجب أن تسجل أسلوب الحياة في مجتمع معين وسلوك أفراده، وهي في الآخر ينبغي أن تخلق إمكانيات اتصال وتعاون بين المجتمعات المختلفة”(18). وجدل الملاءمة هذا، بين المحلي والكوني رفضا لكل أشكال الانطواء أو الالتحاق هو ما نجد باحثا آخر يقترح له كمخرج ما يسميه ب “الحلف الثالث” المتضمن للوعي بالمسؤولية وبأكبر قدر ممكن من قنوات الاتصال المحلية والخارجية. إنه حسب روجيه غارودي “الوعي الآخذ في النشوء على المستوى الكوني بعلاقة جديدة بين الإيمان والتاريخ، بين الإيمان والعمل، بين الإيمان والعالم. هو الوعي بأن كل إنسان فيما وراء جميع الحدود الطبقية والعرقية والثقافية “ملقح بعنصر إلهي”، وإنه بهذا الاعتبار مسؤول مسؤولية تامة عن مصيره الخاص”(19).
من الأمور المسلمة أنه ليس بمقدور العولمة أن تخلق نظاما ثقافيا أو نسقا معرفيا واحدا تخضع له أو تدين به جميع الشعوب، فالهويات الثقافية للشعوب هي أمنع الحصون والقلاع على الاختراق والذوبان الكلي، وإن كان التأثير عليها وتشويه وطمس بعض عناصرها أمرا واردا. يمكن للعولمة أن تخلق نظاما اقتصاديا أو إعلاميا أو سياسيا.. “واحدا “، وهي كذلك تفعل. لكن لا يمكنها أن تخلق “الإنسان (النموذج) الأخير”، فهذه مهمة أكبر من العولمة وأربابها؛ لأنها تصادم سنة الاختلاف الكونية في الحياة البشرية. الاختلاف الذي يعكس: الحرية، الإرادة، والمعنى.. وغير ذلك من المبادئ والقيم غير القابلة للتنميط. فالإنسان على وحدة جنسه وكثير من الخصائص فيه يبقى الكائن الحي الوحيد الذي لا يقبل “الاستنساخ” والنماذج المكررة، والذي يصوغ لنفسه معنى وفلسفة في الحياة ويشق طريق الشر أو الخير فيها. ولا نجد تعابير أبلغ عن هذا المعنى في دين أو نظام كما نجد في دين الإسلام وحضارته، نقرأ ذلك في آيات وأحاديث: الاستخلاف، والتكليف، والتكريم، والتسخير، والتعمير، والاختلاف، و التخيير… لا فرق في ذلك بين عادة وعبادة. كما تمدنا عالمية الإسلام الحضارية الأولى بنماذج عملية عن ذلك كله.
كيف يمكن أن تتم عملية التثاقف بمنهج التعارف والتدافع والتحاور.. في ظل وضع محكوم بمنطق الاستعلاء والاستفراد والهيمنة لثقافات ضد أخرى؟؟ علما بأن العملية بحد ذاتها مطلوبة وضرورية خاصة بالنسبة للثقافات ذات النزوع العالمي كثقافتنا الإسلامية التي تعتبر العالمية إحدى فروضها الدينية والدعوية والحضارية.
من الأمور المسلمة كذلك أنه بإمكان الشعوب أن تؤسس ثقافة عالمية هي جماع ثقافات مختلفة لها أراض محررة تقف عليها، وقنوات وجسور تواصل وتفاعل وحوار تلتقي عبرها على المبادئ والقيم والمصالح المشتركة. لكن الأمور للأسف لا تمشي في هذا الاتجاه بل في الاتجاه الآخر القائم على الضغط والإكراه.
وإن مشكلة العولمة الآن، كما عبر عن ذلك محمد الكتاني، ودائما في سياق التثاقف الذي نحن بصدده، في كونها “لا تحمل.. أي هوية ثقافية، ومن ثم فهي لا تنطوي على عقيدة أو فلسفة أخلاقية، أو أي بدائل توازي أو تتقابل مع هويتنا الثقافية. بل على العكس من ذلك تهمش كل ثقافة ذات طابع إنساني أو أخلاقي. وهذا ما يجعل من مواجهتنا للعولمة مواجهة معقدة بحيث لا نقف معها على أرض مشتركة لأنها تنفي ما نثبته وتثبت ما ننفيه”(20). وانعدام الثوابت والمراجع في هذه العولمة، أو المراكز والمطلقات، هو الذي جعل ناقدا مثل عبد الوهاب المسيري ينعت حضارتها بـ “الحضارة السائلة”، كما تقدم، أي التي لا تحتكم إلى شيء ثابت وقار، ولا تنضبط بعقل ولا منطق، بل تدور مع هوى المصلحة والربح والإنتاج والاستهلاك حيث دار، لا يهمها في ذلك أن تدوس عقائد وأخلاق وأعراف وثقافات الأمم والشعوب. وقد كانت أوروبا “النهضة” و”عصر الأنوار”، وإلى عهد قريب، أحسن حالا إذ كانت ما تزال تحكمها بعض الثوابت والمطلقات. سواء تلك التي بقيت مترسبة عن سيادة الفكر اللاهوتي الكنسي أو تلك التي جاءت بها مرحلة الميلاد الجديد “كإعطاء الأولوية للعقل وسيادة النزعة العقلانية وخاصة مع الفيلسوف الفرنسي رونيه ديكارت، أو إعطاء الأولية لنظام الطبيعية والمادة وسيادة النزعة الوضعية الحديثة مع كونت وماركس والفلاسفة الإنجليز بل وحتى مع تشارلز داروين في الانتخاب الطبيعي، وقل مثل ذلك في العقد الاجتماعي مع ج. ج روسو.. إلخ.
فمع صيغة “التحديث”أو “الأوربة”، كما كانت مطروحة على “الأصول والمراجع” المتقدمة، “كانت ثقافتنا الأصيلة أو هويتنا الثقافية تواجه هوية ثقافية أوربية مؤسسة على قيم جديدة لحياة الإنسان. فكانت المواجهة بين ثقافتين لكل منهما بنيتها العضوية ونظرتها الكونية الشمولية، ولكل منهما أبعادها من عقيدة أو أيديولوجية أو فلسفات أو قوانين. فكنا نواجه كل بعد من تلك الأبعاد الوافدة بما يناسبه في ثقافتنا في حوار موضوعي حينا وفي انفعال عاطفي حينا آخر. وكنا نقف مع الآخر على أرض مشتركة من التسليم ” بالهوية الثقافية “(21).
فالبرغم مما يمكن التماسه من “أصول” ليبرالية علمانية للعولمة، فإنها تبقى شبحا يهدد بمخاطره الدول ذات الأصول نفسها، والمعدودة في مصاف الدول الكبرى. ذلك أن “الرأسمالية النفاثة”* الجديدة قادرة بسرعتها الضوئية عبر القارات على اختراق الحدود والحواجز والقوانين.. وخاصة تلك التي لم تتخذ لنفسها أذرعا وقائية مضادة. فالشعوب التابعة “تشعر.. اليوم، أكثر مما كانت تشعر في المرحلة الاستعمارية أنها مجردة من وسائل وأدوات النضال ضد الرأسمالية الغارية والمفتتة أكثر فأكثر..”(22) و”هكذا يعطي التمغرب (التغريب وبالتعبير المعاصر: العولمة) بدل أن يخلق تثاقفا، سياق تدمير الهوية الثقافية السابقة وعدم نشوء هوية جديدة. ومن هنا لن يعود من الممكن القيام بوظائف الثقافة، وظائف الإبداع والتماسك والتوازن وإعطاء شرعية للتراتبية الاجتماعية والعدالة والزمن المعاش”(23).
وإن مشكلة العولمة الآن، كما عبر عن ذلك محمد الكتاني، ودائما في سياق التثاقف الذي نحن بصدده، في كونها “لا تحمل.. أي هوية ثقافية، ومن ثم فهي لا تنطوي على عقيدة أو فلسفة أخلاقية، أو أي بدائل توازي أو تتقابل مع هويتنا الثقافية. بل على العكس من ذلك تهمش كل ثقافة ذات طابع إنساني أو أخلاقي.
ومن خلال عرض س. لاتوش لأنواع ومظاهر العنف والإبادة التي تفرزها النظم الرأسمالية وسياسات التغريب، والتي يتم التستر عليها بتضخيم طقوس دينية أو عرفية تقليدية عند شعوب أخرى، كالحدود عند المسلمين، ومحارق الأرامل عند الهنود، وتقديم القرابين عند قبائل الأزتيك، أو أكل اللحوم البشرية عند هنود التوبينامبا.. يقول منتقدا “قبل أن نحلم بعالمية حقيقية يجدر بنا التساؤل حول بربرية حضارتنا، بل حتى تعصبها في أعين الآخرين. وهناك كثير من سمات أخلاقنا تبدو مرعبة وشائهة في أعين المجتمعات غير الغربية..”(24)، ويضيف “ومن الجلي أنه لو أن الهند كانت قد غزت العالم لشكل تطهر الأرامل جزءا من حقوق المرأة، ولأصبح اغتيال الأبقار محظورا بوصفه جريمة ضد احترام الحياة “(25). ليس من الممكن إذن، حسب غارودي، ” مباشرة حوار حقيقي بين الحضارات يتيح إخصابا متبادلا للثقافات إذا لم تحلل قبل كل شيء الآليات التاريخية التي منعت أو زيفت حتى الآن هذا الحوار، وأفقرت معايير المقارنة، وبصورة خاصة خلقت الظروف لعدم توازن اقتصادي متنامي بين الغرب والعالم الثالث “(26).
وكتنظيم لإشكالية الثقافة في جدلها بين المحلي والكوني، وتأكيدا لعملية التثاقف في شكلها الإيجابي المثمر ودفعا للأوجه السلبية النافية لهذا التفاعل يضيف غارودي أن المشكلة الأساسية لثقافة اليوم هي في أن تضع نهاية للتصور النزاع إلى الهيمنة في الثقافة الغربية واستبداله بتصور سامفوني متناغم، باستنطاق حكم العالم اللاغربي حيث تغدو المشاكل بعدئذ مطروحة على مستوى الكوكب ولا يمكن أن تحل إلا على مستوى الكوكب، وهذا بمباشرة حوار حقيقي بين الحضارات مع الثقافات غير الغربية “(27). ويؤكد لاتوش بدوره “أن العالمية الحقيقية الوحيدة التي يمكن تصورها، لا يمكنها أن تستند إلا إلى إجماع عالمي حقا، وهي تمر من خلال حوار أصيل بين الثقافات. ومثل هذا الحوار ممكن لأن إمكانية الحوار قائمة، وهو لا يمكنه أن ينجح إلا إذا كان كل طرف مستعدا لتقديم تنازلات، ونحن نشارك الاقتناع بأن كل ثقافة تملك الكثير الذي تعلمه للثقافات الأخرى وبأن بوسعها أن تغتني بإسهامات عديدة “(29).
وعلى كل حال، ومهما كان الوضع، نقول مع برهان غليون: “تبقى الثقافة، لأنها تشكل الدائرة الأكثر ليونة في النسق الاجتماعي، أكثر قطاع مقاومة لسيطرة السلطة، وهي لهذا السبب الأداة الأكثر ضمانا لاستمرار الأمة..، هكذا فإن الشعوب التي حطم الاستعمار دولها، والتي دمرت اقتصاديا أو استبدلت باقتصاديات رأسمالية مختلفة أو حتى متعارضة مع اقتصادياتها، التجأت إلى الثقافة واستطاعت بعد عشرات السنين أن تؤسس من جديد دولة جديدة وأن تباشر بتنظيم جديد للاقتصاد”29.
قبل أن نحلم بعالمية حقيقية يجدر بنا التساؤل حول بربرية حضارتنا، بل حتى تعصبها في أعين الآخرين. وهناك كثير من سمات أخلاقنا تبدو مرعبة وشائهة في أعين المجتمعات غير الغربية
فالحفاظ على المقومات الخاصة بتقويتها عن طريق الفهم المتجدد لها وتفعيلها لتعمل في واقع الحياة، وفي الوقت نفسه تنمية قدراتها الانفتاحية وإمكاناتها الاستيعابية.. كل ذلك كفيل بأن يؤهل هذه الثقافة في ذات الوقت؛ لأن تصمد في وجه الإعصار وأن تساهم فيه بما تمتلك. لكن دعنا نكون أكثر دقة في تناول هذه المقومات داخل بيتنا العربي والإسلامي إذا كان الاتفاق حول كون ضرورة تنميتها وتفويتها هو السبيل الوحيد للمقاومة والصمود والمساهمة والانخراط، فالحلبة طبعا لا يمكن أن يلجها إلا الأقوياء برأسمالهم النقدي، أو برأسمالهم المعنوي، ولا خيار للضعيف إلا التبعية والانسحاق. ونحن نوجه خطابنا هذا إلى من يؤمن برسالة التثاقف وضرورتها الدينية والتاريخية والحضارية.. مستبعدين كل أشكال الرفض للآخر أو للذات وكل أشكال التلفيق التي لا تقوم على أسس ومعالم مرجعية ومنهجية واضحة تؤطر التثاقف وتوجهه نحو مشاركة حقيقية لا صورية، وإيجابية لا سلبية، تنتفع بها الذات كما ينتفع بها الآخر.
3- ملاحظات حول مفهوم “التثاقف” في الفكر العربي المعاصر
تقدم أن التأهيل الذاتي المنطلق من المقومات المحلية بالرفع من الأداء الثقافي وتمتين بنياته وأسسه، وجعله أكثر فاعلية واستيعابا لشرطي الأصالة والمعاصرة، أصبح ضرورة، بل حتمية لا مهرب منها لولوج عالم المدافعة والتغيير. التأهيل الذي يحرر الفكر والثقافة من آفاق عصور الانحطاط والجمود والتقليد.. التي مارست عليه كثيرا من التقييدات والتطبيقات بدل الطابع الانفتاحي الاستيعابي الذي تسمح به أصول الشرع ذاتها، ويحررهما، من جهة أخرى، من مظاهر الاستلاب والتبعية وعقدة تفوق الآخر. وهذا يتطلب أول ما يتطلب في الحالتين معا، مراجعة تصحيحية، بل تطهيرية لكثير من أشكال التحريف والعفن التي لحقت فكرنا وأصابت فيه مقاتل عدة.
يتطلب العودة إلى إعادة بناء كثير من المفاهيم المؤطرة لهذا الفكر وخاصة تلك التي تمتلك قدرة على التوجيه والتأثير، إما بحكم وظيفتها الأصلية، أو بحكم ما أعطاها الاستعمال والتداول قديما. إعادة بناء شاملة تطال الجانب التصوري المرجعي لهذا الفكر، والجانب الآلي المنهجي فيه. من هذا المنطلق، أود إبداء بعض الملاحظات حول مفهوم التثاقف ذاته في استعمالات بعض المفكرين العرب. هؤلاء المفكرون، وإن كانوا مصنفين عموما في الاتجاه القومي، أو حتى العلماني المعتدل، فإن بعضا منهم يصنف نفسه كاتجاه ثالث بين اتجاهين سائدين: “اتجاه الانبهار بالغرب الثقافي والتماهي معه” و”اتجاه الرافضين له للغرب والمستنفرين ضده”.
إن المنهج العلمي القائم على النقد أساسا، يقتضي تمحيص مفهوم الانتماء و “الولاء” للذات أو للآخر فإذا تمحص للذات، لزم من ذلك التزام أصولها وثوابتها التي بها كانت ولا تزال ذاتا. لزم جعل ما هو أصل ومنطلق ثابت وقار، أصلا ومنطلقا ثابتا وقارا.
أما الاتجاه الثالث -حسب أحد المعبرين عنه بوضوح وأقصد عبد الإله بلقزيز، فهو “تيار التثاقف النقدى”، “الذي لا نعثر له على أشباه ونظائر في المجتمع الأهلي”، والذي يؤمن ب “كونية المعرفية ومقولات العقل ومنظومة المفاهيم التي تنهض عليها فكرة الحداثة” وهو “الأكثر توازنا في الوعي العربي المعاصر، وعلى صعيد إدراكي للغرب والثقافة الغربية بالذات. وموقف الفرادة والتميز في موقف هذا التيار- في تحركه على أرضية من التمثل للثقافة الغربية صلبة: فهو يبدي سائرا أنواع الانفتاح عليها دون تردد… لكنه يحفظ لنفسه، في الوقت ذاته، حق مساءلتها وإخضاعها للنظر النقدي لعيار درجة مطابقتها للحاجات الاجتماعية والفكرية للمجتمع العربي. ينتظم منطق هذا التيار وعي حاد بالحاجة إلى ممارسة فعلين معرفيين متضافرين وعضويين، تمثل فكرة “الآخر” ونقده في الآن نفسه”(30).
كانت تلك نتف تعريفية لهذا الاتجاه تصورا ومنهجا. الاتجاه الذي يحترز أصحابه عن أن يكون تلفيقيا انتقائيا بين الاتجاهين، فهو إذ يؤكد الانتماء إلى التاريخ والحضارة واللغة يرفض في الوقت ذاته “أي انغلاق تراثوي” و”أي التزام ماضوي” كما يرفض، إذ يؤكد انفتاحه ناهلا من الغرب، أي شكل من أشكال التبعية والإلحاق والاستلاب، هو إذن، في نظر أصحابه “تركيب” معرفي له شروطه الخاصة في النقد والانفتاح. لكن، لئن كان هذا الاتجاه واضحا في مسألة الانفتاح الكامل المشروط بالممارسة النقدية ودرجة النفع..، وهي أمور ينبغي تقريرها وتأكيدها في علاقة الذات بالآخر، فإن الغامض المبهم يبقى في تحديد مرجعية الذات ومكونات هذه المرجعية. ولعل السؤال الكبير المحرج المتوجه على هذا الاختيار ذي النزوع القومي خصوصا، هو في عدم حسمه وبشكل واضح مع المعطى الإسلامي الوحي كأصل أول لهذه المرجعية، ومحرك أول للذات العربية والإسلامية..
واكتفائه بمحددات أخرى للذات هي إنجازات تاريخية لا تعدو أن تكون شكلا من أشكال التجلي الحضاري لهذا الدين، ثقافة ولغة وتراثا وتاريخا.. إلخ. هذه التجليات التي بانفصالها عن محركها الأول فقدت فاعليتها ولم يعد بإمكانها أن تشتغل للقيام بوظائف الوحدة والتكامل والنهضة والتقدم.. “المحرك الأول” الذي يدلها بسننه الدينية الشرعية الناهضة بالذات، على سننه الكونية القدرية الناهضة بالمجتمع، نحو قيم الخير والصلاح في الحال والفلاح في المآل.
ولاشك أن تجربة ما يناهز القرن من الزمان من العمل تحت ظل تلك الشروط والمكونات، مع طموحات كبيرة أو صغيرة، معظمها، إن لم يكن كلها، قد انتهى إلى نتائج مناقضة لتلك التي كان يطمح إليها بل ويحلم بها. حيث تركزت على طول العالم العربي وعرضه “قيم” التجزئة بدل الوحدة، والنزاع والخلاف بدل التعاون والتكامل، وتضخم منطق “الأنا” وتكرست التبعية بكل ألوانها بدل التحرر وخدمة المصالح القومية.. إلخ.
إن القرآن الكريم وهو نص قد أعلى من شأن العقل بما هو فعل وإنجاز أيما إعلاء. وناط به مهمة الاستخلاف والتكليف والتعمير، وأمر، وهو نص، بارتياد العالم المشهود آفاقا وأنفسا، وحض على العلم وطلبه. وجعل من عالمية رسالته ودعوته فضاء لتعارف وتحاور الحضارات والثقافات…
إن التثاقف النقدي مع الآخر يستلزم مسطرة في النقد تقوم على آليات ومناهج منطلقة من الذات، والذات ليست في العمق إلا الثقافة الإسلامية بسقيمها وسليمها، وليس من سبيل إلى تغيير ذي انتماء حقيقي للذات إلا أن تكون الأصول المرجعية الكبرى للذات على رأس آلاته النقدية الفاحصة سواء تعلق الأمر بما يفد على هذه الثقافة من خارجها أو بما ينمو في أحشائها من تشوهات وتحريفات.
ترى ما معنى الانتماء إلى ثقافة وحضارة وتاريخ إسلامي بلا إسلام موجه؟ إن هذا الاتجاه كما يصرح كثير من بناته ومنظريه يربأ بنفسه عن الالتواء والنفاق العلماني الذي يميز بين “الإسلام الوحي” و”الإسلام التاريخ”، فيطعن في الأول من خلال الثاني ثم يلغيهما ويريح نفسه، واهما، من أية تبعات عقدية وتشريعية، في الوقت الذي يلتمس فيه للذات أصولا ومراجع أخرى خارجية يدين لها بولاء أكبر والتزامات أكثر.
إن المنهج العلمي القائم على النقد أساسا، يقتضي تمحيص مفهوم الانتماء و “الولاء” للذات أو للآخر فإذا تمحص للذات، لزم من ذلك التزام أصولها وثوابتها التي بها كانت ولا تزال ذاتا. لزم جعل ما هو أصل ومنطلق ثابت وقار، أصلا ومنطلقا ثابتا وقارا. وجعل ما هو متحرك ومتغير، متحركا ومتغيرا. فإذا تم التسليم بربانية الوحي، والتمييز فيه بين دوائر الثبات والمرونة والقطعيات والظنيات، ثم تجليات ذلك في تاريخنا، أمكن من جهة أن نستوعب عملية التصحيح الثقافي الداخلية، وأن ندرك، من جهة أخرى، حدود التثاقف وتخومه مع الآخر. أما أن نجعل عملية التثاقف قائمة على تاريخ بلا أصول وحضارة بلا أسس وقيم.. أو قل قائمة على متغيرات بلا ثوابت، فلا شيء يضمن، مهما كان سلاح النقد حادا، الصمود أمام تيار العولمة الكاسح. وهل نعدم شواهد من تاريخنا انهزم فيها المسلمون وانتصرت المبادئ؟ بل وهل كان الفتح الذي به تحققت العالمية الأولى فتحا إلا بهذه المبادئ والأصول؟
للأسف لقد تأسست في تاريخنا الفكري أشكال من التقابلات الوهمية والزائفة غذتها مؤثرات خارجية قديما وحديثا، وتأسست بذلك عوامل من الفرقة والتجزئة “المذهبية” في مدارس واتجاهات قائمة بذاتها، تنتمي إلى أحد طرفي المعادلة. المعادلة التي ابتدأت ب “أهل الرأي وأهل الأثر” و”العقل والنقل” و”الحكمة والشريعة”، وتبلورت إلى “العلم والدين” و”الدين والدولة” و”التراث والتجديد” و”الأصالة والمعاصرة” و”الحداثة والتقليد”… واللائحة مرشحة لإنجاب المزيد.
للأسف أيضا فإن مناهج التاريخ والدراسة لهذا الفكر بمذاهبه الفقهية والعقائدية وتياراته الفكرية والفلسفية، لم تعمل على إحياء وإنضاج “ثقافة الوحدة” المؤطرة للخلاف والمستوعبة له بقدر ما أرخت لـ “الفرق بين الفرق” ولـ “الملل والنحل” وتعمقت في أسباب الخلاف تأصيلا وتفريعا.
إن القرآن الكريم وهو نص قد أعلى من شأن العقل بما هو فعل وإنجاز أيما إعلاء. وناط به مهمة الاستخلاف والتكليف والتعمير، وأمر، وهو نص، بارتياد العالم المشهود آفاقا وأنفسا، وحض على العلم وطلبه. وجعل من عالمية رسالته ودعوته فضاء لتعارف وتحاور الحضارات والثقافات… حيث أثمر كل ذلك معرفة اندمج فيها العقل بالنقل والعلم بالدين والأصيل بالمعاصر، معرفة استوعبت معارف وثقافات الشعوب المفتوحة على اختلاف تشكلاتها. إمكانات هائلة فعلا للتثاقف يتيحها هذا الدين بكونية رسالته، تتجاوز كل دعوات الانفتاح الجزئية والمبتورة التي غالبا ما تنتهي إلى تبعية واستلاب.
يبقى أن تغييرا جذريا ومراجعة عميقة لكثير من المفاهيم والتصورات السائدة “أصيلة” كانت أم دخيلة، التي فرقت أكثر مما وحدت وباعدت أكثر مما قاربت.. بإعادة بنائها على أصول الشرع في انفتاحها واستلهام الخبرات والتجارب التاريخية التي كانت إحدى تجلياتها الإيجابية، أمر وحده كفيل بوضع الأمة في مسارها الصحيح. ومفهوم التثاقف غير شاذ عن هذا الاطراد، لكن قبله نقول لدعاته بضرورة إعادة بناء الثقافة التي تنتمي إلى الذات على أصول الذات لتتحقق بشرط الذاتية كاملا. إذ كلما كان هذا الشرط كاملا كلما كان التثاقف مثمرا، والإخلال بشرط من شروط الذات، أو أصل من أصولها هو فقدان لروافد ودعائم الأصل فيها أن تسند هذه الثقافة في تدافعها مع الثقافات الأخرى. فتضعف، بدونها، إذاك حظوظ النجاح والإيجابية فيها. فكيف إذا كان الإخلال جزءا أو كلا، بأصل الأصول وشرط الشروط، الوحي المؤسس والملهم، منبع القوة والاستمرار؟!
المصدر: مجلة حراء
الهوامش
مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر، ط4، (1406ﻫ/1986م)، ص13.
المرجع نفسه، ص50.
المرجع نفسه، ص26-63.
المرجع نفسه، ص64.
نفسه، ص73-74.
محمد عابد الجابري، العولمة والهوية الثقافية.. عشر أطروحات، مجلة المستقبل العربي، ع: 228 – 2/1998، ص14.
برهان غليون، اغتيال العقل، منحة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية، ط2/1987 دار التنوير للطباعة والنشر ص335.
الجابري، م، س، ص15. ويقترح الكاتب شروطا غريبة لاستكمال الهوية الثقافية، فهذه عنده لا تكتمل إلا إذا كانت مرجعيتها جماع الوطن والأمة والدولة، لتنشد العالمية وتقدر على الأخذ والعطاء. الوطن (الجغرافيا والتاريخ). الأمة (النسب الروحي الذي تنسجه الثقافة المشتركة). الدولة (بوصفها التجسيد القانوني لوحدة الوطن والأمة)، وكل مس بإحداها هو مس بالهوية الثقافية والعكس صحيح. والواقع أنه لا يمكن الفصل بين هذه المكونات ويمكن التعبير عن أيها بالأخرى بشكل أو بآخر، ولهذا نجد تكرار العناصر المكونة لها. في حين أنه بالإمكان التعبير عنها بلفظ جامع هو الأمة باعتبارها أيضا جغرافيا وتاريخ، وتجسيدا قانونيا للوحدة، سواء تعلق الأمر بالمفهوم الكلي أو الجزئي للفظ وأيضا إضافة مكونات أخرى أساسية ومحددة للهوية الثقافية وعلى رأسها الدين، ثم اللغة والتراث…إلخ. أنظر للكاتب بهذا الصدد أيضا: المسألة الثقافية، صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 1994.
الجابري، م، س، ص14.
- ميشيل كلوغ، أربع أطروحات حول عولمة أمريكا.. مجلة الثقافة العالمية (85)، (نونمبر-ديسمبر 1996/رجب-شعبان 1418)، ص57.
(*) في ظل العولمة هناك حديث أيضا عن “الجريمة العابرة للحدود” أنظر في ذلك مثلا: “فخ العولمة، الاعتداء على الرفاهية والديمقراطية، لمؤلفيه هانس بييرمارتن وهار الدشومان، ترجمة: عدنان عباس علي، مراجعة وتقديم رمزي زكي، سلسلة عالم المعرفة ( 238) ط 1، 1999، ص36.
- سيرج لاتوش، تغريب العالم، ترجمة خليل كلفت. نشر ملتقى تانسيفت، ط2، البيضاء 1999، ص47.
- المرجع نفسه، ص49.
- المرجع نفسه، ص50.
(*) في حوار مطول مع د. محمد أركون، حدثني عن بعض ما يلاقيه من تهميش واستعباد ونعت بالرجعية والتقليدية والتطرق.. كلما حاول أن يقف موقفا فيه بعض الحياد من القضايا التي تهم المسلمين والفكر الإسلامي في الغرب. هذا علما بأنه أمضى نحوا من ثلاثة عقود في الدعوة إلى العلمانية وأنماط التحديث الغربي وتطبيق مناهجه المختلفة على الفكر والتاريخ الإسلامي، بل لم يجد حرجا في أن يدون هذا الشعور بالدونية والتحقير رغم قيامه بـ “الواجب” في بعض كتبه، وخاصة كتاب “الإسلام أوروبا الغرب.. رهانات المعنى وإرادات الهيمنة” الذي وقعه لي وطلب مني أن أبلغ مضامينه ونحواه بأسلوبي الخاص. فهو كثير الشكوى من كون قرائه في العالم الإسلامي خصوصا لا يفهمونه كثيرا ويظلمونه كثيرا (كذا قال).
- س.لاتوس، تغريب العالم، م، س، ص64.
- ابن بني، مشكلة الثقافة، ص119.
- المرجع نفسه، ص98.
(*) لا يخفي طبعا أن حديث الكاتب كان قبل انهيار (ا. س) والمنظومة الشرقية الاشتراكية عموما، حيث كانت تشكل قطبا منافسا في الزعامة لـ (و. م. أ). لكن التحليل الثقافي للكاتب يبقى مطردا مستوعبا لكل أشكال التكامل الثقافي بين المراكز الحضارية المتعددة، خاصة تلك التي بدأ يفرزها الاستفراد الأمريكي أو يدفعها باتجاه المنافسة الحادة. كالوحدة الأوروبية، والقوى الآسيوية: اليابان الصين، وما كان يعرف “بالنمور الآسيوية”… أما بالنسبة للعالم الإسلامي فالأمر على رتابته منذ التوزيع الاستعماري بالرغم من توافر مقومات الوحدة والتكتل على كافة الأصعدة والمستويات، يؤطرها تاريخ ديني حضاري واحد، وحاضر من المعاناة والمشكلات واحد، ومستقبل من الآمال والتطلعات واحد.
- ابن بني، م، س، ص108.
- المرجع نفسه، ص115.
- روجيه غارودي، من أجل حوار بين الحضارات، ترجمة ذوقان قرطوط، دار النفائس ط1، (1411ﻫ/1990م)، ص226.
(*) إن لم يكن بمعنى المطابقة والتماهي؛ فبمعنى الخضوع والتبعية والولاء.
- محمد الكتاني، أي منظور لمستقبل الهوية في مواجهة تحديات العولمة، في: العولمة والهوية، سلسلة الدورات، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، (1417ﻫ/1997م)، ص82.
- محمد الكتاني، م، س، ص82.
(*) انظر بخصوص هذا التعبير ودلالاته كتاب “فخ العولمة”، م، س، ص35، وسنزيد هذا المعنى توضيحا أثناء حديثنا عن العولمة باعتبارها نظاما رأسماليا شموليا كليانيا. وقد أطلق البعض تسمية قريبة ومماثلة للعولمة باعتبارها “صيغة جديدة لنظام رأسمالي توربو”. انظر حسن أوريد، الإسلام والغرب والعولمة، كتاب الجيب، منشورات الزمن، رقم 6، 1989، ص71-72.
- برهان غليون، الوعي الذاتي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط2، 1992، ص98.
- نفسه، ص99.
(*) تجدر ملاحظة أن تصور الكاتب عن الإسلام عموما لا يخلو من أثر استشراقي وخاصة في سائل الحدود أو في مقارنته له ب%