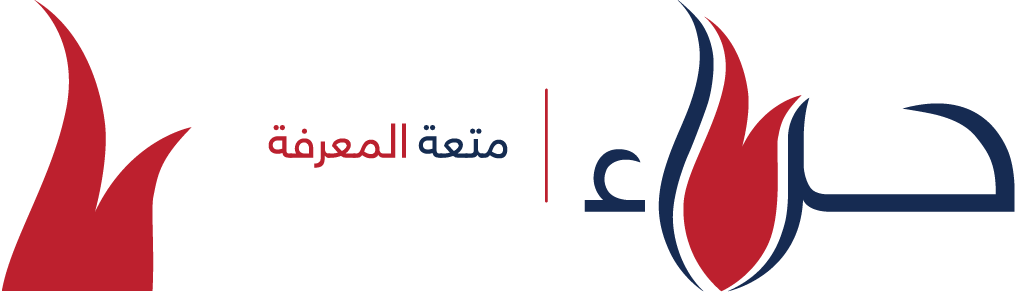نعم، إن الإنسان يشبه البذرة، فلقد وُهبت للبذرة أجهزةٌ معنوية من لدن “القُدرة الإلهية” وأُدرجت فيها خطةٌ دقيقة ومهمة جدًّا من “القَدَر” لتتمكن من العمل داخل التربة، ومن النمو والترعرعِ والانتقالِ من ذلك العالم المظلم الضيق إلى عالم الهواء الطليق والدنيا الفسيحة، ومن الدعاء إلى خالقها بلسان الاستعداد والقابليات لكي تصير شجرةً، حتى تصل إلى الكمال اللائق بها.
فإذا قامت هذه البذرةُ (بسوء مزاجها وفساد ذوقها) بجلب المواد المضرة بها، وصرفِ أجهزتها المعنوية التي وُهبت لها إلى تلك المواد التي لا تعنيها بشيء، فلا شك أن العاقبةَ تكون وخيمةً جدًّا؛ إذ لا تلبث أن تتعفن دون فائدة، وتبلى في ذلك المكان الضيق.
أما إذا أخضَعتْ أجهزتَها المعنوية لتتمثل أمر (فَالِقُ الْحَبِّ والنَّوَى)(الأنعام:95) التكويني وأحسنتْ استعمالَها، فإنها ستنبثق من عالمها الضيق لتكتملَ شجرةً مثمرةً باسقة، ولتأخذ حقيقتُها الجزئية، وروحُها المعنوية الصغيرة صورتَها الحقيقية الكلية الكبيرة.
فكما أن البذرة هكذا فالإنسانُ كذلك. فقد اُودعتْ في ماهيته أجهزةٌ مهمةٌ من لدن القدرة الإلهية، ومُنحَ برامجَ دقيقة وثمينة من لدن القَدَر الإلهي. فإذا أخطأ هذا الإنسانُ التقديرَ والاختيار، وصَرَف أجهزتَه المعنوية تحت ثرى الحياة الدنيا وفي عالم الأرض الضيق المحدود، إلى هوى النفس، فسوف يتعفّنُ ويتفسّخ كتلك البذرة المتعفنة، لأجل لذةٍ جزئيةٍ ضمن عمرٍ قصيرٍ وفي مكانٍ محصور وفي وضع متأزم مؤلم، وستتحمل روحُه المسكينة تبعات المسؤولية المعنوية فيرحلُ من الدنيا خائبًا خاسرًا.
أما إذا ربّى الإنسانُ بذرةَ استعداده وسقاها بماءِ الإسلام، وغذّاها بضياءِ الإيمان تحت تراب العبودية موجهًا أجهزتَها المعنوية نحو غاياتها الحقيقية بامتثال الأوامر القرآنية، فلا بد أنها ستنشقّ عن أوراقٍ وبراعم وأغصانٍ تمتدّ فروعُها وتتفتّح أزاهيرُها في عالم البرزخ وتولّد في عالم الآخرة وفي الجنة نِعمًا وكمالاتٍ لا حد لها. فيصبح الإنسان بذرةً قيّمةً حاوية على أجهزة جامعة لحقيقة دائمة ولشجرة باقية، ويغدو آلةً نفيسة ذات رونق وجمال، وثمرةً مباركة منوِّرة لشجرة الكون.
نعم إن السموَّ والرقي الحقيقي إنما هو بتوجيه القلب، والسرِّ، والروح، والعقل، وحتى الخيال وسائر القوى الممنوحة للإنسان، إلى الحياة الأبدية الباقية، واشتغال كلٍّ منها بما يخصّها ويناسبها من وظائف العبودية. أما ما يتوهمه أهلُ الضلالة من الانغماس في تفاهات الحياة والتلذّذِ بملذاتها الهابطة والإنكباب على جزئيات لذاتها الفانية دون الالتفات إلى جمال الكليات ولذائذها الباقية الخالدة مسخّرين القلب والعقل وسائر اللطائف الإنسانية تحت إمرةِ النفس الأمارة بالسوء وتسييرها جميعًا لخدمتها، فإن هذا لا يعني رقيًّا قط، بل هو سقوطٌ وهبوط وانحطاط.
ولقد رأيت هذه الحقيقة في واقعة خيالية سأوضحها بهذا المثال:
دخلتُ في مدينة عظيمة، وجدت فيها قصورًا فخمة ودُورًا ضخمة، كانت تُقام أمام القصور والدور حفلات ومهرجانات وأفراح تجلب الأنظار كأنها مسارحُ وملاهٍ، فلها جاذبية وبهرجة. ثم أمعنت النظر فإذا صاحبُ قصر واقفٌ أمام الباب وهو يداعب كلبه ويلاعبه. والنساء يرقصن مع الشباب الغرباء، وكانت الفتيات اليافعات ينظّمن ألعابَ الأطفال. وبوّاب القصر قد اتخذ طورَ المشرف يقودُ هذا الحشد. فأدركت أن هذا القصر خالٍ من أهله وأنه قد عُطّلت فيه الوظائف والواجبات. فهؤلاء السارحون من ذويه السادرون في غيّهم قد سقطت أخلاقُهم وماتت ضمائرهم وفرغت عقولُهم وقلوبُهم فأصبحوا كالبهــائم يهـيمون علـى وجوههم ويلعبون أمام القصر.
ثم مشــيتُ قــلــيلاً فـفاجأني قصرٌ آخر. رأيت كلباً نائماً أمام بابه. ومعه بوّاب شهمٌ وقور هادئ، وليس أمام القصر ما يثير الانتباه، فتعجبت من هذا الهدوء والســكـيــنــة واستغـربت! واستفـــسرتُ عن الســـبــب، فــدخلت القصرَ فوجدته عامرًا بأهله، فهناك الوظائف المتباينة والواجبات المهمة الدقيقة ينجزها أهلُ القصر، كلٌّ في طابقه المخصص له في جوّ من البهاء والهناء والصفاء بحيث يبعث في الفؤاد الفرحة والبهجة والسعادة. ففي الطابق الأول هناك رجالٌ يقومون بإدارة القصر وتدبير شؤونه، وفي طابقٍ أعلى هناك البناتُ والأولاد يتعلمون ويتدارسون.
وفي الطابق الثالث السيداتُ يقمن بأعمال الخياطة والتطريز ونسج الزخارف الملونة والنقوش الجميلة على أنواع الملابس، أما الطابق الأخير فهناك صاحبُ القصر يتصل هاتفيًّا بالملكِ لتأمين الراحةِ والسلامةِ والحياة الحرّة العزيزة المرضية لأهل القصر، كلٌّ يمارس أعماله حسب اختصاصه وينجز وظائفه اللائقة بمكانته الملائمة بكماله ومنزلته.
ونظرًا لكوني محجوبًا عنهم فلم يمنعني أحدٌ من التجوّل في أنحاء القصر؛ لذا استطلعت الأمور بحرّية تامة. ثم غادرتُ القصر وتجولت في المدينة فرأيتُ أنها منقسمةٌ إلى هذين النوعين من القصور والبنايات، فسألت عن سبب ذلك أيضًا فقيل لي: “إن النوع الأول من القصور الخاليةِ من أهلها والمبهرجِ خارجُها والمزينةِ سطوحُها وأفنيتُها ما هي إلا مأوى أئمة الكفر والضلالة. أما النوع الثاني من القصور فهي مساكن أكابر المؤمنين من ذوي الغيرة والشهامة والنخوة”. ثم رأيت أن قصراً في زاوية من زوايا المدينة مكتوبٌ عليه اسم (سعيد) فتعجبت، وعندما أمعنت النظر أبصرت كأن صورتي قد تراءت لي، فصرختُ من دهشتي واسترجعت عقلي وأفقتُ من خيالي الواقعي.
وأريد أن أفسر بتوفيق الله هذه الواقعة الخيالية:
فتلك المدينة هي الحياة الاجتماعية البشرية ومدنية الحضارة الإنسانية، وكل قصر من تلك القصور عبارة عن إنسان، أما أهلُ القصر فهم جوارحُ الإنسان كالعين والأذن، ولطائفُه كالقلب والسر والروح، ونوازعُه كالهوى، والقوة الشهوانية، والغضبية. وكلُّ لطيفةٍ من تلك اللطائف معدّةٌ لأداءِ وظيفةِ عبوديةٍ معينة ولها لذائذُها وآلامُها، أما النفس والهوى والقوة الشهوانية والغضبية فهي بحكم البوّاب وبمثابة الكلب الحارس. فإخضاع تلك اللطائف السامية إذن لأوامر النفس والهوى وطمس وظائفها الأصلية لا شك يعتبر سقوطًا وانحطاطًا وليس ترقيًا وصعودًا.
المصدر:
* الكلمات، الكلمة الثالثة والعشرون، المبحث الثاني. بديع الزمان سعيد النورسي.