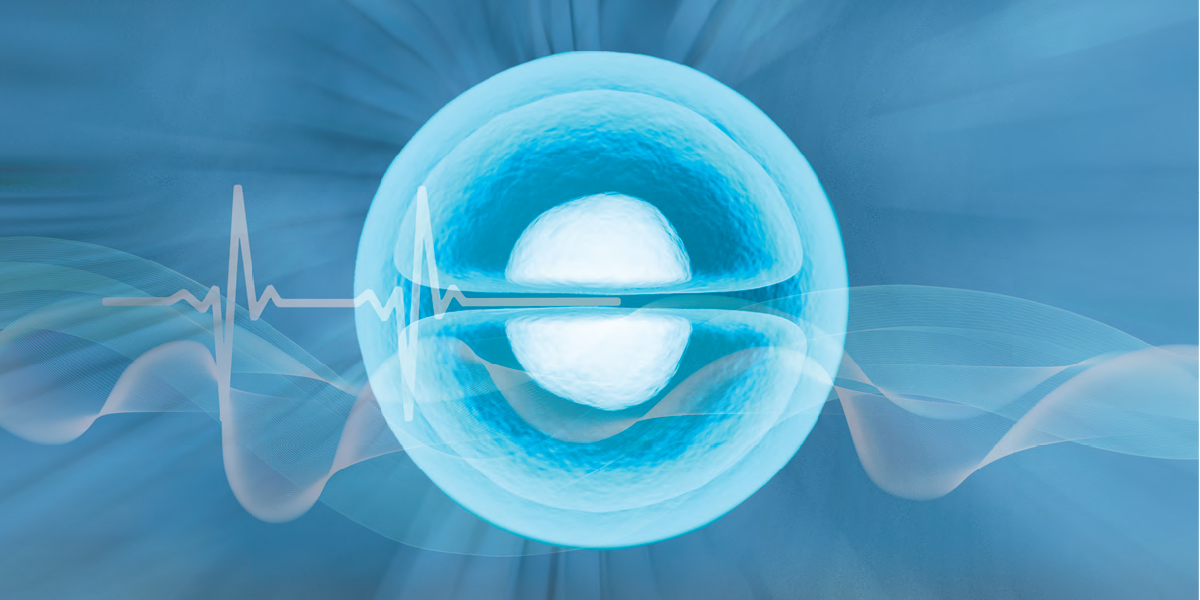علم الفيزياء هو علم الطبيعة، بدءًا من الكوارك البالغ الصغر، إلى الكون الكبير الممتد. وتحاول الفيزياء صياغة “قوانين رياضية” تحكم هذا العالم المادي الطبيعي، وسبر أغوار تركيب المادة ومكوناتها الأساسية، والقوى الأساسية التي تتبادلها الجسيمات والأجسام المادية. إضافة لنتائج هذه القوى أحيانًا في الفيزياء المعاصرة، تضاف مجالات دراسة قوانين التناظر والحفظ، مثل قوانين حفظ الطاقة والزخم والشحنة الكهربائية. ولأجل هذا، يدرس الفيزيائيون مجالاً واسعًا من الظواهر الفيزيائية تمتد من المجالات الصغيرة المدى إلى المجالات واسعة المدى، ومن الجسيمات المادية تحت الذرية التي تتكون منها جميع المادة الباريونية (فيزياء الجسيمات) من دراسة “سلوك” الأجسام الفيزيائية في العالم “الكلاسيكي”، إلى دراسة حركة النجوم في الفضاء المادي، سواء ضمن السرعات العادية أو قريبًا من سرعة الضوء، و أخيرًا دراسة الكون في شموليته.
إن علماء فيزياء الجسيمات يتمثل دورهم اليوم في محاولة “بناء علم للطبيعة” بالمعنى “الدقيق” للكلمة، ولكي نصل إلى إمكانية وجود فيزياء افتراضية، يجب البحث في شروط هذه الإمكانية في نظرية للطبيعة كعلم.
وهنا مفهوم المعرفة يأخذ معناه التقريبي، وبالتالي من السهل إدراك أنه بإمكاننا الوصول إلى معرفة الأشياء التي ندرك مبادئ إمكانيتها، لأنه بدون ذلك، يصبح كل ما نعرفه عن موضوع ما -آلة معينة مثلاً- هو شكلها لأننا نجهل بناءها، ومن ثم ندرك ما نراه فقط. وهذا الأمر مرتبط باقتناع بسيط حول وجودها، غير أن مخترع هذه الآلة يملك معرفة “كاملة”، لأنه يمثل “روح” هذا الإنجاز، ولأن الآلة قد “تواجدت” في دماغه كـ”فكرة متصورة” قبل أن تصبح “واقعًا”.
كما أن ولوج عمق البناء الداخلي للطبيعة عملية “مستحيلة”، إلا إذا تدخلنا بـفعل حر، وبدون شك، فالطبيعة تستجيب بكل انفتاح وحرية، وليس أبدًا بطريقة مغلقة؛ فهي خاضعة لعدد كبير من الأسباب الواجب “تجاوزها”، قصد الحصول على نتائج “خالصة”.
لذا يجب افتراض طبيعة “تستجيب” لشروط معيّنة، وقد تكون معدلة من طرف شروط أخرى. هذا النوع من “التدخل” في الطبيعة يدعى بالتجربة، وكل تجربة هي سؤال مطروح على الطبيعة التي من “واجبها الإجابة” عنها. لكن كل تساؤل يحمل ضمنيًّا حكمًا مسبقًا، لأن كل تجربة كتجربة، هي تنبؤ؛ فالتجريب هو إثارة ظواهر وبناء وقائع مستقبلية. إن الخطوة الأولى نحو العلم، يجب أن تعمل على “إنتاج” مواضيع هذا العلم بذاته.
أزمة النظريات الفيزيائية
ما نريد التفكير فيه هو أن جميع الظواهر ترتبط بـ”قانون واحد”، وهو “مطلق” ولكنه ضروري، لذا يمكن استنتاجها (الظواهر)، وبالتالي معرفتها قبلاً. وفي حالة ما إذا “لم تتمكن” التجربة من تحقيق هذه المعرفة لكونها لا تستطيع أن تغامر فيما وراء قوى الطبيعة، التي تستعملها كوسائل.
وبما أن الأسباب الأولية للظواهر الطبيعية لا تظهر بطبيعتها، فيجب التسليم بوجودها. لكن ما نضمره في الطبيعة ليس له إلا قيمة فرضية، والعلم مثلما هو مبني يجب أن يكون افتراضيًّا، شأنه شأن المبدأ الذي يقوم عليه.
لكن يمكن أن يكون الأمر عكس ذلك، وبالذات عندما تكون الفرضية أهم من الطبيعة نفسها، فـ”تذبذب” الطبيعة بين الإنتاجية والمنتوجية، يجب اعتبارها مفعولاً صادرًا عن ازدواجية المبادئ التي بفضلها تبقى في نشاط دائم: الازدواجية العامة كمبدأ لجميع ظواهر الطبيعة وضرورية للطبيعة ذاتها.
هذا الافتراض “المطلق”، يجب أن يكون معقولاً في ذاته، كذلك يجب أن يخضع للتجربة الأمبريقية، لأنه في حالة عدم خضوع ظواهر الطبيعة لاستنتاج هذا الافتراض، سيفقد هذا الأخير قيمته ويصبح “خاطئًا”، إذ بفضل استنتاج جميع ظواهر الطبيعة عن طريق افتراض واحد و”مطلق”، فإن معرفتنا ستتحول إلى “تقليص قبلي” لهذه الطبيعة؛ أي تصبح “علمًا لطبيعة قبلية”. إذا كان هذا الاستنتاج ممكنًا بشرط البرهنة عليه بالوقائع، فإن نظرية الطبيعة كعلم للطبيعة، ستصبح الفيزياء الافتراضية ممكنة كذلك.
ولا تقتصر فوائد فيزياء الجسيمات على الاكتشافات المذهلة لدقائق تكوين المادة على المستوى تحت الذري، فلقد شهدت السنوات الأخيرة تطبيقات عملية متعددة لفيزياء الجسيمات في الكثير من المجالات، ففي المجال الطبي أصبحت مسرعات الجزيئات عاملاً أساسيًّا في عدد من التطبيقات الطبية، أكثرها شهرة ماسحات بت، كما يعود الفضل إلى علماء فيزياء الجسيمات في العلاج الإشعاعي لمرض السرطان، والتصوير الرقمي بالأشعة السينية وتصوير مناطق واسعة من القلب.
إن “قبول” بعض علماء الفيزياء المعاصرين بوجود وقائع وظواهر طبيعية فوق حسية يظهر الأزمة النظرية التي تعيشها بعض النظريات الفيزيائية، هذه الأزمة تؤدي إلى إعاقة قبول هذه النظريات علميًّا، وقبول برامج البحث للوصول إلى نتائج أكثر أهمية. لذلك، بدأ التفكير في “التخلي” تدريجيًّا عن الغاية وعن المنهجية.
نحن نعيش في “أكوان متعددة”، بدأ النظر إلى بعض الملاحظات العلمية “المنعزلة” (أي اللامتكررة) كنقاط تحول مركزية جديرة بالبحث والدراسة. فقد أدى تحليل بعض الحوادث “المرتجلة” والأفكار التي كانت تبدو “خاطئة”، إلى وضع دليل أساسي لأبحاث علمية، وهنا بدأ الابتعاد عن فكرة ضرورة وجود براديغمات متعددة تكون مرتبطة بظواهر الخبرة الأساسية المختلفة.
إن أي حقل خاص أو استثنائي يتطلب نظام مغاير للأنظمة السابقة؛ نظام تفسير ميتافيزيقي متعلق بخبراتنا الباطنية. وهذا الحقل لا يحوي “أشياء”، بل عمليات مدركة شخصيًّا من طرف الذات الوحيدة فقط، دون “تدخل” عقل الجماعة. وبالتالي فعملية الاتفاق حول هذه العمليات وماهيتها، أمر “مرفوض” و”غير منطقي”، لذلك، بات أمرًا مؤكدًا أنّ نظامًا واحدًا في العلوم لا يمكنه تفسير جميع الظواهر والخبرات.
حتى إننا تحولنا من الاعتقاد بأننا نعيش في “كون واحد”، إلى معرفة أننا نعيش في “أكوان متعددة” وبموازاة هذا التغير. لاحظ العلماء أنّ غالبية الكائنات البشرية قد نظّمت كل خبرتها في طرائق مختلفة لمقاصد متعددة، فجميع المنظومات كيّفت لغايات محددة.
لقد “تحقق” العلم تدريجيًّا من أنه لا يمكن للإنسان إدراك ما هو واقع، لكن بإمكانه وعي ومعرفة الواقع. فرغم التفسيرات العلمية المنجزة لبلانك، أينشتين، وإيدينغتون، لم يحدث تقدم يذكر في حقول الفيزياء المعاصرة. ومرد ذلك، أن النظريات وتصميم التجارب لا تزال قائمة على وجود نظام تفسير واحد؛ أي وجود نظام فيزيائي عالمي شمولي واحد و”صحيح”، نحو إيمان العلماء بالوحدات والثوابت الفيزيائية كثابتَي بلانك وأفوجادرو.. وهذا هو النظام الذي أعطى فيزياء وميكانيك نيوتن “قوّتها” وحضورها العلميين.
لذا لا يجوز الاتفاق أبدًا مع مبدأ أنه لن يكون هناك مزيدًا من الأسرار والألغاز في الطبيعة. فالطبيعة “لا تنفذ”، ولذا فمهما كانت النظرية “مكتملة”، سيعثر دائمًا على ظواهر تخرج عن نطاقها، ولن يتم أبدًا بناء نظرية نهائية وشاملة، فكيف لنا أن نعرف أن الطبيعة نهائية في تنوعها الكيفي أم أنها لانهائية؟ ومن أين البراهين على هذه الصفة أو تلك للطبيعة؟
إن التسليم “ببساطة” وبدون تحفظات بلانهائية الكون الذي يحيطنا، أمر ينطوي على غاية الخطورة؛ إن تاريخ البشرية “قصير جدًّا”، لذا لا يمكن اعتبار هذا الافتراض “حقيقة ثابتة” ومؤكدة. فقد يحدث أن تؤدي معرفة عدد كبير جدًّا من الحقائق والروابط فيما بينها، إلى “ذرى المعرفة” الخاصة الفريدة في نوعها، ثم يبدأ بعدها عدد الاستفهامات التي لا جواب لها بالتناقص.
الطبيعة تحب تقديم مفاجآت
لقد اعتقد منظرو الخطاب الفيزيائي المعاصر في كثير من المرات، أنهم بلغوا تقريبًّا الفهم التام لقوانين الطبيعة، ولم يبق غير غموض يتعلق بالتفاصيل. وفي كل مرة، كانت محاولاتهم “للتخلص” من هذا “التقريب” ووضع نظرية “نهائية” وغير متناقضة، تبوء بالفشل. وبقيت بصفة مستمرة أسئلة “مُصرة” على عدم إيجاد أجوبة لها، وتحولت إلى متناقضات وأزمات نشأت منها أخيرًا نظرية “جديدة”.
من القضايا غير الواضحة -مثلاً- كيف يتحدد مقدار سرعة الضوء وشحنة الإلكترون والثوابت العالمية الأخرى؟ ولماذا هي على هذا الشكل الذي تملكه الآن وليس على شكل مغاير؟ وعلى أية صورة ستكون نظرية “ما بعد الكمية” القادمة، التي قد تستطيع -في نهاية المطاف- أن تفسر بجلاء طبيعة الأثر الذي تتركه الجسيمات الكمية لدى تحركها في “فراغ تام”؟
ليس من نهاية لهذه السلسلة، وكما بينت التجارب فإن عدد الاستفهامات القاعدية التي تبرز في عملية تطور العلم لا تقل فحسب -كما افترض ذلك فاينمان- وإنما على العكس، تزداد أكثر فأكثر. ويجوز القول إن الحدود التي “يلامس” بها العلم عالم المجهول، تطول على الدوام، فهي تشبه الأفق كلما اقتربنا منه يبتعد عنا أكثر فأكثر، إلا أن العلم ما يزال في حالة تطور.
لقد باتت جميع محاولات توجيه التفكير نحو قوانين الفيزياء وحدها دون أمل علمي يذكر، فمنذ مائتي سنة “تصور” العلم الفكر بأنه شيء مادي ملموس، وقورن مع المادة الصفراء التي يفرزها الكبد. لقد قطع علم الفيزيولوجيا أشواطًا بعيدة عن مثل هذه التصورات، ونشأ الفكر -دون أدنى شك- على أساس عمليات فيزيائية. لكن هذه العمليات تحوي الكثير من العقد والانقطاعات الفجائية. ولكل علم مجال نشاطه، ولا يجوز له أن يشغل مكانة غيره من العلوم.
وقد حدثت تعارضات مشابهة في وقت لاحق؛ إن الطبيعة تحب تقديم “مفاجآت” إلى العلماء، بالضبط عندما يعلن عن أن بعض خواصها وقوانينها باتت “شاملة” ومؤثرة دائمًا وفي كل مكان. لكل شيء في الكون مجال تطبيقه المحدد، ويجب أن نكون مهيئين إلى أن العلم سيكتشف خواص غريبة أخرى للزمان والمكان لا نستطيع نحن اليوم تصورها. أما الخواص المعروفة لنا، فعلى العكس، ستفقد أهميتها في نطاق الظواهر “الجديدة”. وهكذا، نرى أن الكون متنوع إلى درجة فائقة، ومع ذلك، فهو في أساسه موحد إلى درجة فائقة كذلك.
(*) أستاذ جراحة التجميل المتفرغ والعميد الأسبق لكلية طب الإسكندرية / مصر.
المراجع
(1) Descartes (René), Œuvres et lettres, Pléiade Gallimard, Paris, (1952), p.41.
(2) Weinberg (Steven), Facing Up: Science and Its Cultural Adversaries, Harvard University Press, (2001), p.84.
(3) Schrödinger (Erwin), Science and Humanism; physics in our times, Cambridge University Press, (1961), p.25-26.