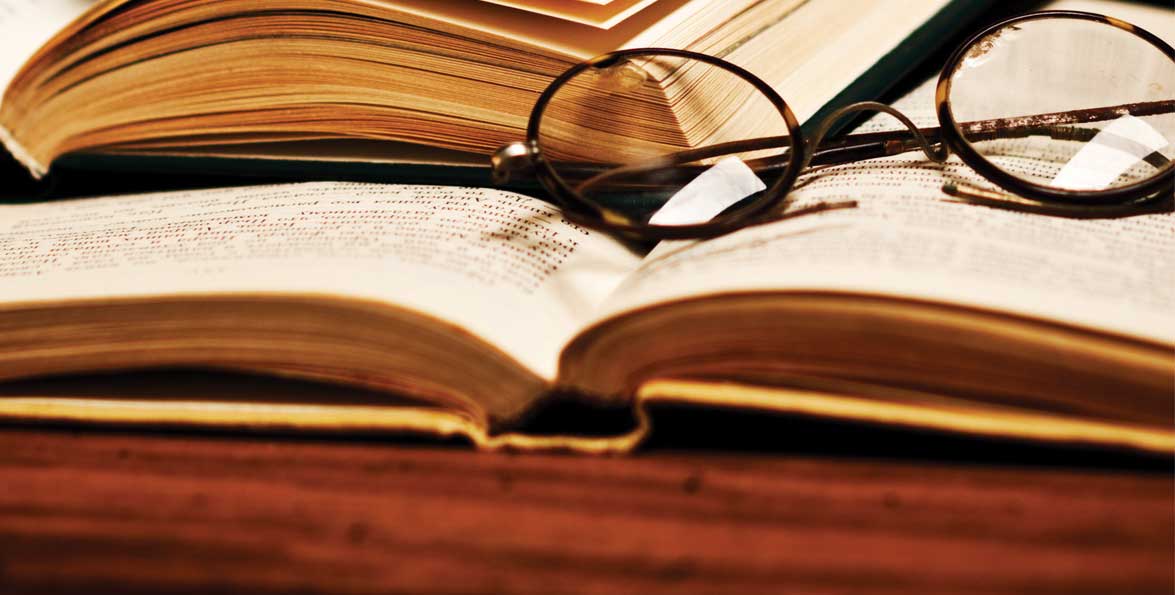من المتفق عليه أن أزمة الثقافة أزمة عالمية، تتداخل في وجودها أسباب عديدة قد يكون التقدم العلمي التكنولوجي في مقدمتها. لكن يأخذ الحديث منحى آخر عندما نتحدث عن الثقافة في المنطقة العربية عامة وفي المغرب خاصة، حيث لا توجد إحصائيات لمعرفة علاقة الشباب بالقراءة بشكل دقيق، لذا يبقى الأمر ضمن حدود التصورات الشخصية القائمة بشكل أساسي على الملاحظة والتحليل الشخصي، كتقييم لبعض المؤشرات التي تفيد بأن الشباب المغربي في حالة عزوف عن القراءة، من بينها أرقام مبيعات الكتب في المعارض أو حتى عدد النسخ الموزعة من الكتب وحساب النسبة التقريبية للشباب من بين المشترين.
القراءة إذن هي الوسيلة المثلى التي ركز عليها القرآن الكريم في أول سورة نزلت، لتؤسس الأداة المعرفية العملية لتَعلُّم الإنسان وتحريره من الجهل والتقليد والركود الذهني والنفسي والعملي والإنتاجي في دورة الحياة والحضارة، ومن خلالها يستطيع الإنسان فهم نفسه ومجتمعه وتطوير عقله. لكن لماذا تحاول المجتمعات الراقية المتعلمة الإفادةَ من وقت فراغها بالقراءة، بينما تراجعت في بلادنا القراءةُ كثيرًا وأصبحت بندًا مهملاً في جدول أعمال معظم أفراد مجتمعاتنا؟ أهو الوقت والعدو وراء لقمة العيش، أم التقنيات الحديثة كالقنوات الفضائية والفيديو والكمبيوتر والإنترنت؟ هل هو غياب دور الأسرة في التوجيه والترشيد والتحفيز للقراءة، أم أن العثور على كتاب قيّم يجذب القارئ بالشكل والمظهر والمضمون أصبح صعب المنال؟
هل هو سعر الكتاب الذي لا يتناسب مع دخل الأسرة الهزيل، أم هي لا مبالاة وشيوع ثقافة الاتكالية والاستهلاك والتسطيح المعرفي، وضعف تكوين الأسر والمناهج التربوية وطرق التدريس التقليدية غير المحفزة على السؤال والنقد والإبداع والانفتاح والمعرفة والاستيعاب؟ والأهم من هذا كله، تُرى هل علَّمْنا أبناءنا -أُسرًا وأساتذة ومؤسسات تربوية واجتماعية وإعلامية- أن يجعلوا من القراءة متعة؟
هذه مجموعة أسئلة وأخرى تطرح نفسها بشدة إذا أردنا مقاربة زوايا آليات النهوض بتفعيل موضوع حب المطالعة في مجتمعنا.
حين نتحدث عن الربيع العربي، ينبغي أن نفرشه بأزهار الربيع الثقافي التي تذبل أمام انخفاض مستويات القراءة والمطالعة بين شبابنا، فإحصائيات بعض المؤشرات تتحدث عن أن 300 ألف عربي يقرؤون كتابًا واحدًا، ونصيب كل مليون عربي هو 30 كتابًا، ومعدّل ما يخصصه المواطن العربي للقراءة الحرة سنويًّا هو عشر دقائق فقط، ومعدل القراءة السنوية للشخص الواحد في العالم أربعة كتب، وفي العالم العربي ربع صفحة. وحين تكون هذه المؤشرات نابعة من أمة “اقرأ”؛ الأمةِ التي أخرجها الإسلام من زمن الجاهلية إلى زمن المعرفة، وأسس لها دعائم لبناء عمارة الأرض والكون بأداة القلم التي علّم بها الإنسانَ ما لم يعلم، نفهم وقتها أن مستوى تطور المجتمع، يلعب دورًَا محدِّدًا في إكساب الأفراد سمات معينة في الحياة من بينها عملية القراءة والتثقيف. لذلك أدرك المسلمون هذا الدور، وانكبّوا على ترجمة الفلسفة اليونانية والانفتاح على الثقافات والمعارف الأخرى قراءة وتحليلاً وتجديدًا وتطويرًا، فحققت هذه الشعوب العصرَ الذهبي للحضارة الإسلامية. لكن مع الوقوف عند فترات التقليد والجمود، قلّ الاهتمام بالعلم وبالقراءة وبالبحث العلمي، وصار موضوع القراءة هو “ألف” “باء” مجتمعاتنا. فتطور المجتمعات الأوربية ما كان ليتحقق لولا تقدّم العلم وتفعيل النهوض الثقافي. وهذا يعني أن القارئ الأجنبي ليست لديه سمات بيولوجية تجعله أكثر قدرة على القراءة من القارئ في المجتمعات العربية عمومًا، وإنما هو تعوُّد على ممارسة تؤكد هذا الانطباع. فالأوربيون -على سبيل المثال- عندما يكونون في طريقهم إلى العمل أو في وقت الفراغ، فإن هذا الوقت لا يضيع هدرًا، إنما يستثمرونه في قراءة الصحف أو أي كتاب يكون معهم، لدرجةٍ كنتُ أتألم لحال بعضهم في ميتروهات لندن ساعة الدروة، وهم يمسكون بيد في عمود الميترو حتى لا يقعون أرضًا، ويستعملون اليد الأخرى في تصفح الكتاب مع شدٍّ وجدبٍ وزحمةٍ من دون أي انزعاج أو تراجع عن استمتاعهم بالقراءة والمطالعة.
أظن أنه عندما يستطيع المجتمع أن يضع الوقتَ في مكانه ويؤسس وعيًا مجتمعيًّا بأهميته، يمكن أن يمارس السلوكيات نفسها. فكيف السبيل إلى إعادة اعتبار وإحياء قيمة الوقت واستثمارها في المعرفة والتعلم؟
فماذا قدمنا في مجتمعنا، في مدارسنا، في مؤسساتنا التربوية، لتشجيع شبابنا على القراءة واستثمار الوقت في المعرفة بشتى تلاوينها وتخصصاتها ومواضيعها؟ هل احترمنا عقولهم بتقديم منتوج يتميز بالمصداقية ويجيب عن تساؤلات عصرهم؟ هل أعدنا الاعتبار للثقافة الراقية والمثقف الحقيقي الذي يجب أن يتم الترويج لأفكاره وأعماله عبر كل القنوات الإعلامية حتى يصبح مثلاً أعلى يعوض نجوم الغناء الرديء والفن الهابط الذي يستحوذ على أغلب الفضائيات العربية؟ هل غرسنا محبة القراءة في أبنائنا وجعلناها عادة تلازم شبابنا في مختلف الفضاءات؟ هل استطاعت أحزابنا أن تسعى من خلال تطبيق فعلي عملي لبرنامجها السياسي في هذا الاتجاه تتم أجرأته تربويًّا واجتماعيًّا وإعلاميًّا؟ هل عملنا على تقريب الكتاب من القارئ، وجَعْله في المتناول كمًّا ونوعًا ومنهجًا حتى يستوعب تباين المستويات الفكرية والذوقية والمزاجية والفنية للقارئ؟ وبالتالي هل جعلنا مضامين الكتب في مجتمعاتنا تتماشى مع الحاجيات الملحّة والتحديات المؤرقة لشبابنا حتى نبعدهم من منزلقات وأخطار البحث عن إجاباتها في الأماكن المظلمة؟ ألم يَحِن الوقت بعدُ للتفكير بجدية، وتكثيف الجهود للقيام بمبادرة خطة إستراتيجية شمولية تعمل على النهوض بالقراءة من خلال الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع، باعتبارها بوّابتنا نحو المستقبل والمنافسة الحضارية العالمية؟
ألم يَحِن الوقت لإعلان ثورة ربيع ثقافي ننمّي بربيعها مجتمعنا، ونعمل على تقريب الكتاب من القارئ، وذلك بجعله في المتناول بتأثيث فضاءات الأحياء والقرى بمنتدى ثقافي أو مكتبة أو نادٍ ودار للشباب ومهرجانات للقراءة والمطالعة؟
وهناك مقولات لعلماء عظام تبين أهمية القراءة والمطالعة الحرة أذكر منها:
– الإنسان القارئ تصعب هزيمته.
– إن قراءتي الحرة علّمتني أكثر من تعليمي فـي المدرسة بألف مرة.
سئل أحد العلماء العباقرة: لماذا تقرأ كثيرًا؟ فقال: لأن حياة واحدة لا تكفيني” فالقراءة هي المفتاح الذي يدخل بواسطته أي شخص إلى مجالات العلوم والعوالم المختلفة.
(*) كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن طفيل بـ”القنيطرة” / المغرب.