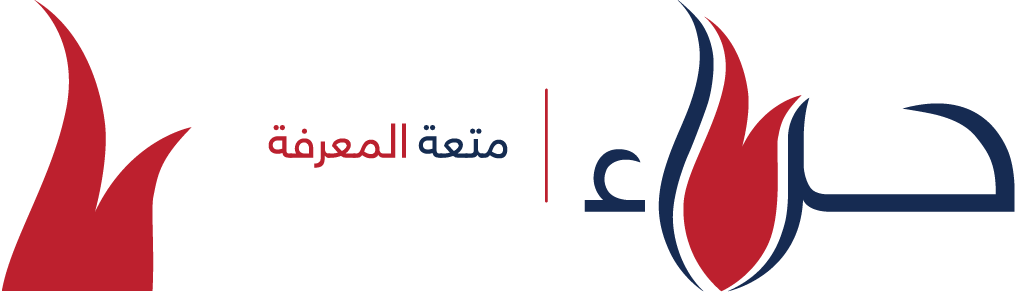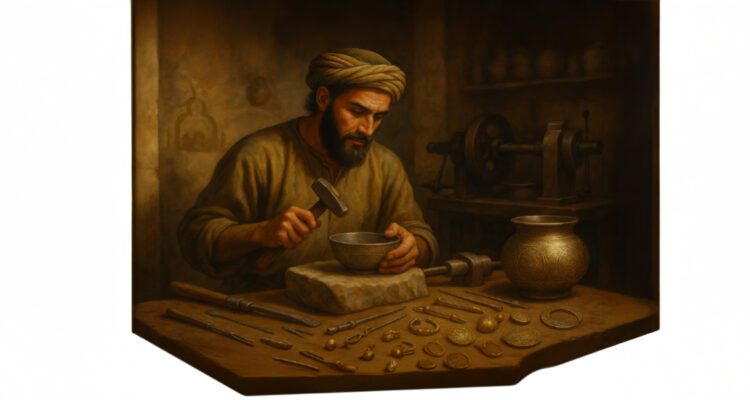نجح الفنان المسلم في تشكيل المعادن من النحاس والذهب والفضة والبرونز، وحولها إلى قطع أثرية مبهرة. وبدت الأعمال الفنية المعدنية هي الوسيلة الفنية الأكثر استمرارية، والأفضل توثيقًا في كثير من الدول الإسلامية. ومن المعلوم أن استخدام المعادن بالمجتمع الإسلامي كان استخدامًا مهمًّا جدًّا وواسع النطاق.
طريقتَي الطرْق والسحْب
ومنذ اكتشاف المعادن، استخدم الفنان المسلم طريقتين رئيسيتين ساعدتاه كثيرًا على صناعة التحف المعدنية، وهما “الطرق والسحب”. وفي نفس الوقت طبَّق الفنان المسلم أسلوب الخرط أو النقل لتشكيل المعادن وتطويعها؛ من خلال الخراطة أو السحب في المخراط، بعدة أنواع من المشغولات المعدنية الإسلامية. وتعدّ عملية الطرْق في الأساس، من أقدم الطرُق التقنية التي استخدمت في عملية صنع التحف، منذ أن تم اكتشاف المعادن الطبيعية في دول الشرق الأدنى. ففي القرن السابع قبل الميلاد، تم صنع بعض أنواع الحُلي والآلات الصغيرة، كالشناكل، والمخاريز، والمغارز، والإبر، وغيرها من قطع النحاس الطبيعية في الأناضول، وذلك وفقًا لأسلوب الطرق هذا. ولكن بعد اكتشاف الذهب والفضة والقصدير والعديد من المعادن اللينة، بات من السهل طرْقها وتطويعها وتشكيلها، حسب التحفة المطلوبة وهي باردة. وفي العصور المبكرة كانت كل تلك المعادن الطبيعية تطرق بمطارق حجرية، وتسحب على سندانات من الحجر أيضًا أثناء تشغيلها.
ارتبط تطور أساليب الطرق والسحب ارتباطًا مباشرًا مع الاكتشافات المعدنية، ومع اختراع عملية تليين المعادن بعد تسخينها وجعلها في وضع يمكن تشغيله، حيث أمكن تشكيل القطع المعدنية إلى الشكل الدائري والبيضاوي أو المحدب المستدير. وبعد أن تم الحصول على المعادن بعد عملية استخلاصها من الفلزات أمكن إكثارها، حيث ترتب على ذلك أيضًا تنوع طرق التشغيل والتصنيع والتطوير. ومع تتابع المخترعات المعدنية بعد استخلاصها وتنقيتها، أمكن صهرها وإعادة صبها في القوالب الخشبية أو الحجرية، التي أعدت من قبلُ حسب النموذج المطلوب، أيْ تم التوصل لاكتشاف أسلوب الصبّ. وذلك الاكتشاف قد لعب دورًا في صناعة التحف المعدنية، وأصبح من الممكن تشكيل المعدن سواء بالحجم أو السُّمك أو الطول المرغوب فيه. وبتلك الطريقة أمكن تصنيع أي شكل مطلوب من الألواح المعدنية. وبناء على ذلك استخدم صُنَّاع التحف المعدنية طريقة الطرق -السابق ذكرها- بكل مناطق الشرق الأدنى، للقيام بصناعة أشكال وأنواع متعددة من القطع النادرة.
الفنان المسلم وتقنية اللحام
كان صُنَّاع التحف المعدنية يقومون بأعمال لحام المعادن، معتمدين على أنفسهم من البداية حتى النهاية؛ وذلك نظرًا لدرايتهم التامة بأنواع المعادن المناسبة والمستخدمة في لحام المعادن، إضافة إلى علمهم أيضًا بدرجة ذوبان المعادن. وكان الفنان المسلم يرجح دومًا سبائك الذهب والنحاس أو الذهب والفضة، في القيام بلحام التحف المعدنية؛ لأن الذهب الخالص ينصهر بدرجة 1083 من الحرارة، لكن إذا تم إضافة النحاس إليه بنسبة 10 بالمائة، فإن الانصهار ينخفض إلى 940 درجة، شرط ألا يتجاوز ذلك نسبة النحاس في تلك السبائك عن 18 بالمائة، وذلك كي لا ترتفع درجة الانصهار مرة أخرى. كما كانت تجهز سبائك نحاسية فضية وأخرى زنكية، للاستخدام في لحام الأعمال والتحف والمشغولات الذهبية.
وعن لحام الأعمال البرونزية، فكان يتم إعداد سبائك برونزية لها ترتفع فيها نسبة القصدير، كما استخدمت أيضًا سبائك نحاسية حديدية في لحام أعمال الحديد، علمًا بأن تواؤم الألوان بين المعدن الأصلي والسبائك المستخدمة يُعد من الأمور المهمة جدًّا، وحتى يمكن الوصول إلى اللون المطلوب، قام الفنان المسلم بعملية خلط لمجموعة من المعادن ببعضها البعض، مع القيام بتغيير الآخر منها، ليصل إلى اللون المطلوب والمستوى المراد. كما تمكّن الصنَّاع المسلمون في إبداع تحف فنية معدنية كبيرة الحجم، من ألواح معدنية عبارة عن قطعة واحدة. ولكن هذه الطريقة كانت شاقَّة، لذا رجع أصحاب الخبرة الفنية في صناعة بعض الأواني، إلى جعل هذه الألواح قطعتين أو أكثر، ثم القيام بجمعها في قطعة واحدة عن طريق استخدام اللحام.
استُخدمت عملية الصهر والضغط الحراري، كطريقة لأعمال اللحام منذ القدم، واستخدمت أيضًا بالعصور الوسطى لصهر ولحام التحف المعدنية الحديدية والصلبة فقط، بينما رجح الصُنَّاع في المعادن الأخرى استخدام طريقة البرشمة واللحام بمواد أخرى. أما الصانع المسلم في صناعة التحف المعدنية، فاستخدم طريقة “التبشيم والبرشمة” باعتبارها نوعًا من أنواع النقش أو الزينة بالمسامير، وبالأخص في القازانات (القدور الكبيرة)، والمراجل، والأسطال، والمواقد الضخمة، عند تثبيت المقابض والمماسك والآذان بالجسم الأساسي. ودون ذلك من التحف المعدنية، فإن الفنان المسلم وما لديه من خبرات اكتسبها على مر الأزمنة، فضَّل استخدام اللحام في توحيد الأجزاء الصغيرة، كالصنابير والآذان والأقدام في التحف الدقيقة والصغيرة الحجم.
مسحة من القوة والحرفية
كتب “ابن الفقيه الهمذاني” في القرن التاسع الميلادي (الثالث الهجري) يصف مهارة أهل إيران في إنتاج التحف المعدنية، حيث قال: “ولفارس فضل في اتخاذ الآلات الظريفة المحكمة من الحديد. وقال بعض الحكماء لما وقفوا على أشياء ظريفة عند بعض الملوك من آلات فارس: لقد ألان الله عز وجل لهؤلاء القوم الحديد وسخره لهم حتى عملوا ما أرادوا. فهم أحدق الأمة بالأغلال والأقفال والمرايا وتطبيع السيوف والدروع والجواشن”. وتأكيدًا على ما أورده “الهمذاني”، فإن التحف المعدنية الإيرانية الساسانية، يبدو عليها مسحة من القوة والحرفية يندر وجودها بالتحف المعدنية الأخرى لأي أمة، وأوضح مثال على ذلك، ما ظهر من الصواني والأطباق الذهبية والفضية، ذات الزخارف البارزة بمتاحف روسيا الاتحادية.
يوجد هناك صنفان من التحف المعدنية يمكن اعتبارهما حلقة وصل بين الطراز الساساني والطراز الإسلامي في إيران، وبعض التحف من هذين الصنفين يعود إلى العصر الساساني في القرنين الخامس والسادس بعد الميلاد، والبعض الآخر منها يعود إلى بداية العصر الإسلامي أو القرنين السابع والثامن بعد الميلاد؛ وهي مجموعة متنوعة من الأباريق البرونزية ومجموعة من التحف المعدنية على شكل طائر أو حيوان. كما بدت الأباريق الإيرانية ذات أشكال متنوعة ومختلفة، لها في العديد من الأحيان مقبض طويل وصنبور ممتد، تم تزيينها برسومات حيوانية أو آدمية بمناطق مختلفة. تميزت الزخارف في الأباريق الإسلامية، بالدقة الشديدة وصغر الحجم وجمال المنظر. وهناك أيضًا تحف معدنية نسبت للصانع الإيراني في القرن الثاني عشر الميلادي (السادس الهجري)، تمثلت في العديد من المرايا البرونزية التي تشبه إلى حد كبير نظيراتها الصينية، وعليها عدة زخارف تظهر مهارة الفنان في إعداد الزخرفة لشغل المساحة الدائرية.
وكل تلك المرايا مصنوعة من البرونز أو الصلب، بعضها بمقبض وبعضها الآخر بحلقة متصلة بجزء بارز في وسط السطح المزخرف. وخلافًا لذلك، نجح الفنان المسلم في صناعة مباخر مختلفة الشكل، منها المزين بزخارف مخرمة، ومنها المزين بأشكال حيوانات صغيرة. كما صنع الفنان المسلم أيضًا، المسارج والهواوين والسلطانيات ذات الأشكال المبهرة. وهناك بعض التحف المعدنية التي لا يزال جمالها على حاله منذ صناعتها من مئات السنين، منها عدد من الصواني موجودة حاليًّا في خراسان وهمذان والري وسمرقند، وبكل تلك التحف المعدنية، موضوع زخرفي يتوسط قاعها وتحيط به موضوعات أخرى محفورة على شكل دوائر ذات مركز واحد فقط.
استخدام الأسلاك بالرسم والزخرفة
في العصر السلجوقي (1037-1194م) تميزت التحف المعدنية الإسلامية المصنوعة من النحاس أو سبائك النحاس، والمزخرفة بأسلوب التخريم المستخدم فيها آلات ومعدات التخريم بالتطور الكبير، علمًا بأن ذلك الأسلوب الزخرفي استخدم منفردًا في نقش وزخرفة العديد من الآثار المصنوعة بطرق الألواح الرقيقة للحصول على الأثر مثل القناديل، أو مع طرز زخرفية أخرى على أعمال معدنية، وعلى وجه الخصوص الأعمال البرونزية المصنوعة بطريقة الصب مثل المباخر والمواقد. واستخدم الفنان المسلم أسلاكًا من الذهب أو الفضة في عمل رسوم منها، من خلال ثني أو تعريج الخيوط، مما مكنه من عمل لوحات زخرفية ناطقة بجمالها وروعتها، وكان يقوم بلحام هذه الخيوط ببعضها البعض، أو عبر تثبيتها فوق اللوحة المعدنية المعدة من قبل.
وبالتالي استُخدم بصفة عامة في تلك الأعمال، الأسلاكُ اللينة ليسْهُل ثنيُها وتطويعها، لتصل إلى الأشكال المطلوبة. وتمكن الصانع المسلم أيضًا من عمل لوحات زخرفية من الأسلاك الدائرية أو المبرومة المفتولة، التي يمكن لحامها مع بعضها البعض.. وكل تلك الأساليب الزخرفية أثبتت مدى حذاقة الصانع المسلم ومهارته، وبالأخص عند تثبيت ولحام الموتيفات الزخرفية مع بعضها البعض.
ومع ازدهار العصر الإسلامي، تم صناعة الأسلاك المعدنية بأسلوب السحب من الثقب، حيث تم إعداد وتجهيز أنواع متعددة وبأشكال مختلفة، من الأسلاك المعدنية من قِبَل أمهر صانعي أو ساحبي الأسلاك من المسلمين. واستخدمت -كذلك- الخيوط المعدنية في أعمال صناعة وزخرفة الفنون المعدنية الإسلامية، وفي زخرفة الحلي والمجوهرات والتزيين بتقنية النقش على مختلف أنواع المعادن. كما استخدم الصُنَّاع المسلمون تقنيات سحب الأسلاك بالقوالب المصنوعة من الصلب، وكانت تلك القوالب بعَرض 4-5 سم، وبسُمك 0.5 سم، وهي عبارة عن قطع طويلة ورقية تشبه المسطرة، كما كانت الثقوب متراصة ومتتابعة من الأوسع إلى الأضيق.
تلك الثقوب التي رُصَّت وفقًا لأطوالها كانت قُمعية الشكل، وفتحة الثقب، في الطرف الذي سيدخل منه السلك، بينما الطرف الآخر الذي سيخرج منه السلك أوسع من الطرف الآخر، وكانت الأشرطة الذهبية أو الفضية المحمية، يَزجُّ بها من الطرف الأوسع للثقب ويتم سحبها من الطرف الأضيق، ثم تمرر تلك الأسلاك من الفتحات القمعية المتتالية، للحصول على أسلاك بأحجام مختلفة، ويمكن أن تكون هذه الثقوب الموجودة في القوالب، بأشكال دائرية أو بيضاوية أو مربعة أو مثلثة أو على شكل نجمة. ويمكن استخدام قوالب سحب الأسلاك أيضًا، في تصغير حجم أو قطر السلك، أو تغيير شكله الأصلي، بينما كان يتم سحب الأسلاك الأكبر سمكًا، على مناضد خاصة بها، وأما الأسلاك الرفيعة فيمكن الاكتفاء بسحبها يدويًّا.
هذا ونلحظ من خلال ما أوردناه، أن الفنان المسلم استلهم من تراثه ودينه وكل الحضارات التي ورثها، العديد من أنواع التكوينات الزخرفية المعدنية، التي حفرها ونقشها ورسمها وزخرف بها التحف. كما استخدم الصانع المسلم بحرفية نادرة، كل الأساليب الصناعية في عمل وصنع الزخارف المعدنية، حيث جمَّلها وزينها بلمسات جمالية إبداعية، فمنها المحفور ومنها المفرغ والمخرم، والمطعم بالذهب أو الفضة أو النحاس الأصفر.. وكل ذلك يعتبر غيضًا من فيض حول ما اكتشف من نجاح الصانع المسلم في تطويع كل المعادن التي وصلت إلى يديه، والتي ما زال التاريخ يكشف عن جمالها، وسيظل يظهر منها الكثير من الزخارف المعدنية الأخرى.
(*) كاتب وباحث مصري.
المراجع
(1) الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي، زكي محمد حسن، مؤسسة هنداوي، القاهرة 2017م.
(٢) موسوعة التحف المعدنية الإسلامية، د. نبيل علي يوسف، ج2، دار الفكر العربي، القاهرة 2010م..
(٣) تطور فن المعادن الإسلامي، أولكر أرغين صوي، تعريب: الصفصافي أحمد القطوري، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة 2005م.