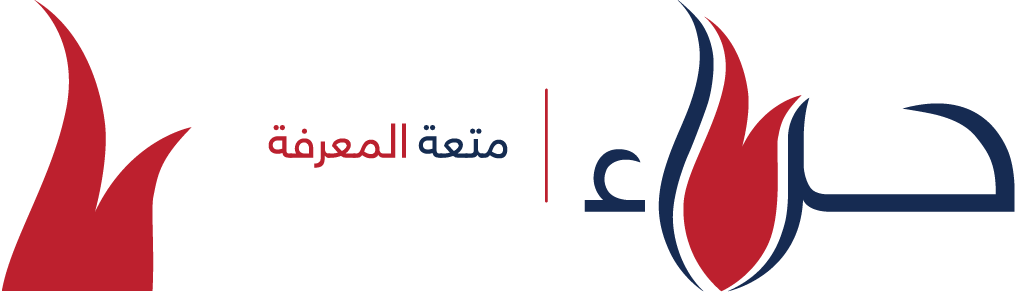الوقف: هو التنازل لله تعالى –مؤبدًا– عن ملكية المال، من أجل أن ينتفع به الناس وذلك كوقف المساجد ليصلي فيها الناس، ووقف المدارس على طلبة العلم، ووقف مياه الشرب في الطرقات والشوارع والأسواق.
والوقف: هو التصرّف في ريع العين وما تدره من مال مع بقاء ذاتها وجعل منفعتها لجهة من جهات البر، وهي بهذا تخرج من ملك صاحبها، وسبل منفعتها يجعلها مبذولة على وجه القرب لله تعالى.
وقد عني المسلمون بأنظمة الري، وإنشاء السدود، وقاسوا ارتفاع المياه، وقسّموا المخزون المائي بين الفلاحين بالعدل، وابتدعوا ديوان النهر، وكان المتولّي للسد يلاحظ ارتفاع الماء، وينفذ سعاته بخبره إلى ديوان النهر أو الماء، فينفذ الرسل إلى جميع من يتولون شعب الأنهار فيقسّمون الماء بحسب ارتفاعه، وقد تعددت المنشآت المائية الموقوفة، حسب حاجة الناس، وكل منها يؤدي وظيفة محددة.
وأشهر المنشآت المائية ما يلي:
السدود:
السد: عائق يبنى في مجرى النهر عموديًّا على مجراه في الموقع الذي تسمح الطبيعة الطبوغرافية فيه بتخزين المياه فيه، وتحدد الاعتبارات الطبيعية ونوع التربة، والمواد وطريقة إنشاء السد. وتنقسم السدود إلى نوعين رئيسين؛ الأول يبنى في المناطق الجافة لحجز مياه السيول، وفي المناطق ذات الكثافة المطرية لحجز مياه الأمطار لاستخدامها بعد انتهاء موسم الأمطار، كسد مأرب. والنوع الثاني يبنى على مجاري الأنهار لحجز مياه الأنهار لاستخدامها في أوقات محددة. وتحجز السدود أو الجسور كما تعرف في مصر، المياه المتفرعة من نهر النيل لري أراضي محددة في زمن محدد، ثم تكسر لتروي الأرض التي تليها، وهكذا.
وذكر المقدسي استخدام السدود في البلاد الإسلاميّة، وتحدّث عن عجائب بلاد فارس والعراق في ظل الخلافة العباسيّة، والمنشآت المائية التي أقامها الخلفاء هنالك.
المقاييس:
تعد المقاييس المقامة على الأنهار أداة لرصد حركة فيضانها، حيث كان فيضان النهر عند حد معين يعكس بشرى موسم زراعي جيد، كما كان يخلف مشكلة عند عدم وفاءه بتوفير المياه، سواء لحاجة الاستخدام في المدن والقرى أو للزراعة. ومن ثَمَّ، فإن المقاييس اعتبرت من المنشآت المائية الهامة التي اعتنى بها من قبل حكام المسلمين.
وأشهر تلك المقاييس مقياس النيل بالروضة (247هـ/861 م)، وقد بني هذا المقياس في ولاية يزيد بن عبد الله في مصر على عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله جعفر بن المعتصم بن الرشيد الذي ولد سنة (205هـ/820م)، وقيل سنة (207هـ/822م)، وبويع بالخلافة سنة (232هـ/846م) بعد الواثق بالله. وكان المشرف على عمارة هذا المقياس في أرجح الآراء هو المهندس أحمد بن محمد الحاسب.
وشيد مقياس لأول مرة على نهر دجلة في سنة (293هـ/905م)، وكان طوله خمسًا وعشرين ذراعًا، على كل ذراع علامة مدورة، وعلى كل خمس أذرع علامة مربعة كتب عليها بحديدة علامة الأذرع، تعرف بها مقادير الزيادات.
القناطر:
تتكون قناطر المياه عادة من برج المأخذ، وهو برج به سواقي لرفع المياه من مكان منخفض إلى أعلى، ثم يُصب هذا الماء في سطح البرج، حيث تنحدر المياه إلى مجرى محمول على سلسلة من العقود أو القناطر التي تنحدر بنسبة معلومة لتجري المياه إلى الجهة المراد وصولها إليها.
وعُمل بسمرقند نهر يجري في أنابيب من الرصاص، وبنيت عليه مسناة -قنطرة- عالية من حجر، يجري عليها الماء إلى أن يدخل المدينة، وصفّح وجه النهر كلّه بالرصاص، وعمل في خندق المدينة مسناة، وأجري عليها، وهو نهر يجري وسط السوق بموضع يعرف بباب الطاق، وكان أعمر موضع بسمرقند، يقول ياقوت الحموي: وفي المدينة مياه من هذا النهر عليها بساتين، وليس من سكّة ولا دار إلا وبها ماء جار إلا القليل، وقلّ أن تخلو دار من بستان.
ويعد إمداد المدن الجديدة التي يشيدها حكام المسلمين بالمياه أمرًا حيويًّا، حرص على تأكيده علماء السياسة الشرعية عند حديثهم عن شروط إنشاء المدن، لذا حين شيد الأمير أحمد بن طولون (220 280هـ /835 884م) ضاحية القطائع لتكون مقرًّا لحكمه في مصر، حرص على تزويدها بمصدر ينقل لها مياه النيل. ومن مآثر ابن طولون المعماريّة في مصر القناطر التي تعرف الآن بمجرى الإمام، وتقع بالقرب من مدينة الفسطاط، في حي البساتين، وما زالت أطلالها شاخصة إلى اليوم، وتمتاز قناطر ابن طولون بأنها أول نموذج لقناطر معلقة في مصر، وقد شيدها ابن طولون لتوصيل المياه إلى قصره الواقع أسفل الهضبة التي عليها قلعة صلاح الدين الآن.
وتعد قناطر مجرى العيون في القاهرة منشأة مائية، وكان الهدف منها هو تزويد قلعة صلاح الدين الأيوبي بالماء، وقد شيدت لتتزود منها القاهرة بالمياه، ومن هنا تأتي أهميتها. والواقع أن المنشئ الأصلي لقناطر مياه القلعة هو السلطان العادل أبو بكر بن أيوب الذي تولى الحكم من سنة 596هـ/1200م إلى سنة 615هـ/1218م. وكانت القناطر حينذاك عبارة عن مجرى ماء فوق السور الشرقي للعاصمة، وكان طرفه الجنوبي يبدأ من ضفة النيل عند الموضع المعروف الآن بدار السلام، ويمتد حتى يتصل بأسوار القلعة. وقد جعل العادل فوق الجدار قناة يرفع الماء إليها بالسواقي من النيل ويسيل فيها حتى يصل إلى القلعة، وكان ذلك عندما استقر رأيه على الإقامة الدائمة في القلعة بدلاً من حصن القاهرة التي اضطر إلى الإقامة فيها كل من سبقه من سلاطين الأيوبيين.
الصهاريج:
تعد أماكن خزن المياه أهم المرافق العامة للتجمعات السكانية البعيدة عن الماء، وذلك لضرورتها في تأمين احتياجاتها من هذه المادة، سواء للشرب أو لري المزروعات. ومن هنا اهتدى الإنسان إلى طريقة يضمن بها وجود الماء، حيث ابتكر الصهاريج، وهي عبارة عن خزان صناعي لتخزين المياه واستخدامها في وقت الحاجة إليها.
والصهاريج نوعان: العام والخاص، حيث تخصص الصهاريج العامة لتخزين الماء وتوزيعه بالمدينة، فهي بهذا تشبه محطات المياه بالمدن في وقتنا الحاضر، أما الصهاريج الخاصة، فهي ما كانت مخصصة لخدمة منشأة بعينها، وهي عادة أصغر حجمًا.
ولعل أكبر مشروع حضاري شهد بناء العديد من الصهاريج عرفته الحضارة الإسلامية هو مشروع درب زبيدة، الذي يَسَّرَ طريق الحج بين العراق ومكة المكرمة.
ويعد “صهريج تنيس” من أشهرها. وتقع مدينة تنيس في شمال دلتا النيل بمصر داخل بحيرة المنزلة، وهي عبارة عن جزيرة، لذا سعى ولاة مصر في العصور الإسلامية المختلفة، إلى توفير المياه لها، خاصة أنها كانت أحد المراكز الصناعية، حيث اشتهرت بصناعة المنسوجات، ولوقوعها بالقرب من البحر فقد عدت من الثغور. وهجرت تنيس في فترة تاريخية غير محددة، غير أن أهميتها بدأت تقل بصورة واضحة في العصر العثماني، وقد ذكر العديد من المؤرخين أن بتنيس صهاريج ضخمة لتخزين المياه، كشف عن أحدها أثناء إجراء حفائر في تل تنيس الأثري سنة 1979م، وهو صهريج كبير.
وانتشرت الصهاريج العامة والخاصة في مدينة الإسكندرية بصورة لفتت انتباه المؤرخين والجغرافيين.
أحواض سقي الدواب:
ولقد وضع الإسلام مبدأ الرفق بالحيوان خلافًا لما يظنه البعض من أنه مبدأ أوروبي النشأة حديث الظهور، فقد بنى المسلمون لذلك عمائر لرعاية الحيوان، وقد وصلنا على سبيل المثال من العصرين المملوكي والعثماني نوعان من العمائر تهتم بشؤون الحيوانات، من حيث سقيها وإيوائها وطعامها، وهي أحواض سقي الدواب والإسطبلات.
وانتشرت هذه الأحواض في الطرق الرئيسة للمدن، وداخل القاهرة وجدت الأحواض، إما منفردة أو ملحقة بالعمائر الدينية والمدنية والتجارية والحربية، حيث اتخذت الأحواض موضعًا متميزًا في العمائر بالواجهات الرئيسة لها ليسهل شرب الدواب منها. ويمكن تشبيه أحواض إرواء الدواب اليوم، بمحطات الوقود التي تزود السيارات بالوقود وانتشارها في المدن وعلى الطرق، مما يبين مدى أهميتها.
بالرغم من أن أحواض سقي الدواب بنيت ووقفت أساسًا لسقي الدواب، إلا أنها حبست أيضًا لينتفع الناس بمائها في غسل أثوابهم وأوانيهم وملئها ولوضوئهم واغتسالهم وللتزود منها بالماء للاستعمالات المنزلية، وغير ذلك من المنافع. وقد عمل الواقفون على تعيين خادم للحوض أو قيم أو فراش لتمكين الدواب من الشرب بسهولة، ومساعدة الناس للاستفادة من ماء الحوض، كما أوكل إليه تنظيف الحوض وكنسه وغسله، وتجفيف أرضيته، والرش أمامه، والعمل على ملء الحوض بالماء بصفة دائمة. وكان العمل يبدأ من مشرق الشمس إلى آخر النهار أو أذان العشاء.
النواعير:
الناعورة آلة لرفع المياه من الأنهار أو الآبار، وتسمى في فلسطين القواديس أو الدواليب، والغراريف أو النواعير في سورية والعراق، والسواقي في مصر، والسواني أو الدواليب في الأندلس، وتفيدنا وثائق الوقفيات ووثائق المحاكم الشرعية في تونس أن النواعير انتشرت في جميع ربوعها.
وتعد نواعير حماة من أشهر نواعير العالم الإسلامي لجودة صنعها ودقة تركيبها ولدورها المؤثر في محيط حماة الزراعي، وفي المدينة نفسها. ويبلغ عدد نواعير مدينة حماة خمس عشرة ناعورة، وخارجها إحدى وسبعين ناعورة.
ومصر بلد الساقية، فلا توجد قرية أو مدينة في مصر إلا وبها العديد من السواقي، سواء لرفع المياه للشرب، أو لري الأراضي الزراعية.
أما السانية فهي آلة ابتكرها الإنسان في وسط شبه الجزيرة العربية لرفع الماء من الآبار إلى مجاري ري المزروعات. وتتباين السواني من حيث التركيب من منطقة إلى أخرى، وعادة ما تتألف من قوائم خشبية تنصب فوق البئر أو على حافته.
الطواحين المائية:
عرف المسلمون قوة جريان المياه كطاقة متجددة، ويذكر القزويني: “أن أهل الموصل انتفعوا بدجلة انتفاعًا كثيرًا، مثل شق القناة منها، ونصب النواعير على الماء يديرها الماء نفسه، ونصب العربات، أي الطواحين التي يديرها الماء في وسط دجلة في سفينة وتنقل من موضع إلى موضع”. يشير هذا النص إلى استغلال الماء الجاري في الأنهار والقنوات المتفرعة منها في إدارة الطواحين التي تعمل بالماء، كطاقة حركية مفيدة. وقد انتشرت هذه الظاهرة في المدن التي أمكن إقامة هذه الطواحين على أنهارها،
المصادر والمراجع:
ـ ابن إياس (محمد بن أحمد ت 930هـ /1524م)، بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق: محمد مصطفى، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1961م.
ـ ابن جبير (محمد بن أحمد ت 614هـ /1217م)، رحلة ابن جبير “رسالة اعتبار الناسك.. في ذكر الآثار الكريمة والمناسك”، مكتبة الهلال، بيروت، 1986م.
ـ ابن فضل الله العمري (شهاب الدين أحمد بن يحيى)، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تحقيق د. أيمن فؤاد سيد، المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، القاهرة، 1986م.
ـ ابن مماتى (أبو المكارم الأسعد ت 1209 م) كتاب قوانين الدواوين، تحقيق عزيز سوريال، مكتبة مدبولى، القاهرة، 1991.
ـ المقدسى (شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد البشارى ت 390 هـ )، أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم، تحقيق: دى خويه، ليدن، 1906.
ـ المقريزى (تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدى، ت 845هـ / 1441م)، الخطط المقريزية “كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار”، وضع حواشيه خليل المنصور، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ / 1988م
ـ عبد الحكيم القفصي، الناعورة بتونس أثناء القرنيين الثامن عشر والتاسع عشر، بحث مقدم إلى مؤتمر الألكسو للآثار، ليبيا، 1990.
ـ عبد الرحيم غالب، موسوعة العمارة الإسلامية، برس، بيروت، 1988.
ـ فريد الشافعي، العمارة الإسلامية.. ماضيها وحاضرها ومستقبلها، جامعة الملك سعود، الرياض، 1982م.
ـ محمد الششتاوي، منشآت الرفق بالحيوان في مدينة القاهرة في العصرين المملوكي والعثماني، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2001م.
ـ محمد وليد كامل، وسائل الري عند العرب، الندوة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1988م.
ـ محمود باشا الفلكي، الإسكندرية القديمة، دار نشر الثقافة بالإسكندرية، 1967م.
ـ ياقوت الحموي “شهاب الدين ابن عبد الله الرومي البغدادي، (574 ـ 626هـ)”، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، 1957.