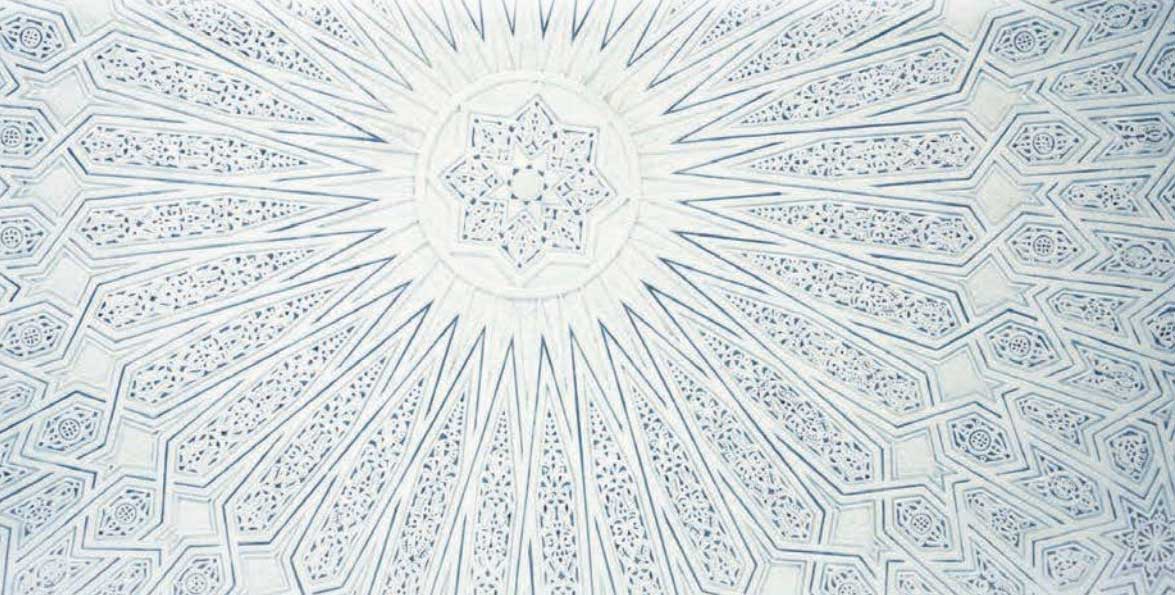ليس من مبالغات القول إن “الإنسان كائن جمالي”، ودليل ذلك أنه ميال -فطريًّا- إلى الشعور بالجمال وتذوقه وممارسته، ويكفي دليلاً على ذلك ملاحظة أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة أبعاد في التعامل مع الجمال؛ تمثل البعد الأول في أن لغة القرآن وبيانه مثلتا القيم الكبرى للجمالية الفنية، قيمًا سحرت ألباب العرب وغيرهم، ونشأت -لأجلها- علوم وفنون لإبراز تلك القيم وتحديد عناصرها الجمالية ووظائفها الفنية.
وإن القمم العالية للبيان القرآني، لتعد أحد المداخل الأساسية التي ولج منها الإنسان العربي عند نزول الوحي، ليتزود من جمال القرآن في مبانيه ومعانيه وأساليبه، يقول الدكتور مصطفى بن حمزة: “وأحسب أن ملاحظة الجمال قد كانت أكبر المداخل وأوسعه إلى الإسلام منذ أن أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته في الناس، وقد كان في قمة الجمال بيان القرآن الكريم الآسر الذي لم يتمالك العرب إذ سمعوه أن أعلنوا انصياعهم له، إذ كانت الكلمة الواحدة تأخذ بمجامع القلوب؛ فقد سمع الأعرابي قول الله تعالى: (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ)(الحجر:94)، فذهب به الفكر كل مذهب في استحضار جوانب الروعة في فعل “اصدع”، فلم يتمالك أن سجد، فقيل: لِم سجدتَ؟ قال: سجدت لجماله”.
أما البعد الثاني، فيظهر في أن مضامين القرآن الكريم وتوجيهاته، لفتت نظر “هذا الإنسان” إلى الجمال الذي يبدأ من أعماق داخله، ويمتد إلى مختلف العناصر الطبيعية التي تحيط به في عالم النبات والجماد والحيوان، وفي محيطه الأرضي وملكوت السموات.
والاستقراء هاد إلى تبين هذا الملحظ في الخطاب القرآني، منها قوله تعالى: (لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ)(التين:4)، ومنها: (وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ)(النمل:60)، ومنها: (وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ * وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً)(النحل:5-8)، (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ)(الملك:5)، و(إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ)(الصافات:6)، و(انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ)(الأنعام:99)، و(وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا)(النور:31).
وقد لخص الدكتور عماد الدين خليل هذين البعدين في قوله: “إن التعامل القرآني مع الجمال يأخذ اتجاهين؛ فأما أولهما فيقوم على المضامين الجمالية التي يطرحها كتاب الله، بدءًا من حديثه عن خلق الكون والعالم والطبيعة والحياة والخلائق والإنسان، مرورًا بلفت الأنظار والسماع إلى حشود الجماليات التي تنتشر في أمداء السموات والأرض، وانتهاء بالتأكيد على الجمال والزينة كعناصر ضرورية متممة، لتجربة الحياة المؤمنة المستقيمة. وأما الاتجاه الثاني فيقوم على الأسلوب، وقد قيل في معجزة القرآن (الأسلوبية) الكثير”.
أما البعد الثالث، فيتجلى في أن من توجيهات القرآن وآدابه، ما يتعلق بتجميل الحياة والحرص على التمتع بزينتها وبهجتها؛ استرواحًا بها، وإظهارًا للحمد والشكر المتوجب من الإنسان إلى الله المنعم بفيوضاتها التي لا تعد ولا تحصى. ويظهر هذا البعد في التوجيهات القرآنية التي تمثل قواعد حاكمة في هذا الميدان، من مثل قوله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ)(الأعراف:31)، وقوله: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ)(الأعراف:32).
القادح الجمالي في الفطرة الإنسانية
بل يمكن للدارس أن يذهب إلى أبعد من ذلك، فيلمح أن السياق القرآني، لفت إلى ما يمكن تسميته بـ”القادح الجمالي” في المحيط الإنساني؛ ذلك القادح الذي أنار بداخل الإنسان المسلم، القدرة على تمثل الجمال في سياق وصف القرآن لمعجزة إنزال الماء وإنبات النجم والشجر والزهر، وتحويله إلى واقع معيش عبر تجميل المنزل والمدينة والفضاء العام بمختلف أنواع الحدائق والبساتين، يقول الدكتور يحيى وزيري: “إن وجود الحدائق بالمساكن والمباني الخاصة، أو وجود المناطق الخضراء بالمدن، اتجاه حضاري وجمالي نبه إليه القرآن الكريم في العديد من آياته، حيث يقول سبحانه وتعالى: (أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَئِلَهٌ مَعَ اللهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ)(النمل:60).
من هذا المنطلق، يجب ألا ينظر إلى محاولات إنبات الحدائق على أنها رفاهية، بل هي إحدى نعم الله على البشر، ويتأكد ذلك من قوله تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ)، ومن هنا تتأكد الدعوة الصريحة لإيجاد الحدائق التي تدخل تحت كلمتي “الزينة” و”الطيبات” اللتين وردتا في الآية السابقة”.
والمتأمل في الأبعاد المذكورة آنفًا، يهتدي إلى أن القرآن الكريم كان يؤسس في الوسط العربي والإنساني، أبجديات ثقافة الانتفاع الجمالي بعد أن أحكم الإنسان ثقافة الانتفاع المادي والخدماتي بمفردات الكون، وصارت محددًا من محددات العلاقة التي تحكمه بمحيطه.
وإذا كان الانتفاع المعرفي العلمي وسيلة الإنسان للانتفاع المادي والخدماتي من عناصر الكون المختلفة، فإن الانتفاع الجمالي وسيلته إلى الارتقاء الروحي، وهذا ما يفسر عناية القرآن الكريم بهذا الجانب.
وقد استطاع الإنسان، باهتدائه بهدي القرآن، أن يستوعب هذه الأبعاد، فصارت له معيارًا يتذوق به الجمال، كما أضحت له فلسفة تتفجر من خلالها إبداعاته الفنية في الشعر والقصص والحكمة والخط والزخرفة والعمارة والتصوير وغيرها من الفنون.
ويمكن القول إن الحضارة الإسلامية، في كسبها الإبداعي الفني، تمثلت هذه الروح، وانطلقت ببذورها لتتلاقح مع الكسب الإنساني المنتمي إلى حضارات أخرى وفق حركية “التعارفية الحضارية” التي جعلها القرآن الكريم علة وسببًا في تكوُّن الشعوب والقبائل: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)(الحجرات:13).
وإذا كان من مهمات علماء الأمة وفقهائها، السعي إلى حسن تنزيل أحكام القرآن على الواقع -أفرادًا وأسرًا ومجتمعات ومؤسسات- فإن المطلوب اليوم، أن يسعوا إلى حسن تنزيل التوجيهات الجمالية والفنية القرآنية في ذلك الواقع، وأن يجعلوا من ضمن قواعدهم الأصولية والفقهية، ما له تعلق بوجوب تنزيل التمثل الجمالي القرآني في مناشط حياة الناس الذوقية والجمالية.
الجمالية السليمانية في القرآن الكريم
لم يقتصر القرآن على تحريك وجدان الإنسان نحو تلك الأبعاد الجمالية الثلاثة، وإنما استثمر القصص القرآني لترسيخ القيم الجمالية وتأكيد أهميتها في حياة الناس. وقد اقتطفت من حديقة القرآن ثلاثة مشاهد كلها تتصل بشخصية سليمان عليه السلام، ومع اختلاف سياقاتها، إلا أنها تشكل جميعها لوحة دالة على الإحساس الجمالي وتذوقه وتمثله لدى نبي الله سليمان عليه السلام، وكيف لا، وهو الذي ينتمي إلى بيئة جمالية جلالية، بيئة داوود عليه السلام الذي قال عنه القرآن: (وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ * أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)(سبأ:10-11).
المشهد الأول
يقول الحق سبحانه وتعالى عن سليمان عليه السلام: (وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ * يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ)(سبأ:12-13)؛ في هذه الآيات الكريمة التفات إلى جوانب من العمران الجمالي والوظيفي في عهد سليمان عليه السلام، انخرط في رفع قواعده نفر من الجن بناء على رؤى تخطيطية وتوجيهات دقيقة -ما يشاء- من هذا النبي الكريم.
وقد وقف المفسرون على معاني تلك المكونات المعمارية والعمرانية، غير أنهم تعاملوا معها وفق رؤية فقهية لم تتح لهم فرصة السؤال عن بعض الأسرار الكامنة خلف توجيهات سليمان عليه السلام للجن على أن يشيدوا له تلك المآثر العمرانية. يقول السخاوي، مثلاً: “المحاريب: المساكن والمنازل الشريفة، وقيل هي المساجد. والتماثيل: الصور من الملائكة والنبيين والصالحين، كان يعمل في المساجد من نحاس وصفر وزجاج ورخام ليراها الناس فيعبدوها. وإنما أمر سليمان عليه السلام بعمل الصور -وهي حرام في شرعنا- لأنه كان مباحًا في شرعهم، ويجوز أن يراد أنهم كانوا يعملون تماثيل الأشجار وما لا روح فيه”.
ومع أن الآيات المذكورة ليست بصدد التحليل أو التحريم، وإنما سيقت لمقصدية الإشادة بملك سليمان عليه السلام وازدهار العمران المساوق للصلاح في عصره. فقد ظل الخطاب التفسيري ينطلق من هذه الرؤية الفقهية إلى عصرنا الحديث، وهذا ما يلمسه الدارس في قول الإمام الطاهر بن عاشور: “ولم تكن التماثيل المجسمة محرمة الاستعمال في الشرائع السابقة، وقد حرمها الإسلام؛ لأن الإسلام أمعن في قطع دابر الإشراك لشدة تمكن الإشراك من نفوس العرب وغيرهم، وكان معظم الأصنام تماثيل، فحرم الإسلام اتخاذها لذلك، ولم يكن تحريمها لأجل اشتمالها على مفسدة في ذاتها، ولكن لكونها كانت ذريعة للإشراك.
واتفق الفقهاء على تحريم اتخاذ ما له ظل من تماثيل ذوات الروح، إذا كانت مستكملة الأعضاء التي لا يعيش ذو الروح بدونها، وعلى كراهة ما عدا ذلك مثل التماثيل المنصفة، ومثل الصور التي على الجدران وعلى الأوراق والرقم في الثوب ولا ما يجلس عليه ويداس، وحكم صنعها يتبع اتخاذها، ووقعت الرخصة في اتخاذ صور تلعب بها البنات لفائدة اعتيادهن بأمور البيت”.
وهي استنباطات جليلة في بنيتها الفقهية، لكنها تقيم حجبًا بين يدي تدبر الآيات وتذوق معانيها في سياق امتداح القرآن لنبيه سليمان عليه السلام ، الذي استطاع الجمع والتوفيق بين الملك والصلاح والعمران والجمال. وهي مكونات شهدت -وما تزال- تنافرًا وتعارضًا واختلالاً في العديد من التجارب التاريخية والمعاصرة.
ولعل أخطر ما في نص السخاوي قوله: “والتماثيل: الصور من الملائكة والنبيين والصالحين، كان يعمل في المساجد من نحاس وصفر وزجاج ورخام ليراها الناس فيعبدوها”، ووجه الخطورة؛ أنه يعلل صناعة تلك التماثيل باتخاذها معبودات، وهذا لا ينسجم مع الطبيعة التوحيدية للأنبياء، ويفرغ معنى الابتلاء والامتحان من محتواه القرآني، إلى موقف ترصدي للإيقاع بالناس في شرك الشرك والانحراف العقدي، بل وينافي السياق النصي للآية وسياق السورة والسياق المقاصدي للقرآن الكريم.
وأما منافاته للسياق النصي للآية، فلا يستقيم اعتبار تلك الأعمال مما يستدعي شكر الله عليها، إذ الشكر يكون على حميد الأفعال، وما دام عبادة الأصنام من دون الله عملاً مشينًا، فهو غير داخل في صنف الأعمال الحميدة، وغير مطلوب فيه شكر الله. وأما منافاته لسياق السورة، فقد ورد في سورة سبأ آيات عديدة تضعف التعليل الذي ذهب إليه الإمام السخاوي، وتنفي أن يسمح سليمان عليه السلام لنفسه بأن يأمر الجن بصناعة التماثيل ليعبدها الناس اختبارًا لهم وابتلاء. فقد ورد في تلك السورة قوله تعالى: (قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ لاَ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ)(سبأ:22)، فالزعم كائن من المشركين وليس من الأنبياء. وورد في السورة قوله سبحانه: (قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلاَّ بَلْ هُوَ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)(سبأ:27)، وقوله تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا)(سبأ:33)، وهو قول منصف من قبل المستضعفين، يكشف حين تنزيله على حال سليمان عليه السلام أنه لا يستبعد -في ظل تفسير الإمام السخاوي- أن يقوم من مملكة سليمان عليه السلام نفر من الناس يحتجون عليه بأنه كان سببًا في الشرك لأنه أمر الجن بصناعة التماثيل للعبادة.
وكيف يجوز للإمام السخاوي قول ذلك وهو يتلو في سورة سبأ نفسها قوله تعالى: (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلاَئِكَةِ أَهَؤُلاَءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ)(سبأ:40-41).
وإذا انتفى ما يذهب إليه بعض المفسرين في توجيه تلك الآيات، لم يبق -إذن- إلا القول بمقصدية الجمال في صناعة سليمان عليه السلام للتماثيل. وكنا نأمل من الخطاب التفسيري أن يتوسع في تحديد ملامح تلك المقصدية وأبعادها، ويبرز كيف أن سليمان عليه السلام -الذي آمن بالجمال وتمثله وجعله سلوكًا يوميًّا- يرى بحسه الجمالي وتربيته الذوقية، أن تتزين الفضاءات بجمال التماثيل والمحاريب والجفان.
وفي المقال القادم محاورة لبقية المشاهد التي تؤكد مفهوم “الجمالية السليمانية” إن شاء الله.
(*) مستشار بوزراة الأوقاف الكويتية / المغرب.