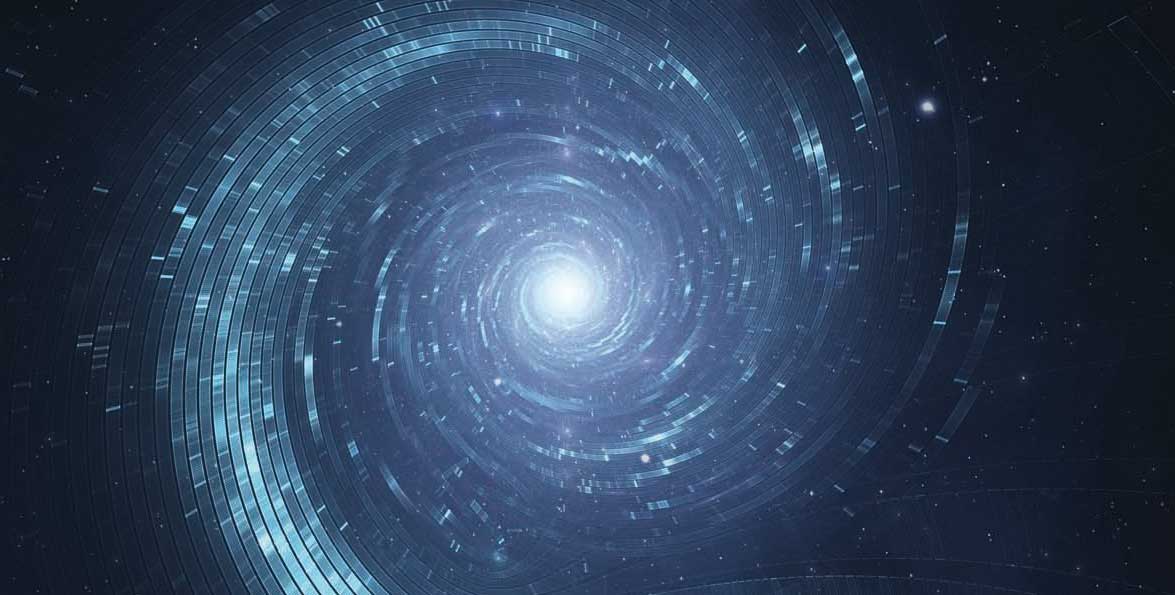تعاني أمتنا اليوم آلامًا كثيرة ومآتم عديدة، إذ تتكاثف في سمائها سحب الظلمات وتتضافر عليها الدياجى الحالكات، لتضيق الخناق على مساحات الضوء وتكسر قناديل النور ومصابيح الاستنارة.
ويصاحب هجوم الظلام عواصف من الإعلام الأهوج وأعاصير التحريض “الأعمى” وزوابع الإرجاف والتيئيس والإقناط التي تسعى لإطفاء شموع العقول وأشعة القلوب، بحيث يصبح أبناء الأمة قوالب دون قلوب، وأشباحًا دون أرواح، وبحيث يصيرون أعجاز نخل خاوية يفقدون كل قدرة على صناعة الحياة ولا يهتدون سبيلاً ولا يملكون أي فاعلية.
هذه الفتن العمياء المدعومة بمكر خارجي مسلح بكل الإمكانات القادرة على إسقاط سقف الأمة على رؤوس أبنائها، وهذا التصاعد الرهيب في هذا الاتجاه، ينبئ عن أن مرحلة الحمل قد اكتملت، وأن أوان الميلاد قد آن، وأن الكتلة الحرجة القادرة على صناعة التغيير قد أوشكت على الاكتمال، وأن هذه الآلام -من ثم- ما هي إلا آلام المخاض.
هذه الحقيقة يمكن أن يقرأها من يفتح كتب الهداية التي حض هذا الدين على قراءتها والاستفادة منها في كل نواحي العمارة، وفي شتى مراحل النهوض، وفي شتى مساحات الفكر، بما في ذلك هذه المساحة التي يقترن فيها المادي بالمعنوي، ويتعانق فيها عالما الغيب والشهادة.
إن كل كتب الهداية تقول بأن “الجمال” قد يتفجر من بطون “القبح” و أن عيون “الخير” قد تنبجس من صخور “الشر”، وهذا ما ستبرزه هذه المقالة في عناوينها الأربعة:
1- آيات كتاب الوحي
تتنزل آية القرآن من صاحب العلم الكامل ومالك القدرة المطلقة، لذلك فهي تحمل إضاءات تساعد المستضيء بها عبر مفاتيح التدبر على رؤية بعض المساحات في عالم ما وراء المادة، حيث تتلفع في كثير من الأحيان “المنح” بأثواب “المحن”، وتتنكر “النعم” في صور “النقم”، وتتخفى “الأنوار” في بطون “الظلمات”، وقد تأتي “العطايا” على أقدام “البلايا”، ويأتي “اليسر” على مطايا “العسر”، وتُقبل “الأفراح” على ظهور “الأتراح”.
وإشارة إلى هذا المكر الإلهي بأعدائه، والنصر الخفي لأوليائه، ومن أجل التأهل لتنزل المدد الإلهي والعون السبحاني، والنصر الرباني، نجد القرآن يقول: (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ)(البقرة:216)، ويقول: (فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)(النساء:19).
وفي سورة النور أشار الله إلى إعصار الإفك الذي أراد به المنافقون واليهود إطفاء أنوار النبوة، وكان فتنة عظيمة فقال تعالى: (لاَ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ)(النور:11).
ومن يتمعن في آيات الفرقان، فسيجد دروسًا عميقة وكثيرة في هذا السياق. فإن الله “يخرج الحي من الميت”، ويخرج اللبن -وهو من أهم الأغذية لحياة الإنسان- من بين فرث ودم، ويخرج العسل من بطن حشرة حقيرة وصغيرة مع أن فيه شفاء للناس، وضمّن هذا الدرس في سورة سميت باسم هذه الحشرة وهي “النحل”.
وأشار القرآن إلى أن مبدأ الإنسان من نطفة حقيرة تخرج من مَبْوَلَي الرجل والمرأة، ويستقر في رحم المرأة إلى أن يخرج منه بعد تسعة أشهر من العيش في قرار مكين داخل هذا المكان المهين.
وذكر أن كليم الله موسى – عليه السلام – تربى في بيت عدو الله فرعون بل في حِجْره، مع أن الأول من أولي العزم من الرسل، أما الآخر فقد تفرد بزعم: (مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي)(القصص:38)، ومقولة: (أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى)(النازعات:24)، لذلك أخذه الله: (نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأُولَى)(النازعات:25).
وأورد القرآن أن الرياح التي يراها الناس عذابًا ذاتُ فوائد جليلة على حياة الإنسان، ابتداء من تلقيح الشجر لكي تثمر، وتلقيح السحب لكي تمطر: (وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ)(الحجر:22).
ووصولاً إلى دور الرياح في تسيير جميع السفن الشراعية، وهذا واضح، والسفن البخارية التي تعتمد على الفحم الحجري أو النفط أو الغاز أو الطاقة النووية، فإن هذه الأنواع من الطاقة لا تحترق لتدير محركات هذه السفن، إلا عبر الأكسيجين الذي تتضمنه الريح كما يقول العلماء، وهذا ما أشارت إليه الآية القرآنية التي تقول: (إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ)(الشورى:33).
ولأن آية القرآن تتجاور في ثناياها الفوائد المادية والمعنوية، فإن فاصلة الآية: (لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ)، تشير إلى هذا المعنى الذي استدللنا عليه هنا، ففي ظل الصبر والشكر تتحول النقم إلى نعم، كما تتحول رياح السَّموم إلى وسائل لتسيير السفن التي تحمل الناس وتوصل المنافع إليهم.
2- دلائل كتاب الكون
ومن يقرأ آيات الكون فسيجد دلائل لا حد لها تؤكد إمكانية توليد الشر للخير، ومجيء الهدايا على صور بلايا، وخروج المنافع من أكمام المضار.
ومن هذه الدلائل أن المياه تتفجر من بين الصخور الصماء، وتنبعث من بين أطباق التراب الصلد المتحجر، وأن الأمطار تتصبب من عيون الغيوم السود، وأن السماء لا تمطر إلا بعد أن تتلبد بالغيوم التي تحجب الشمس ثم تدمدم فتبرق وترعد، وبعد ذلك ينزل الغيث الهطال والماء المدرار.
أما الأرض فإنها لا تنبت إلا بعد أن تغرقها المياه، وتهزها وتحدث فيها تشققات: (فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ)(الحج:5).
وتخرج تلك النباتات المنيرة التي تُعد كائنات حية في كثير من الوجوه، من بين طبقات الأرض الغبراء التي هي ميتة في الأصل.
ومن تلك الدلائل أن الأزهار الجميلة تخرج من بين الأشواك القبيحة، والربيع الزاهي بكل مشاهد الجمال لا يأتي إلا من رحم الشتاء المحفور بكثير من القبائح ومآتم الموت لمليارات الأزهار والأشجار والحشائش.
وفي دائرة النباتات، فإن النار التي تحرقها تكشف عن معادنها الأصيلة والنفيسة، فإن أغلى أنواع البخور والروائح الطيبة هو العود، قال الشاعر:
لولا اشتعال النار في ما جاورت
ما كان يُعرف طيب عَرْف العودِ
ومن الضروري أن يسبق الدخان عبير العود كما قال شاعر آخر، وهو يشير إلى هذا المخاض الجميل وهذه النسبية السننية:
تريد مهذَّبا لا عيب فيه
وهل عودٌ يفوح بلا دخان؟!
ومن المعلوم في هذا الكتاب الكوني الهائل، أن الفجر تسبقه دياجير حالكة، كأن خيوط الفجر تتسلل من بين أطباق الظلام الدامس.
وغالبًا ما يكون كسوف الشيء قرينة على نفاسته، كما أشار إلى ذلك الشاعر:
وفي السماء نجومٌ لا عداد لها
وليس يكسف إلا الشمسُ والقمرُ!
لكن الكسوف أو الخسوف ليسا أبديّين، بل هما مؤقتان ليعقبهما مزيد من التوهج والانبلاج.
وفي إطار التراب الميت ذي المنظر القبيح، فإنه يخفي تحته كثيرًا من المعادن الجميلة والجواهر النفيسة، والطاقات الحيوية لحياة الإنسان كالنفط والغاز والحديد والذهب الذي تستخرج مادته الأولية “التبر” من وسط أركمة “التراب”.
أما النفط الأسود ذو الرائحة الخانقة والطعم القاتل والأثر الحارق، فإنه يدير عجلة الحياة، إذ يحرك سائر وسائل المواصلات، ويدير شتى ماكينات الصناعات، ويوقد الكهرباء التي تنير دروب الحياة وتحمل للإنسان عشرات الفوائد، ومن مواد النفط تشكل ما يسمى الصناعات البتروكيماوية، التي توفر للإنسان عشرات السلع التي تحتاج إليها حياة الترفّه الإنسانية.
وحول الأرض توجد سلسلة من الأخاديد التي يتراوح عمقها ما بين 60 و150 كم كما يقول العلماء، ولأول وهلة تبدو كندوب تشوه وجه الأرض، لكن فوائدها المرتبطة بامتصاص درجة الحرارة الزائدة على حاجة الإنسان لا تقدر بثمن، ولولاها لظلت درجة حرارة الأرض في ارتفاع مع ما سيحدثه ذلك من تداعيات إلى أن تنفجر مثل القنبلة النووية.
أما البراكين التي تبدو كبثور في ناصية الأرض، ولا سيما في المناطق الاستوائية الجميلة بتربتها الخصبة وأمطارها الغزيرة، فإنها ليست شرًّا محضًا كما يظن بعض الناس، بل هي من أهم أسرار الحياة والجمال في هذه الأرض، إذ إنها مصدر 71% من الأمطار النازلة على الأرض كل عام، التي تأتي على شكل غازات تنبعث من باطن الأرض عبر فوهات البراكين، ثم في ظروف وأسباب يصنعها الله -سبحانه وتعالى- تتحول إلى أمطار تحيي الأرض بعد موتها، وتحمل الحياة لكل الكائنات فيها.
3- قرائن كتاب الكائنات
من يُلقِ نظرة على كتاب الكائنات، فسيجد هذه الحقيقة بارزة كالشمس في كبد السماء، إذ تتغطى النعم بأثواب النقم، وتتبرقع “المفاتن” بنقاب “الفتن”، وتتسور ثمار الكائنات اليانعة بأشواكها المؤلمة وتتسلح بسمومها الناقعة.
ومن المعلوم في هذا السياق، أنه من سم الأفاعي يستخرج ترياق الحياة، لذلك صارت الأفعى رمزًا للصيدلة والدواء.
ومن جلود الثعابين والتماسيح تصنع أرقى وأغلى الحقائب والأحذية، ومن فرو الدِّببة تصنع أثمن المعاطف النسائية، ومن بعض أنواع الغزال يُستخرج أرقى العطور الذكية وهو المسك.
وفي ذات الدائرة، فإن الحيوانات هي المصدر الأساسي لتجمل الإنسان، إذ يخرج الحرير من بطن دودة القز، وتصنع أفخم أنواع الصوف من بعض أنواع الأنعام.
وفي كثير من الأنعام والدواب نِعَم عظيمة تتخفى وراء ما يكرهه الإنسان منها، حتى ينطبق عليها قول الشاعر:
كم نعمةٍ لا يُستقل بشكرها
لله في طي المكاره كامنة
وما ينطبق في مجال الحياة المادية ينطبق أكثر في مجال الحياة المعنوية، حيث يفر الإنسان من كثير من المكروهات التي تخفي وراءها كثيرًا من المحبوبات، كما قال الشاعر:
رُبّ أمــــــــر تــتــــــقـــيه جــر أمــرًا تـرتجيه
خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه
كأن المكروهات هي المظروف الذي يخفي داخله رسائل الله المتضمنة لما يحبه الإنسان، إذا أحسن استثمار الأسباب وقوّى توكله على الله كما قال أحد الشعراء:
ولكل حال مُعقِب ولربما
أجلى لك المكروه عمّا يُحمدُ
وهكذا فإن “المكاره” تبرز توَهج “المكارم”، وتصيِّر المحن جسرًا للعبور إلى المنح، وهذا ما سنجعله مسك هذه المقالة.
4- “المحن” جسر العبور إلى “المنح”
يؤكد التدبر في آيات القرآن، والتفكر في آيات الأكوان، والتبصّر في آيات الكائنات وعلى رأسها الإنسان، أن “المحن” في حياة الأفراد والكيانات، جسر للعبور إلى “المنح”، إذا أُحْسِن استثمارُها على الوجه الأمثل.
إن فقه الابتلاء يثبت أن “المنحة” تتسلل في كثير من الأحيان من بين براثن “المحنة”، و”النعمة” تخرج من رحم “النقمة”، و”المزايا” تتكوّن في بطون “الرزايا”، و”الآمال” تنشق من صخور “الآلام”، و”الأفراح” تتولد بين أكوام “الأتراح”، ويثبت أن أشجار العِبرات لا تطيب إلا بمياه “العَبرات” وأن “الأشواق” لا تضطرم إلا باضطراب “الأشواك”.
وعلى هذا الأساس قد يكون الانكسار هو طريق الانتصار، وقد يكون الانفصال سببًا لدوام الاتصال، وقد تكون الوحدة سببًا للوُحدة، وقد يكون الاختلاف مقدمة للائتلاف.
وكما قال الشاعر العربي:
قد يُنعم الله بالبلوى وإن عظمت
ويبتلي الله بعضَ القوم بالنعم
وتشير فلسفة المحنة إلى أن المنع قد يصير منحًا، وأن العسر قد يصير يسرًا، وأن الداء قد يصبح دواء، وأن البُعد قد يصير قربًا، وقد يكون الغلق عين الفتح، والمرض عين العافية، والنقصان ذات الكفاية، والإساءة عين الإحسان.
وقد يصبح القدح مدحًا، والمحق بركةً، والضعف قوةً، والفقر غنًى، والدمار عمارًا، إذ إن العاقل يستطيع أن يستخرج من حفرة العثرة جوهرة العبرة، ويستغل الخطوب لتمحيص النفوس وتصفية القلوب، وقد تقوده الزَّلة إلى دخول بيت الذلة بين يدي ربه فيصلُح ويفلَح.
وقد ساعدنا على فهم ذلك الحكيمُ الفارسي “أزدشير” الذي قال: الشدة كُحلٌ ترى به ما لا تراه بالنعمة. ومن هنا يصبح الألم نعمة، إذ إنه ينبه صاحبه إلى وجود مشكلة، ويستفز فيه جهازه المناعي ويستنفر طاقات التحدي الكامنة فيه، مما يعني أن المحنة هي خير للمؤمن الحق.
وكما أن قوة الظلمة تؤذن بالانبلاج، فإن قوة الشدة تؤذن بالانفراج، كما قال أحد الشعراء:
وكل الحادثات وإن تناهت
فموصولٌ بها فرج قريبُ
وزبدة القول: أن الشدائد توقد في المرء طاقة التذرع والتضرع، التذرع بالأسباب، والتضرع إلى مالك الأسباب، وعندها تكتمل معادلة الفوز والنصر والتمكين.
والآن حان أن نتساءل: كيف يمكن أن نصنع من الشرور جسورًا للعبور إلى السرور؟
(*) أستاذ الفكر الإسلامي السياسي بجامعة تعز / اليمن.