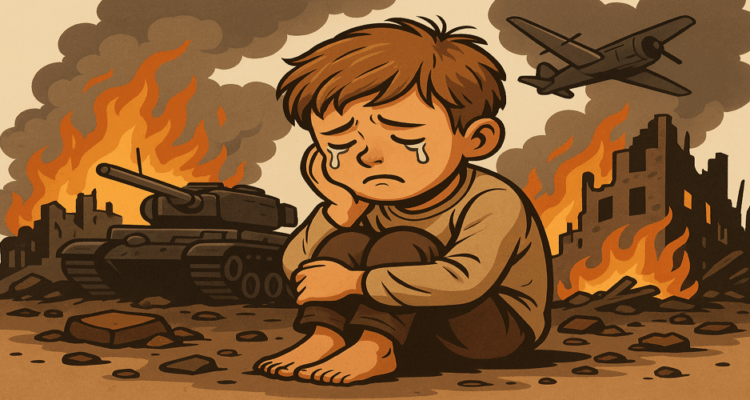الطفل، أجمل كائن حي في الكون، صاحب القلب البريء والنقي، تبدو في ملامحه بسمة صافية تتجلى فيها الفطرة الإنسانية السليمة، نبيّ السلام وحامل رسالة الأمن للعالم. من ذا رأى ذلك الوجه البشوش فلم يرق له ويلاطفه؟ من ذا رأى في عينيه لمعة الدمع البارد فلم يحب له ويقبّله ويواسيه؟ ومن ذا يجرؤ أن يمزق تلك البراءة ويذبحه أو يطلق نحو جبينه الرشاش، أو يستهدفه من إحدى الدبابات الضخمة، أو يرسل نحو صدره القليل الحجم صاروخًا يطيح بالمكان كله؟ كلا… ما هو إلا وحش ضار بلغ به الجوع مبلغه، أو سبع مقيت! ثم حاشاهما من ذلك.
ما زالت الصراعات محتدمة في أطراف شتى من الجغرافيا، ويشتعل أوارها يومًا بعد يوم، فتتلظى في نيران جحيمها ملايين من الناس. فغزة تحترق، والسودان تحتضر، وأوكرانيا ترنّ صرخاتها في الأسماع. في كل قارات الأرض تدقّ الحرب طبولها كل سنة، فلم تتخلص من ويلاتها أوروبا والأمريكان، فضلاً عن الدول الأفريقية والآسيوية والشرق الأوسط بوجه الخصوص. تمرّ البشرية كلها بالحروب الطاحنة العصيبة والأوضاع الحرجة والصعبة في مختلف المناطق، ولا زال الأطفال أكثر الشعوب معاناة ومكابدة لآثار هذه الاشتباكات؛ من فقد الهوية والعائلة والأوطان، ومشكلة البقاء والاستقرار، والتشرد والتشرذم، والتيه والضلال… إلى غيرها من نتائج سلبية ومريرة وتداعيات باهظة الثمن.
الأطفال هم المرآة الصافية التي تعكس معنى المعاناة والمكابدة لويلات الحروب وأعبائها المزرية، وأعينهم الفياضة وأوجههم الشاحبة، هي التي تسلط الضوء على وجه الجرائم المكمّمة التي تبقى بلا صوت، وفظاعة الأحداث التي تُرتكب تجاههم ويدهسون كل يوم تحتها. ومن أنين عويلاتهم يتفجع ضمير الإنسانية التي تجمدت في صدور العالمين، فهم الناطقون باسم المجتمعات المنكوبة وسفراؤها، وهم المدافعون عن القضية والمقاومون في ثغورها بصرخات عالية.
فمذكّرات آن فرانك، تلك الفتاة الألمانية، هي ما تصف لنا بعمق وتفتح لنا نافذة إلى الجرائم البشعة التي اختبرتها القوات النازية على اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية في الهولوكوست، وهي التي عانت من المجازر والإبادات الجماعية التي شنّتها القوات النازية في هولندا، وعاشت مع عائلتها مختبئة لسنتين في غرفة سرّية بأمستردام، والتي لم تبلغ من العمر حينها خمسة عشر عامًا. وكذلك أيضًا صورة آلان – الطفل الكردي – الذي وجدوه مطروحًا في إحدى الشواطئ التركية للبحر الأبيض المتوسط وهو غارس وجهه الندي الأملس في الرمال، هي التي أيقظت قلوب الملايين ولفتت أنظار العالم إلى معاناة آلاف النازحين والمشرّدين السوريين الذين تشتتوا على متن الجغرافيا، وأتى بمشكلتهم هذه إلى طاولة انتباه المجتمع العالمي. وكذلك صورة الطفلة نابالم، وهي تركض عارية في الشوارع جرّاء الحروق البالغة التي أصابت جسدها بعد هجوم نابالم في جنوب فيتنام، ما عكست التفاتًا عالميًّا وأثارت ضجّات واسعة تندد بالحروب الفيتنامية التي جرت عام 1972م.
من أخطر التساؤلات المرتفعة والتحديات التي تنمّ عنها هذه الصراعات الجارية اليوم هي مشكلة الأطفال والولدان. الأطفال هم أكثر الشعوب ضحية لكل الحروب والمجازر والإبادات، وهم اللسان الناطق عن الأهوال التي حدثت في صفحات التاريخ، وفي هذه الأيام آلاف من الأطفال يتعرضون لمذبحة كل لحظة. ففي غزة، الأطفال يُقتلون كل يوم ذبحًا وقصفًا وتفجيرًا ويموتون شرّ ميتة، يتجرّعون من قساوة العيش أمرّها، ويمشون في ظلال الغبار والدخان، وكثيرون منهم تظلّ أجسادهم الباردة الهامدة عالقة تحت الأنقاض، وكثيرون منهم فاقدو البصر والسمع ومبتورو الأقدام والأيادي في المستشفيات والمؤسسات الصحية التي هي بنفسها تقاوم الدمار والخراب. فـ15 ألفًا من الأطفال الفلسطينيين قد قُتلوا بأبشع الحالات وأشنعها في السنة الأخيرة في قطاع غزة، والحقيقة الصادمة هنا أنه ما كان أكثرهم ضحايا الأسلحة والآلات الحربية، بل المجاعة والعطش والأمراض الصحية التي طالما أنهكت وأرهقت المنطقة وانتشرت في كل أسرة انتشار النار في الهشيم.
ثم إن جيوش الاحتلال التي حاصرت المنطقة ومنعت كل المساعدات الخارجية والإسعافات الغذائية لضرورات المعيشة، وسدّت الطرق دونها من كل جانب، لتُسقط المنطقة بأجمعها وتُعذّب الملايين وتُبقيهم في مستنقع المجاعة. فأغلب الولدان اليوم تحت وطأة الأمراض مثل الهزال والشلل وغيرهما، وحتى بعد كل ذلك، تشدّ قوات الاحتلال الخناق على المنطقة حتى تُطارد المستشفيات والمنشآت الطبية قصفًا وتخريبًا، مثل مستشفيات مجمّع الشفاء الطبي، ومجمّع ناصر الطبي، والمستشفى المعمداني، ومستشفى كمال عدوان، وغيرها، وكذلك الكوادر الصحية والممرضين والأطباء حتى بلغ عدد من قُتل منهم 200. هذا ما دعا إليه البابا فرانسيس، حيث ناشد سائر دول العالم شرقًا وغربًا أن يفتحوا أعينهم وتُبعث الأضواء نحو الأطفال المضغوطين تحت الكيد العدواني في قطاع غزة، وليقف العالم بأجمعه مع الأطفال الملهوفين في غزة انتصارًا لهم ضد الإرهاب والتطرف.
وفي نفس الإطار، نستطيع أن نقرأ ما يحدث في الدول الإفريقية التي تعيش بين مطرقة الصراعات الداخلية وسندان الأزمات الصحية. ففي السودان، ملايين البشر على حافة الكارثة الإنسانية. فالصراعات الأهلية التي اشتعل فتيلها منذ أبريل عام 2023 تستمر بكل شراسة وبشاعة، ما جعل المنطقة بأسرها تسودها الفوضى والهلع وأجواء متوترة يُخيّم عليها الخوف. وأكثر من 30 مليونًا من الناس، بما في ضمنهم 16 مليونًا من الأطفال، ينشدون خدمات عاجلة وتدخلات سريعة، وستة ملايين من الأطفال حاليًّا مشرّدون قد فقدوا بيوتهم ومساكنهم، و2.8 مليون منهم تحت الخامسة من عمرهم. والأخطر في الاشتباكات الراهنة التي ضربت بكل القوانين والحقوق الدولية عرض الحائط، وحسب التقارير التي صدرت من اليونيسيف، أنه يوجد هناك تصاعد هائل وملحوظ في الاعتداءات الجنسية التي تمتد نحو الأطفال، وأنه في مطلع العام 2024، أكثر من 200 طفل صاروا ضحية لأعمال الاغتصاب والاعتداء الجنسي، الذي أصبح سلاحًا وقحًا من ضمن التكتيكات الحربية.
ونفس السيناريوهات، وبخفة، تتمثل في أوكرانيا، حيث أكثر من ستمائة طفل تم قتلهم في الصراعات الدائرة بين القوات الأوكرانية والروسية، و680 طفلاً جريحًا بإصابات بالغة ونازفة. وقد صبّت الهجمات دمارًا واسع النطاق على المدارس والمؤسسات التعليمية والعمران، وما صرّحت به الإحصائيات بأن حالة الحرب قد أحدثت في آلاف الأطفال قلقًا نفسيًّا وصدمات غائرة، مما قد يُسبب اضطرابات في حياتهم المستقبلية.
وأجدر الأمور ذكرًا والتفاتًا وأخلقها انتباهًا من بين التحديات والجروح الغائرة التي تدعها الحروب على الأطفال الذين هم في نضارة حياتهم وعمر زهورهم، مشكلة فقدان العائلات التي تذهب ضحية لفظائع الحرب والتشتت الذي تفرضه على مشاعر الولدان، ليفقدوا بذلك في منطلق مسيرتهم الحياتية العمود الفقري لا منحة عنه ولا مجال، فتغيب هناك القدوة التي كانت لترسم معالم في طريق تربيته وتنشئة أخلاقه وتنمية شخصيته على مدى الحياة، وتبقى هذه المأساة ثلمة لا تُسد، وفراغًا لا يُملأ طول الدهر. بل الأثقل من هذا، أن هذه الورطات لا تتوقف على الوالدين فحسب، بل يتجاوزهما إلى أفراد الأسرة الآخرين والقرابات المتبقية وغيرها، حتى يسبب كل هذا تشتتًا وقلقًا هائلين في نفوس هؤلاء الأطفال وآثارًا بالغة في مشاعرهم وأحاسيسهم، فيستسلمون للأمراض النفسية غير بعيد، وكذلك يتشكل هذا تيهًا ووحشة يعاني منهما الأطفال. حسب الحسابات والتقارير الواردة حتى الآن، يوجد هنالك أكثر من خمس مئة ألف طفل مهاجر ونازح، هائمين ومشردين على كوكبة الأرض، يعني أن كل واحد من 115 طفلاً من الأرض غريب عن أهله ووطنه.
ثم إن الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال في المناطق هي الأدهى والأمر، كما نرى في السودان، حيث الجيوش الثورية قد نسفوا كل القوانين والحقوق الإنسانية الدولية في وضح النهار وذروها في الرياح. فالحالات هناك -حسب التقارير التي أخرجتها اليونيسيف- مفزعة للغاية، حيث تعدّوا على المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء، بالاعتداءات الجنسية. فالآلاف من الأطفال أصبحوا ضحية للتحرش الجنسي، والاختطاف، والكثير منهم تم تجنيدهم إلى الجيوش عنوةً وإكراهًا، إلى غير ذلك من العواقب الوخيمة التي تتركها الصدامات على النفوس الناعمة. فالأكثر من الجروح الظاهرة التي تستنزفهم، هذه العمليات تترك فيهم آثارًا باطنة أشد وطأة عليهم، وجروحًا غائرة غير مندملة على مدى الحياة. إذ تسبب هذه الاعتداءات، وما عاينوه بأم أعينهم من المخاوف والأهوال التي تتردد حولهم لحظةً فلحظة، وما تحملوه من ألم الفقدان للأهل والعائلات، قلقًا وصدمات نفسية ويأسًا وشللاً، ما يضع ميزانية الحياة في كفة الانهيار. وطبقًا لما يراه الخبراء، أن هذه تسبب اضطرابًا في النشوء النفسي لدى الصبيان، وأن هذا ربما يؤدي إلى انقباضهم وعدم ائتمانهم للحياة، وتترتب آثارها في العلاقات الصحيحة لديهم، ويشكّل منهم “جيلاً ضائعًا” في المستقبل.
فالمسؤولية والعبء الأخلاقي الذي تحمله الأوضاع علينا وعلى المجتمع العالمي ضخمة بكل ما تعنيه الكلمة. وكل المنظمات قد نصّت على العوامل التي تستطيع أن تؤمّن الأطفال في كل المناطق. فلحل هذه المشكلة، لا بد أن يكون هناك مسعى جبّار وجهود ملتئمة مشتركة متعددة الجوانب.
أولاً: لا بد أن يتم إبرام تضامن عالمي وتحالف متكاتف لدفع الصراعات الدموية، بتوطيد الأواصر الدبلوماسية، ووساطة ذات كفاءة وجدارة، وفحص الأسباب الجذرية التي أدّت الجانبين إلى التصادم.
ثانيًا: إيصال المساعدات الإنسانية الشاملة لكل الأطفال الضحايا الذين يرزحون تحت الاضطهادات حتى الآن، بما فيها من الطعام والشراب والسكن والرعاية الطبية والدعم الاجتماعي والسيكولوجي، والحضّ على بناء أجواء صديقة للأطفال.
ثالثًا: بناء مؤسسات قوية مسؤولة لمطاردة كل المنتهكين والمعتدين على الحقوق، والمكدّرين لمعنى السلام والأمن.
رابعًا: البحث عن استثمارات تنموية بعيدة المدى لإعادة التأهيل والإدماج للأطفال المنكوبين، والتي تساعد على دعم التعليم والتدريب الذي يعيدهم إلى الحياة العادية الآمنة المطمئنة.
الأطفال مواعيد المستقبل، بذور الآتي، وطلائع الصباح القادم. دعنا نمدّ لهم أكفّ الرحمة والحنان، ونرحّب بهم إلى يوم باهر ومشرق، ليعمروا العالم من جديد، ويستخلفوه ويبنوه على درب السلف، لكي لا ينطفئ مشعل الكون ونور البشرية. عالم لا تقضّ فيه القنابل مضاجع الأبرياء، يتفتح فيه أزهار الأمن والسلام، ويلعب فيه الأطفال مستبشرين بلا وجل أو قلق، مبتسمين للحياة.