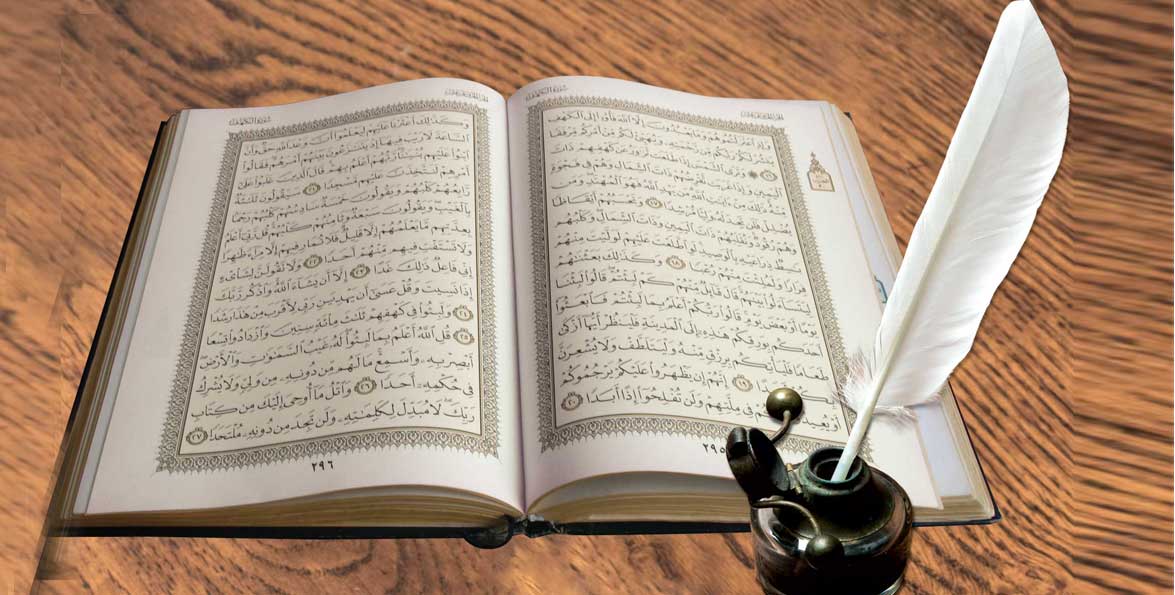الظواهر الكونية هي يقينيات علمية أي تثبيتات إيمانية للقلب يخاطب الله تعالى بها العقل من خلال أمثال يضربها للإنسان في نفسه أو في آفاق الظواهر الطبيعية المحيطة به، لعله بكل يقينية تستقر في قلبه يترقى في مراتب الخشية من الله كما جاء ذلك في قوله تعالى:) إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)(فاطر:28). والعلماء كما قال ابن عباس -رضي الله عنه- في تفسيره لهذه الآية: “هم الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير”. فهؤلاء كما يتضح من سياق الوصف القرآني السابق لهذه الآية، هم الذين ينطلقون من مراجع الكون المنظور ليثبّتوا في يقينهم آيات الكتاب المسطور. حتى إذا تكونت الصورة في عقل الناظر، نفذت أنوارها إلى القلب فحصل هنالك اليقين بأن الله على كل شيء قدير.
وعليه فلما كان الله في كل شيء -يراه الإنسان أو لا يراه- وكان هو الكل متجليًا نوره في كل مكونات الكون وجّه سبحانه المتعرفين عليه إلى النظر والتفكر في هذه المكونات العاكسة لنور ضيائه. لعل هذا الإنسان المكرم بالعقل إذا نفذ إليه ذلك الشعاع الساطع من نور هذه المكونات، ارتقى من خلال تلك المدارك في درجات الكمال الموصلة إلى الانسجام مع كمال الكون. فجاء الخطاب القرآني من أجل ذلك موجهًا الإنسان إلى الجمع بين القراءتين؛ قراءةِ المسطور وقراءةِ المنظور، على اعتبار أن الكتاب المسطور يقدم للإنسان قواعد العلاقة التفاعلية بينه وبين الكون، وأن الكون الذي هو الكتاب المنظور يشكل المرجع التجريبي لوضع النماذج التفسيرية لهذه العلاقة في ظل وحدة بنائية متكاملة تتكامل فيها عناصر الواقع والعقل والوحي.
فإذا انطلقت معرفة الإنسان العلمية من وحدة هذه العناصر الثلاثة تكامل في يقينه عالم الشهادة مع عالم الغيب، فترقى بذلك في مراتب الكمال التي من أجلها خلق. أما إذا انطلقت معرفته من قراءة تجزيئية لا تعتمد النظرة التكاملية الجامعة بين المسطور والمنظور، فإن الإنسان يبقى بعيدًا عن هذا المنال ولا يمكن له أن يصل إلى كمال المعنى المراد من الإشارات الكونية بقدر ما يقع في توظيف اللفظ القرآني أو الظاهرة الكونية فيما شاء من تأويل. فالقرآن والكون بوحدتهما التكاملية بين الواقع والعقل والوحي، يذكّر كل منهما القارئ بعلاقة التلازم القائمة مع الآخر، إذ لا يمكن فهم أحدهما إلا من خلال حسن قراءة الآخر. فكان بناء الكتاب المسطور متناظرًا مع بناء الكون المنظور في العوالم الثلاثة؛ عالمِ الشهادة وهو الواقع المشهود مما نلمس ونحس، وعالم الغيب النسبي وهو المغيب المدرك بقوة العقل، وعالم الغيب المطلق وهو الوحي الذي نزل بعلم الله وحده وليس لنا إلا أن نؤمن به.
الوحدة التكاملية بين القرآن والكون
ومن هنا يجب أن تكون الوحدة التكاملية بين القرآن والكون، المدخل لكل قراءة علمية تهدف إلى الإحاطة بحقائق الأشياء وفق منهاج القرآن الذي يرسم للعقل البشري الطريق الواضح الذي يجب أن يسلكه في بناء الفكر العلمي والإدراك المنطقي. فالقرآن لما دعا الإنسان إلى النظر في الكون: (قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ)(يونس:101)؛ اختزل في ذلك النظر -كما رأينا- كل المنهاج التجريبي الذي وصل إليه العقل البشري من ملاحظة وفرضية وتجربة. ولا أدل على ذلك مما جاءت به الآية الأخرى في قوله تعالى: ( أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ * قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدِيرٌ)(العنكبوت:19) التي تستوعبت كل المنهاج التجريبي بين كلمتي “انظروا” و”كيف” اللتين تجمعان خصائص الملاحظة والفرضية والتجربة، بل وتتجاوزها إلى حد التوثيق الزماني والمكاني لموضوع البحث بإقرار السير في الأرض كعنصر دال على البُعد المكاني، والفارق بين بدء الخلق ونشأته الآخرة كعنصر دال على البعد الزماني. وذلك لإضفاء صفة الدراسة المقارناتية على ظواهر الخلق بالتنقل بين أرجاء الأرض، ثم الربط الزمني بين مراحلها على اعتبار عامل الزمن مؤثرًا في تطورها.
فالآية بإقرارها لعلاقة التلازم القائمة بين بُعدَي المكان والزمان في موضوع النظر هذا، إنما تكون أقرتْ بنسبية كل واحد منهما للآخر، إذ لا يصير لأحدهما مدلول إلا إذا أخذ من مفهوم وحدته مع الآخر. وهو ما كشفت عنه حديثًا دراسات الفيزيائي الألماني “ألبيرت أينشتاين” في نظريته للنسبية التي أصبحت اليوم أساسًا لكل الدراسات العلمية الدقيقة، حيث قال في كتابه مبادئ النسبية: “إن المكان في حد ذاته والزمان في حد ذاته، هما متغيران محكوم على كل منهما بالاضمحلال كما يضمحل الظل. ولا يمكن لأحدهما أن يُبقيَ حقيقته إلا من خلال توحده مع الآخر”. ونحن نعرف أن الظل ليس شيئًا ماديًّا، بل مجرد أثر في المكان لجسم مادي متغير مع الزمان. فإذا غاب أيٌّ من الزمان أو المكان، زال مفهوم الظل الذي تبقى نسبيته من نسبية بعدي الزمان (الشمس والقمر اللذين هما مصدر الضوء المحدث للظل، واللذين بهما نعلم عدد السنين والحساب) والمكان (الأرض التي هي البساط الذي عليه يقع الظل). وهذا يعني أن المعالجة لا يصير لها مدلول إلا من خلال هذه الوحدة الزمكانية التي تقوم عليها نسبية كل من الزمان والمكان بعضهما لبعض.
فكان التوجيه الرباني في هذه الآية منهاجًا تجريبيًّا شاملاً سطّر الحق سبحانه فيه مجال البحث وفق محورين متلازمين: محور أفقي وهو المكان الذي تدل فيه عبارة (فِي الأَرْضِ) على شمولية المجال لكل النُطُق التي ترتفع أو تنخفض عن مستوى سطح الأرض، ومحور عمودي وهو الزمان الذي تدل فيه عبارتا بدْء الخلق ونشأته الآخرة على فعل الزمان كأداة يغير الله بها خصائص الخلق ويرتب بها أطواره وفق سنة التطور التي خلقه عليها. وعلى سكة هاذين المحورين تُنزّل قاطرة البحث لتسير بخطى حثيثة تطلب بوسائل البرهنة والاستدلال الحقائق العلمية المفضية إلى الحقيقة المطلقة الكامنة خلف كل هذه الحقائق النسبية، وهي اليقين بأن (اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) كما جاء في آخر الآية.
وهذا ما تستبطنه الإشارات الكونية في القرآن الكريم، التي غالبًا ما تأتي الآيات بها في سياقات مهيأة للتعامل مع المنهاج التجريبي بالدعوة إلى النظر، أي الملاحظة وافتراض التساؤلات لإخضاع الظاهرة للتجربة والاختبار. والغاية من كل ذلك تحريك عقل الإنسان لسبر أغوار الكون والكشف عن أسراره من أجل تقويم فكره على درب الاستقامة الكونية التي هو جزء منها.
ونستشهد على هذا النهج بدعوة سيدنا إبراهيم -عليه السلام-، إذ لما أراد الله أن يُقرّ في قلبه اليقين سلك به سبحانه هذا المنهاج؛ منهاجَ الملاحظة والفرضية والاختبار فقال عز من قائل:(وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ)(الأنعام:75)، وذلك بأن جَعَله يجول بخاطره بين أجرام الكون ملاحظًا عظمة مكوناته ودقة نظمها. فوضع -عليه السلام- فرضية تأليه الكوكب، ثم بعده القمر، ثم الشمس. فلما أخضعها للاختبار وجدها كلها تأفل، فخلص بعقله من خلال ذلك إلى حقائق نسبية تفيد عدم استحقاق هذه المكونات التأليه، ومن خلالها إلى الحقيقة المطلقة التي جاءت مقررة في قوله تعالى على لسان نبيه إبراهيم: (إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ)(الأنعام:79). وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن إبراهيم -عليه السلام- كان منطلقه إيمانيًّا، لأنه ما استدل بالكوكب الذي رآه، ولا بالقمر، ولا بالشمس على الله، وإنما استدل بالله عليها بدليل قوله -عليه السلام- كما حكى عليه ربه -سبحانه وتعالى-: (لاَ أُحِبُّ الآفِلِينَ)(الأنعام:76). فما جعل -عليه السلام- هذه الظواهر الكونية إلا حقائق نسبية أقام بها الحجة على قومه، حتى يوصلهم -عن طريق العقل- إلى الحقيقة المطلقة التي جاءت مقررة في خطابه كما رأينا.
وبذلك يتضح أن عالم الشهادة الذي نعيشه بحواسنا، هو مادة خصبة للعقل من أجل الخوض في عالم الغيب النسبي. فإذا أحسن الإنسان التعامل معه، ارتقى بالاطمئنان القلبي في عالم الغيب المطلق فكان من الموقنين، وهو ما نستشفه من حقيقة طلب سيدنا إبراهيم -عليه السلام- من ربه رؤية كيفية إحياء الموتى، يقول تعالى: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)(البقرة:260).
وقد يختلف الناس حول مغزى هذا السؤال كما قال القرطبي رحمه الله: “اختلف الناس في هذا السؤال، هل صدر من إبراهيم عن شك أم لا؟ فقال الجمهور: لم يكن إبراهيم -عليه السلام- شاكًّا في إحياء الله الموتى قط، وإنما طلب المعاينة”، وذلك لأنه لو لم يؤت العلم من ربه بمنهاج المشاهدة والمعاينة، لما تمكّن من تثبيت اليقين في مواجهة التحديات الفكرية والعقدية لذلك الزمان. قال تعالى حاكيًا عن نبيه إبراهيم -عليه السلام-: (قَالَ بَل رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ)(الأنبياء:56).
ولتثبيت صحة هذا المنهاج -منهاج التيقن بالملاحظة والفرضية والتجربة- ولتفصيل مقاصده، جاءنا ربنا الكريم في سياق الآيات بقصة أخرى، جعلها سبحانه معطوفة على تلك التي حاج فيها الملك إبراهيم والتي بُهت فيها الملك بحجة “اليقينية الكونية” التي أقامها عليه إبراهيم -عليه السلام- فقال عز من قائل: (أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)(البقرة:259).
هذه القصة كما يظهر من مضمونها، جاءت لإظهار محدودية علم الإنسان ونزوعه إلى الخطأ. فحتى ولو كان هذا السؤال:(أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا) قد صدر عن أحد أنبياء بني إسرائيل كما جاء في بعض التفاسير، إلا أنه جاء من قبيل الافتراض بعد ملاحظة الخراب المهول الذي حل بالقرية. فهو إذن من باب الاستبعاد الظني، لأن إعادة البلدة إلى ما كانت عليه من العمارة بعد فجائية الخراب، يتطلب من الوقت ما لا يمكن تصوره. ولإثبات خطأ الرجل في تقديره لقدرة الله، أجرى الله له اختبارًا على نظير البعد الذي أخطأ منه التقدير وهو الزمن؛ فأماته مائة عام، ثم سأله بعد أن بعثه ليجعله يكتشف بالمعاينة التجريبية التي أجراها الله على طعامه وشرابه وحماره أن ظنه الذي استبعد به إحياء الله القرية الخاوية كان خاطئًا تمامًا كما هو خاطئ الآن في تقديره للمدة التي لبثها ميتًا وإن لم يكن الرجل كاذبًا؛ -عز وجل- (قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ).
وقال القرطبي -رحمه الله- في تفسير معنى قوله تعالى: (فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ)؛ “أي لما اتضح له عيانًا، قال أعلم أن هذا الضرب، من العلم الذي لم أكن أعلمه على معاينة فتيقن ذلك بالمشاهدة”. وقال ابن كثير -رحمه الله- أن آخرين قرأوا (قَالَ أَعْلَمُ) على أنه أمر له بالعلم كما قال لإبراهيم -عليه السلام-: (وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).
وهكذا فقصة هذا الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه، جاءت في سياق الآيات ممهدة لاستيعاب المقصد من طلب إبراهيم -عليه السلام- رؤية كيفية إحياء الله الموتى. فقد ذكر ابن كثير -رحمه الله- في معرض تفسيره لقول الله تعالى: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى)؛ “أن إبراهيم بعد ما قال لنمرود ربي الذي يحيي ويميت، أراد -عليه السلام- أن يترقى بذلك من علم اليقين إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة”. فأراد بسؤاله (كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى) أن يرى الكيفية، أي الطريقة التي تمكنه معاينةُ تفاصيلها من طمأنة نفسه بعدما لاحظ قدرة الله على الإحياء وافترض افتراضات لذلك. فكان أن هيأ الله تعالى له ذلك المختبر الطبيعي الذي ستكون فيه التجربة العلمية هذه المرة على نطاق البعد المكاني بصرّ الطير وتوزيع أجزائهن على قمم الجبال المتباعدة ثم دعوتهن، حتى يوصله عن طريق المعاينة التجريبية بالبرهان إلى الإحاطة بحقيقة الإحياء حسًّا ومضمونًا.
من خلال هذه الاستشهادات يتضح أن القرآن يقر المنهاج التجريبي كأساس لبلوغ اليقين. فهو عين المنهاج ونبع الاستقامة العلمية؛ إذ يستوعب بتوجيهاته كل وسائل الملاحظة والفرضية والاختبار، بل ويهيمن عليها بالتوثيق الزماني والمكاني لموضوع البحث، حتى يفضي من خلال حقائق الكون النسبية إلى الحقيقة المطلقة التي ليست بعدها إلا الضلال.
وهذا ما ينبغي أن يستوعبه كل متطلع لبناء فكر علمي، وكل باحث في حقل العلوم التجريبية، لأن القرآن آيات تهدي إلى الحق، والكون بصائر تعصم الناس من الخطأ، فمن لم يستدل بها على الحق بمنهاج علمي حكيم حُجبت عنه كل الحقائق.
(*) كلية العلوم، جامعة ابن طفيل / المغرب.