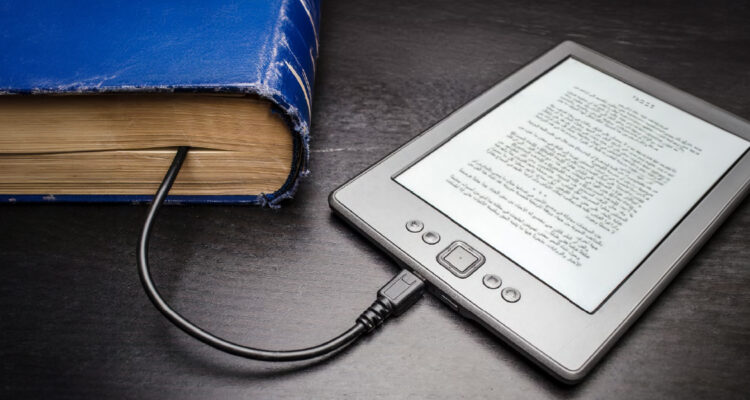تطرح الرقمية بما تفرضه من تحولات وإبدالات عميقة على جميع الأصعدة تساؤلات عدة، خاصة لدى الشعوب حديثة التعامل مع التكنولوجيا، أو التي ليست لديها ثقافة تكنولوجية ورقمية كافية. هذه الأسئلة أوجدت فريقين؛ فريقًا مؤيدًا للرقمية لما تقدمه من خدمات جليلة للإنسان في عصر السرعة، وفريقًا ظل يمانع الرقمية كما ظل يتعامل بحذر مع التكنولوجيات الحديثة. ولعل من بين أهم المواضيع التي تثير اليوم تساؤلات عديدة من قبل المهتمين المثقفين، مشكل الكتاب الرقمي الذي صار شيئًا فشيئًا يعوِّض الكتاب الورقي، حتى صار قبلة الباحث العلمي والقارئ النهم، بل حتى قراءة القرآن صارت تتم في كثير من الأحيان عبر المصاحف الرقمية(١).
لقد مرت الكتابة بمراحل متعددة إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اليوم، حيث أصبحنا في عصر المعلومة نعيش مرحلة الأدب الرقمي والكتابة الرقمية، وعرفت مقاومات عدة على مستوى حواملها بالشكل نفسه الذي تعرفه اليوم، من خلال مقاومة النصوص الرقمية والكتاب الرقمي.
لقد تطور الإنسان عبر الزمن وتطورت وسائل تعبيره، ومن أهم تلك الوسائل الكتابة وحواملها، والحامل أو السند (Support) هو ما يحمل المكتوب من كتاب وغيره، حيث إن الإنسان في البداية ابتكر الكتابة الصورية أو الكتابة بالصورة (Image)، أي المعتمدة على الرسوم حيث يتم رسم المعنى أو الشيء المعبر عنه. ومن ثم كان عدد الكلمات بعدد ما تعبر عنه، وكانت تلك العلاقة بين الدال والمدلول علاقة ضرورية، لأن الشكل (Forme) كان يعبر صوريًّا على المدلول كما هو الحال في بعض اللغات اليوم، التي لا زالت تحافظ على هذه النمطية كـ”الكانجي” (Kanji) في اللغة اليابانية.
ويرجع أول نص عثر عليه مرسومًا، إلى ٤٠ ألف سنة، علمًا بأن عمر الإنسان اليوم لا يزيد عن ١٠٠ ألف سنة حسب علم الجينات الوراثية (DNA)، وهو نص عثر عليه في الحضارة الآشورية التي عمرت آسيا، ويحمل رموزًا سحرية على اعتبار أن السحرة والمنجِّمين كانوا يستفردون بالكتابة ويمتلكون سلطتها، ويرجع إليهم الحاكم للتنبؤ بمصير البلاد في الأمور الصعبة.
ثم انتقل الإنسان من الرسوم إلى الكتابة الرمزية، ويرجع أول نص عثر عليه في الصين إلى حوالي ٧٠٠٠ سنة فقط، وهو نص كتب على درقة سلحفاة، وهو بدوره يومئ -حسب الباحثين- إلى معلومات سحرية وتنبُّئية.
ويمكن القول إن عمر الكتابة الفعلي يعود إلى ٤٠٠٠ سنة، حيث تنقل الإنسان -قبل اكتشاف الورق- عبر حوامل متعددة للكتابة، من عظام الحيوانات، وسعف النخيل والحجر والحرير والشجر.. وذلك في ثلاث مناطق رئيسية، هي الصين وبلاد ما بين الرافدين ومصر.
ونظرًا لتوفر الصين على الغابات الكثيفة اعتمدت لحاف الشجر، وفي بلاد الرافدين حيث يكثر الطين استعمل الطين للكتاب، ومصر التي تتوفر على دلتا النيل وفر لها أوراق البردي التي اتخذتها حاملاً للكتابة.
كل هذه المراحل تشكل مرحلة كبرى هي مرحلة ما قبل الدفتر، حيث سيظهر تمثيل الدفتر الذي يمكن أن يشكل كتابًا من خلال ظهور الألواح؛ ألواح الكتابة. ومن أشهر هذه الألواح، ألواح الطين الذي يشبه الآجور والذي يؤخذ أو يعجن نيِّئًا ثم يكتب عليه ويطهى. ويرجع أول نص عثر عليه في هذا السياق، إلى ملحمة “غلغامش” للسومريين، كما استخدمه الرومان. وقد استمرت الكتابة على الألواح إلى عصور متقدمة، حيث يرجع آخر لوح إلى القرن الثامن عشر، وهو لوح خشبي، بل إن من إرث هذا اللوح ما يسمى الآن بـ”التابليت” (Tablette)، الآلة التي اتخذت شكلاً جديدًا ومخالفًا تمامًا.
واستعملت مصر أوراق البردي، حيث كان يتم لصق عدة أوراق مع بعضها البعض ويتم الضغط عليها، ثم يكتب النص الذي يتخذ شكلاً طويلاً في الغالب، فيما كان يسمى بـ”الرولو” الذي قد يصل ٤٠ مترًا للنص الواحد(٢).
وسيتم فيما بعد اختراع الأبجدية، الذي أحدث قفزة كبيرة في مجال الكتابة، أي اكتشاف عدد من الحروف يمكن التوليف بينها لتكوين عدد لا متناه من الكلمات، وهو اختراع يمكن قياسه اليوم باختراع الحاسوب، حيث سيعني هذا الاكتشاف انتقال الإنسان من التصوير والتجسيد إلى التجريد.
والواقع أن اكتشاف الكتابة سيدعو إلى نوع من المقاومة التي تشبه اليوم مقاومة البعض لاعتماد الحاسوب والكتابة الرقمية أداة للتوثيق والبيانات عوض المطبعة والكتاب. فقد كان سقراط من بين من قاوموا الكتابة، لأنه كان يتشبث بالقراءة والتعلم المبني على المشافهة باعتباره فيلسوفًا مشاء، حيث سيعتبر الكتابة عملية خطيرة ستقضي على التفكير وتوحي -بحسبه- بأنها حية، غير أنك إذا خاطبتها لن تعيرك جوابًا، ولا تملك القدرة على الدفاع عن نفسها. ويمكن القول إن الموقف نفسه اتخذته الثقافة العربية التي قامت على المشافهة، والتي ترفع شعار كون “العلم يؤخذ من أفواه الرجال”، أو كما تعبر عن ذلك عبارة “حفظ عن ظهر قلب”، على اعتقاد منهم أن القلب لا العقل من يحفظ، أو قولهم في الفرنسية “Apprendre Par Coeur”. غير أنه مع الزمن ستصبح هذه الكتابة أساس الحضارة، خاصة بعد اكتشاف المطبعة التي ستساهم بشكل كبير في تيسير وصول المعلومة إلى العالم، بل إن البعض يعتبرها بداية النهضة الأوروبية.
فظهور المطبعة في القرن الخامس عشر، سيشكل ثورة حقيقية نقلت المعرفة من عالم الخواص إلى عامة الشعب، ومن ثم كان البعض يتخذون منها موقفًا مضادًّا على اعتبار أنها ستخلق حربًا بين الأجيال، خاصة من طرف الكنيسة. كما استمرت هذه المقاومة إلى القرن السابع عشر، حيث فطن “لويس الرابع عشر” بدوره إلى خطورة الكتابة والنشر، التي أتاحتها المطبعة، ومن ذلك الفوضى الأدبية في النشر التي قد تنجم عن هذه المطبعة، حيث سيتمكن كل من هبَّ ودبَّ من النشر والكتابة، ومن ثم تخريب العقول، وإيجاد الفوضى، وتشويه صورة الأدب.. ولذلك سينتدب بعض الأدباء والمفكرين لحماية الثقافة، ومنهم “موليير” في الكوميديا، و”راسين” في التراجيديا.
هذا القمع القائم على الخوف من الكتابة الشعبية والكتابة المخالفة للسياق الجمعي وما أسموه فوضى الثقافة، دام في جميع الثقافات بما فيها العربية التي قامت بإحراق وإتلاف العديد من المؤلفات والكتب العظمى، لا سيما منها بعض الكتب الفلسفية والصوفية.
واليوم فرض الحاسوب على الإنسان أن يبتدع طريقة جديدة للكتابة وهي الكتابة الرقمية، حيث أصبح الكل باستطاعته أن يكتب وينشر كيف شاء على الحاسوب، وأصبح من يمتلك حاسوبًا، شبيهًا بمن يمتلك مطبعة ودارًا للنشر، وأصبح بإمكانه أن ينشر ما نشره ويوجهه إلى جميع القراء في العالم في ثوان معدودة. ومن جهة أخرى أصبح قادرًا على نشر نُسَخ لا محدود، ومن ثم ستتلاشى ترهة نفاد النسخ التي كنا نسمعها.. كما ستتلاشى فكرة أن الكتب الجيدة هي التي تقرأ، حيث بإمكانك أن تنقر في بعض المكتبات الإلكترونية فتجد أردأ رواية قرئت ملايين المرات، في حين رواية كنا نسميها عالمية قرئت بضع مرات في العالم طبعًا.
إن هذا الفتح الجديد -إن صح التعبير- يومئ إلى أننا خلال عقود قليلة قد نتخلى -شئنا أم أبينا- عن الكتاب الذي قد يصبح في يوم من الأيام أثرًا من المآثر، وتحفة من التحف شبيهة بالتحفة الطينية التي ضمت ملحمة “غلغامش”. ونجد الكثيرين اليوم كما وجدوا من قبلُ عند اكتشاف الكتابة الرموزية أو اكتشاف المطبعة، يعارضون هذا النموذج للكتابة على اعتبار أنه مجمع للأخطاء والهفوات التي تنتشر بسرعة عبر الإنترنت. كما أنه يحد من الإبداع حسب البعض الآخر، بل إن العديد من الأكاديميين الذين لم يفتحوا أعينهم على الحاسوب والإنترنت، يرون في الكتاب الرقمي والمراجع الرقمية وثائق غير علمية لا تستحق الاستشهاد بها في البحوث والأعمال العلمية.
هذه المقاومة التي نجدها اليوم طبيعية جدًّا، لأننا أمام طفرة جديدة شبيهة بطفرة اكتشاف الكتابة نفسها كما يذهب إلى ذلك الباحث المغربي “محمد أسليم”، وهو تحول لا يحدث إلا مرة في عشرات القرون، ولا بد أن يصنع المفاجأة والدهشة، خاصة في الدول النامية التي لم تستطع بعد مواكبة التغيرات التكنولوجية، التي فرضت نفسها فرضًا، والتي أصبحت تهيمن على الاقتصاد والطب والسياسة وغيرها. ولعل التحولات التي نجدها في التربية، خير دليل على هذا التحول الكبير.
فإذا كان التعليم في كثير من الدول النامية يعتمد -حتى الآن- على الكتاب المدرسي الورقي باعتباره المرجع الأساس الذي يفرض على المدرس والمتعلم معًا التوفر عليه وإحضاره والاشتغال عليه في الفصل، حيث نجد أحيانًا المحفظة أثقل من التلميذ حين تصل المواد إلى سبع أو ثمان في بعض المستويات، فإن الدول المتقدمة قد استبدلته منذ سنوات بالحاسوب، خاصة في اليابان، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، وبعض الدول العربية(٣).
لقد استغنت كوريا الجنوبية -مثلاً- عن الكتاب في التعليم منذ ٢٠١١م، وفرضت بدلاً منه اللوحةَ الإلكترونية، حيث يملك كل تلميذ جهاز تابليت (Tablette) يوفر له كل شيء، ويحميه من مغبة نسيان الدفتر والكتب المدرسية، ومن الصعوبات المرتبطة بحملها والتنقل بها من مكان إلى مكان، ويتيح له التعامل مع كل الوثائق والمراجع التربوية التي قد يطلبها المدرس.. كما تهيئه للتعامل مع المعلومات والإنترنت في وقت مبكر، ومن ثم المساهمة مستقبلاً في تطوير هذا الحاسوب وتطوير العلوم التكنولوجية. وهذا النهج سارت عليه كثير من الدول.
والواقع أن إدخال التقنيات التكنولوجية، وتعميم الحاسوب والإنترنت على كل المؤسسات التعليمية في الدول النامية، ضرورة لا بد منها في المستقبل. ومن ثم على الدول العربية أن تبادر جميعها إلى إعادة النظر في طرق ومناهج تدريسها، وكذا في وسائلها التعليمية. فالانخراط في عصر المعلومة والمعلومات، يفرض ذاته اليوم على الجميع، والبقاء في الهامش هو حاجز كبير نحو التقدم تتعدد مغباته مستقبلاً. ومن ثم فاستباق عملية التعامل مع التكنولوجيات الحديثة التي تتطور باستمرار وبشكل رهيب، يجعلنا نتحكم فيها ونوجهها الوجهة الصحيحة، في حين أن التخلف عنها سيجعلها تتحكم فينا وتوجهنا وترهبنا كذلك. وتبقى المدرسة هي السبيل الوحيد لتربية الأجيال على المعلومات وتوجيههم للمواءمة بينها وبين الكتاب وتربية ذوقهم الفني على الجمع بين المعاصرة والتراث.
وأخيرًا، فإن تطور الكتابة وحواملها من الوسائل البدائية إلى الوسائل التكنولوجية المتقدمة التي أنتجت الكتابة الرقمية، هو عنوان على تطور تمثلات الإنسان للعالم، وتطور مداركه نتيجة البحث العلمي المتواصل.. وسؤال نهاية زمن الكتاب ليس سوى سؤال علمي مشروع ضمن أسئلة كثيرة يطرحها العلماء الذين يرون في التطور السريع والمستمر للتكنولوجيا اليوم، رهانًا على إبدالات جديدة (New Paradigms) لا ندري حدودها أو منتهاها.
(*) كاتب وباحث مغربي.
الهوامش
(١) https://drgawdat.edutech-portal.net/archives/13552
(٢) الكتابة على ورق البردي عند المصريين: https://mawdoo3.com، (١٥ نيسان ٢٠٢٤م).
(٣) https://al-ain.com/article/the-march-of-education-in-the-uae-46-years-space