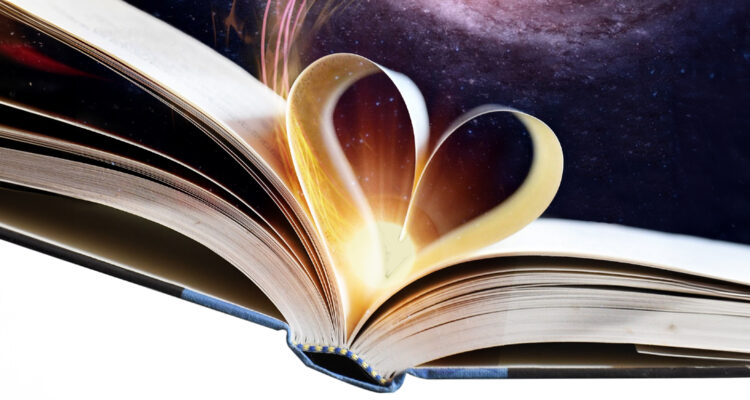يرى البعض أن العلم والأدب نقيضان لا يجتمعان.. بينما يرى آخرون أنهما جناحان لا غنى عنهما للعروج الحضاري؛ فالعلم يهيمن على الماديات والحرف وعمران الحجر، بينما يعنى الأدب بالمعاني والأفكار وعقول البشر. إذن، كيف يمكن المقاربة بين رؤى الفريقين؟
للعلم موضوعيته وتجريداته، وللأدب ذاتيته وإلهاماته.. وللعلم نظرياته وحقائقه، معادلاته ورياضياته، مصطلحاته ومختبراته، كيمياؤه وفيزياؤه، ذراته ومجراته، أحياؤه وجيناته، رموزه وآثاره العقلية والتقنية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة.. في حين أن للأدب عالمه الخاص من العقائد والآراء، والدوافع والمشاعر، والأفكار والثقافات، عالم التواصل الشفهي والكتاب، عالم اللغات وإيحاءاتها وتلميحاتها، وغموضها ووضوحها، وشعرها ونثرها، وجميلها وبديعها، وآثارها المتنوعة فكرًا ووجدانًا، ثقافة وعرفانًا. وللعلم طرائقه في البحث ونهجه في التفكير، سواء أكان موضوعه الفيزياء أو التاريخ، الطب أو الفلسفة أو غيرهما.. بينما الأدب رحمٌ منه يولد الناس، ودنيا فيها يعيشون ويكبرون، يفرحون ويحزنون، يبدعون ويجسدون، يحلمون ويتطلعون، ثم يموتون.
ولقد ظن البعض أن دارس العلم عالم، ومن درس الأدب أديب، لكن شتان بين الدراسة والممارسة. فعبر حضارتنا كان -وما زال- لدينا أطباء ومهندسون وكيمائيون، يُقرضون الشعر، ويكتبون المقال والقصة والرواية والمسرحية، ويبدعون في الفنون التشكيلية.. كما يوجد مفكرون وأدباء وشعراء وفنانون، لهم أياديهم وأفكارهم ومدارسهم ودراساتهم العلمية. بل في ضوء النظريات المعرفية الحديثة تقرر -ما سبق إليه فحول حضاراتنا- أن ما يسمى بالعلوم الإنسانية، هي علوم ينطبق عليها نفس المنهجية الصارمة للعلوم التجريبية. ولعل تجربة “الفراهيدي” و”سيبويه” أبلغ شاهد في هذا المضمار. فالاثنان نظرا في الآثار الأدبية نظرة العالم الباحث عن القوانين الدينامية التي تقف خلف عمل النظام، فأنتج الأول علم العروض، وأبدع الثاني علم النحو، وكلاهما علمان صرفان يخضعان للمنطق الرياضي. في حين أن هناك من لا يزال يدرس (المقالة النقدية) كضرب من ضروب الإبداع الأدبي، لها سماتها الإبداعية الخالصة، ولا تنتمي بصلة إلى العلوم الصرفة.
ويلاحظ أن العقل الإنساني غير محدود بقدراته وإدراكاته، وما يمكن للإنسان أن يتقنه في حياة واحدة. فالمرء يمكنه إتقان أكثر من لغة، ويتبحر في علوم ونحويات وبلاغة لغته الواحدة الخاصة، ويتقن في الوقت ذاته أصول الحساب والجبر والرياضة العقلية، وبالتدريب والممارسة يمكنه إتقان علوم مختلفة.
فلقد أنتجت حضارتنا العربية الإسلامية علماء عباقرة موسوعيين، لم يكن لديهم قطيعة بين كيمياء وفلك وحساب وطب، وبين فكر وفلسفة وشعر وأدب؛ كـ”الرازي” الطبيب الفيلسوف، و”جابر بن حيان” أبي الكيمياء، و”الزهراوي” أبي الجراحة، و”ابن سينا” الشيخ الرئيس، و”ابن البيطار” أعظم عباقرة الأعشاب والنباتات والصيدلة، و”ابن النفيس” إمام الطب، و”ابن الهيثم” أميــر النــور والبصريات، و”عباس بن فرناس” أول طيار في التاريخ، وصولاً إلى “إبراهيم ناجي”، و”أحمد زكي”، و”رشدي راشد”، و”مصطفي محمود”، وغيرهم كثير.. كما يوجد “الكندي” فيلسوف فلاسفة العرب، و”الفارابي” المعلم الأول، و”أبو الريحان البيروني” العالم الموسوعي، و”الخوارزمي” أول من اخترع الصفر، و”الإدريسي” مؤسس علم الجغرافيا، و”ابن بطوطة” أمير الرحالة.
لقد كانوا في مختبراتهم، ومشافيهم، ومعاهدهم وجامعاتهم، يمزجون ويختبرون، يشرّحون ويعالجون، يدرسون ويحاضرون.. كما نراهم في مكاتبهم ومكتباتهم يحللون الكلمات والعبارات، ويستخرجون المعاني والتصنيفات، ويصوغون الرؤى والفلسفات، ويبدعون الأشعار والقصص والروايات.
لا جفوة ولا جفاء
ينبغي الاهتمام الكافي بالعلم باعتباره قيمة اجتماعية وسمت نهضوي، حيث كان يتم الاهتمام بالتقنية والتكنولوجيا والاستيراد والاستهلاك أكثر من العلم والتنظير والإنتاج والتصدير، أو بالأبحاث التطبيقية أكثر من الأبحاث العلمية النظرية، لأن مفهوم العلم كان -وما زال- تطبيقيًّا. إن الحلول للمشاكل المجتمعية المتنوعة تكون إبداعية بقدر ما يتوافر فيها الأصالة والمرونة والطلاقة، ومن هذه العناصر -أيضًا- يمكن فهم عملية الإبداع الأدبي؛ فعلى الأديب توظيف الأدوات العلمية بمرونة، وتكريس الآليات الابتكارية بطلاقة لينتج عملاً مبتكرًا وفنًّا أصيلاً.
وثمة محاولات للوصول إلى علم متكامل يفسر كل الظواهر الجمالية في الأدب، بينما يبقى على الأديب السعي حثيثًا، للكشف عن كل القوانين الحركية التي تفعل فعلها في صنع الجمال الأدبي. مهمة لا يمكن الوصول إليها إلا باتباع سبل البحث العلمي الصرفة المعتمدة على الرياضيات والمختبر. ويذهب “زكي نجيب محمود” في مقال له ضمن كتابه “مجتمع جديد أو الكارثة”، إلى أن: “التقاء الأدب بالعلم، إنما هو التقاء غير مباشر عن طريق إدخال التطبيقات العلمية وأسلوبها في شرايين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، دخولاً يُحيل تلك الحياة علمًا مُجسدًا”. ثم يضيف: “بعدئذ يجيء العالم لينفعل بالحياة المحيطة به على ما هي من صبغة علمية، فيتأثر بها وينفعل فيبرع ويُثري”.
فصفة العلمية صفة منهجية بمعايير معينة، إذا توفرت في التفكير أصبح علميًّا بغض النظر عن موضوع البحث. وجاء في “موسوعة لالاند الفلسفية: “العلم هو مجموعة معارف وأبحاث على درجة كافية من ناحية الوحدة والعمومية، ومن شأنها أن تقود المشتغلين بها إلى استنتاجات متناسقة، لا تنجم عن مواضعات ارتجالية ولا عن أذواق أو اهتمامات فردية تكون مشتركة بينها، بل تنجم عن علاقات موضوعية تكتشف بالتدرج وتتأكد بمناهج تحقق محددة”. وليس من شك في أن التخصص الدقيق في فروع العلوم والمعارف، يفرض عدم إمكانية تجاوزها بغير تعلمها وإتقانها والتبحر فيها، وتبسيطها ونقلها لغير المتخصصين. وفي نفس الوقت هناك ضرب من أصول الفكر والعلم، الذي يعتمد العقل الذي هو مناط البحث والتحليل والتفكير، وهو الفلسفة المقرونة بالثقافة الواسعة.
فالمعماري المتخصص تخصصًا دقيقًا في التصميم الحضري، لا يمنعه مانع من التثقيف والمثاقفة والإلمام بتاريخ العمارة ونظرياتها، أو تاريخ الفن والأدب عمومًا، إلمامًا يقترب من دائرة تخصصه. كل هذا مقرون بتملك ذهنية برهانية تحليلية تعتمد العقل والمنطق في القراءة والتحليل. وذات الأمر ينطبق على متخصص في علوم الطب والتشريح وعلوم الأدوية، فلا يمنعه مانع من الإلمام بفروع من الطب أو العلم أو الثقافة تقع خارج دائرة تخصصه العام أو الدقيق، وهكذا. ولعل مشكلة العلم والأدب في الثقافة العربية، هي إشكالية مرتبطة بجوانب الحياة وتنظيماتها المتنوعة. يدلل الواقع على أن العلم والأدب لا يتقدمان ويبدعان إلا في ظل مؤسسات ومحاضن فكرية واقتصادية واجتماعية وتعليمية وإعلامية متعافية.
ولنا وقفة مع الشاعر “معروف الرصافي” ، وهو يدلي بدلوه فيقول في قصيدة له منها:
أدب العلم وعلم الأدب***شرف النفس ونفس الشرف
بهما يبلغ أعلى الـــرتب***كــل رام منــهـــما فــــي هــدف
أيها السابح في بحر الفنون***غائصًا في لُجّها المتلــطِّم
قرنك الحاضر من أرقى القرون***خضع السيف به للقلم
فالمعالي أودعت في الكتب***كاللآلي أودعت في الصَدَف
إنها دعوه لمشاركة أهل الاختصاص والبحث العلمي في الحياة الثقافية كتفًا إلى كتف مع نظرائهم من أهل الأدب، فيزيدونها تراكمًا على تراكم. إنها دعوة لإيجاد لغة مشتركة بين العلم والأدب يستفيد منها العامة، بحيث لا يبقى التخصص حكرًا على أهله حبيسًا عليهم يختفي باختفائهم.
إن اجتماع الأدب بالعلم، يقلل من جفاف النظرية العلمية وينشرها للعامة، كما أن العلم يكشف خفايا نفس الأديب شاعرًا أو ناثرًا أو فيلسوفًا، ويفسر سبب بروزه وتميزه وتأثيره على مجتمعه. إذن، على كل علم أن يصبح فنًّا، وعلى كل فن أن يصبح علمًا. فاللقاء الرائع، لقاء العلم بالأدب (علم الأدب، وأدب العلم)، والصفاء والوئام بينهما يمهد لثقافة العروج بجناحين، ولا ينهض مجتمع أو يرتفع شأن أمة، إلا بهما معًا.
(*) كاتب وأكاديمي مصري.