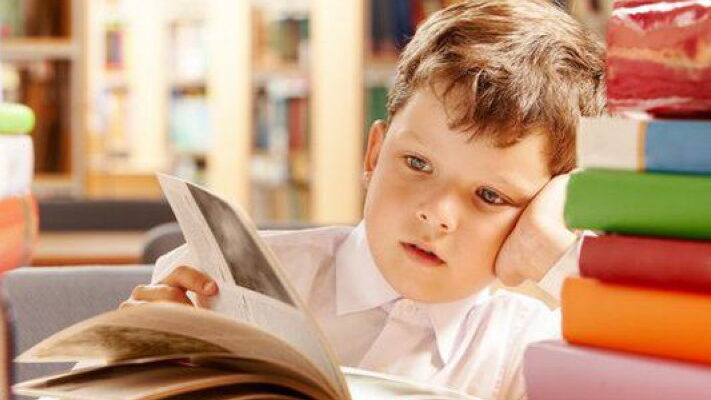إنَّ القراءة هي إحدى الوسائل المهمة لاكتساب العلوم المختلفة، والاستفادة من منجزات المتقدمين والمتأخرين وخبراتهم. وهي أمر حيوي يصعب الاستغناء عنه لمن يريد التعلم، وحاجة ملحَّة لا تقل أهمية عن الحاجة إلى الطعام والشراب. ولا تقدُّم للأفراد فضلاً عن الأمم والحضارات بدون القراءة؛ فبالقراءة تحيا العقول، وتستنير الأفئدة، ويستقيم الفكر، والقراء المنهجيون هم في الغالب النخبة المتميزة، والصفوة المؤثرة في التكوين الفكري والبناء الثقافي والمعرفي للأمة، ولهذا كانت العناية بالقراء عناية بروح الأمة وقلبها الحي النابض القادر على البناء والعطاء.
فالقراءة تشكل وعيًا جديدًا، وتصيغ إنسانًا حديثًا، فتتغير بالقراءة مفاهيمه وتتحسن تصوراته، وتضيء مبادئه، ويتسع أفقه، وتحسن أخلاقه، وتصلح طباعه، وينتقل من العطالة للفاعلية والعطاء، ومن الهدم للبناء، ومن الظلمات للنور، وتغير من تطلعاته وهمومه واهتماماته ليساهم في بناء أمته.
ومن أعجب الظواهر أن تجد عددًا من القراء ممن يلازمون الكتاب ويأنسون بالقراءة في ليلهم ونهارهم، ثم تطالع أحوالهم، وتنظر لحياتهم بعد عدة سنوات، فلا ترى تغيرًا في حياتهم، ولا تقدمًا في ذاتهم ولا في فكرهم، نعم قد تجد تغييرًا، لكن تغييرًا طفيفًا لا يستقيم مع ما يبذلونه من جهود في سبيل العلم والمعرفة.
أين ذهبت الكتب التي يقرؤونها، وأين أثر الثقافة التي يتلقونها، وأين تأثير الأفكار التي يتصفحونها؟ هل ذهبت سدى، وهل ضاعت جهودهم دون فائدة تذكر؟ هل كانت تلك الجهود التي يبذلونها في المطالعة والمعرفة أضغاث أحلام لا أثر لها في دنياهم؟
لقد جرت العادة أن لكل غارس ثمار لما غرس، ولكل زارع حصاد لما زرع، فأين أثر ذلك الغرس؟ وأين ذهب حصاد ذلك الزرع؟ هل كانت البذور فاسدة؟ أم أداء الغارس تالفًا؟
لقد كان الطالب في عهد السلف ما أن يطلب العلم إلا ويظهر أثر العلم في قوله وفعله وسلوكه وتعبده، فينقله العلم من واد إلى واد آخر، فتتشكل شخصيته وتتغير طباعه وتتحول وجهته، لتحدث له ولادة جديدة، تتغير فيها ملامح حياته عبر ما نال من العلم النافع، فما فائدة الشجر إن لم يكن لها ثمار، وما فائدة الجهد الذي نبذل في الغرس والسقي والمعاهدة إن لم يكن لتلك الشجر آثار تعود على الغارس؟
ومن يتأمل هؤلاء الذين لا ينتفعون بالقراءة سيجد أن سر ذلك في أربعة أسباب:
أولاً: القراءة الغير المنظمة؛ فالقراءة لا تعطي للقارئ ثمارها، ولا يقطف منها أثرها إلا إذا كانت منظمة، فالبعض يقرأ كتابًا من الشرق وآخر من الغرب دون أن يكون بينهما رابط يربط بينهما، أو يقرأ فصلاً من كتاب دون أن يتمه، ثم ينتقل لفصل آخر من كتاب آخر، فتكون قراءته مبعثرة ليس لها نظام معين فتجده يضيع الأوقات في المطالعة العشوائية، ليس عنده منهجية وتنظيم لعملية القراءة والتثقف الذاتي، فالقراءة المنظمة مثل الخطط التنموية التي تضعها الدول المتقدمة لعمران مدنها، فبعد عدة سنوات ترى فرقًا شاسعًا بين شكل مدينة في الماضي وشكلها في الحاضر.
ثانيًا: التركيز في قراءة مجال واحد من مجالات القراءة التي في الغالب لا تنفع من يقتصر عليه فقط، مثل من يقتصر في قراءته على قراءة الروايات بمختلف أنواعها، أو يقتصر على الفكر الغربي فقط دون أن يهتم بالفكر العربي، أو يهتم بالشعر دون أصناف الأدب الأخرى، فمن يقتصر على نوع واحد من القراءة مثل من يقتصر على نوع واحد من الطعام فيولد في جسمه خللاً، ويضعف أجهزة جسمه عن الأداء الحسن، وكذلك الاقتصار على نوع من أنواع المعرفة ينتج خللاً في حياة المرء وفكره وثقافته وتشويشًا في تكوينه العقلي وتشويهًا في رؤيته.
ثالثًا: ضعف الجدية في القراءة، فمن يقبل على القراءة بعدم جدية لا ينال منها الثمرة المرجوة، فالقراءة لا تنفع صاحبها إلا إذا أقبل عليها كما يقبل الطالب على مذاكرة دروسه النظامية حفظًا ومراجعة وتلخيصًا ومناقشة مع معلميه وزملائه، وينتقي خير أوقاته للمطالعة، فلا يقرأ وهو شارد الذهن، وبعد المطالعة يفكر فيما قرأ لينظر ماذا أضافت له تلك الساعة التي قرأها، فالتفكير ينقح المعرفة ويجود الأفكار، فمن يتعامل مع القراءة على أنها رحلة أو نزهة لا يفكر فيما يقرأ ولا يكتب ما استفاد ولا يلخص أهم المعلومات ولا يناقشها مع القراء لن يحصد من القراءة الثمرة الناضجة شيئًا يذكر.
رابعًا: ضعف الإنتاج المعرفي؛ فالمعرفة لا تصير ملكة لصاحبها ولا تصبح له مهارة إلا إذا استطاع صاحبها صياغتها في شكل إنتاج معرفي: تدريسًا ومناقشة وتعليمًا وتأليفًا بشتى صوره، فالإنتاج المعرفي يعمل على الرسوخ العلمي للقارئ، وتصبح المادة العلمية والمعرفية حاضرة في الذهن، ومؤثرة في حياته، مما تجعله قريبًا من الآثار النافعة للعلوم والمعرفة، فالإنتاج المعرفي يجعل صاحبه يمارس ما تعلَّم ويزاول ما اطلع عليه، فتقترب المعرفة من نفسه، حتى تخالط ذاته وتؤثر في نفسه وتفكيره وسلوكه وشعوره.