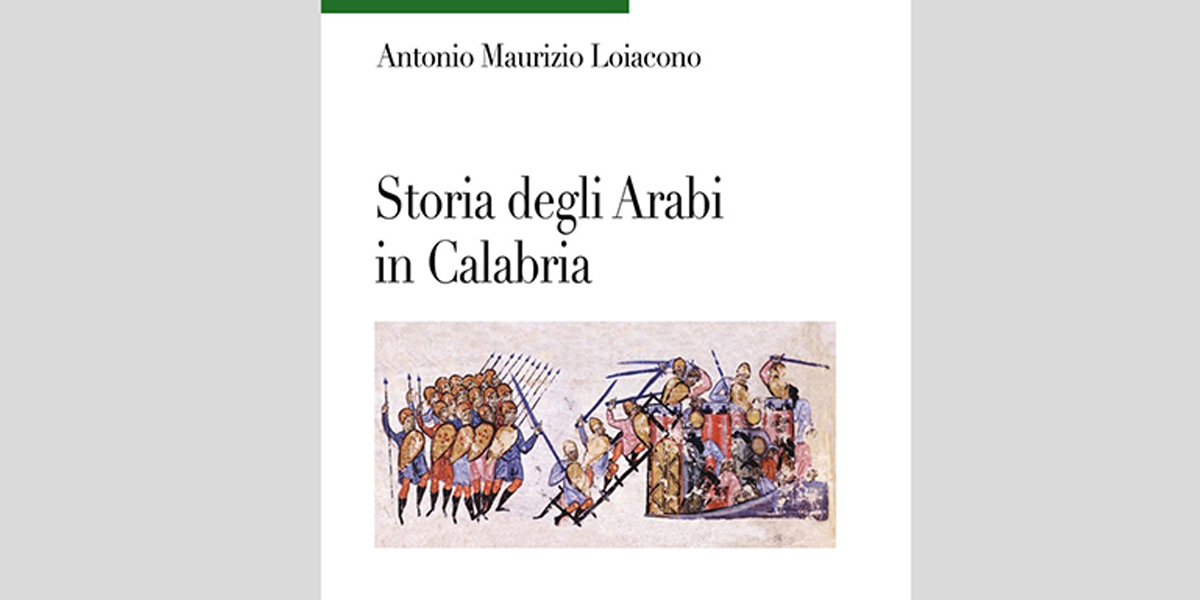يشكو البحث التاريخي المتعلّق بالفترة الإسلامية في إيطاليا، بوجه عامّ، من حالة من غبن، متأتية بالأساس من وهن التكوين اللغوي في اللسانين العربي والإيطالي من الجانبين، وهو ما مثّل ساترًا وحائلاً بين الطرفين. لكن إيطاليا تبدو قد فطنت لهذا العَوَر بشكل يفوق ما عليه الحال من الجانب العربي، وتسعى جاهدة لتفادي هذا النقص، وذلك عبْر ما نشهده من تشجيع موجة الاستعراب الإيطالي سيما في أوساط جيل الشباب الذي بدأ يشقّ طريقه بإصرار في تعلّم العربية، سواء ضمن التكوين الجامعي أو خارجه، وهو ما لم يخل من مصاعب وأحكام مسبقة ترهق الدارس أحيانا.
فبوجه عام غالبًا ما ينحصر تاريخ العرب في إيطاليا في أذهان كثيرين بحيز جزيرة صقلية، والحال أن امتداد الحضور العربي أوسع من ذلك التصوّر. فقد شمل امتدادُ الحضارة العربية إقليمًا مهمّا من أقاليم إيطاليا وهو المعروف بـ”كالابريا”، وهي المنطقة الجنوبية الواقعة بين جزيرة صقلية ومنطقة باري. فبالصعود قدمًا نحو شمال إيطاليا نصادف تجارب متفرّدة من ذلك الحضور. إذ احتضنت منطقة بوليا قاعدةً تاريخيةً أخرى للحضارة الإسلامية، مع ما يُعرف لدى المؤرخين الإيطاليين بـ”إمارة باري”، بقيادة خلفون الأمازيغي. وقد نالت الإمارة اهتمامًا معتبَرًا من قِبل أستاذ التاريخ الوسيط جوزوي موسكا (1928-2005) في أبحاثه، ونشر عملاً مهمّا في الشأن. تمّ ذلك حوالي 847م، حتى وإن كان المفرّج بن سلام، الأمير الثاني خلال الفترة القصيرة بين 853م و 856م، هو من وطّد دعائم الإمارة وطلب ولاية الحكم: ليس من الحاكم الأغلبي، خلال الفترة التي كانت فيها صقلية تابعة للدولة الأغلبية في تونس، بل مباشرة من دار الخلافة في بغداد. لاحقًا شهدت الإمارة إبان عِقدها الأخير تحولاً، أي إلى تاريخ 871م، وذلك مع سدوان، المعروف بغاراته الكاسحة التي استهدفت المنطقة. تعلّق الأمر بإحدى القلاع الإسلامية القليلة والخاطفة، إذ فضلاً عن الفتح الموفّق لصقلية، أقيمت مستوطنات أخرى بترانتو، وغاريليانو في جهة الشمال، وفي فورميا وغايتا. ناهيك عن التاريخ الخاص لإمارة لوشيرا، حيث تحوّل المسلمون في ظرف عقدين من أقلية إلى أغلبية على مستوى عدد السكان، ولكن لم يتبقّ للمسجد الذي أقيم أي أثر، وإن كان المركز الرئيس.
الكتاب الحالي الذي نتولّى عرضه “تاريخ العرب في كالابريا“، هو مؤلف من إعداد أنطونيو ماوريسيو لوياكونو، وهو باحث إيطالي مهتمّ بالحقبة الوسيطة من تاريخ إيطاليا، فضلاً عن كونه أصيل منطقة كالابريا وعلى دراية جيدة وإلمام عميق بطبوغرافية المنطقة وتاريخها، ناهيك عن كونه خبيرًا في الشؤون الأثرية بالجهة. الكتاب الحالي متفرّد من حيث الاشتغال على الجانب الحضاري والأثري والتاريخي للمنطقة في حقبة الوجود العربي في إيطاليا، وهو من الأعمال المهمّة والشاملة في الشأن. حاول صاحبه الإتيان على كافة مظاهر الحضور العربي في الإقليم، من الآثار المادية إلى الألفاظ اللغوية المتخلدة في لهجة متساكني الجهة، وهو ما يجعل الكتاب مرجعًا مهمّا في مجال من مجالات التوسع الحضاري الإسلامي.
قسّم الباحث بحثَه إلى ثلاثة أقسام رئيسة، حيث جاء القسم الأول بمثابة إطار تاريخي للحديث عن كالابريا وعن الفتح الإسلامي. تلاه قسم ثان تحدّث فيه أنطونيو ماوريسيو لوياكونو عن الأطوار التي مرت بها كالابريا مع الحقبة البيزنطية ثم مع الفتح الإسلامي، ناهيك عن تخصيص حيز واسع للأسرة الكلبية الحاكمة في الجهة وإلى حين تراجع النفوذ العربي ومجيء النورمان. أما القسم الثالث من الكتاب فقد ركّز فيه الباحث على جرد الآثار المادية للمنطقة مع بيان تنوعّها، مستعرضا ما خلّفه العرب في شتى المجالات العمرانية والهندسية والفنية والزراعية، ثم خصّص حيزا ضمن هذا القسم للحديث عن الحضور البارز للعربية في اللهجة المحكية لكالابريا.
التاريخ والأسطورة
أطلّ الحضور العربي في كالابريا منذ القرن التاسع للميلاد، في فترة كانت فيها المنطقة تحت سلطان الدولة البيزنطية. ويرد في إحدى الروايات أن أول مجيء للعرب إلى المنطقة كان مع ظهور سفينة عربية في عرض البحر قبالة كالابريا، حصل ذلك في الرابع عشر من يوليو سنة 650 ميلادية، حين اقتربت سفينة تابعة للسّراسِنة (المسلمين) من شاطئ تاوريانه. وقد ورد ذلك في يوميات بطرس أسقف المدينة، حيث اندلعت عاصفة هوجاء فجأة، صرّح على إثرها المتابعون للحدث أنها كانت بفعل بركة من بركات القديس سان فانتينو العجوز.
لقد مثّلت غارات العرب على المنطقة تهديدًا متكررًا. ففي إحدى الغارات التي تعود إلى العام 812م، تروي أسطورة أن القدّيس فاوستينو دي سيراكوزا، وقد عاش قبل خمسة قرون واجترح معجزات، قد ظهر على الشاطئ بين الصواعق والعواصف ليغرق سفن الخصم في أكثر من مناسبة. بشكل فعلي، منذ ما يزيد على ألف سنة، سنة 902م، حقّق إبراهيم الثاني، بعد أن اجتاز مضيق مسّينا، نصراً حتى وإن كان دخوله إلى ريجيو كالابريا خاطفاً، إذ توفّي على إثر ذلك خلف أسوار كوسينزا، أثناء متابعة حملته العسكرية، دون أن يستقرّ له مقام في غزواته على البرّ. لاحقا، سنة 950م، علا في ريجيو كالابريا أول مسجد، حتى وإن كان مسجدا خاطفا، إذ استمرّ قائما مدة أربع سنوات. وأيضا سنة 986م، كما دوّن مؤرّخ عايش تلك الحقبة: “سقطت المدينة المقدّسة شيراكو بأيدي العرب وعاثوا فسادا في كالابريا”. كما غامر بعد خمسمائة سنة أيضا الأميرال المعروف خيرالدين بربروس، فقد قام بإنزاله في ريجيو كالابريا رفقة اثني عشر ألفا من رجاله، وحاصر المدينة وحمل معه زهاء الألف أسير، كانت من بينهم ابنة دياغو غايطاني، حاكم المدينة، التي تزوّجها لاحقا.
وتكشف الوقائع التاريخية أن أول مظهر من مظاهر الحضور العربي في كالابريا كان بوساطة التجارة، ليتطوّر مع مرور الوقت إلى توغل في النسيج الاجتماعي. فقد كان مقدم العرب إلى كالابريا في البدء مصلحيا نفعيا، بدا ذلك جليا في انتشار التقنيات والمعارف الجديدة التي مسّت جوانب اقتصادية مثل الريّ والحِرف والخزف، بما أدخل تحويرا جليا على العوائد الاجتماعية والإنتاجية. هذا وإلى حدود النصف الثاني من القرن الحادي عشر، حين احتل النورمان كالابريا، كانت المنطقة تُعدّ بمثابة الحد الفاصل بين الشمال المسيحي والجنوب الإسلامي، وبين الشرق البيزنطي والغرب المغاربي، فقد كانت كالابريا نقطة وصل وفصل بين عديد القوى النافذة في المتوسط.
وبشأن تفسيرات دواعي حضور العرب في كالابريا يرد في الشأن، بعد تواجد العرب في بالرم (باليرمو)، وجد الدوق أندريا دي نابولي (834-840 م) نفسه محاصرا من طرف قوات الأمير اللونغوباردي شاردو (832-839 م)، الذي هاجم مدينة برتينوبيا بحثا عن منفذ على البحر التريني. قرّر قنصل نابولي الاستنجاد بعرب باليرمو الذين تدخلوا في الصراع، وهكذا أبعدوا الخطر اللونغوباردي، ومن هناك بدأ التوغل العربي في المنطقة.
الاستشراق الداخلي والاستشراق الخارجي
نشير في الأثناء أن ثمة تقليدا سائدا في الدراسات التاريخية الإيطالية الحديثة والمعاصرة، انشغل تحديدا بالحضور العربي الإسلامي متتبّعا تغيّر أشكاله وتبدّل أوضاعه، حاول ألاّ ينحصر بالجنوب، بل كثّف أبحاثه في شتى أرجاء إيطاليا وامتدّ إلى أقاليم واقعة في الوسط والشمال، حيث لم يكن ذلك الحضور العربي نفوذا عسكريا وتسييرا سياسيا فحسب. وهذا التقليد السائد في الدراسات التاريخية يمكن أن نطلق عليه “الاستشراق الداخلي”، وقد شهد تطورا بيّنا سيما في العقدين الأخيرين، وتركّز اهتمامه في الفترة الإسلامية وما بعدها مع مجموعة من الباحثين منهم ماركو برانكو، وأميديو فينييللو، وأليكساندرو فانولي. في مقابل ذلك الاستشراق الداخلي نجد “استشراقا خارجيا” ارتبط بهواجس التوسع الاستعماري والتطلع إلى إنشاء مستعمرات في إفريقا والشرق، كان من أبرز أعلامه: ميكيلي أماري (1806-1889) أبرز المعنيين بهذا التفرع التاريخي سيما من خلال كتابه المعروف “تاريخ مسلمي صقلية” الصادر في ترجمة عربية في فلورنسا 2003. إذ سرعان ما دبت لوثة السياسة في الاستشراق الإيطالي وغدا عينا ودليلا للتوسع الاستعماري، حيث انضمّ ثلة من آباء الاستشراق الإيطالي إلى “لجنة المصالح الاستعمارية المكلّفة بالشؤون الإسلامية” سنة 1914، منهم ليونه غايطاني وكارلو ألفونسو نللينو، وإغناسيو غوديي، وكونتي روسيني، ودافيد سانتيلانا، وهذا الأخير هو تونسي يهودي الديانة عُيِّن سنة 1913 أستاذ التشريع الإسلامي في جامعة روما. وقد أورد الباحث فلافيو ستريكا في بحث بعنوان: “كارلو ألفونسو نللينو ومشروع احتلال ليبيا“، في مجلة “حوليات” التابعة إلى كلية العلوم السياسية في كالياري سنة 1983، أن المستشرق نللينو قد شارك في مجمل الاجتماعات واللجان التي قدّمت المشورة للمستعمر بشأن القضايا الإسلامية إبان احتلال ليبيا.
ما يكشف عنه البحث الأثري الحالي في كالابريا أن كثيرا من المعالم العمرانية العربية قد توارت. حيث هُدّمت العديد من المساجد أو جرى تحويلها إلى كنائس، تشهد على ذلك العديد من البنايات القديمة في كالابريا التي تحمل هندسة عمرانية شرقية جلية، وتنتشر أمثلة من تلك الأبنية في تروبيا وسكاليا وكوسينزا وكاتنزارو. كما نجد العديد من فضاءات العبادة التي تعود إلى حقبة النورمان تتضمّن عناصر معمارية وزخارف متأتية أو مستوحاة من الثقافة الإسلامية. كما هو الشأن في كنيسة ماريا ديل باتير بمنطقة روزانو، وأيضا في كنيسة سانتا ماريا داي تريدينتي وكنيسة سان جوفاني تريستيس. وأما اللقى الأثرية الفخارية التي تعود إلى الحقبة العربية فهي وفيرة في الجهة، وهي إما من إنتاج خزفي محلّي أو مستورَدة من أصقاع العالم الإسلامي.
الآثار الفيلولوجية
ومن ضمن الآثار الباقية يخصص الباحث فصلا مهمّا للآثار اللغوية العربية في لهجة كالابريا المحلية الراهنة، وهو كمّ لغوي ثري ومتنوع، يمسّ عديد المجالات العلمية والاجتماعية والاقتصادية. ففيما يتعلق بالكيل والوزن نجد مفردات عدة منها: “كنتارو” (قنطار)، و”كافيزو” التي تعني (قفيز) بالعربية، ونجد “روطولو” التي تعني (رطل)، و”تومانو” التي تعني (ثمنة). أما في المجال الزراعي وهندسة الري فنجد وفرة هائلة في المصطلحات منها “فورا” التي تعني (فورة) الماء، و”جابيا” التي تعني (الجابية) و”مركاتو” التي تعني (المرقد) المخصص للرعاة والخدم، و”مرجيو” التي تعني (المرج)، و”سينا” التي تعني (السانية) و”زرفاتا” التي تعني (الزريبة). أما في مجال علم النبات فنجد “كرّوبا” التي تعني (الخروب)، و”كوتوني” التي تعني (القطن)، و”جونجولانا” التي تعني حب (الجلجلان)، و”زاهارا” التي تعني (زهر) البرتقال و”زبيبو” التي تعني (الزبيب).
وفيما يتعلق بالفلاحة البحرية نجد كلمة “شاباكا” و”شابِكا” التي تعني (الشبكة). وأما ما تعلق بأدوات الاستعمال فنجد كلمة “بالاتا” التي تعني (البلاط) الأرضي، و”باردا” التي تعني (البردعة)، و”بوطانا” التي تُنطَق أحيانا “فوتانا” وتعني (البطانية)، و”كارافا” التي تعني “الغرّاف”، و”كوفا” التي تعني (القفّة) و”فونداكو” أي (الفندق) وتعني الدكان أو المتجر، و”جارّا” التي تعني (الجرة)، و”هازانا” التي تعني (خزانة) و”جوبوني” التي تعني (الجبّة) المغاربية، و”ماتافو” التي تعني (المعطف)، و”مطراهو” التي تعني (المطرح)، و”ساطوري” التي تعني (الساطور) و”شاشينة” التي تعني (الشاشية) المغاربية، و”زمبيلي” التي تعني (زمبيل). وفيما يتعلق بالمهن نجد “هراري” أي (الحرائري)، و”سكارو” أي (السقاء). وكذلك أسماء حيوانات مثل “كنزيرو” التي تعني (الخنزير)، و”جيورانا” وتعني (الجرانة) الضفدعة. أما ألقاب العائلات فنجد على سبيل المثال: “باريللا” أي (بار الله)، و”فادللا” أي (فضل الله)، و”مامون” أي (ميمون)، و”مدافري” أي (مظفري)، و”مولي” أي (مولى) و”ناييمي” أي (نعيمي). كما نجد تعابير وصيغا مثل “مباطولا” أي (باطل)، و”كسارا” أي (خسارة)، و”جوفا” أي (جحا)، و”مشكينو” أي (مسكين).
يسدّ كتاب أنطونيو ماوريسيو لوياكونو، الذي حاولنا الإتيان على أهمّ محاوره بإيجاز، ثغرة مهمة في البحث التاريخي الإسلامي في إيطاليا، سيما بتركيزه على فضاء محدد. فقد تميز الكتاب بالتقصي والتوثيق في ما أورده، وهو ما يجعل من المؤلَّف وثيقة مهمة وضرورية لكل من يروم البحث في تاريخ المنطقة فترة الحضور الإسلامي. وللذكر نشير إلى أن التراث الإسلامي في إيطاليا متنوع سيما في مجال الآثار والنقائش والمخطوطات، وهو ما يتطلب مجهودات حثيثة من الطرفين، العربي والإيطالي، لإزاحة الستار عنه، لكن يبقى عائق الإيطالية، هذه اللغة المهمَلة من قِبل العرب، أحد العوائق المؤثرة، فتجاوز هذه النقيصة شرط لازم لتذليل المصاعب ورفع الغشاوة.