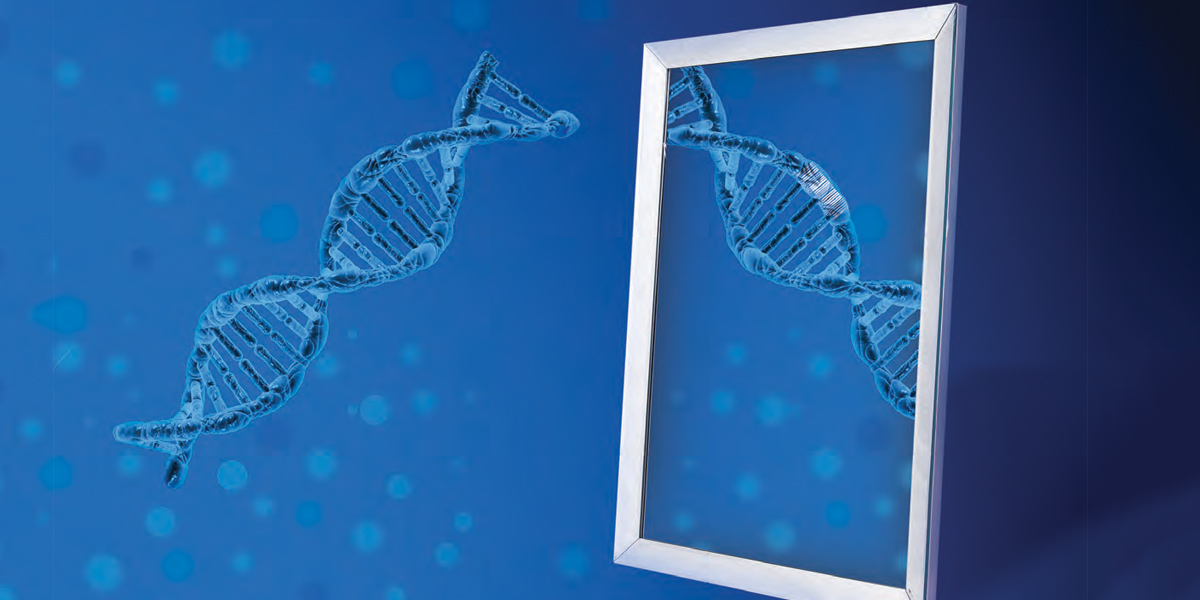إن الاستنساخ بمفهومه العام هو التوالد الخضري أو اللاجنسي، وهو آلية يتم استخدامها في الطبيعة كطريقة للتكاثر عند الحيوانات غير الراقية أو النباتات الراقية وغير الراقية. فإذا كان الاستنساخ قد أثار ضجة عارمة في الأوساط العلمية والاجتماعية كافة في الآونة الأخيرة، فإن ذلك يعود إلى استخدام تقنيات تخصيب مخبرية ليس لها مقابل في الطبيعة، والتي يمكن تطبيقها على الإنسان لتوليد أجنة بشرية متماثلة، وهو ما انتهى إليه علم الوراثة بشكل عام، والهندسة الوراثية بشكل خاص.
الاستنساخ والأخلاق
في نهاية القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة، وبالرغم من الحقائق العلمية الكثيرة التي تكشفت عن هذا الحقل، يأتي إمكان تطبيق بعض الاكتشافات والتقنيات كالاستنساخ، ليقلق المجتمع العلمي.
وهنا يمكن أن يثار سؤال هام: ما الذي يمنع هؤلاء الباحثين المشتغلين بهذه الأبحاث الجينية والوراثية من استخدام تقنية الاستنساخ لأهداف توالدية، أي لاستنساخ البشر؟ ماذا لو اضطرت بعض الحكومات استنساخ البشر أو استخدام تقنيات الاستنساخ على البشر تحت طائلة المسؤولية القانونية؟
وماذا لو امتنعت حكومات أخرى عن وضع تشريعات مماثلة؟ فهذا يعني تهيئة بيئة مناسبة للباحثين المغامرين، للقيام بأبحاثهم في تلك الدول التي تسمح ولا تحّرم. إن الالتزام بالمعايير الأخلاقية قد يصبح مسألة شخصية، ولا يمكن اعتمادها وسيلة لإقناع كل باحث بضرورة التقيد بالقوانين وعدم التعرض للطبيعة البشرية أو لقوانين الحياة، بحيث تتوقف محاولات استنساخ وتعديل طبيعة البشر كما يقول “فهد نصر” في مقاله “هل يُسمح بالاستنساخ البشري؟”
الاستنساخ العلاجي والتوالدي
يؤثر الباحثون التمييز بين نوعين من الاستنساخ العلاجي والتوالدي، والأول يهدف إلى توليد وعزل خلايا جذعية بشرية يُراد منها تشكيل المادة الأولية؛ لإنماء خلايا متخصصة -كالخلايا العصبية والعضلية- وذلك لاستخدامها في علاج طيف واسع من الأمراض كالسكري وأمراض القلب والتليف الكيسي أو الحوصلي. وتستخدم حاليًّا تقنية الإغراس النووي؛ لنقل النواة من خلية المانح إلى البويضة فتشرع الأخيرة بعد التحريض (الكهربي) بالانقسام الميتوزي فتشكل جنينًا بشريًّا مستنسخًا.
ويمكن أيضًا للبويضة غير المخصبة أن تنمو من خلال سيرورة التوالد الكبرى، وتعتمد على تحريض البويضة قبل أن تنهي انقسامها الميوزي أو الانتصافي الذي يسمح للخلايا الجنسية بتضعيف عدد صبغياتها. أما الاستنساخ التوالدي فيهدف إلى استخدام التقنية نفسها لتوليد جنين بشري يتم اغتراسه في رحم امرأة حاضنة فيؤدي (فيما لو تم نموه) إلى ولادة طفل مستنسخ.
ويبرر البعض الاستنساخ العلاجي الذي يهدف إلى إنتاج خلايا جذعية بأنه لا يعارض قدسية الحياة، لأنه يستخدم أجنة بشرية في مرحلة مبكرة من النمو. ويضيف هؤلاء ويعلنون أن الاستنساخ بوساطة النقل النووي ينتج كينونة بيولوجية ليس لها مقابل في الطبيعة، لذا لا يمكن اعتبارها شخصًا.
هذه الآراء تصرخ بالتناقض، لأن البويضة المخصبة بالنقل النووي تحمل في داخلها إمكان النمو لتصبح كائنًا حيًّا، لذا تستحق الاحترام، أما النقل النووي بالذات فهو يعارض الطبيعة لأنه يؤدي -فيما لو استخدم الاستخدام التوالدي- إلى توليد نسخة مماثلة لإنسان موجود، وهذا ما نعارضه بشدة لأنه مخالف لكل قوانين الطبيعة، كما أنه يترتب عليه مشكلات أخلاقية.
كثير من الباحثين يتحفظ على جواز الاستنساخ في النطاق الحيواني غير البشري، لأن تطبيقه يؤدي إلى اختلال في التوازن الحيوي إذا سمح لكل من يملك تقنية الاستنساخ الحيوي أن يستخدمها بلا ضمانات أو حدود.
فما الوضع الأخلاقي للبويضة المخصبة بالنقل النووي، والتي ستنمو إلى مرحلة “الكيسة الأريمية” لكي تستخدم في الأبحاث العلمية، والتي تهدف بدورها إلى إنتاج خلايا جذعية لمعالجة بعض الأمراض؟ هل يجوز أن نضحي بأجنة بشرية لمعالجة المرضى؟
هنا يبدو جليًّا أن الاستنساخ البكري قد يشكل بديلاً عن الاستنساخ الذي يتم بالنقل النووي، وذلك لأنه لا يثير المعضلات الأخلاقية نفسها للأسباب التالية:
أولاً: تخصيب البويضة بكريًّا لا يعد استنساخًا لنواة مانح، بل يؤدي إلى كينونة جديدة ليس لها مقابل في الطبيعة.
ثانيًا: البويضة المخصبة بكريًّا لم تأت نتيجة التقاء البويضة بالنطاف، وعليه فإنها لا تملك الحقوق نفسها التي تحظى بها البويضة المخصبة طبيعيًّا.
ثالثًا: إن تكوينها الوراثي وإن كان يوافق تمامًا الكائن الذي سحبت منه البويضة، فهو يختلف عنه، لذا يمكن أن تشكل مصدرًا للخلايا الجذعية، وتستخدم لعلاج المانح نفسه.
رابعًا: قد تكون مصدرًا لسلالة عالمية من الخلايا الجذعية.
خامسًا: إذا كان لا بد من السماح لتقنية الاستنساخ بأن تستخدم على الإنسان لأهداف طبية، فوحدها آلية الاستنساخ البكري يمكن اعتمادها، لأن أكثر الباحثين حزمًا وتشددًا لا يعارضونها.
إن الاستنساخ الجديد -إذا اقتصر تطبيقه على غير المجال البشري- لا خطر فيه، بل فيه كثير من المصالح المعتبرة من النواحي الطبية والاقتصادية، سواء تم في النطاق النباتي كما يجري تطبيقه، أو في المجال الحيواني الأدنى (الميكروبات) كما عرف منذ أمد، أو في الحيوانات العليا الثديية كالنعجة دوللي، ولكننا -ومعنا كثير من الباحثين- نتحفظ على جوازه في هذا النطاق الحيواني غير البشري، لأن تطبيقه يؤدي إلى اختلال في “التوازن الحيوي” إذا سمح لكل من يملك تقنية الاستنساخ الحيوي أن يستخدمها بلا ضمانات أو حدود. وقد جرب العالم في الأعوام القليلة الماضية “جنون البقر” لاستخدامه الغذاء الحيواني، لتسمينه وزيادة وزنه.
الاستنساخ والقانون
يبدو أنه في عصرنا الراهن عصر الثورة العلمية والتكنولوجية المتمثلة في الطفرات والقفزات الهائلة في تقنيات المعلومات والاتصالات، وبحوث البيولوجيا والهندسة الوراثية التي يسميها “توفلر” بالقنبلة البيولوجية، يبدو أنه في هذ العصر كُتب على القانون أن يتخلى عما يتمتع به من وقار وتؤدة، وأن يلهث لهاثًا سريعًا لملاحقة الآثار الاجتماعية بالغة العمق التي أحدثتها وستحدثها هذه الثورات العلمية المتلاحقة في حياة الأفراد والمجتمعات.
إن التطورات الحديثة في علوم الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وتقنيات الاتصال وثورة المعلومات والإنترنت وبحوث الجينات والإخصاب المعملي والنقل النووي الجسدي الاستنساخي، قد تركت وستترك انعكاسات بالغة الخطورة والتأثير على القانون بمختلف فروعه المدنية والتجارية، هذا فضلاً عن انعكاساتها على مهنة القانون ذاتها، بحيث أصبح أداؤها أكثر يسرًا ورقيًّا من الحالة البدائية التي كانت عليها منذ عقود، وأكثر تعقيدًا وتركيبًا في نفس الوقت.
والحق يقال إن كثيرًا من باحثينا القانونيين قد تنبهوا إلى ما تمثله الثورة العلمية التكنولوجية من تحديات لنظامنا القانوني، فأخذوا يخوضون في مجالات للبحث كانت إلى عهد قريب تعد في نظر أسلافهم نوعًا من الافتراضات الخيالية، كتلك التي برع فقهاء المسلمين الأوائل في الحديث عنها كنوع من الرياضة العقلية والتدريب الذهني.
رجال الدين والاستنساخ
وبعد ولادة النعجة دوللي باستخدام التقنية الجديدة للنقل النووي الجسدي، هبت عاصفة الحديث عن المشروعية إذا ما طبقت هذه التقنية على البشر، وترددت أصدؤها في كل أنحاء العالم، وشارك فيها كل من رجال الدين والقانون والأخلاق والفلسفة والعلماء ورجال السياسة، وكالعادة في كل نقاش ساخن، حفلت الساحة بالمعارضين الذين يرون في استنساخ البشر أمرًا غير مشروع دينيًّا وأخلاقيًّا، والمؤيدين الذين يحذرون من الوقوف في وجه التطور العلمي.
وكما هو متوقع، وقف رجال الدين على مختلف انتماءاتهم الدينية ضد تطبيق تقنية الاستنساخ في مجال توالد البشر، وفي تقديمه لكتاب “ج. إ. بنس” (من يخاف الاستنساخ) كتب الدكتور محمود حمدي زقزوق مقالاً بعنوان “الإسلام لا يعتمد للإنجاب إلا طريقًا واحدًا”، حيث إن الاستنساخ للكائن البشري يؤدي إلى مشكلات شائكة ومعقدة من شأنها تهديد نظام الأسرة كله، وهو نظام يقوم على الزواج الذي هو علاقة حميمة بين زوجين، ويعد الأطفال في الأسرة ثمرة طبيعية، ومن شأن الاستنساخ أن يؤدي إلى اختلال هذا النظام وفقدان هذه العواطف وضياع الانتماء الطبيعي داخل الأسرة.
كما عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، ندوتين عن “الاستنساخ بين العلم والدين”، “والاستنساخ في رؤية الفقهاء” في يوليو وأغسطس عام 1998، وكان هناك إجماع من فقهاء المسلمين على تحريم الاستنساخ البشري، لكونه عبث بالبشرية سيؤدي إلى فسادها، ولأنه يخالف المنهج الإلهي في الخلق وسيؤدي إلى اختلاط الأنساب وانهيار الأسرة، ومفاسده على الإجمال أكثر من المصالح التي تعود من ورائه إن كانت هناك مصالح على الإطلاق.
الاستنساخ في أوروبا
وقد صدرت عديد من التشريعات في الدول الأوروبية (ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا وسويسرا) تنظم التدخل الطبي في الجينات بما في ذلك الاستنساخ، سواء بحظر التلاعب في الخصائص الوراثية، أو استعمال الخلايا المعدلة، أو أي نسخ للجنس البشري، أو خلق عملاق إنساني، أو إنسان مختلط من حيوان (ألمانيا)، أو تحديد أهداف أبحاث الهندسة الوراثية في التشخيص العلاجي، أو الوقاية أو الأغراض العلاجية (إسبانيا)، أو حظر الخلط بين الجينات الإنسانية والحيوانية (بريطانيا وسويسرا).
الاستنساخ وصلته بالأخلاق
أما في مصر، فالمشرع -كما يذكر الدكتور محمد نور فرحات- ما زال على تجاهله لمثل هذه التقنيات، اكتفاء بالأحكام العامة في القانون، على الرغم من مطالبة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والتي طالبت بالتدخل التشريعي، وألقت الضوء على الجوانب الدينية والعلمية والطبية المتعلقة بتقنيات الهندسة الوراثية.
وللأسف إننا نجد المستشار الخبير بالقانون يقدم لنا رؤية متشائمة، ولكنها في الحقيقة واقعية في عدم الامتثال للقوانين التي توضع في هذا الشأن فيقول: “إن التجربة علمتنا أن البحث العلمي له منطق التطور الذاتي المستقل، الذي لا يعبأ كثيرًا بصيحات الاحتجاج الأخلاقية أو بالحرمات الدينية، فكم من صيحات ارتفعت ضد تجار الإخصاب المعملي وضد تجارب نقل الأعضاء، ومع ذلك أصبحت هذه الممارسات واقعًا مفروضًا على المجتمعات أن تتعامل مع آثارها أيًّا كانت درجة استحسانها أو استهجانها”.
ومن هنا يكتفي المستشار القانوني بطرح بعض الإشكاليات الرئيسة ـ وهي كثيرة جدا ـ التي تترتب على تطبيق التقنيات البيولوجية الجديدة لعمليات الإخصاب الصناعي منها ما يتعلق بمسئولية الطبيب أو العاملين في المركز الطبي ومنها ما يتعلق بالآثار التي تترتب على التلقيح وهي نتائج شديدة الخطورة، ولكن الأهم والأخطر هو تلك التحديات بالغة الخطورة التي يمتلكها تكنيك الإخصاب على النظام القانوني للنسب وما يتبعه من آثار مرتبطة بالميراث وحقوق الصغير في الحضانة والنفقة وموانع الزواج بين الأقارب وما إلي ذلك، وغيرها من المشاكل الشرعية والقانونية إضافة إلى الإشكاليات الكثيرة والمستحيلة والتي لم تواجهها الإنسانية من قبل.
أخلاقيات المستقبل
وعامة يُملي علينا التفاؤل المنبثق من الإيمان بالعلم وأخلاقياته، والأخلاق المنبثقة من باطن الضمير الإنساني الحي، أو الذي ينبغي -لصالح الإنسان- أن يكون حيًّا، أن نتمسك بأخلاق خاصة بالعلم ينبغي أن تسود واقع البشرية المعاصرة. ومن هنا فتوضيح آليات هذه التجارب العلمية الخاصة بالاستنساخ، أو بالهندسة الوراثية، ونتائجها المرتقبة، ومخاطرها المحتملة، يقع على كاهل الباحثين عبر مقالات مبسطة ومحاضرات وندوات علمية عبر الفضائيات والشبكات المعلوماتية.. هذا النوع من النقاش المفتوح، يسمح للمجتمع بإدراك أن قانونًا أو تشريعًا عالميًّا قد يكون هو الخطوة الأولى نحو عالم أكثر أمانًا واحترامًا لكرامة الإنسان. وقد تجد الأمم المتحدة نفسها داخل هذه الدوامة، فتحض عندها كل الدول على القيام بالتشريعات اللازمة، لحظر التجارب على الإنسان، والسماح بتلك التي تضمن التقدم العلمي والطبي لمعالجة المرضى وتخفيف آلامهم.
(*) قسم الفلسفة والاجتماع، كلية التربية، جامعة عين شمس / مصر.