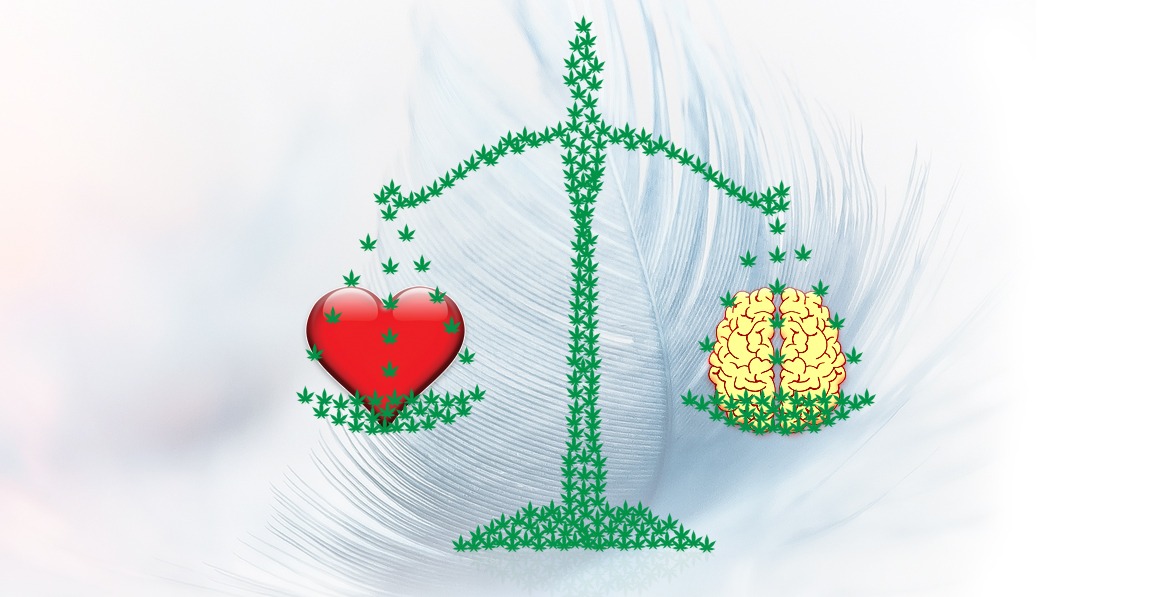ظهرت قضية “العفو العام” على نطاق الإنسانية قاطبة مع ظهور مصطلح “الجرائم ضد الإنسانية”، خصوصًا في القرن العشرين بعد الحرب العالمية الثانية، حيث -ولأول مرة- تقف الإنسانية بشكل قانوني لمحاسبة نفسها على نطاق كوني، ومنذئذ تحول العفو إلى قيمة أخلاقية تلجأ إليها الشعوب لتأمين انتقال مدني سلمي للسلطة، نحو مرحلة جديدة من التصالح بين أعضاء المجتمع الواحد.
ولما كان العفو العام عن الجريمة موجودًا وتطور حتى صار تشريعًا، فأصبح يعرف في الاصطلاح القانوني أنه قانون يصدر عن السلطة التشريعية، بهدف محو الصفة الجرمية عن الفعل، وبه يتنازل المجتمع عن حقه في معاقبة الفاعل على فعله، وهو عفو شامل يشمل جميع الجرائم والأشخاص بأحكامه.
ويصدر هذا العفو غالبًا إثر الاضطرابات السياسية والاجتماعية، ومحاولة تغيير بعض الأنظمة الشمولية، إما بالثورة أو الانقلاب، فيسعى المشرع أو رئيس الدولة أو الملك إلى إصدار عفو عام، فيسدل الستار على ذلك الماضي وما اكتنفه من ذكريات أليمة، سعيًا لتحقيق مصالحة عامة، ونشر الطمأنينة والسكينة في المجتمع.
ظهرت قضية “العفو العام” على نطاق الإنسانية قاطبة مع ظهور مصطلح “الجرائم ضد الإنسانية”، خصوصًا في القرن العشرين بعد الحرب العالمية الثانية.
إن فلسفة العفو ليست دفع الأفراد والجماعات إلى التمادي في الجرائم أو تجاوز القوانين والحدود، بل محاولة إبعاد جوّ الذنب والجريمة عن المجتمع. وبناء على هذا، فإن الدين الإسلامي يتوخّى من ذلك تحقيق عدة أهداف، من أهمها القضاء على الذاتية والأنانية، إذ من المعلوم أنّ النسبة الأكبر من الصراعات السياسية والاجتماعية منشؤها حب الذات والجري وراء المصالح الذاتية في الحكم على البلاد والعباد. وهو ما يصطلح عليه الفيلسوف طه عبد الرحمن بـ”مبدأ النسبة”؛ أي إن “النفس البشرية تنسب الأشياء إليها، ولا تزال هذه النسبة تتزايد ويتسع نطاقها مورثة الشعور بأنه أضحى يملك ويسود، حتى تنبعث فيه الرغبة في السيادة على غيره من الخلق، ثم تأخذ هذه الرغبة في التصاعد والاشتداد حتى تستبد به”.
تلك هي فلسفة العفو الذي يراد به الدفع بالمجتمع نحو التصالح مع الذات والغير، في نزوح جماعي للضمير الإنساني نحو الرقي والكمال لكي يعفو ويصفح عمن ظلم واعتدى.
وإذا كنا بصدد التسويق، وإعطاء مدلول آخر لهذه القيمة الإنسانية والأخلاقية، ذات البعد الاجتماعي والسياسي، يستجيب لنداء الفطرة الإنسانية السليمة، فإنه لا بد وأن نستشير التاريخ الإنساني في أرقى حقبه الزمنية، ونستدعي نماذجه الحية التي يشهد لها العالم بأسره في العدالة الاجتماعية، ذلك لأن التاريخ مدرسة شاهدة على مراحل رقي المجتمعات وتطورها أو انحطاطها وأفولها.
أما النموذج الحي الذي نحن إزاء بسطه وتحليل أحداثه -وفق رؤية جديدة- فهو حدث “فتح مكة” الذي شهد له التاريخ الإسلامي -وبالضبط في عهد النبوة- والذي أُرِّخ له في العشرين من رمضان في العام الثامن من الهجرة، حيث كان حدثًا باهرًا للعالمين، وكان نموذجًا راقيًا يحتذى به في قضية “العفو العام”.
وقد اعتبره المؤرخون والدارسون معجزة في العفو عن الناس، لا يمكن أن تتكرر على مر التاريخ، لما كان لها من وقع مفاجئ على أهل مكة والجزيرة العربية وكل العالم من حولها آنذاك.
وقبل الدخول في تفاصيل الحدث، دعونا نستحضر شهادات بعض المستشرقين الغربيين المنصفين، والتي جاءت نتيجة دراسة علمية اكتملت فيها عناصر المنهج العلمي الحديث، القائم على الملاحظة والتجربة والاستقصاء حول هذا الحدث الذي توِّج بـ”العفو العام”.
ونبدأ بالمستشرق الفرنسي “إميل دير منجيم”
(E. Dermenghem) الذي يشهد شهادة منصفة على هذا الحدث في كتابه “حياة محمد” فيقول: “إن محمدًا قد أبدى في أغلب حياته اعتدالاً لافتًا للنظر، فقد برهن في انتصاره النهائي على عظمة نفسية قلما يوجد لها مثيل في التاريخ، إذ أمر جنوده أن يعفوا عن الضعفاء والمسنين والأطفال والنساء، وحذَّرهم من أن يهدموا البيوت، أو يسلبوا التجار، أو أن يقطعوا الأشجار المثمرة.. وأمرهم ألا يجردوا السيوف إلا في حال الضرورة القاهرة، بل رأيناه يؤنب بعض قواده ويصلح أخطاءهم إصلاحًا ماديًّا ويذكِّرهم بأن الحفاظ على نفس واحدة خير من ألف فتح.
وذلك ما أكده المؤرخ الأمريكي “واشنجتون أيرفنج” (Washington Irving) في كتابه “حياة محمد” أيضًا، معلقًا على قرار “العفو العام”، حيث قال: “كانت تصرفات الرسول محمد في أعقاب فتح مكة، تدل على أنه نبي مرسل لا على أنه قائد مظفر، فقد أبدى رحمة وشفقة على مواطنيه برغم أنه أصبح في مركز قوي. ولكنه توّج نجاحه وانتصاره بالرحمة والعفو”.
إن فلسفة العفو ليست دفع الأفراد والجماعات إلى التمادي في الجرائم أو تجاوز القوانين والحدود، بل محاولة إبعاد جوّ الذنب والجريمة عن المجتمع
وباستدعاء هذا النموذج الحي من التاريخ الإسلامي واستحضار هذه الواقعة التي كانت فتحًا عظيمًا، ليس للمسلمين فقط بل حتى للأديان المجاورة والثقافات الأخرى التي تتلمس عظمة الإسلام والمسلمين في تعاملهم مع مخالفيهم وحتى أعدائهم بالسماح والعفو ومنحهم الحرية التامة، بالأحرى مع المجاورين من أهل الكتاب وغيرهم.
فبعد أن تم صلح الحديبية، اشتغل المسلمون بنشر الإسلام وتعاليمه، وكان وفاؤهم لقوم قريش أمرًا مقررًا فيما أحبوا وفيما كرهوا. وعندما نقضت قريش المعاهدة كان الفتح، حيث استجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لنصرة المتحالفين معه -وهم قبيلة بني كعب- والرد على عدوان قريش من السرعة والحزم، فسار جيش المسلمين مسرعًا إلى مكة، ونصبت الخيام وأوقدت النيران في معسكر يضم حوالي عشرة آلاف جندي.
دخل أبو سفيان رضي الله عنه مكة مبهورًا مذعورًا، وهو يحس أن من ورائه إعصارًا، إذا انطلق اجتاح ما أمامه فما يقف دونه شيء. ورأى أهل مكة الجيش الفاتح يقبل من بعيد، فاجتمعوا على سادتهم ينتظرون الأمر بالقتال، فإذا بأبي سفيان ينطق بصوت عال: “يا معشر قريش، هذا محمد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن”؛ فتفرق الناس إلى دُورهم وإلى المسجد.
كان الجيش يتقدم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته يبدو عليه التواضع الجم. إن الموكب الفخم المهيب الذي ينساب به حثيثًا إلى جوف الحرم، والفيلق الدارع الذي يحف به، ينتظر إشارة منه فلا يبقي بمكة شيئًا قائمًا.
إن هذا الفتح المبين ليذكره بماض طويل الفصول؛ كيف خرج مطاردًا.. وكيف يعود اليوم مؤيدًا منصورًا.. لكن الصحابي الجليل سعد بن عبادة رضي الله عنه زعيم الأوس، ذكر ما فعل أهل مكة ثم شعر بزمام القوة والسطوة في يده فصاح: “اليوم يوم الملحمة.. اليوم تستحل الحرمة.. اليوم أذل الله قريشًا”.. فلما بلغت هذه الكلمة مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشًا” (رواه البخاري). ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة شاكرًا حامدًا ربه، متواضعًا لله.. كان يحفه خير الجنود وعليهم وَقَار البطولة، وكان بإمكانهم تدمير مكة على رؤوس المشركين الذين عذّبوا المسلمين وسجنوهم وحاصروهم وأخرجوهم من ديارهم.. ولكن بعد أن طهر المسجد أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم قريش وهم صفوف يرقبون قضاءه فيهم، فقال صلى الله عليه وسلم: “لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده”.
ثم أعلن النبي الكريم في هذه اللحظة “العفو العام” عن أهل مكة عندما اجتمعوا حول الكعبة وهم يسمعون له، إذ قال: “يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟” قالوا: خيرًا، أخ كريم و ابن أخ كريم، قال: “فإني أقول لكم ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء”.
تلك كانت قصة “العفو العام”، وكان هذا ما نطق به لسان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في يوم “الفتح الأعظم”، الذي شهد له التاريخ بعظم عفوه وتسامحه مع ألدّ أعدائه.. ولا شك أن ذلك قمة التعبير عن العفو عمن ظلم واعتدى.
كان هذا الفتح فتح أخلاق ورحمة قلما نجد في تاريخ البشرية فتحًا يضاهي فتح مكة في روعة أخلاقياته. لقد ازدحمت في ذاك اليوم، مشاهد الأخلاق الكريمة، وصور الخلال السجية، حتى تيقن الدارسون والباحثون والمفكرون في التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية، أن محاضن التربية التي كانت “دار الأرقم” وعاء لها، قد أتت أُكلها وأينعت ثمارها وانتفضت حية في سلوك الصحابة يوم الفتح.
فلم نسمع يوم صدور “العفو العام”، أن رجلاً مسلمًا هتك عرض امرأة، أو هدم بيتًا، أو أفسد زرعًا، أو قتل ظلمًا، أو فزّع طفلاً.. فأخلاقيات “العفو العام” هي أخلاقيات تمخضت عن نفوس أُشربت على التراحم فيما بينها والتآخي والتغافر. ليس هذا فحسب بل وبعد تمكُّن المسلمين من الحكم، شيدوا نظامًا زاخرًا بالعفو والتسامح والأخوة، متحلّيًا بالحق الرحمة والعدالة.