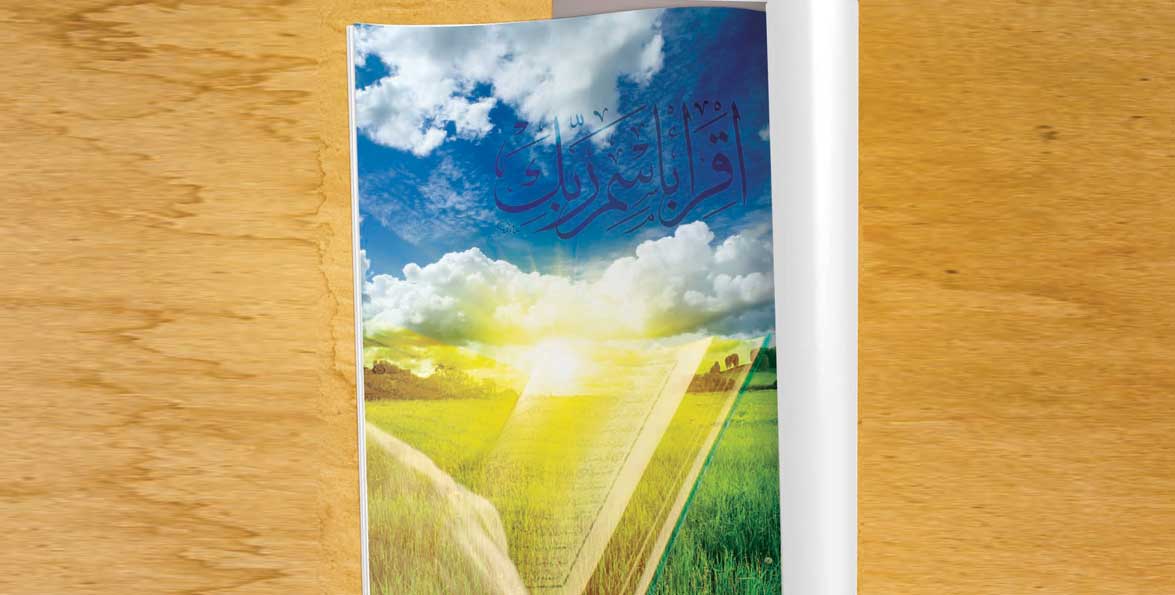إن الجمع بين القراءتين تجلٍّ من تجليات التكامل المعرفي في القرآن المجيد، فلا يخفى على قارئ ولا قارئة لكتاب الله عز وجل، أن أول ما أشرق من أنوار هذا الوحي الخاتم على دنيا الإنسان هو قوله سبحانه: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾(العلق:1-5).
نرى إذن، ومنذ هذا الإشراق الأول أن ثمة أمرًا بقراءتين:
الأولى: قراءة في الخلق ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾، ولا شك أن هذه القراءة في الخلق لها أبجدها ولها آلياتها ولها خطواتها ولها مؤشرات تقويمها. والقراءة الثانية التي تبرز: هي القراءة في الكتاب المسطور ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾.
إن فعل القراءة في عالم الإنسان وفي دنياه أصبح -بحمد اللٰه- ممكنًا بإقدار الله عز وجل لهذا الإنسان على هذه القراءة؛ وتجلّي هذا الإقدار في الجانب المنظور كان من خلال الأسماء وتعليمها ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾(البقرة:31). ورضي الله عن سيدنا عبد الله بن عباس حين قال: “علَّمه حتى القصعة والقُصيعة”، والعلماء -وعلى رأسهم بهذا الصدد أبو الفتح ابن جني- على أنَّ المقصود بـ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ هو إقداره على تسمية الأشياء، وهذا الإقدار هو الذي يمكّن الإنسان من تفصيل وتفكيك المجملات؛ بحيث يستطيع أن يأتي إلى مجمل ويفكِّكه، وكلُّ جزء ينتج عنده وينجم من هذا التفكيك يكون قادرًا على إعطائه اسمًا، فيضبطه في مكانه من خلال هذا الاسم، وهكذا يستمرّ في التفكيك، ويكون بعد ذلك من خلال هذه الصور والمعالم الأسمائية قادرًا على التركيب، أي إنها قراءة في اتجاهين: تفكيكًا وتركيبًا، قراءة قد أصبحت ممكنةً بسبب هذه القدرة على التسمية.
أما في الجانب الذي هو جانب الكتاب المسطور، فنجد الكلمات، وذلك في قول اللٰه عز وجل: ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾(البقرة:37). هناك إذن، الأسماء في الكتاب المنظور، وهناك الكلمات في الكتاب المسطور، وهناك -كذلك- المواءمة بين الإنسان وبين الكتابين، وهي مواءمة كانت ممكنة بسبب الدمغة الأولى والفطرة الأولى: ﴿فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾(الروم:30).
المواءمة البنائية
وتقوم هذه المواءمة الممكّنة من القراءتين في الجانب المنظور “الكوني”، وفي الجانب المسطور “جانب الوحي” على مجموعة من الأسس أبرزها البنائية. ففي الجانب المنظور “الجانب الكوني”، نجد أن هذا الكون بناء عضوي ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾(الذاريات:47)، ﴿أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا * رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا﴾(النازعات:27-28)، وهذا البناء له مقصديَّة هي التسخير ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ﴾(لقمان:20)، وفي مواطن من كتاب اللٰه يبرز أن هذا الكون وحيُه هو أن يتسخّر لك أيها الإنسان، ومنها قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾(فصلت:12)، وقوله سبحانه: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا﴾(الزلزلة:4-5)، وحيًا جديدًا، فحين يقول الإنسان: ما لها؟ ما لها لا تتسخر؟ يكون الجواب: إن ذاك الوحي القديم الذي هو وحي بالتسخر، قد نُسخ كما قال الإمام القرطبي في جامعه: “بوحي جديد هو وحي بعدم التسخر؛ لأن زمن الحساب قد أزف”، وهو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ * وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ * وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾(الانشقاق:3-5). فهذا الكون إذن مسخَّر، ويمكّن من هذا التسخير، كون الإنسان قادرًا على تفهّمه من خلال المقوِّمات التي زوَّده اللٰه عز وجل بها، وفي مقدّمتها المواءمة ثم قدرة معرفة الأسماء.
أما في الجانب المسطور “الوحي”، فنجد أنه هو أيضًا بناء؛ فاللٰه سبحانه وتعالى يتحدث عن القرآن المجيد فيقول: ﴿وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً﴾(الفرقان:32)؛ والشيء الرَّتل هو الحسن البناء والنَّضد، وهو بناء له مستويات:
أولها: المستوى الصوتي القائم على نضد الحروف، ونضد الكلمات، ونضد الأصوات؛ أي بنائها. ثانيها: المستوى المفاهيمي، وثالثها: المستوى النسقي، ورابعها: المستوى التنزيلي، وخامسها: المستوى التقويمي.
والقرآن المجيد من خلال هذا البناء، كأنه جملة واحدة كما نصّ عليه أبو بكر ابن العربي -رحمه اللٰه- حين قال: “ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة، متسقة المعاني، منتظمة المباني، علم عظيم لم يتعرّض له إلا عالم واحد… ثم فتح اللٰه عز وجل لنا فيه، فلما لم نجد له حمَلَة، ورأينا الخلق بأوصافِ البطَلَة، ختمنا عليه، وجعلناه بيننا وبين اللٰه، ورَدَدناه إليه”.(1) وللإمام الشاطبي كلام أيضًا بهذا المعنى؛ أي أنّ القرآن كالخبر الواحد وكالجملة الواحدة، وابن حزم الأندلسي أيضًا له في إحكامه كلام يفيد هذا المعنى، والبرهان البقاعي والبدر الزركشي وغير هؤلاء، كلهم تكلّموا عن كون القرآن المجيد بناء عضويًّا، وأنه لا يفهم إلا بردّ بعضه على بعض.
وهذه البنائية هي التي مكّنت الإنسان من أن يقوم بالقراءة من خلال تلقي الكلمات، وهذا أبرز تجليات المواءمة بينه وبين كتاب الختم، وقد ذمّ الله عز وجل الذين جعلوا القرآن عِضِين؛ أي الذين يفرِّقونه ويعضّونه، وذلك في قوله تعالى:
﴿كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ * الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾(الحجر:90-91).
وإذا كانت القراءة في الجانب الكوني تتم بالتفكّر ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاْلأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ﴾(آل عمران:191). فإنها في الجانب المسطور “الوحي” تتم بالتدبر ﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾(محمد:24).
التسخير والتيسير
وتتجلى جمالية التعبير القرآني أيضًا من خلال التقابل بين “سخّر ويسّر”، فهناك التيسير ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾ في أربعة مواضع من سورة القمر، وفي سورة مريم ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ﴾ إلى غير ذلك من مواضع ورود التيسير في القرآن الكريم. وهناك التسخير الوارد في مثل قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ﴾(الأعراف:54)، ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾(النحل:12)، ﴿اللٰهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ﴾(الجاثية:12)، ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾(الجاثية:13)،
﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ﴾(الأعراف:54).
إن القراءة في الكون المسخَّر هي التي أعطتنا علوم التسخير، أي إن حوار الإنسان مع الكون، من خلال هذه المواءمة التي له معه من خلال إقدار اللٰه إياه على الدخول إلى مساربه بالأسماء، وتفكيك مجملاته هذا الحوار، هو الذي أعطى علوم التسخير التي تجعلنا قادرين على الحركة وعلى الفعل؛ إذ الكون هو مرجع الحركة ومرجع الفاعلية.
في الجانب الآخر نجد أن القراءة في الوحي الميسَّر هي التي أعطتنا علوم التيسير، فالحوار مع الوحي هو الذي مكّننا من القدرة على تبيّن الوجهة والقبلة المقصودة بالفعل والحركة، وحوار الإنسان المستدام مع الوحي من خلال بنائيته، ومن خلال المواءمة التي له معه، وكذا من خلال القدرة على التفهّم بسبب الكلمات التي أوتيها وتلقّاها عبر الرسل الكرام -عليهم جميعًا أزكى السلام- هو ما مكّن من تنمية علوم التيسير. قال عليٌّ كرم اللٰه وجهه: “ذلكم القرآن فاستنطقوه”، وفي رواية عن عبد اللٰه بن مسعود رضي الله عنه: “ثوّروا القرآن”؛ أي حرِّكوه لكي يخرج مكامنه.
فالقرآن المجيد في موازاة مع الكون الذي هو مرجع للحركة والقدرة والفاعلية، يصبح مرجعًا للقيم، ومرجعًا للوجهة ولحضور القبلة التي سوف ترشّد هذه الحركة. وجليّ أن القدرة على الحركة بدون قيم وبدون وجهة وبدون قبلة، قد تجعل من هذه الحركة فاتكة بالإنسان وبالأرض -الكوكب الذي يعيش عليه الإنسان- وبمحيط الإنسان. وهو ما حذّر منه رب العزة في سورة الأعراف في سبع آيات مفصلاتٍ فيها بيان، أن العلاقة الوطيدة بين القراءتين هي سبب الحياة والنماء، كما فيها أن الانفصال بينهما سبب الفساد والهلاك، قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ * إِنَّ رَبَّكُمُ اللٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ * ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللٰهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ * وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾(الأعراف:52-58).
إن العناية بإزاء القراءة في الكون مرجع الحركة والفعل، بالقراءة في الوحي لاستبانة القبلة، ولاستمداد الوجهة منه في محافظة دائمةٍ على الوصل، والجمع بين هاتين القراءتين هو ما يجعل الحركة والفاعلية راشدتين بانيتين ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾(البقرة:256).
باب العلم قبل القول والعمل
إن الإنسان وهو يتحرَّك في خضمّ ما سلف تؤطِّره أمور:
أولها: الرؤية الموجودة في القرآن المجيد والتي تبيّن دوره ووظيفته، كما تبيّن المحاور التي ينبغي أن يتوافر على الوعي بها لكي يكون فاعلاً.
ثانيها: الثمرة التي هي حاجته إلى العمل. فهذه الرؤية تكون بمثابة القطب الجاذب الذي يجعل القراءة في الكون، قراءة ناجعةً نافعةً لكن دون انفصال -وكما سلف- عن علم القبلة والوجهة، مما يجعل العمل عملاً يُتوَخَّى به إرضاء اللٰه عز وجل؛ إذ هو سبحانه وتعالى الذي أقدر عليه ومكّن منه ابتداء، ونحن نرى في القرآن المجيد كيف أن الإنسان اختُزِل في عمله، فحين نادى نوح عليه السلام ربه قائلا: ﴿رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾(هود:45)، أجابه رب العزة بقوله: ﴿يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾(هود:46)، فاختزل الإنسان في هذه الآية في عمله. وهذا العمل لن يكون ناجعًا إلا إذا كان -كما رأينا- مؤطَّرًا بالرؤية، وحيث قد قيل بحقٍّ إن فقه البخاري يتجلى في تراجمه، فقد أحسن -رحمه اللٰه- حين قال: “باب العلم قبل القول والعمل”.
إن التحديات التي يواجهها الإنسان القارئ أثناء فعل القراءة كثيرة، غير أن أهمها ثلاثة:
أولاً، تحدّي التمكّن من الوقوف على وظيفته وعلى دوره “الخلافة، الأمانة، العبادة” وأن يكون ذا وعي بالقيم الحاكمة الكبرى والتي يمكن إجمالها في ثلاث:
1- التوحيد
2- التزكية
3- العمران
وهي قيم حاكمة تتفرّع عن كل واحدةٍ منها مجموعة قيم ليس هذا مقام التفصيل فيها. فالوعي بالوظيفة والدَّور إذن، تحدٍّ أساسيّ يواجه الإنسان أثناء القراءة.
غير أن هذا التحدّي يسلّمنا إلى تحدٍّ ثان يسمّيه القرآن المجيد “الإبصار” في قوله تعالى: ﴿وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾(الصافات:175)، وفي قوله سبحانه: ﴿وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾(الصافات:179)؛ أي أَعِنْهم على هذا الإبصار فسوف يبصرون، والمقصود أساسًا بالإبصار، هو إبصار العلامات والآيات، أي البصائر ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا﴾(الأنعام:104).
ففي الجانب الكوني، نجد أن الكون فيه آيات؛ فالليل آية، والنهار آية، والشمس آية، والقمر آية ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾(فصلت:37)، وهذه الآيات وجب أن يوقف عليها ووجب أن تُتبين معالمها وألا يغفل عنها:
﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾(يوسف:105).
وفي الوحي “الكتاب المسطور” نجد كذلك عبارة آيات، وهذه الآيات علامات، لأن الآية لغةً هي “العلامة” ﴿إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلاَئِكَةُ﴾(البقرة:248)، أي علامة ملكه.
فإبصار الآيات، والاهتداء بالعلامات، هو الذي يجعل الإنسان بعد التمثل للوظيفة وللدَّور، قادرًا على السير برشادة ﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾(الملك:22).
التحدّي الثالث -وهو الثمرة- أن يكون الإنسان عاملًا بمقتضى كلّ ما مضى، مع استحضار أنّ العمل يجزى عليه، ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَى﴾(النجم:39-41). وتحضرنا هنا حقيقة مؤقتية الإنسان، وكون المعاد نهاية حياة وبداية أخرى، نهاية حياة فيها عمل ولا حساب، وبداية أخرى فيها حساب وجزاء ولا عمل، وهو ما جاء في قوله تعالى ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللٰهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ﴾(البقرة:281) كما يبرز مقوّم الإتقان باعتباره مقومًا أساسًا يجعل الإنسان من خلال إيمانه بالمعاد يروم أن يكسب الأجر الأوفى والأوفر مع رب العالمين ﴿إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾(الكهف:30).
مقوم آخر لابد منه لمسّ القرآن الكريم، هو مقوم المنهاجية، ومن مقوّمات العمل -كذلك- في هذه المنظومة الكلية بالإضافة إلى الإتقان، جانب النفع الذي أعطي في هذه المنظومة أهمية خاصةً ولّدت علوم المقاصد والمآلات مما هو مفصّل وبدقة في أبوابه.
وجبت الإشارة مرة أخرى إلى أنّ ثمة حاجة ملحة للضم بين القدرة على الحركة والفعل من جهة، والقدرة على استبانة الوجهة والقبلة من جهة ثانية، حتى يرشد الإنسان ولا يتيه. ونجد هذا الضم في مواطن كثيرة من القرآن الكريم، بالإضافة إلى الموطن الأول الذي به افتتحنا حديثنا هذا، أي أول آية في سورة العلق، بالإضافة إلى آياتِ سورة الأعراف. ومن هذه المواطن، سورة الواقعة، حيث نجد آية من أبلغ وأجلى ما يمكن أن تكون عليه الدلالة بهذا الصدد، وهي قوله تعالى: ﴿فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ﴾(الواقعة: 75-79)؛ حيث نجد البنائية الكونية التي تبرز من خلال مواقع النجوم، ونجد البنائية القرآنية التي لا يمكن أن يوقف عليها إلا بمقوّم يبرز ها هنا بجلاء، وهو مقوِّم الطهارة الذي يجعل الإنسان العالم قادرًا على دخول كنّ القرآن المجيد واستخلاص هدايته.
مقوّم المنهاجية
ويشترط فيها:
1- أن تكون هادفةً دائمًا لتحقيق السعادتين في العاجل وفي الآجل.
2- أن تكون تجريبية تأثيلية، وتكاملية عبر الزمن.
3- أن تكون منفتحة قابلة للنماء، أي لا تكون عبارة عن أنساق مغلقة.
4- أن تؤدي إلى التسبيح، أي الوقوف على عظمة الخالق من خلال خلقه، لكن قبل ذلك وأثناءه وبعده، من خلال كلامه الأزلي الخالد.
5- الفاعلية والنجاعة والإحكام.
وإذ إن حديثنا حديث عن التكامل المعرفي الناجم عن الضمّ والجمع بين القراءتين، فإنه تجدر الإشارة إلى أنه لتحقيق القراءة التكاملية، لابد من عدم إهمال الجانب المؤسَّساتي وهو جانب بدوره له مجموعة من المقوِّمات يمكن إجمالها فيما يأتي:
1 – توضيح مقاصد المؤسَّسات قبل أن يبدأ العمل فيها، وقبل أن ترصد لها إمكاناتها ومواردها، وكذا قبل أن تخطّط برامجها، حيث يجب أن تكون المقاصد بيّنة وواضحة بين يدي ذلك كله.
2- المضمون المستجيب للمقاصد، وتتمحور حول كل هذا، مجموعة من المعارف والعلوم، والقدرات التي وجب أن تكتسب من أجل بلورة المضامين الأنسب.
3- البشر المكوِّن والمكوَّن قصد الاضطلاع بما سبق.
4- دراسات الجدوى في كل حين بطريقةٍ جزئية ثم بطريقة كلية.
5- الهياكل القانونية والإدارية الممكنة مما سبق والميسّرة له.
6- استيفاء الجوانب المادية.
7- التقويم حتى يقبل الجيّد ويدرأ غيره.
وبدون التكامل بين هذه المقوِّمات؛ مقوِّمات القراءة والمناهج والمؤسسات، فإن فعل القراءة غير التكاملية، قد ولّد مجموعة من الاختلالات التي نعاني منها بجلاءٍ في واقعنا المعاصر.
ولكي يكون فعل القراءة التكاملية بين الكتابين المنظور والمسطور، وبين العلوم المنبثقة عن الحوار معهما، ونقصد بذلك علوم التيسير وعلوم التسخير أمرًا ممكنًا، لابد أن يضطلع الإنسان بكل ما سلف من مقوّمات، حتى يكون الجمع بين القراءتين قادحًا لزَند التكامل والتنامي والإغناء لكلٍّ منهما، ضامًّا بين القدرة على الحركة والقدرة على استحضار القبلة واستبانة الوجهة واستخلاص القيم، وعابرًا بين الكتابين والعلوم المستخلصة منهما، بالخبرات المستكنهة من كل منهما، إلى كل منهما.
هذه جملة أفكار مركّزة، حاولت من خلالها ملامسة الأسس النظرية، والشروط التطبيقية، لبلوغ غاية التكامل المعرفي التي جاء كتاب الختم “القرآن” ليمكّننا منها، عبر تجلية بعض سبل ذلك بآياته وبصائره، وبحسبنا أن تكون هذه الإشارات عبارة عن صور أولية ترسم معالم هذا الدرب القرآني المبارك المديد.
ــــــــــــــــ
الهوامش
(1) نظم الدرر، 1/6-7.