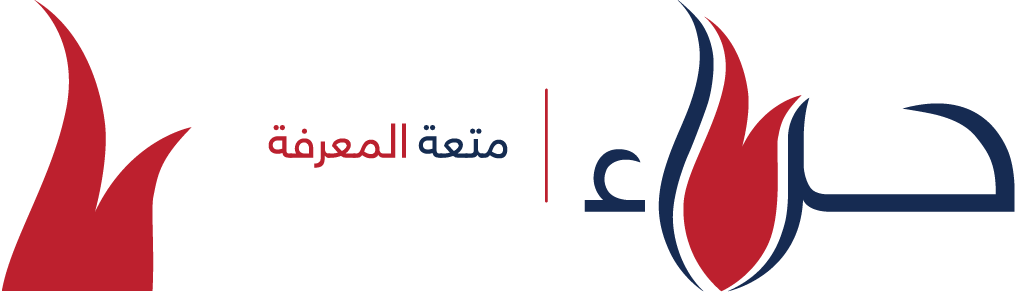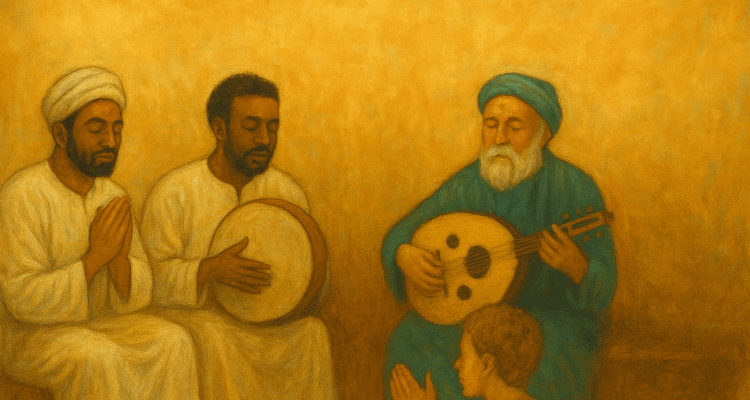يتميز الإنشاد الصوفي بمجموعة من الأعراف والتقاليد التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، وارتبط ظهوره بانتشار حركة التصوف في البلاد الإسلامية بصفة عامة. فقد نشأت أعراف وتقاليد هذا الإنشاد في أوساط المتصوفة، ومن خلال الممارسة المستمرة لنشاطهم. ولهذا، تحتل الموسيقى الروحية في التراث الموسيقي العربي عامة، والمغربي على وجه الخصوص، موقعًا بارزًا، لما تحمله من سمات وخصوصيات تميزها عن سائر الأنماط الموسيقية والغنائية الأخرى، خاصة الموسيقى التقليدية وفنون الموسيقى الشعبية.
وتتجلى أبرز هذه السمات في الأجواء الروحية التي تسمو بوجدان الإنسان إلى أعلى المقامات والمراتب، مما يجعل هذه الموسيقى ذات أبعاد كونية وإنسانية، تشكل جسرًا للتواصل بين بني البشر، يتم من خلاله توحيد الثقافات وبناء روابط مشتركة فيما بينها.
الموسيقى الروحية وتبادل التجارب
تبلورت أبرز أساليب وخصائص هذا الإنشاد عبر احتكاكه وتفاعله مع غيره، مما ساعد على التبادل بين مكوناته. وقد ساهم في ذلك ما تميز به رجال الطرق الصوفية من تنقل وتجوال في الآفاق، حتى كاد أن يكون لكل طريقة فروع خارج البلاد التي نشأت فيها.
وقد تجلى هذا التفاعل مثلاً في تأثر متصوفة المغرب بالتصوف الشرقي، بفضل الروابط والاتصالات التي قامت بين الطرق الصوفية، والرغبة في تبادل المعارف والخبرات الروحية. على المستوى المحلي المغربي، نجد مثالاً على ذلك في العلاقة المتينة التي ربطت خلال القرن الحادي عشر بين ثلاث زوايا كبرى: الزاوية الدلائية وشيخها محمد بن أبي بكر الدلائي، والزاوية الناصرية بدرعة وشيخها محمد بن ناصر، والزاوية الفاسية وشيخها سيدي عبد القادر الفاسي. فرغم تباين مواقعها الجغرافية، فقد كانت على تواصل مستمر عن طريق التزاور والتراسل والأخذ والعطاء، مما خلق بينها تفاعلاً أثمر تقاربًا في وسائل العمل وتماثلاً في النتائج.
وعلى المستوى الخارجي، نجد مثالاً عند محمد بن أبي بكر الدلائي الذي اتصل، أثناء رحلة الحج، بالشيخ محمد البكري شيخ الطريقة بمصر، فأخذ عنه طريقته وروى عنه “صلاة الفاتح لما أُغلق”، ثم لقنها لمريديه في الزاوية الدلائية، وما تزال هذه الصلاة معتمدة لدى الطريقة التيجانية حتى اليوم.
كما يتجلى التبادل الخارجي في شيوع ألحان الأزجال والموشحات التي وضعها الموسيقي والصوفي الكبير علي بن عبد الله الششتري في العهد المريني، حيث تلقاها رجال الصوفية وأنشدوها في حلقات الذكر. وما تزال مميزاتها اللحنية بارزة حتى اليوم في نوبات المألوف الأربعة عشر بتونس، كما لا تزال تظهر في ألحان “همزية” الإمام البوصيري.
وقد تنوعت أشكال الأغنية الصوفية بتنوع الطرق ومناهج غنائها ورقصها. ولعبت المدنية دوراً في بلورة أسلوب الأداء، فيما ظل غناء البدو متمسكًا بالبساطة. وقد أشار العلامة المختار السوسي إلى الفرق بين غناء الطرقيين في الحاضرة والبادية عند ترجمته للشيخ الحاج علي السوسي الدرقاوي، فقال: “إن الفرق هو أن الحضريين يمدّون الغنة ويؤنِّنون في غنائهم، بخلاف أصحاب الشيخ، فإنهم لم يتربوا عنده بمثل ذلك، بل السماع المطلق. ولهم نغمات غير ما يعهد عند الحضريين، عليها حلية البداوة وبساطتها ورونقها”.
الموسيقى الروحية وآداب الذكر
تتميز الموسيقى الروحية بآداب خاصة في الذكر، منها أن يستمع بعض الذاكرين لبعضهم، فإن كان الشيخ موجودًا فبغنته ينطلقون جميعًا، وإن لم يكن فبغنة أحسنهم صوتًا. ومن آدابها أيضًا أنه إن كان الذاكرون جماعة، فالأولى أن يرفعوا أصواتهم بطريقة واحدة موزونة.
أما في حالة الإنشاد الصوفي الجماعي، فإن المجموعة الصوتية تحرص على أن تكون الأصوات منسجمة ومتناسقة، حتى يكون صوتهم كأنه يخرج من “لهاة واحدة”، لما لذلك من أثر في القلوب. ولهذا، يفضل الذاكرون الغناء الجماعي لأنه أكثر تأثيرًا وأشد قوة في رفع الحجب عن القلب.
وقد أوضح الشيخ محمد المهدي الفاسي في كتابه ممتع الأسماع أن المنشدين في أداء حزب “العزيز ذو الجلال” كانوا يقطعون الألفاظ وفق ما يناسب الطبوع الأندلسية، فيمدون المقصور، ويقصرون الممدود، ويحركون الساكن، ويسكنون المتحرك.
الموسيقى الروحية: مميزات وخصائص
لا تقتصر الموسيقى الروحية على المراسيم الدينية أو المناسبات الخاصة، بل تتجاوز ذلك إلى فضاءات أرحب. فالأذان مثلاً، وهو دعوة إلى الصلاة، يصدح خمس مرات في اليوم من صوامع المساجد ليملأ أرجاء المدن والقرى. وتلاوة القرآن الكريم أيضًا ليست حكرًا على المصلين، بل يستمع إليها الناس صباح مساء عبر الإذاعة والتلفاز، كما تتصدر كثيرًا من الحفلات العامة والخاصة.
ومن مميزات الموسيقى الروحية بالمغرب قيامها غالبًا على الأداء الفردي وخلوها من الآلات الموسيقية، خاصة في الأذان وترتيل القرآن. أما في غيرهما، فالغالب أن يكون الأداء جماعيًّا يتخلله أحيانًا إنشاد فردي أو عزف على الآلات في حالات نادرة.
وعلى الرغم من تداخل الفنون الموسيقية عامة، فإن الموسيقى الروحية تبقى محتفظة بخصوصياتها الواضحة، التي تتجلى في الأجواء التي تمارس فيها، وأساليب أدائها، والملابسات التي تحيط بها. فهي ترتبط بالمراسيم الدينية، كالصلاة والإعلان عنها بالأذان، أو بالمناسبات الكبرى مثل عيدي الفطر والأضحى، أو الاحتفالات الدينية كالمولد النبوي الشريف والهجرة النبوية، مما يجعلها فنًّا أصيلاً يجمع بين البعد الروحي والجمالي.
الموسيقى الروحية: الواحد المتعدد
تتحكم في ممارسة مستعملات الموسيقى الروحية جملة من المواصفات العامة، التي تشكل الإطار الملائم لها، وتتحدد بمقتضاها الشروط النفسية والفنية الكفيلة بخلق المناخ السليم لأدائها. ولهذا، تتميز الموسيقى الروحية بخصائص متعددة، سواء من حيث نوعية الموضوعات التي تتطرق إليها، أو من حيث اعتمادها على ألحان موسيقية مميزة، تشكل في الغالب مزيجًا من الطبوع والمقامات المستعملة في أنماط الموسيقى المغربية. ويمكن تحديد هذه الخصائص من خلال ما يلي:
1- من حيث الموضوعات:
تعتمد الموسيقى الروحية على قصائد منظومة في الذكر لأقطاب الصوفية (ابن الفارض، الششتري، الحراق…)، وعلى ما نظمه أشياخ الطرق ورجالها من أوراد وأحزاب وأدعية؛ مثل دلائل الخيرات للشيخ الجزولي (المتوفى عام 870 هـ)، والصلاة المشيشية لمولاي عبد السلام بن مشيش، وحزب الإبريز للشيخ سيدي محمد بن عيسى، وورد الكتانيين وأذكار الطريقة الوزانية والتيجانية وغيرها. وقد أُلِّف بعض هذه الأوراد بلغة تمزج بين الفصحى والعامية، وأُلِّفت أخرى بإحدى اللهجات الأمازيغية إمعانًا في استنهاض القوم بلسانهم؛ مثل كتاب بحر الدموع للشيخ محمد بن علي الهوزالي، ومنظومة الأصناكي وغيرهما. وقد جمع كلام الصوفية بين المنظوم والمنثور، في حين لا تُنشَد عند طوائف المستمعين إلا الأشعار المنظومة.
2- من حيث الألحان الموسيقية:
تُقدَّم الأغنية الصوفية على ألحان موسيقية هي في الغالب مزيج من الطبوع والمقامات المستعملة في أنماط الموسيقى المغربية، والتي تتشكل أغلبها من الطبوع المستعملة في الموسيقى الأندلسية. وقد أفرد الدلائي خاتمة كتابه لذكر ما هو مستعمل من الطبوع الأندلسية في محافل الذكر عند المتصوفة. فذكر عددًا من طرائق هذه الطبوع الأندلسية: طريقة من الحجازي المشرقي في إحدى وعشرين صنعة، طريقة من الأصبهان في عشر صنعات، طريقة من رمل الماية في خمس صنعات، طريقة غريبة الحسين والصيكة مختلفتين في تسع عشرة صنعة، طريقة من الحجازي الكبير والحصار في اثنتي عشرة صنعة (الأربعة الأخيرة منها تميل إلى طبع عراق العجم، وتتلوها أربع صنعات تميل إلى رمل الذيل، ثم أربع أخرى تخرج فيها إلى طبع الرصد)، وطريقة من المشرقي الصغير في سبع صنعات تليها سبع أخريات في طبع الاستهلال. وهكذا يبلغ عدد طبوع الموسيقى الأندلسية المستخدمة عند أصحاب الذكر (حسب الدلائي) اثني عشر طبعًا. وغالبًا ما يكون الذكر جماعيًّا، مما يرمز إلى التلاحم الروحي الذي يجمع أتباع الطريقة.
3- من حيث الرقص (الشطح):
وجد الصوفية في الرقص خير سبيل إلى استراق القلوب واستلاب الوجدان، وكأنهم يريدون من خلال تعاطيهم للشطح تكسير القيود التي تربطهم بالأرض والناس والحياة المادية، ليحلّوا في الأجواء الروحانية الصافية. ولهذا تتمسك الطرق بالرقص تمسكًا عظيمًا لأنها تعتبره أداة فعالة في تحقيق المقاصد الصوفية، فأصبح يمثل ركنًا من أركان الفن الصوفي إلى جانب الذكر والغناء والموسيقى.
إن أهم ما يميز رقص الطرقيين أنه يسير وفق قواعد وتقاليد متوارثة بين رجال الطرق، ويختلف حركة وقوة وحدة باختلاف الطوائف. فإذا كان مثلاً رقص درقاوة والقاسميين هادئًا يقتصر على الهز العمودي للجسم، فإن رقص احمادشة وعيساوة يعتمد على تحريك قوى الجسم والأطراف مع الضرب العنيف بالأقدام على الأرض. ويبلغ الرقص ذروته عند بعض الطوائف، خاصة عند الانصراف إلى التوسل والجذب على مقاطع كلمة المدد التي تُردَّد على نغمة مكررة، كما هو الشأن عند العيساويين وأهل توات. وفي هذه الحالة يتحد الوجدان ويختلط الإيقاع بالأداء الصوتي، الذي يكاد يتحول إلى حشرجة مختنقة. وقد يستحوذ على المريد في هذه الحالة حالٌ من الوجد يفقد معها وعيه بالناس وما حوله.
وقد أشار ابن خلدون إلى هذه الظاهرة بقوله: “الجسد إذا رجع عن الحس الظاهر إلى الباطن ضعفت أحوال الحس وقويت أحوال الروح وغلب سلطانه وتجدد نشوؤه”. وأضاف أن الذكر كالغذاء لتنمية الروح.
4- الأوراد والذكر:
أصبح التوسل بالأوراد والأذكار يشكل، إلى جانب المواظبة على الصلاة، دعامة أساسية في تكوين المريد وتربيته تربية روحية. كما تساهم الآلات النقرية بدورها في بلورة الخصائص الإيقاعية لأغاني الطرقيين. يظهر ذلك من وفرة الآلات المصاحبة للإنشاد وحركات الرقص؛ كالطبلة لدى القاسميين، والدف والطاسة عند التهاميين، والطارة عند العيساويين، والهواز لدى الهداويين، والتعريجة وأكوال عند احمادشة، والبندير لدى الجيلاليين. وقد نتج عن تداول آلات النقر أن أصبحت بعض إيقاعات الأغاني الصوفية بالغة التعقيد والصعوبة، خاصة لدى احمادشة وهداوة. كما بلغت الأوزان الموسيقية درجة من الاكتمال جعلتها تقوم بذاتها وتستقل بكيانها. ومن أبرز هذه الأوزان: الخمّاري والمزلوك والمجرد عند احمادشة، والرباني والجيلالي والمجرد والجيلالية عند الجيلاليين.وعلى النقيض من الطوائف التي تلجأ إلى صياغة ألحانها في أوزان موسيقية محددة، نجد مريدي الطريقة الجزولية مثلاً يعتمدون على الألفاظ وحدها كأساس للتلحين، فيمدّون أو يقصرون الكلمات ويغيرون حركاتها بما يلائم الألحان، حتى يكاد ينعدم الميزان الموسيقي. وقد انعكست هذه الظاهرة على إنتاجهم الغنائي فجاءت أناشيدهم حرة الأداء، بينما جاءت أغاني الطوائف الأخرى صاخبة الإيقاع، أدعى للتواجد والشرود الفكري، وأقرب إلى الجذب منها إلى الرقص المنتظم.
5- الآلات الموسيقية:
يمكن تصنيف الطوائف الصوفية في المغرب من حيث استعمالها للآلات الموسيقية إلى ثلاث فئات:
– الفئة الأولى: تعتمد على الآلات الوترية، وغالبًا ما يرتبط رجالها بالأوساط البورجوازية والمحافظة. وتلتقي هذه الفئة مع “أجواق الآلة الأندلسية” في استخدام الوترية. من أبرز طوائفها: الصديقية، الحراقية، الريسونية، الشقورية، والدرقاوية. وتكاد تنفرد مدن الشمال المغربي باستخدام هذه الآلات داخل الزوايا، تعبيرًا عن نزعة التحرر وسمة التسامح.
– الفئة الثانية: تعتمد على آلات النفخ والنقر، ومن أبرزها: التهاميين، الغازيين، العيساويين، احمادشة، وجيلالة. وهي طوائف تنتمي إلى أوساط الحرفيين وعامة الشعب. وتحتل آلات النقر فيها المرتبة الأولى، إلى جانب آلات النفخ كالغيطة والليرة والعوادة.
– الفئة الثالثة: تكاد لا تستعمل سوى آلات النقر، مثل طائفة هداوة التي تستخدم الإيقاع الثلاثي في “الأكوال”. وتندرج تحتها الزاوية الحسونية بمدينة سلا، التي تستخدم الطاسة والطبلة والطبل الكبير والطارة (البندير).
أما بعض الطوائف الأخرى فقد وقفت موقفًا سلبيًّا من الآلات الموسيقية فامتنعت عن استعمالها، بينما رحبت بها طرق أخرى ورأت فيها وسيلة جمالية تكمّل الذكر والإنشاد. وقد أشار الشيخ الحسن اليوسي إلى ذلك في روايته عن محمد بن أبي بكر الدلائي، حيث كان ابن حسون يستقبل أصحاب الآلات يوميًّا بزاويته في سلا، معتبرًا أن الأصوات تحمل أسرارًا ومعاني توافق أحوالاً جمالية روحانية. في المقابل، عارض بعض الشعراء والعلماء في المغرب خلال القرن الثالث عشر الهجري ظاهرة استعمال الآلات في الأذكار، معتبرينها انحرافًا عن النقاء الروحي للأوراد الصوفية.
المراجع
(1) محمد حجي: الزاوية الدلائية، الرباط، 1964، ص: 56
(2) الترياق المداوي في أخبار الشيخ سيدي الحاج علي السوسي الدرقاوي، 1381 هـ /1961 م، ص: 206
(3) أبو عبد الله الزواوي، عنوان أهل السر المصون، عن الأعلام للمراكشي، ج4، ص: 93
(4) مفتاح الفلاح عن الأعلام، ج 4، ص: 94
(5) عبد الرحمن بن خلدون المقدمة، الفصل الحادي عشر في عام التصوف، ص: 469
(6) نقلا عن: السعادة الأبدية لابن الموقت، ج 1، ص: 53
(7) محمد بن العباس القباج، الأدب العربي في المغرب الأقصى، ج1، ص: 17