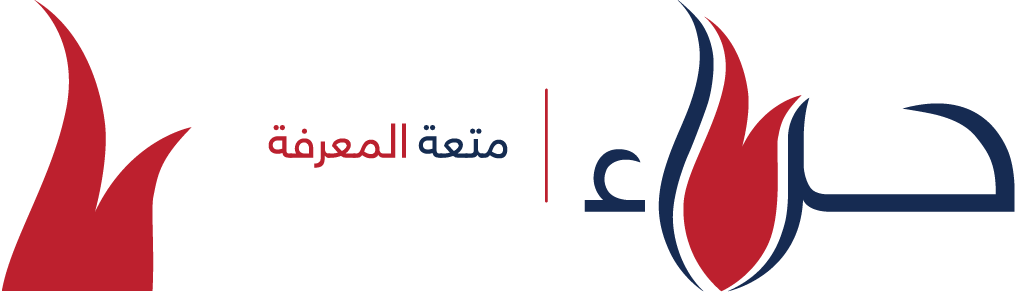مثلت الرواية منذ ظهور الحديث في الثقافة العربية نوعًا من وسائل تعزيز الوعي بالنهضة، وهو ما تجلى في توجه عدد كبير من رواد الإحياء العربي والإسلامي إليها مستثمرين إمكاناتها الفنية والجمالية في دعم مشروعات الإصلاح والنهضة.
مهمة تجلية معالم الطريق للسائرين
لقد فعل ذلك -في الشرق العربي، مشرقه ومغربه- كل من: رفاعة الطهطاوي (ت 1873م) في “تخليص الإبريز في تلخيص باريز” الذي يعده طه عبد المحسن بدر عملاً روائيًّا بصورة ما. وعلي باشا مبارك (ت 1893م) في روايته “علم الدين”. ومالك بن نبي (ت 1973م) في روايته “لبيك حج الفقراء”.
وفعل ذلك في ديار العجم المسلمة -ولا سيما في تركيا- عدد من الأدباء الذين توجهوا إلى التوعية بالأفكار الإسلامية من طريق الرواية من أمثال: أحمد توناي يلديز (1931م)، وحكيم أوغلو إسماعيل (و1932م)، وشعله بوكسل شغار (و1938م)، وياوز بهادر أوغلو (و1945م). فضلاً عن “نجيب فاضل” (ت 1983م).
وتأتي رواية “عودة الفرسان” في هذا السياق الذي يعكس الوعي بسهمة الرواية في خدمة قضايا النهضة والإصلاح من منظور الهوية الإسلامية.
1- عودة الفرسان: خطاب النوع
ترجع أهمية تحليل خطاب النوع إلى أنه مقدمة منهجية لقراءة العمل، واستثماره وتشغيله الحضاري في واقع الأمة. والحقيقة أن الكتاب من منظور خطاب النوع -على ما تهتم به نظرية الأدب- ينتمي إلى حزمة متقاربة من الانتماءات المعرفية هي: حقل رواية السيرة الذاتية أو رواية “ترجمة النفس”، وحقل التراجم والسير، وحقل التاريخ الفكري والحركي الإسلامي المعاصر، وحقل أدب الرحلات، وحقل أدب السجون والمعتقلات.
والحقيقة أن التدليل على الخمسة الانتماءات المعرفية هذه ممكن من خلال تحليل خطاب واجهة العمل من جانب، ومادته المعرفية التي تأسس منها من جانب آخر، وهنا ألتقط شواهد تدعمه وتؤيده.
يعلن فريد الأنصاري (1380هـ-1430هـ/1960-2009م) عن هوية هذا العمل في أكثر من موضع؛ إذ يقرر في عنوانه أن “رواية عودة الفرسان سيرة محمد فتح الله كولن”، ثم هو يختتم العمل (ص٣٣٦) فيقول عنه إنه: “رواية شاعرية النفس، واقعية المضمون، وهّاجة النور، ساحبة الأحزان، شاجية القلب، نازفة الروح، وصية الوجدان، تغني للأمل، تهتف للمستقبل تكفكف الدمع وتمسح الألم”.
ويقول في التقديم (ص7): إن أساس هذا العمل هو: “نصوص الحوار الصحفي الواسع الموسوم بدنياي الصغيرة، حيث عرض فيه الأستاذ فتح الله كولن كثيرًا من فصول حياته، التي كانت المادة الرئيسية لهذا النص”.
وهذا النص الأخير هو المعتمد الظاهر في تعيين نوعها بوصفها رواية سيرة نفس أو رواية ترجمة نفس، ويعزز هذا فيقول (ص7): إنه زود بنصوص أخرى مساعدة “طيلة سنوات من التواصل المثمر، بمعلومات ثمينة عن حقائق تاريخية هامة، ظروف الخدمات الإيمانية بتركيا”، وهو الذي يؤيد انتماء هذا العمل إلى حقل دراسات التاريخ الفكري والحركي المعاصرين، خلال نصوص السيرة أو الترجمة الذاتية للأستاذ كولن.
وأما أنه نص في أدب الرحلات فظاهر جدًّا من نصوص كثيرة جدًّا تصور النزوع الواضح نحو “الهجرة” والسفر لأجل الدعوة، يقول الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله (ص214): “ثم بدأ شوق الهجرة يلهب ضلوعه من جديد؛ فالهجرة في حياة فتح الله منهاج حياة، مسلك روح، وطريق سير إلى الله، ورحلة أبدية في طريق تجديد الدين، وخدمة حقائق الإيمان.. ففتح الله منذ أن سمع نداء الروح لم يزل سائرًا في طريق هجرته المقدسة حتى تفطرت قدماه”. ويقول كذلك ( ص215): “ولكن شوق الهجرة إلى الله كان أقوى بقلبه.. وكان روحًا عاشقًا لرياح الهجرة في سبيل الله”.
ثم إن هذا العمل رواية من أدب السجون بدليل تلك الصفحات الممتدة التي تروي ما كان، مما تعرض له صاحب السيرة وعدد من رفاقه للسجون، يقول (ص227): “ثم بدأت حملة الاعتقالات.. وبقي الاعتقال مستمرًّا على قدم وساق حتى امتلأت السجون.. (ص239)، وهناك في المعتقل العسكري أدخلوه غرفة.. هناك بعدها أدخلوه زنزانة واسعة.. (ص280)، لما أدخلوهم الزنزانة نزعوا منهم كل شيء؛ المصاحف و.. (ص281)، ورغم الظروف السيئة للاعتقال، فقد أصبح ذلك المعتقل معسكرًا ربانيًّا للذكر والعبادة والصلاة.. ( ص286)، كان السجناء يعانون.. فكانوا إذا أغلقوا نوافذ الزنزانة اختنقوا بشدة الحرارة وصاروا كمن في فرن ملتهب”.
وأظن أن هذه النصوص – كافية في هذا السياق- للتدليل على حزمة الانتماءات المعرفية المرصودة تعيينًا لخطاب النوع الحاكم لهذا العمل.
والعمل صالح للتمدد على خريطة خطاب النوع؛ ليكون مثالاً على رواية العائلة التي ترصد تعاقب الأجيال في الأسرة الواحدة، مما يمكن تسميته برواية النهر، التي تبدأ مع جيل الأجداد ثم الآباء، ثم الأخوة في أسرة واحدة، وهي كذلك مثال على الرواية المعرفية التي تصور التطور الفكري والتكويني الذي مر به محمد فتح الله كولن على طريق بناء الذات، والتحول إلى الإسهام في التأثير المعرفي والإيماني في قطاعات ممتدة من جماهير المسلمين في تركيا وسائر بلدان العالم الإسلامي.
2- موجز زمني لحياة رائد رجال النور، فتح الله كولن
إذا صح -وهو صحيح إن شاء الله تعالى- الانتماء المعرفي لهذا العمل إلى رواية ترجمة النفس، فإنه يصبح من المهم التوقف أمام موجز كرونولوجي (زمني) لأحداث هذه الحياة الخصبة المثمرة لصاحب السيرة محمد فتح الله كولن. وفيما يلي محاولة لهذا المخطط الزمني للحادثات الأساسية التي تشكلت على امتدادها سيرة هذا القائد الملهم:
19٤١م: الميلاد. 1945م: بَدْء رحلة التكوين والتعليم في الرابعة من عمره على يد والدته. 1946م: الالتحاق بالمدرسة الابتدائية بالقرية، واستمر بها ثلاث سنوات. 1948م ترك المدرسة. 1949م: الالتحاق بمدرسة سعدي أفندي؛ ليواصل تعليمه النظامي من جديد. وفاة جده “شامل” الذي كان له أثر كبير في تكوينه. 1950م: بدء نشاطه في الوعظ. وفاة الأب الروحي لـ”كولن” الإمام محمد لطفي أفا المعروف بـ”الألورالي”. ترك مدرسة سعدي أفندي ولحوقه بحلقة شيخه عثمان بكتاش. 1957م: تعرفه على رسائل النور لـ”سعيد النورسي”. الانتقال إلى مدينة أدرنه. 1961م: التجنيد الإجباري. 1962م: الرحيل إلى مدينة إسكندرون. 1968م: تأسيس السكن الطلابي. 1968م: وتأسيس المخيمات الدعوية لبناء المسلم المعاصر. 1968م: والحج لأول مرة. 197٤م: الانقلاب الثاني في تركيا والتعرض للمعاناة الطويلة. 1971م: وفاة والد فتح الله كولن. 1977م: توسع الدعوة وخروجها خارج تركيا. 1993م: وفاة والدة الأستاذ فتح الله كولن. 1996م: تأسيس الحوار الوطني. 1999م: خروج فتح الله كولن من تركيا.
وهذا الموجز الكرنولوجي أو الزمني التسلسلي لحياة صاحب السيرة (فتح الله كولن)، تعيد التذكير بمجموعة من القيم التربوية الحضارية بالغة الأهمية هي:
أ- منزلة المَحْضن الأول؛ الأسرة في بناء النفس المسلمة، ولا سيما عندما يكون الوالد والوالدة من هذا النمط الطيب الحريص على الرزق الحلال والتربية الدينية لأبنائهما.
بـ- دور البيت الكبير أو العائلة الممتدة المتمثلة في الأجداد والأعمام، ثم الإخوة والأخوات في تعزيز المنظومة الأخلاقية.
جـ- دور المعلم أو المدرس في التأثير في بناء العقل والضمير المسلم.
د- دور الشيخ والمسجد في حياطة الضمير المسلم وتنميته.
هـ- دور الرحلة والسفر والصحبة الطيبة في تعزيز الملكات والمواهب وتطويرها.
و- دور القراءة الواسعة والمتنوعة في التكوين العقلي، ثم في التأثير الدعوي مع تنوع قطاعات الجماهير المدعوين، وتنوع مشاربهم، وتوجهاتهم وميادين اهتماماتهم.
ز- وضوح أثر المجاهدة الروحية من طرقها السنية النبوية، المتمثلة في الحفاظ على الارتباط بالكتاب العزيز على الدوام، والحرص الشديد على العبادات والعناية بمقاصدها، ولا سيما عبادة الصلاة والصوم بوجه خاص.
3- نهوض رائد النور واللهب: خطاب الفكرة المحورية في سيرة كولن الذاتية
إن تحليل دعوة الفرسان.. سيرة محمد فتح الله كولن، من منظور الكلمات المفتاحية، يكشف عن بروز بالغ الوضوح لثلاث كلمات مفاتيح يمكن أن تمثل محور الدخول إلى مسارات التشغيل الحضاري لهذه السيرة الكريمة في واقع الأمة ومستقبل شعوبها. وهذه الكلمات الثلاث المفتاحية هي: النور، اللهب، الجبل.
أ- مصطلح “النور” يشير في هذه السيرة إلى المنهج؛ من جانب والغاية التي سعت إلى تحقيقها السيرة في واقع الجماهير من جانب ثان. وهو مصطلح قرآني ارتبط “كولن” به من خلال منجَز “سعيد النورسي” (ت 1379هـ/1960م) المشهور بـ”رسائل النور” التي هدفت إلى الإصلاح الإيماني في الأمة على هدي تفعيل الرؤية القرآنية الحيوية.
والنص الممتد لهذا العمل (دعوة الفرسان) يكشف عن حضور طاغ لهذه المفردة/الرمز التي تتحرك بحمولات دلالية بالغة الدفء والثراء والغنى والبشر والأمل والميلاد الجديد.. وفيما يلي جملة من نصوص “النور” في هذه الرواية/السيرة:
– محاضن الطفولة هي مزارع الأسرار، في تربتها تدفن بذور النور. (ص30)
– وللقرآن في زمن الغربة نور لاهب. (ص50)
– وكنت أبيت أتلقى مشاهدات عن بطل النور. (ص61)
– كان الإمام بديع الزمان النورسي قد أشعل قناديل النور. (ص95)
– لكن بديع الزمان.. بقي هناك يبشر الناس بالأمطار والأنوار. (ص 96)
– وعندما وجد فتح الله رسائل النور تكشفت له خريطة فتح العالم. (ص98)
– الآن وجدت النور. (ص102)
– أن تكون طالب نور في زمن الظلمات يعني أنك قد انخرطت في خدمة الروح. (ص162)
– وشاهدت النور يتدفق نحو جميع جهات الأرض. (ص334)
بـ- وأما مصطلح اللهب، فإنه يتحرك على امتداد الثقافات بحمولات دلالية تتعلق بالاختبار والمحنة والتطهير، وكل ذلك تعرض له فتح الله كولن في مسيرته الطويلة الملهمة والمثمرة. وقد استطاع الدكتور فريد الأنصاري -رحمه الله- أن يضع يده على هذا الرمز، ويصوره بلغة شفافة واضحة كاشفة في كل محطات حياة الداعية الكريم.
وفيما يلي جملة من هذه النصوص الكاشفة عن حضور هذا المصطلح المكتنز بالدلالات في هذه السيرة/الرواية:
– ولم يزل في كل عصر يرفدها بنشيج الشرق اللاهب صديق أو شهيد. (ص24)
– وانطلق المطر يهطل على الحرائق المشتعلة بغزارة حتى اغتسلت من أدرانها أغصان السلام. (ص43)
– للقرآن بأرض الغربة نور لاهب. (ص50)
– بدأت أشواق الدراسة.. تلهب آماله الكبرى من حين لآخر. (ص79)
– لقد شاهد فتح الله ببصيرته الصافية ووجدانه الوهاج، تجليات النور.. فما كان منه إلا أن انجذب إلى لهيب الكوكب الدري. (ص104)
– وللشر في ملحمة العصر أخبار من لهب.. لكنه حمل على كتفه رشاش دموعه ودخل في اللهيب. (ص113)
جـ- مصطلح الجبل؛ إذا كان اللهيب يمثل نمطًا من الفتنة، فقد كان النور مادة النجاة من هذا اللهب، وقد تهيأ لهذا النور من يحمل مشاعله فكان جبلاً أو جبالاً اعتصم بها “كولن” حتى صار هو الآخر عاصمًا لقطاعات كثيرة جدًّا ممن اهتدوا بالنور الذي شغله في نفسه وفي حياة الآخرين؛ ليحميهم وينجيهم. وبهذا تحرك الجبل بكل رمزيته وحمولاته الدلالية المستقرة في الثقافة العربية رمزًا للحماية والصيانة والصد والمقاومة ومواجهة المخاطر والفتن. يقول الدكتور فريد الأنصاري: “فتح الله” وارث سرٍّ لو ورثه الجبل العالي لانهدَّ الصخر من أعلى قمته”. (ص13)
لقد صدرت هذه الرواية/السيرة سهمة “كولن” في قيادة جيوش النور التي واجهت جيوش اللهب، بدليل (ص100) نهوض بعد أن “وجد لقاح سره، وبرق غيمته”، في هذه اللحظة تقدم ولسان حاله: “سيركب فرس السلطان محمد الفاتح، ويعبر بقوائمه بحر الظلمات” من جديد؛ لأجل غاية نبيلة هي “تربية الأجيال وإنقاذ الإيمان” (ص121).
(*) أستاذ العلوم واللغة بكلية الآداب، جامعة المنوفية / مصر.
المراجع
(1) عودة الفرسان سيرة محمد فتح الله كولن رائد الفرسان القادمين من وراء الغيب، فريد الأنصاري، دار النيل للطباعة والنشر، القاهرة ٢٠١٠م.
(٢) انظر: تطور الرواية التركية، عائشة عبد الواحد، جامعة طنطا، 2010م، ص:35.