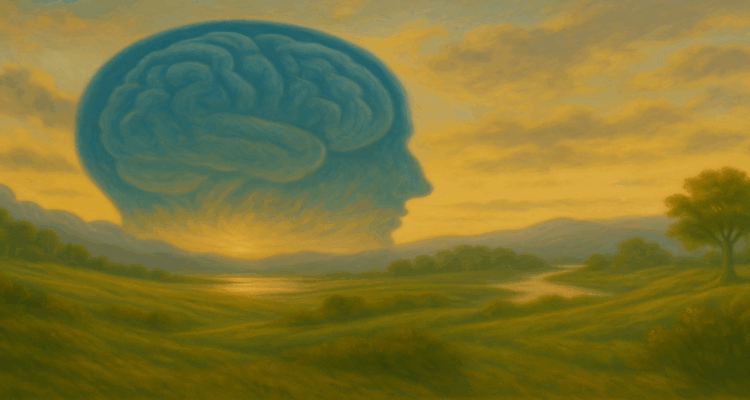كرَّم الله تعالى الإنسان، وجعله خليفةً في الأرض، وجعل العقل سِمَةً تميّزه عن غيره من الكائنات، فكان هذا الجوهر العلامة الفارقة التي بها امتاز الإنسان عن سائر المخلوقات، وبها نال الأفضلية. قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾[الإسراء: 70].
لذا حرَّم الإسلام كل ما يُعطّل هذا الجوهر كيفما كان نوعه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “كلُّ مُسكِرٍ خمر، وكلُّ خمرٍ حرام” [رواه مسلم].
فأغلق الإسلام كل منفذ يمكن أن يكون طريقًا لتعطيل العقل عن أداء وظائفه التي خُلق لأجلها، باعتباره مناط التكليف، وسبيل إدراك عظمة الخالق عبر التدبر في الملكوت، والتأمل في جميل الصنعة وبديع الخلق، لإدراك الحقيقة الواحدة لهذا الكون، وهي وحدانية الله تعالى، لإفراده بالربوبية والألوهية.
العقل بين الفلسفة والدين
مجّدت الفلسفة في مهدها اليوناني العقل، ومنحته القداسة الكبرى، معتبرةً إيّاه الطريق الأوحد نحو التأمل وإعمال الفكر لإدراك حقيقة الوجود. فارتبط التصور الأول للفلسفة الأفلاطونية، في بعدها المثالي الطوباوي، بالعقل، حتى قال أفلاطون: “لا يدخل أكاديميتنا إلا من كان رياضيًّا”، كنايةً عن استخدام العقل وما يستلزمه من آليات منطقية.
فعدَّ العقل جوهرًا منذ أفلاطون إلى ديكارت في القرن السابع عشر، حيث اعتبر الفيلسوف الفرنسي أن العقل وحده هو الطريق لإدراك الحقيقة التي لا تستطيع الحواس إدراكها، فظلت العقلانية نزعة فلسفية تمجّد العقل كجوهر، إلى أن تعاملت الأنساق الفلسفية في أوروبا مع العقل كأداة، في محاولةٍ للإجابة عن سؤال: كيف يعقل العقل؟
فأرست الفلسفة الحديثة بعد ديكارت تفكيرًا جديدًا عن العقل باعتباره أداةً لإدراك العالم وفهم الوجود.
إن هذا التمجيد لا يختلف عن المنظور الديني من حيث فعل الإعلاء، فقد أولى الخطاب الديني للعقل عناية كبرى، وأنزله منزلةً متخيرة رفعت الإنسان إلى درجة الأفضلية على بقية المخلوقات، وهو شأن عالِ المقام لا يدركه إلا أولو الألباب.
وقد وردت في القرآن آياتٌ كثيرة تحدّثت عن العقل بتعظيم وثناء ومدح، وذمّت في مقابله اللاعقل، مُدرجةً إيّاه في قائمة الدواب غير العاقلة، قال تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾[الأنفال: 22].
فكان الذم والاستهجان القرآني قوي النبرة في شأن من لا يستخدم عقله لإدراك الوجود ومعرفة خالقه، فهو لا يقلّ شأنًا عن بهيمة الأنعام، بل هو أضل، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾[الأعراف: 179].
وتعدّدت المفردات المنتمية لحقل العقل من تفكّر وتدبّر وتبصّر ونظر، ووردت كلمة العقل بمرادفاتها كالنهى واللب والحلم والفؤاد، ما يدل على العناية الكبرى للخطاب القرآني بالعقل.
وبهٰذا زكّى مقامه سواء في إلحاحه على التدبّر والتفكّر في آيات الله الدالة على وجوده، قال تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[العنكبوت: 20]. في دعوةٍ صريحة للنظر العقلي في الكون لمعرفة كيفية بداية الخلق، وهذا لا يتأتى إلا بأدوات العلم والمعرفة.
وفي مقامٍ آخر، نجد الدعوة إلى التفكّر في الخلق واضحة المعالم، كجزءٍ من التعبّد للإنسان المؤمن الذي يزداد يقينه إيمانًا بإعمال العقل في إدراك الموجودات، ومعرفة أسرار الخلق والصنعة فيها التي تدل على طلاقة القدرة وتشهد لله تعالى بالوحدانية، يقول تعالى: ﴿قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾[يونس: 101].
وفي توجيه الخطاب بما يحتاج لإعمال العقل لأهله من الفاهمين والمجتهدين، يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾[البقرة: 164].
فهٰذه الآيات على تعدّدها لم تُذكَر إلا لتكون أدلةً متكاثرة، فاسحةً للعقول بالإدراك حسب مقدرتها وإمكاناتها الاستيعابية.
ولا بدّ أن العقل يظل الطريق الأوحد لمعرفة وجه القدرة الكامنة فيها، من حيث إدراك خصائصها الطبيعية، التي يستطيعها العقل والعلم، أو تدركها الحواس التي لا تستطيع إنكار مشهدٍ كإنبات الأرض بعد قَحْطٍ.
ولذلك نجد القرآن ينتقي مخاطبيه ويتوجه إلى فئة بعينها تمتاز بخصيصةٍ تميزها عن غيرها كلما استدعى مقام الخطاب تصنيفًا دقيقًا، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾[آل عمران: 190].
فما احتاج للعقل خُوطب بأهله، كآيات الخلق، وما استلزم العلم خوطب به أهل العلم، كما في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾[الأنعام: 97].
وما احتاج إلى الفقه خوطب به أهله، كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾[الأنعام: 98].
وكل هذه الفواصل القرآنية بؤرتها المركزية هي: العقل، الذي يظل في التصور الإسلامي ذا قيمةٍ عليا، استوجبت الحفاظ عليها، ضمانًا لسلامته وسلامة بقية الحواس والجوارح.
العقل مناط التكليف وسبيل التوحيد
جعل الإسلامُ العقلَ شرطًا من شروط التكليف، فأسقطَ التكليفَ عن المجنون، لذلك أوجب الإسلام على الإنسان حفظَ العقل، وحرَّم أيَّ مُسكِرٍ من شأنه أن يذهب به ويفقده قُدرته على التمييز بين الحسن والقبيح، والرديء والجميل، والخير والشر؛ إذ به يُدرك الإنسانُ التكاليفَ الشرعية التي أوجبها الله عليه. فلا تصحُّ الأعمال ولا تُقبل إلا إذا أدركت النفسُ صنيعَها ووعَت فِعلَها.
وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن: “مَن كان مسلوبَ العقل أو مجنونًا فغايتُه أن يكون القلم رُفع عنه، فليس عليه عقاب، ولا يصحُّ إيمانه ولا صلاتُه ولا صيامُه، ولا شيءٌ من أعماله؛ فإن الأعمالَ كلَّها لا تُقبل إلا مع العقل، فمن لا يعقِل لا تصح عبادته، لا فرائضه ولا نوافله، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي ٱلنُّهَىٰ﴾[طه: 128]”. ومن هنا كان الحرصُ كبيرًا على العناية بالعقل، حتى يكون صاحبُه مؤديًا لشرع الله في الأرض، فتستقيم الحياة وتنبني على مراد الله. فسدَّ الإسلامُ كلَّ طريقٍ لإفساده، ولو كان بقطرة خمر، لأنها سببٌ لشرب كثيرٍ منه، كما قال ابن تيمية: “ولهذا حرَّم الله إزالةَ العقل بكلِّ طريق، وحرَّم ما يكون ذريعةً إلى إزالة العقل، كشرْبِ الخمر، فحرَّم القَطْرَةَ فيها، وإن لم تُزِل العقل، لأنها ذريعةٌ لشرب الكثير الذي يُزيل العقل”.
وجعل الإسلامُ العقلَ أداةً للتدبّر والتفكّر في القرآن، لما يحمله من ألوانٍ معجزة، فيكون طريقًا إلى تثبيت الإيمان بالله. قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾[محمد: 24].
وكذلك للتفكّر في ملكوت السماوات والأرض، وتأمُّل مخلوقات الله لاستكناه عظمته المتجلية فيها، قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ * فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ﴾[الغاشية: 17-21].
فيكون العقلُ بذلك طريقًا نحو إدراك عظمة الخالق حينما يُمعن في التدبّر والتفكر في سرِّ الخلق وجماله وتناسُقه، وحُسن صَنعته. ويزدادُ يقينُه أكثر حين يكون العلمُ نِبراسَه في ذلك، فتزداد الخشيةُ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُاْ﴾[فاطر: 28]، إذ يكون أهلُ العلم أكثرَ من غيرهم يقينًا لما حققه العلم في نفوسهم من إدراكٍ ملموسٍ وبيِّنٍ للحقائق.
العقل نعمة عظمى لبناء الحضارة
لا تقتصرُ وظيفةُ العقل في الإسلام على التكليف الشرعي والتدبّر في الخلق والملكوت، وإنما جعله الإسلامُ وسيلةً لإعمار الأرض وتحقيق الخلافة التي أرادها الله تعالى لعباده. فتعمر الأرض وتزدهر الحياة وفق منهج الله وشرعه الذي ارتضاه لخلقه، وفق الحكم التي يعلمها الإنسان أو التي لا يعلمها.
فتُبنى الحضارةُ، ويرقى الإنسانُ في مدارجها، فيحيا في سلامٍ وهناءٍ ووئام، يعبد الله ويوحده، مؤديًا ما عليه من رسالة وأمانة حَمَلها. لذا، فالناظرُ إلى الأمم التي مجّدت العقل، وعملت على شَحذِه وتفتيق طاقاته، استطاعت أن تبلُغ أعلى المنازل في سُلَّم الحضارة الإنسانية، بل وتمكّنت من قيادة العالم.
ولعلّ تمجيدَ العقل هنا لا يكون إلا برفع شأنِ العلم في أوساطها، وتقدير العلماء ورفع مكانتهم بين الناس، فتصبو القلوب إليهم، وتجلّهم، وترنو إليهم الأبصار إعجابًا بمنجزاتهم.
ولعلّ عودةً سريعةً إلى استنطاق تاريخنا العربي ستؤكّد بجلاء هذه الحقيقة الضائعة الآن؛ فالعصر الذهبي للإسلام شهد حَراكًا محمومًا نحو التأليف والإنتاج العلمي في شتى فروع المعرفة، حينما مُجِّدَ العلم، ودَفعت السلطةُ بالعقل قدمًا في محضنٍ عربيٍّ شديدِ الاغتناء الثقافي بفعل روافدَ دخيلةٍ من الفرس واليونان والهند وغيرها.
لذا، فتمجيد العقل هو تمجيدٌ للعلم، ما يُمهد الطريق نحو البناء والرقيّ الحضاري، الذي نلحظه في بلدان الغرب، التي سارت على نسقٍ تصاعدي، رافعةً من قاطرة العلوم، صانعةً للعقول القادرة على حمل مشعل التقدُّم وقيادة الركب الحضاري.
العقل نعمة منسية
كثيرًا ما يتأمّل الإنسانُ في النِّعم التي وهبها الله تعالى له، فينظر في نعمٍ مادية كالولد، والعقار، والمتاع، والزوج… وأحيانًا قد يلتفت إلى نِعَم الحواس والجوارح والصحة، فيحمد الله على نعيمه. لكنه يتناسى نعمةً كبرى، لولاها لما استقامت دنياه، ولضلَّ في السبل خبطَ عشواء.
نعمةٌ لا يتفكّر فيها المرء إلا نادرًا، حين يرى أمامه مجنونًا يهذي بكلام، أو يسير بلا هُدى، أو يزور مستشفى للمجانين، فيرى كيف يحيا أولئك الذين فقدوا أعظمَ النعم.
ومن هنا، كان لفْتُ الإسلامِ النظرَ لنعمةِ العقلِ عبر التدبر والتفكر والنظر، لا لإدراك عظمة الخالق فحسب، وإنما لتبيُّن حقيقة العقل وقيمته كجوهرٍ إنسانيٍّ به يمتاز هذا الكائنُ عن غيره. لأن أي انحدار به عبر التعطيل، سيضع الإنسانَ الذي كرّمه الله تعالى في مرتبة البهيمة، وهذه منزلةٌ لا تليقُ بشرف الإنسان، الذي جعله الله خليفةً له في الأرض، يُعمِّرها بالخير والنبل، وينشر فيها الفضائل ومكارم الأخلاق.
الهوامش:
– أحمد بن تيمية، فتاوى الرياض، 10/435، 436.
– ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، 10/444.