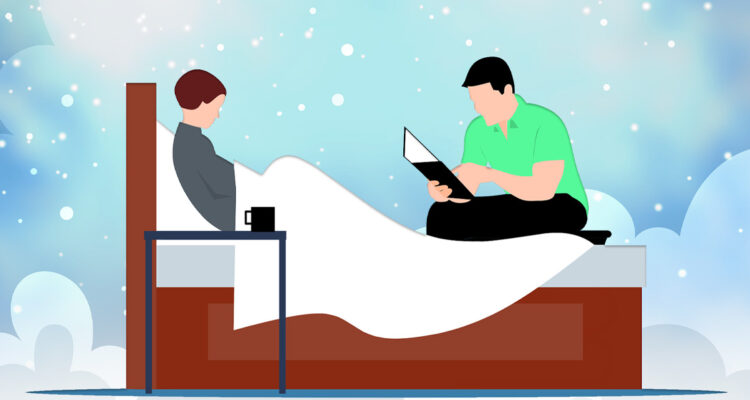يقوم العمل الأدبي -في العموم- على ثلاثة عناصر رئيسة، هي المبدع، والنص، والقارئ أو المتلقي. وهي عناصر لا يتحقق لها الوجود الفعلي إلا مجتمعة؛ فلا يوجد نص دون مبدع، وليس للنص وجود فعلي دون قارئ أو متلقٍّ.
وأدب الأطفال، بوصفه نوعًا من الأدب، تقوم أعماله كذلك على هذه العناصر الثلاث. غير أن لأدب الأطفال طبيعة خاصة، فهو يوجَّه إلى فئة محددة من المتلقين، هم الأطفال الذين يختلفون -بطبيعة الحال- عن الكبار في تكوينهم العقلي والفكري والنفسي.. مما يفرض على المبدع أن يقدم نصًّا يسهل على الطفل استيعابه، والإفادة منه على مختلف المستويات التربوية، والعقلية، والنفسية.
من المعروف أن النمو النفسي للطفل يتم بتضافر عوامل عدة، يأتي أدب الأطفال بوصفه واحدًا منها. ولعل أبرز أنواع ذلك الأدب قربًا من الطفل هو الحكايات بنوعيها الشعرية والنثرية.
فالطفل بطبيعة تكوينه النفسي، ينجذب إلى الحكايات بشكل واضح. ولا شك أن الحكايات الموجَّهة للأطفال، يمكن أن تسهم في البناء النفسي للطفل، بحيث يسير هذا النمو في مساره الطبيعي أو الصحيح إذا كانت تلك الحكايات قادرة على إشباع المتطلبات النفسية له. وحتى يتحقق ذلك، ينبغي أن يشعر الطفل أن تلك الحكايات تمثل أهمية بالنسبة له، كأن تكون هذه الحكايات قادرة -على سبيل المثال- على أن تدفعه لإتمام عمل يود القيام به بعد أن تثير في داخله حب هذا العمل، والحرص على إتمامه.. أو أن تكون هذه الحكايات قادرة على دفع الطفل إلى تَعَلُّم أشياء كان يود أن يتعلمها. ويمكن أن نضرب مثالاً على ذلك، قصة “الحصان الوحيد” لـ”زكريا تامر”، التي تقدم للطفل بأسلوب يسير للغاية، فكرة لا غنى له عنها مفادها، أن الإنسان كسائر المخلوقات، لا يستطيع العيش وحيدًا، فلا بد له من الانخراط في المجتمع أو البيئة المحيطة. ولا شك أن استيعاب الطفل لهذه الفكرة وقبوله لها، يسهم بدور كبير في تهيئته نفسيًّا للعيش داخل المجتمع بشكل سوي.
وينبغي للحكايات الموجَّهة للأطفال -كذلك- أن تراعي حاجاتهم النفسية، بحيث تتجنب هذه الحكايات تناول الموضوعات ذات الأحداث المعقدة، أو المركبة، أو المتداخلة، أو العميقة.. وأن تأتي تلك الأحداث على صورة متوالية حتى يسهل على الطفل متابعتها. وينبغي لهذه الحكايات كذلك، ألا تنطوي على تحليلات نفسية دقيقة لسلوكيات البشر وطبائعهم، ويمكن أن نضرب مثالاً على ذلك، قصيدة “البومة والطاووس”، لـ”محمد مفتاح الفيتوري”، التي تقدم للطفل بأسلوب رمزي بسيط للغاية، قصة شعرية يتعلم الطفل منها خُلُق التواضع؛ فلا يحق لإنسان أن يفتخر على غيره بنعمة وهبه الله إياها. وقد قدم “الفيتوري” هذه الفكرة على لسان الطير، إذ يفتخر الطاووس بجماله أمام البومة الكريهة الدميمة، فترد عليه البومة بأنه لولا قبحها ما ظهر جمال الطاووس، يقول الفيتوري:
وقالت البومة للطاووس:
لولا صورتي الكريهة الدميمة
ما كنت تمشي الخيلاء معجبًا
بريشك الجميل.
فابتسم الطاووس ضاحكًا وقال:
صدقت يا سيدتي الحكيمة.
وحتى تحقق حكايات الأطفال غايتها في إشباع الجانب النفسي لدى الطفل وتنميته، فإن أسلوبها ينبغي أن يكون بسيطًا، وغنيًّا بالصور الموحية، التي تقوم على الأوصاف الحسية التي يسهل على الطفل إدراكها. ويمكن أن نضرب مثالاً على ذلك، قصة “الشاطر محظوظ” لـ”يعقوب الشاروني”، التي جاء أسلوبها بسيطًا.. فجمل القصة قصيرة، ومفرداتها سهلة، وتراكيبها واضحة، وصورها موحية.. وهو ما يتضح من خلال هذا المقتبس من القصة: “بعد سفر طويل، وصل محظوظ مع زملائه الخمسة إلى مدينة عظيمة، بيوتها بيضاء، ونوافذها كبيرة، وطرقاتها متعرجة، ويتوسطها قصر كبير ذو قباب عالية، وعلى الفور أدرك محظوظ أنها مدينة الأميرة”.
وينبغي كذلك للقصص الموجَّهة للأطفال، ألا تثير موضوعاتها قلق الطفل فتفزعه أو تخيفه.. فالقصص التي تحكي عن الأشباح -على سبيل المثال- تثير مخاوف الطفل من هذه الأشباح، لدرجة يصعب فيما بعد التغلب عليها.
وتسهم الحكايات الموجَّهة للأطفال بدور كبير في ترسيخ كثير من المعارف والعادات السلوكية التي تدعم النمو النفسي للطفل، إذ تسلط هذه الحكايات الضوء على الجوانب الروحية للطفل، الدينية والأخلاقية، فتهذب سلوكه. ويمكن أن نضرب مثالاً على ذلك، قصيدة “الثعلب والديك” الشهيرة لـ”أحمد شوقي”، التي يقدم فيها للطفل بأسلوب غير مباشر، قيمة أخلاقية تتمثل في ضرورة الابتعاد عن الكذب، وتجنب المكر والخديعة. ويطرح شوقي ذلك من خلال قصة شعرية خيالية تدور أحداثها على ألسنة الحيوانات والطيور، يقول:
| بَـــرَز الـــثـــعـــلـــبُ يــــــومًــــا | في شِعار الواعظيـنا |
| فَمشى في الأرض يَهْدي | ويَـــسُـــبُّ الماكـريـنـا |
| ويــــــقــــول الـــــحـــــمـــد لله | إلـــــــه الــــعــــالـميـــــنـا |
| يــــــا عـــــبــــاد الله تـــــوبـــــوا | فهو كهفُ التــائبيـــنا |
| وازهدوا في الطيْـر إن الـ | عيش عيشُ الزاهديــنا |
| واطْــلُــبوا الــديـــك يـــؤذن | لصَلاة الصُّبْـح فيــنا |
| فأتـــى الديـــــكَ رَسُـــــــــول | مِن إمام الناســكـيــنا |
| عَـــــرَضَ الأمــــــرَ عَــلَـــيـــــهِ | وهو يَرجو أن يَلـيــنا |
| فــأجـــــاب الديــــكُ عُــذْرًا | يا أضَــل المهـتـديــنا |
| بَــــلِّـــــغ الـثـعـلـبَ عــــنــــي | عنْ جُدودي الصالحــينا |
| عـن ذَوي التِّـيجان مِـمَّــن | دَخلَ البَطْنَ اللعيــنا |
| إنـــهـــم قــــالـــوا وخـــيرُ الـ | قَوْلِ قَوْلُ العـارفـيـنا |
| مُخـطــئٌ مَــنْ ظَــنّ يَـــومًــا | أنَّ لِلــثـــعــلَبِ ديـــــنا |
وينبغي للحكايات الموجَّهة للأطفال كذلك، أن تكون قادرة على إشباع حاجة الطفل النفسية إلى المعرفة التي تعينه على إدراك العالم من حوله، كإمداده بالمعارف المتصلة بخصال الحيوانات، وبيئات النباتات، وغير ذلك. وينبغي أن تُقَدَّم هذه المعرفة للطفل بأسلوب غير مباشر، حيث الطفل يتذمَّر من المعرفة التي تُقَدَّم له بأسلوب مباشر. ويمكن أن نضرب مثالاً على ذلك، سلسلة “حكايات من عمان” لـ”يعقوب الشاروني”. ولا شك أن معرفة الطفل بطبيعة العالم أو البيئة المحيطة به، تهيئه نفسيًّا لتقبُّل هذا العالم، وتمنح الطفل القدرة على التعامل -فيما بعد- مع هذا العالم بأسلوب سوي.
غير أنه ينبغي للمبدع أن يكون دائمًا على وعي تام بالعنصر الجمالي للأدب، فلا ينشغل عنه بالمعلومات والمعارف التي يقدمها للطفل، بل عليه أن يحرص على تقديم هذه المعارف في أسلوب جمالي يحقق للطفل المتعة النفسية.
وينبغي للحكايات الموجَّهة للأطفال أن تغرس في نفوسهم القيم النبيلة والأخلاق الحميدة، لأن الطفل يتأثر بشكل لاشعوري بأبطال الحكايات وشخوصها، فيقتدي بها، ويحاكي سلوكياتها، فيكتسب منها قيمًا سلوكية نبيلة، مثل تحمُّل المسؤولية والصدق، ومساعدة المحتاجين، وبر الوالدين، وحب الوطن والفخر بالانتماء إليه.. ويمكن أن نضرب مثالاً على ذلك، بالحكايات التاريخية الموجَّهة للطفل؛ إذ يربط هذا النوع من الحكايات حاضر الطفل بماضيه، مما يقوِّي لدى الطفل الشعور بالانتماء إلى وطنه.. ولعل قصص “معارك المغرب التاريخية” لـ”حميد السملالي” خير مثال على ذلك.
ومن الضروري كذلك أن تنمِّي الحكايات الموجَّهة للأطفال ثقة الطفل في ذاته، مما يجعله مؤهلاً نفسيًّا لتحدي الصعوبات -التي تواجهه- وتجاوزها مهما كانت صعبة أو شاقة. وهذا بطبيعة الحال، يولِّد لدى الطفل شعورًا سويًّا بذاته القادرة على العمل، كما يولِّد لديه كذلك الشعور بدوره الفاعل والمهم في الحياة. ويمكن أن نضرب مثالاً على ذلك بما جاء في قصة “عاقبة الغدر” لـ”الهادي بن ضياء”، فحين يرى محمود شيخًا ينزف الدم من جسمه، يسارع إلى إنقاذه إحساسًا منه بالمسؤولية تجاه هذا الشيخ: “كانت القافلة الصغيرة تواصل طريقها، والأصدقاء يتبادلون الذكريات والأقاصيص الطريفة ليبعدوا عن أنفسهم عناء السفر، وبينما هم يتجاذبون أطراف الحديث، إذ لفت انتباههم شيخ ينزف الدم من جسمه، فنزل محمود عن راحلته، وحاول مرافقوه منعه من ذلك”.
وينبغي للحكايات الموجَّهة للأطفال كذلك أن تنمي قدرات الطفل العقلية، مما يجعله مؤهلاً -فيما بعد- لحل المشكلات بطريقة يسيرة. وتسهم قصص الألغاز بدور كبير في تنمية ذلك الجانب لدى الطفل، وتأهيله للاعتماد على نفسه في تحديد المشكلة، وتحديد الطريقة الأنسب لحلها.
ومن الضروري أن تراعي الحكايات الموجَّهة للأطفال، إشباع حاجة الطفل النفسية إلى اللعب والترفيه والتسلية؛ فالطفل بطبيعة تكوينه النفسي، يميل نحو قراءة الحكايات المسلية أو سماعها، إذ تأخذه هذه الحكايات نحو عالم خيالي يحقق فيه الطفل رغباته، على نحو لا يتحقق في عالم الواقع. وقد نجد هذا في معظم الحكايات الموجهة للأطفال، فمعظم هذه الحكايات، لها -إلى جانب دورها التربوي- جانب آخر خاص بتسلية الطفل وإمتاعه. ويمكن أن نضرب مثالاً على ذلك مجموعة “قصص فكاهية” لـ”كامل كيلاني”.
وحتى تحقق الحكايات الموجَّهة للأطفال غاياتها النفسية، فلا بد أن تراعي مستوى الطفل العقلي ومرحلته العمرية؛ فلا يحاول المبدع إقناع الطفل بأفكار لا تناسب مستواه العقلي أو العمري. ويستلزم هذا من المبدع أن يكون على تواصل جيد مع الأطفال، حتى يتسنى له فهمهم على الوجه الصحيح.
وينبغي للحكايات الموجَّهة للأطفال ألا تقدم لهم صورة غير صحيحة عن الحياة؛ فلا تصور لهم الناس على أنهم جميعًا سعداء، أو خيِّرون، أو متعاونون.. أو أنهم جميعًا -خلافًا لذلك- أشقياء أو أشرار أو تغلب عليهم الأنانية.. لأن الطفل يُشَكِّل -نتيجة لذلك- صورة مغلوطة عن الحياة لا تعينه على التعامل معها فيما بعد، بأسلوب سوي.
(*) كلية الآداب، قسم اللغة العربية، جامعة بني سويف / مصر.