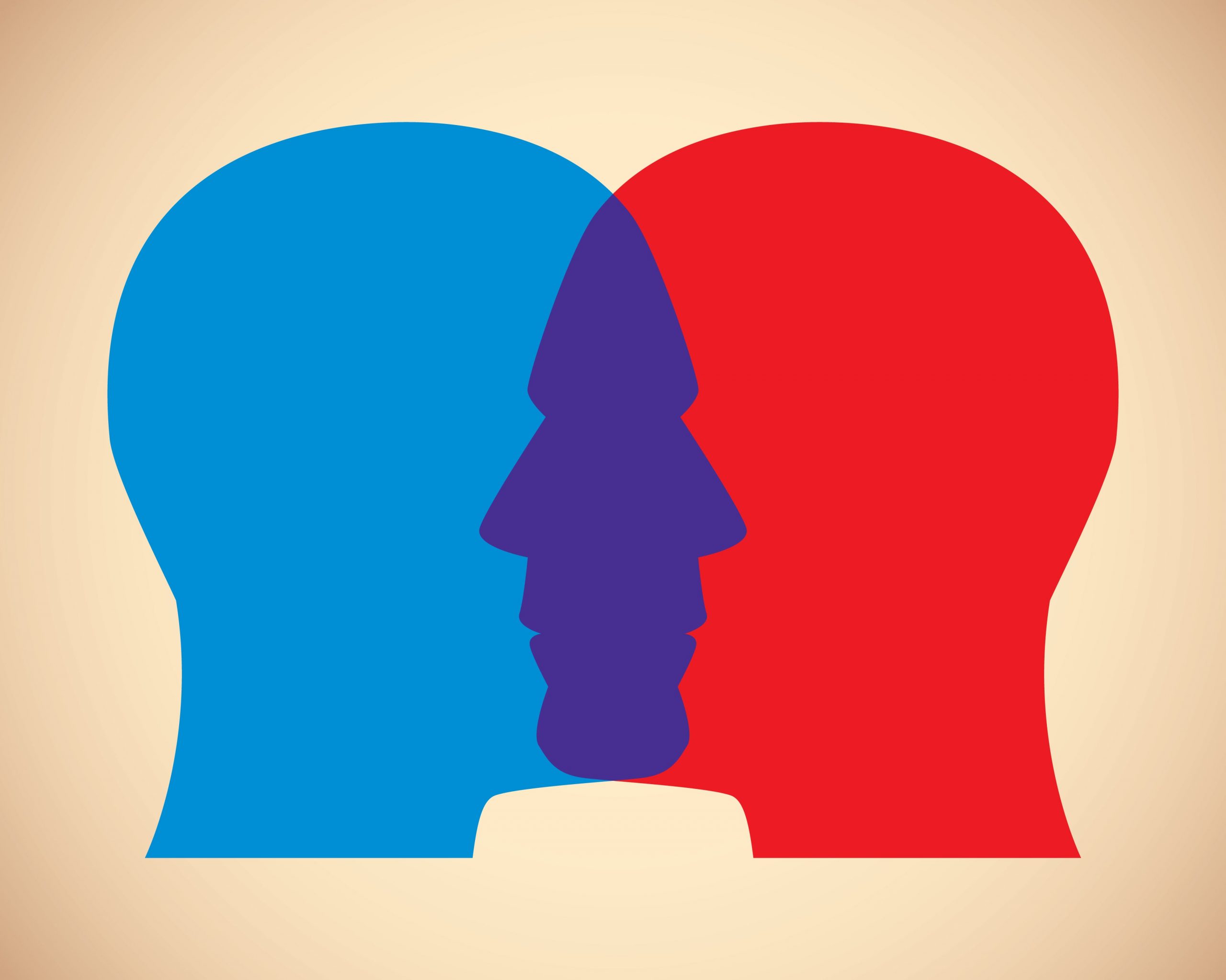ما زالت أمتنا الإسلامية تتطلع إلى تغيير واقعها إلى الأحسن، ويمكن وصف حالها بالقول إنها:
أمة ميزتها اليوم عن كل الأممِ ..
فتوحات عظمى لجبهات الجراح والألمِ ..
سمتها الذل والهوان والتأخر عن ركب التقدمِ ..
شغلت نفسها بالتغني بالماضي والكثير من الأماني والأحلامِ ..
وتوسلات إلى الله أن يرفع ما مسها من ضرٍّ وهمِّ ..
تقول: “هل من نهاية لما نحن فيه؟ ومتى الخروج من هذا النفق المظلمِ؟”.
وقد بُذل فيها العديد من المساعي للتغيير، واختلفت الطرق إليه، وكثرت الاجتهادات والآراء حوله، ونشأت جماعات وحركات لأجله، بل وشهدنا صراعات ونزاعات، لكن لم يتحقق التغيير الحقيقي بعد، ولم توضع مشاكل الواقع الكبرى على سكة الحل، مما يبقي موضوع التغيير موضوعاً راهناً وأولويًّا، طالما الحال على ما هو. فمطلوب مزيد الانشغال به فكرًا وعملاً وإن طُرق كثيراً وقُتل بحثاً، فهو من المواضيع الممتدة صلاحيتها إلى أن تتحقق على أرض الواقع، وتوضع الأمور في نصابها.
وطالما نتحدث عن تغيير واقع أمة إسلامية، فإننا نتحدث عن مرجعيتها في ذلك، أساس بنائها، وعمدة قيامها، المشَكِّلَةِ لمعادلتها الاجتماعية والثقافية والنفسية، ولا يمكن أن تكون إلا المرجعية الإسلامية. هذه الأخيرة تنص على أن تغيير واقعها متعذر ما لم تُحدث التغيير الأساس الداخلي، ألا وهو تغيير ما بالأنفس، سنة الله التي لا تتبدل ولا تتحول؛ إذ قال سبحانه: (إِنَّ ٱللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَومٍ حَتَّىٰ یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِم) الرعد(11).
إن الآية تنص صراحةً على “أن التغيير يبدأ من الذات المغيِّرة (التي تريد التغيير)، وليس من الذات التي يراد تغييرها، وتحديد المنطلقات والأوليات والأولويات شيء مهم، فالتغيير يبدأ من الذات … التغيير النفسي من عندنا، وحين نغير ما بأنفسنا فإن الجو سيتهيأ للتغيير”.
ذلك هو المنهج الرباني في التغيير الاجتماعي والبعث الحضاري، المشتملُ على بيان ما يجب أن يكون عليه حال الإنسان يؤهله لأداء رسالته الإصلاحية في الواقع كما يرضى الله سبحانه؛ فلم يدعه لنفسه المليئة بالشوائب، والممكنة بأخطر الملكات والقدرات، يفعل ما يريد كما يريد، بل شرع له سبيلاً تغييريا لما بنفسه يطهرها من الشوائب، ويوجه ملكاته في الاتجاه الصحيح الباني للحياة، المعمر للأرض المصلح لها.
ونعتقد أن طرح موضوع تغيير ما بالأنفس ينبغي أن ينطلق من مقدمات أساسية مترابطة يفضي الواحد منها إلى الآخر:
أولا: الانطلاق من مبدأ “العيب فينا والمشكل من عندنا“
إن سوء الواقع الإسلامي قد يجعل البعض يقول: أنى هذا الحال من التخلف والانهزام والشقاء والعسر في الحياة، -وقد قالوا ذلك في عهد التنزيل لقوله تعالى:(أَوَلَمَّاۤ أَصَـٰبَتۡكُم مُّصِیبَةࣱ قَدۡ أَصَبۡتُم مِّثۡلَیۡهَا قُلۡتُمۡ أَنَّىٰ هَـٰذَا)( آل عمران:١٦٥) ونحن مسلمون مؤمنون بالله وبدينه، يفترض أن نكون منتصرين، وممكنين في الأرض، ونحيى الحياة الطيبة، وألا نشقى ونعيش في الضنك، مصداقا لقوله تعالى:(طَهَ * مَاۤ أَنزَلۡنَا عَلَیۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ لِتَشۡقَىٰۤ)(طه:١-٢)، وقوله سبحانه: (یُرِیدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡیُسۡرَ وَلَا یُرِیدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ)(البقرة:١٨٥)، وقوله: (مَنۡ عَمِلَ صَـٰلِحࣰا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنࣱ فَلَنُحۡیِیَنَّهُۥحَیَوٰةࣰ طَیِّبَةࣰ) (النحل:٩٧)، وقوله:(وَكَانَ حَقًّا عَلَیۡنَا نَصۡرُ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ)(الروم:٤٧).
والقرآن يجيب على هذا الاستشكال بقوله تعالى:(قُلۡ هُوَ مِنۡ عِندِ أَنفُسِكُمۡ)(آل عمران:١٦٥) ، وقوله: (ذَ ٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتۡ أَیۡدِیكُمۡ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَیۡسَ بِظَلَّامࣲ لِّلۡعَبِیدِ)( آل عمران:١٨٢)، إن الآيات في هذه المسألة كثيرة، مؤداها ترسيخ تلك القاعدة، التي تفسر للمسلمين أوضاعهم في كل زمان ومكان، وهي أن مرد مشكلاتهم كيفما كانت إلى ما بأنفسهم، ومن الظلم الذي يلحقونه بأنفسهم. وكذا تثبيت منطق الواجب لديهم، الذي يحتم عليهم تحصيل ذلك السبب الأعظم لتغيير واقعهم، ألا وهو تغيير ما بالأنفس، ذلك الدور الأساس في قضيتنا التغييرية برمتها.
فيحتاج المسلمون إذاً، إيقاف بكائياتهم وغنائياتهم الحزينة، والكف عن أحلامهم الوردية دون أي فعل أو إنجاز على الأرض!، وكذا الخروج من دوائر الإحباط وطقوس اليأس وأجواء الكآبة، وحالة التقمص لأدوار المظلوميات وعقلية المؤامرات، ونشوة الشعور الخادع بالسكينة والطمأنينة إلى ما بأنفسهم، وتزكيتها، فذلك هو ما يغذي حق البقاء لواقعهم المزري الذي يتحرقون لتغييره؛ فرأس مشكلاتهم أنهم يشعرون بثقل وطأة الواقع عليهم، دون الوعي بمقدار ما يسهم ما في أنفسهم لدوامه واستمراره.
ثانياً: مبدأ النقد الذاتي
إن المنطلق الصحيح الذي يرشدنا إليه المنهج الرباني في تغيير ما بالنفس، توجيه النقد إلى الذات واتهامها، والشعور بالمسؤولية تجاه ما يجري من أحداث، وإدانة التفكير التبريري، والنقد الذاتي الصحيح ذلك النقد البناء المتوازن، لا الجلد للنفس، ولا إدخالها في دوامات الاكتئابِ والتوتر والأمراض النفسية. “ونعني بالنقد الذاتي ذلك الأسلوب من التفكير الذي يحمل صاحبه المسؤولية في جميع ما يصيبه من مشكلات ونوازل أو ما ينتهي إليه من فشل. ونعني بالتفكير التبريري: ذلك التفكيرَ الذي يفترض الكمال بصاحبه، وإذا أخطأ برأه من المسؤولية، وراح يبحث عن مبررات خارجية، وينسب أسباب الأخطاء أو القصور والفشل إلى الآخرين”.
وإن من أعظم الأخطاء التي نقع فيها توجيه الاتهام والنقد إلى الآخر، وتزكية أنفسنا واستبعاد إمكان الوقوع في الخطأ من ذواتنا، ولا يخفى أن ذلك هو ابتعاد عن كشف الخطأ والخلل، وتشخيص الداء الحقيقي، ما يعني الابتعاد عن تغيير ما بالأنفس والارتقاء بها، وبالتالي عن تغيير الواقع كما المأمول.
فالقرآن الكريم يصر على جعل هذا المبدأ القاعدة الأساس في تفسير جميع الأخطاء الفردية أو الاجتماعية، وهو ما تضمنته تلك الآيات الواردة في المقدمة السابقة، التي ترد المشكلات إلى ما بالنفس، وظلم الإنسان نفسه. كما نجده يعرض لنا أنموذجا تطبيقيا لممارسة النقد الذاتي وإدانة التفكير التبريري؛ من خلال قصة آدم وزوجه مع إبليس، يقول تعالى: (وَیَـٰۤـَٔادَمُ ٱسۡكُنۡ أَنتَ وَزَوۡجُكَ ٱلۡجَنَّةَ فَكُلَا مِنۡ حَیۡثُ شِئۡتُمَا وَلَا تَقۡرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّـٰلِمِینَ * فَوَسۡوَسَ لَهُمَا ٱلشَّیۡطَـٰنُ لِیُبۡدِیَ لَهُمَا مَا وُۥرِیَ عَنۡهُمَا مِن سَوۡءَ ٰ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَىٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنۡ هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّاۤ أَن تَكُونَا مَلَكَیۡنِ أَوۡ تَكُونَا مِنَ ٱلۡخَـٰلِدِینَ * وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ * فَدَلاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَآ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَآ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ)(الأعراف:١٩-٢٢).
نلاحظ أن هذا المقطع القصصي يذكر صراحة دور الشيطان في إغواء آدم وزوجه، وكأنه هو المسؤول الأول، إلا السؤال الذي يطرح نفسه: كيف أجاب آدم وزوجه؟ هل لاما إبليس ووسوسته؟ أما ماذا كان موقفهما؟ يقول تعالى: (قَالَا رَبَّنَا ظَلَمۡنَاۤ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَتَرۡحَمۡنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَـٰسِرِینَ)(الأعراف:٢٣) إنهما يحملان نفسيهما مسؤولية الخطإ والمعصية، ولم ينسبا ذلك مطلقا إلى إبليس. والقرآن يسجل هذا المشهد، وذلك اللوم للذات قاصدا تربية المسلمين وتوجيههم لاتخاذ “النقد الذاتي منهجا في تقويم الآثار السلبية التي تنتج عن الممارسات الخاطئة”.
أما التبرير وتبرئة الذات وتزكية النفس، إنما هو منهج الشيطان وديدنه، إذ ينطلق من اتهام الآخر، والهروب من تحمل مسؤولية فعله؛ فها هو ينسب الإغواء إلى الله تعالى؛ حيث قال: (فَبِمَاۤ أَغۡوَیۡتَنِی لَأَقۡعُدَنَّ لَهُمۡ صِرَ ٰطَكَ ٱلۡمُسۡتَقِیمَ) الأعراف:١٦. وفِي موضع آخر نجده يتبرأ مما فعله من الإضلال للناس؛ إذ يقول تعالى:(كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ)(الحشر:١٦)، ويقول تَعالى:(وإذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أعْمالَهم وقالَ لاَ غالِبَ لَكُمُ اليَوْمَ مِنَ النّاسِ وإنِّي جارٌ لَكم فَلَمّا تَراءَتِ الفِئَتانِ نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ وقالَ إنِّي بَرِيءٌ مِنكم إنِّي أرى ما لا تَرَوْنَ إنِّي أخافُ اللَّهَ واللَّهُ شَدِيدُ العِقابِ)( الأنفال:٤٨).
وهكذا، يكون الانطلاق من اتهام الذات هو الانطلاق الصحيح في تغيير ما بالأنفس، وإن كان صعبا ومكلفا، لكنه ضروري، بل سجية سامية وخلق نبيل، ينبغي تحلي الإنسان فرداً وجماعةً بها في مواقف الحياة كلها؛ حيث تجعله يوجه نظره نحو ذاته، كلما صوب نظره وأشار بأصبع الاتهام نحو الآخر.
ثالثاً: شرط الإرادة
تتعلق هذه المقدمة بذلك الشرط الوجداني والنفسي، الذي يلزم لنجاح أي سعي للتغيير، بل كل سعي إنساني في الحياة، إنه شرط إرادة الفعل الجازمة. والإرادة كما يعرفها جودت سعيد “هي حب تحصيل أمر ما وإرادته والإخلاص له”، أو هي “باعث باطني عند الإنسان يتولد من رؤية الشيء الحسن، كما يتولد الميل إلى الرائحة الزكية، والنفور من النتن”.
فلكي ينجح المسلمون في تغيير ما بأنفسهم، وكذا تغيير واقعهم، هم بحاجة أن يريدوه، فلن يوجد منهم العمل التغييري ما لم يتوفر شرط إرادته، ذلك هو قانون وجود العمل والفعل، يقول ابن تيمية في فتاواه:”والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود المقدور عليه منه، فالعبد إذا كان مريداً للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها صلى، فإذا لم يصل مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة”.
والمقصود بالإرادة الجازمة تلك التي يقترن بها الفعل والإنجاز، وليس مجرد الهم وحديث النفس والتمني؛ إذ الهم كما يقول ابن تيمية كذلك “قد لا يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة … وأما الإرادة الجازمة فلا بد أن يقترن بها مع القدرة على فعل المقدور، ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظة أو خطوة أو تحريك بدن”، والله تعالى يقول: (لَّیۡسَ بِأَمَانِیِّكُمۡ وَلَاۤ أَمَانِیِّ أَهۡلِ ٱلۡكِتَـٰبِۗ مَن یَعۡمَلۡ سُوۤءࣰا یُجۡزَ بِهِۦ وَلَا یَجِدۡ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِیࣰّا وَلَا نَصِیرࣰا * وَمَن یَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنࣱ فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ یَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا یُظۡلَمُونَ نَقِیرࣰا)(النساء:١٢٣)، فالأهم كما تشير الآية، الأعمال والأفعال على الأرض التي تضفي الاستحقاق والكفاءة، لا التمنيات والأحلام.
وإن الحديث عن الإرادة لا بد أن يصحبه الحديث عن القدرة التي هي الاستطاعة على الفعل باستخدام الوسائل والإمكانات الموجودة، والتي يمكن تعريفها بأنها “معرفة كيفية تحصيل هذا الأمر المراد”. والأصل أن كل إنسان يمتلك من القدرات والإمكانات المادية والمعنوية على اختلافها وتفاوتها بين الناس، ما يمكنه من التغيير والتجديد في حياته على المستوى الفردي على الأقل.
ونعلم أن الإرادة التغييريــة لدى الإنسان لا تنبعــث من فراغ، ولا تتولد من الصدفة، وإنما لا بد أن تتأسس على الوعي والإحساس العميق بالمشكل في الواقع، وشهوده والحضور فيه، وعدم الرضا عنه، والتحرق لتغييره وإصلاحه، وأنه المعني الأول به، والمسؤول عنه.
رابعاً: الحذر من التسويف
يميل الإنسان عادة حين يعزم على أمر أو فعل يريد أن يخرج به عن المعتاد والمألوف إلى أن يسوف ويؤخر ذلك. وبما أن التغيير هو انتقال من وضع مألوف إلى آخر غير مألوف، فإنه لا محالة ستكتنفه هذه الآفة؛ فتسول له نفسه بالتأجيل والتسويف إلى حين، بضغط من سلطان العادة عليه، القوي قيده، والشديدة أغلاله عليه، حتى ليصعب الفكاك منه.
يقول الغزالي محذرا من هذا التسويف وحالة الانتظارية في كتابه “جدد حياتك”: “كثيرا ما يحب الإنسان أن يبدأ صفحة جديدة في حياته، ولكنه يقرن هذه البداية المرغوبة بموعد مع الأقدار المجهولة، كتحسن في حالته، أو تحول في مكانته. وقد يقرنها بموسم معين، أو مناسبة خاصة… وهو في هذا التسويف يشعر بأن رافدا من روافد القوة المرموقة قد يجئ مع هذا الموعد، فينشطه بعد خمول ويُمَنِّيه بعد إياس. وهذا وهم. فإن تجدد الحياة ينبع قبل كل شيء من داخل النفس. والرجل المقبل على الدنيا بعزيمة وبصر لا تخضعه الظروف المحيطة به مهما ساءت، ولا تصرِّفه وفق هواها. إنه هو الذي يستفيد منها… إنه يقدر على فعل الكثير دون انتظار أمداد خارجية تساعده على ما يريد. إنه بقواه الكامنة، وملكاته المدفونة فيه، والفرص المحدودة، أو التافهة المتاحة له يستطيع أن يبنى حياته من جديد. لا مكان لتريث… لا مكان لإبطاء أو انتظار… إن كل تأخير… لا يعني إلا إطالة الفترة الكابية… بل قد يكون ذلك طريقاً إلى انحدار أشد، وهنا الطامة”.
وهكذا، يعد التسويف آفة خطيرة، ومعيقا كبيراً لأي بداية أو انطلاق نحو الإنجاز تغيير أو تجديد في الحياة، فينبغي الحذر منه، وتجنب الوقوع فيه، والمبادرة إلى البدء دونه، فلا مجال للتأخير، ولا وقت للانتظار؛ فالواقع سيء لا يُحتمل، والانتظار يعني استمراره، وتثبيتا لسلطانه، والله تعالى جعل الإنسان أقوى من الظروف، بما مكن من قدرات إدراكية وعقلية ونفسية، وهو القائل سبحانه: (فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِینَ)(آل عمران:١٥٩)، أي “فإذا عزمت فبادر ولا تتأخر وتوكل على الله، لأن للتأخر آفات، والتردد يضيع الأوقات”.