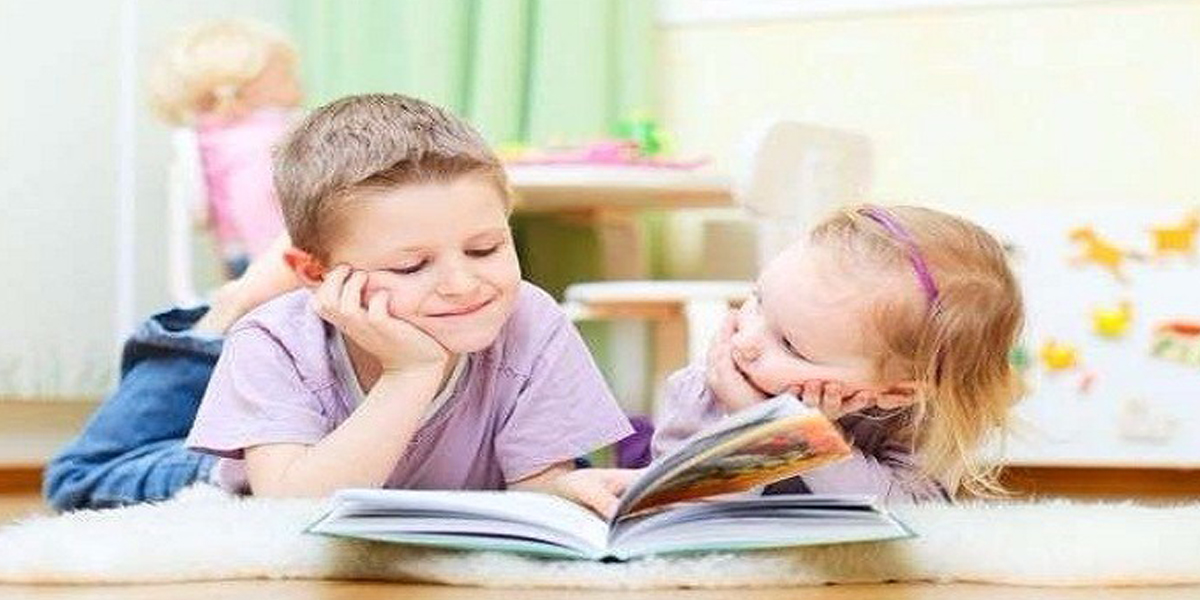كيف يكون الزوج والولد عدوًّا لأقرب الناس؟ مع أن العداوة تعنى البعد، كما أن الولاية تعنى القرب، والقرب والبعد يكونان في الحقيقة بالمسافة، والولد والزوج هما أقرب الناس. فإن الزوجة قريبة، والولد قريب بحكم المخالطة والصحبة والحياة معًا.
وإننا حين نمعن التأمل هنا نجد أن أمر العداوة يقاس بمعناها النفسي لا بحقيقتها اللغوية، فكل من أراد لك الخير، وأعانك على طاعة ربك فهو وليك القريب من قلبك وإن تباعدت بينكما المسافات، أما من كان عونًا للشيطان عليك فعمل على دفعك إلى الشر، وحاول تثبيط عزمك عن طاعة ربك فهو العدو البعيد منك وإن كان أقرب الناس إليك نسبًا ومكانًا.
والولد والزوج يقربان بالألفة الحسنة، والعشرة الطيبة، والمعاونة على الخيرات فيكونان في هذه الحالة وليَّين، ولكنها يبعدان بالنفرة والفعل القبيح، والصد من الخيرات وتثبيط العزم عن الطاعات فيكونان حينئذ عدوَّين، وعن هذا أخبرت الآية الكريمة وحذرت وبه أنذرت.
وقد سأل رجل ابن عباس رضى الله عنهما عن هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ(التغابن:14)، قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة، وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا الناس فقهوا في الدين، وهموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾(التغابن:14).
وفى هذا بيان لوجه العداوة، فإن العدو في الآية لم يكن عدوًّا لذاته، وإنما كان عدوًّا لفعله، فإذا فعل الزوج أو الولد فعل العدو كان عدوًّا، ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وطاعة ربه، أو دفع العبد إلى معصية الله.
ويزيد الأمر وضوحًا ما ورد من أسباب نزول الآية أن عوف بن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولد، وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه، فقالوا: إلى من تدعنا؟ فيرق ويقيم فنزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾(التغابن:14). أي احذروهم على أنفسكم، والحذر على النفس يكون بوجهين: إما لضرر في البدن، وإما لضرر في الدين، وضرر البدن يتعلق بالدنيا، وضرر الدين يتعلق بالآخرة فحذر الله العبد من ذلك وأنذره به.
وفى إطار تفسير العداوة هنا يقول مجاهد: ما عادوكم في الدنيا، ولكن حملتهم مودتهم على أن أخذوا لهم الحرام فأعطوه إياهم، وهذا تفسير صحيح لأن الآية وإن كانت نزلت لسبب خاص إلا أنها عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد، وخصوص السبب لا يمنع عموم الحكم، فمن تدفعه محبة الولد أو الزوج لقبول الرشوة، أو الحصول على مال عن طريق الغش، ليهيئ لهم في ظنه مناخًا معيشيًّا ماديًّا يباهي به، أو يرضي النفوس المريضة، فهذا وأمثال أهله أعداء له خصوصًا إذا علموا بذلك، وسكتوا عليه، ولم ينهوا عن المنكر، ولم يقدموا النصيحة، ولم يرفضوا الحرام وقس على هذا.
وكما أن الرجل يكون له ولده وزوجه عدوًّا، فكذلك المرأة يكون لها ولدها وزوجها عدوًّا إذا تحقق نفس المعنى بأن حملها الزوج على معصية ربها، أو حال بينها وبين طاعته سبحانه وتعالى.
وعلينا أن نتدبر جيدًا قول النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإيمان، فقال له: أتؤمن وتذر دينك ودين آبائك، فخالفه فأمن، ثم قعد له على طريق الهجرة فقال له: أتهاجر وتترك أهلك ومالك، فخالفه فهاجر، فقعد له على طريق الجهاد، فقال له أتجاهد فتقتل نفسك وتنكح نساؤك، ويقسم مالك، فخالفه فجاهد، فقتل فحق على الله أن يدخله الجنة” (صحيح مسلم).
فهذه صورة من صور الصد عن الحق، وعن العمل الصالح خالفها العبد الصالح فنجا، وفاز برضوان الله عز وجل، وهذا الصد عن الخير يأتي من الشيطان بطريقين: الأول: الوسوسة، والثاني: بأن يحمل على ما يريد من ذلك الزوج والولد والصاحب بأن يستخدم هؤلاء لتحقيق ما يريده، من الإفساد في الأرض، فمن خالف شياطين الجن وشياطين الإنس كان من السعداء، ومن وافقهم صار من الأشقياء المحرومين من رضوان الله ورحمته.
أي إن الله عز وجل أعطاكم المال، والأولاد ابتلاءً واختبارًا وامتحانًا، لينظر أتطيعونه أم تعصونه؟، وفي هذا تنبيه لوجدان العبد وضميره حتى لا تحمله النعمة بالمال أو الولد على فعل المحرم، أو منع حق الله تعالى، ذلك أن المال والولد إذا سيطر حبهما على القلب حتى حجبا عنه أنوار الهداية والطاعة خاب العبد وخسر، أما إن آثر العبد جانب الطاعة على المال والولد، وكان المال والولد من الأسباب المعينة له على التقرب إلى الله والتسابق في الخير، فالله عنده أجر عظيم وهي الجنة بعينها، وأعظم من ذلك أن يحل بالعبد رضوان الرب.
إن الآمال في الدنيا كغيم يظل، وعمل الآخرة باق دائم، وكل فرد مسؤول عن نفسه، وليس من العقل أن يضيع المرء مستقبله لآمال فانية، أو لقرابة وصلة.
إن الذي تشح به من الحقوق، وتبخل به على مستحقيه لتسعد به ولدك، أو تسر به زوجك، إنما تشقى به نفسك في يوم يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، إذ يكون لكل واحد يومئذ شأن يلهيه بنفسه، ويشغله عن غيره.
إن مالك في الحقيقة هو ما قدمته رجاء رحمة الله، وإن مال وارثك ما أخرته بعد موتك. فلماذا نبخل على أنفسنا بتقديم ما ينفعنا، ولماذا نجعل من المال والولد سببًا في شقاء يدوم، بدلاً من أن نجعلهما من الأسباب الموصلة إلى رضوان ورحمته؟
حقًّا إن المال والبنين زينة وجمال في الدنيا، فإذا كانا عونًا للعبد على طاعة الله، كانا خيرًا وبركة، لأنهما بذلك يكونان في جملة الباقيات الصالحات التي هي خير ثوابًا، وخير أملاً.