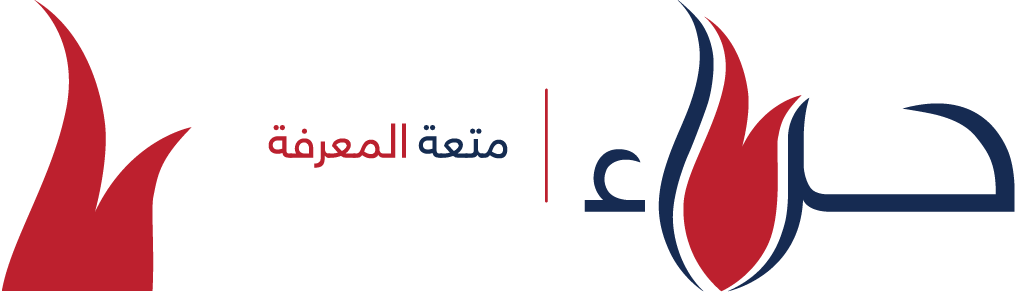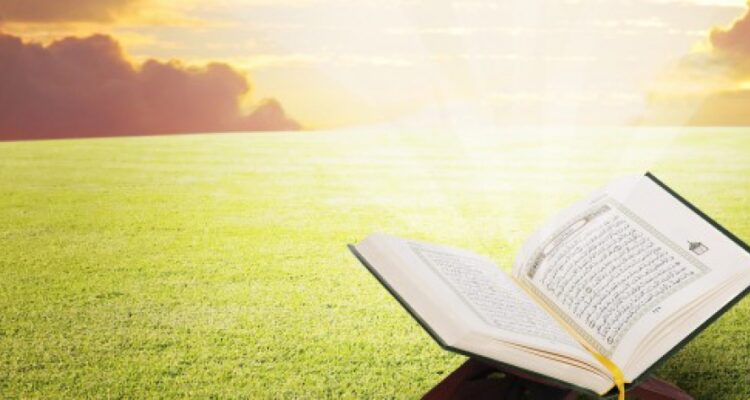إعجاز لغوي في القرآن الكريم
يُعد التكرار المعنوي صورة من صور البديع اللغوي، ويتجلَّى ذلك على مستوى الجملة، مثل قوله عز وجل: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له”، فهنا معنى متكرر؛ لأن “لا إله إلا الله” و”وحده لا شريك له” متساويان في المعنى. وتطبيقًا لذلك جاء قوله سبحانه وتعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ ﴾(التوبة: 29)، فالتكرار في القول يُثبِت المعنى، فإذا قرأنا قوله: “لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر”، وجدناها تقوم مقام قوله: “ولا يدينون دين الحق”؛ لأن من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر لا يؤمن بدين الحق.
ومن مظاهر التكرار المعنوي أيضًا ما يُعرَف بـ التكافؤ اللفظي والتركيبي، وذلك من خلال إعادة الجملة نُطقًا ومعنًى، ويتجلَّى ذلك في قوله سبحانه وتعالى: ﴿أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ * ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ﴾(القيامة: 34–35)، وكذلك قوله جل وعلا: ﴿فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾(المدثر: 19–20).
ويُعد التكرار المعنوي أكثر استخدامًا في سورة الكافرون، في قوله عز وجل: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ * وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾.
نجد أن قوله: “لا أعبد” يشير إلى المستقبل من عبادة آلهتكم، ولا أنتم فاعلون في المستقبل ما أطلبه منكم من عبادتكم إلهي.
وقوله: “ولا أنا عابد ما عبدتم” أي: ما كنتُ عابدًا قط في الماضي ما عبدتم، ولا أنتم عابدون في الماضي في الوقت الذي أنا عليه من عبادتي الآن.
ومن ألوان البديع المعنوي كذلك الجمع، وهو الجمع بين شيئين أو أكثر في حكم واحد، ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾(الكهف:46)؛ فالمال زينة الحياة الدنيا وكذلك البنون.
ومن الفنون البلاغية كذلك المقابلة، وهي توازي الأفعال أو المعاني، فتأتي بمعنيين متوافقين أو معانٍ متوافقة ثم ما يقابلها.
ومن الجدير بالذكر أن ابن الأثير لفت الأنظار إلى قضية التوازي في المقابلات، بمعنى أنه إذا كانت الجملة مستقبلية قوبلت بمستقبلية، والماضية بماضية. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾(سبأ:50). وكذلك قوله عز وجل: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ﴾(الليل: 5–10)، فالله عز وجل جعل التيسير مشتركًا بين الإعطاء والتقوى والتصديق، وجعل ضده، وهو التعسير، مشتركًا بين أضداد ذلك، وهي المنع والاستغناء والتكذيب.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن طرفي المقابلة قد يأتيان متعاقبين أو متباعدين، وقد يصل التباعد إلى حد مجيء طرفٍ في صدر النص والآخر في نهايته، ومن أمثلة ذلك سورة المؤمنون التي بدأت بقوله عز وجل: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾(المؤمنون: 1)، وجاء ختامها بقوله: ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾(المؤمنون: 117).
ومن أوجه المقابلة كذلك العكس والبديل، مثل وجود فعلين في جملتين، ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾(الروم: 19)، وكذلك حين يقع العكس بين لفظين في طرفي جملتين، مثل قوله عز وجل: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾(البقرة: 187).
المراجع:
(1) ابن الأثير: المثل السائر، ج 3، ص 7.
(2) القزويني: الإيضاح، ص 498.