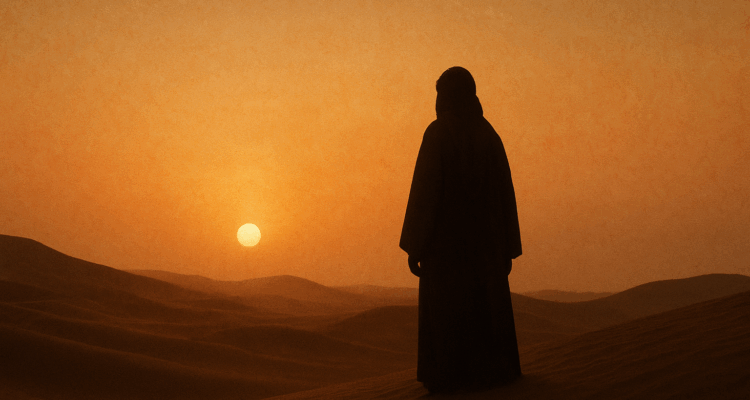تمر الأيام والشهور وتتسابق كما تتسابق الرياح، ونحن في آونة تذوب فيها الألسنة بمدائح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتتوحَّد القلوب في المحافل المحمدية، وتفوح منها العبير والأريج. ربيع الأول رحل، وتبقى رسائله الراسخة في سويداء قلوبنا، رسائل خالدة لا تشبه غيرها. ربيع الأول شهر غيَّر مسار التاريخ البشري، ونال من الاهتمام والتركيز أكثر وأوفر مقارنةً ببقية الشهور. إنه الشهر الذي شهد تحوّلات لافتة في مجريات الأحداث الجاهلية، وكان فجرًا جديدًا للعصر الذي غمره ظلام الجهالة، وغباء الغياهب والحلكة والدُّجى والدياجير السوداء.
ويتميز ربيع الأول بحدثه الأعظم؛ ميلاد سيد المرسلين، وإمام المتقين، ونور العالمين، والصادق المصدوق، وصفوة الخلق، وخاتم النبيين، والسراج المنير، والرسول الأمين، ونبي الله وصفيه وخليله محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم نورًا ومصباحًا يهدي من الظلمات إلى النور، ومن الاضطراب إلى الطمأنينة، ومن الضياع إلى المنعة، وإلى ركن شديد من الأركان.
وداعًا يا ربيع الأول… يا شهر النور والضياء
مما لا بد من التنبه إليه أن “الوداع” في قولنا “وداعًا يا ربيع الأول” لا يعني أن نور ربيع الأول قد انطفأ أو أن شموعه قد نفدت، بل هذه بداية لمرحلة جديدة من تاريخ البشرية. لقد رحل ربيع الأول، ولكن لم ترحل أنواره من قلوبنا ووجداننا، بل تبقى أنوارُه وأضواؤه ناجمةً عن طلوعه، وهذا الوداع فرصةٌ لنور لا ينطفئ، وعهد لا ينقطع، وتغيّر لا يُمحى، لأن أنواره وأضواءه كلها تنبع من مصدر حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مصدر لا ينضب.
نعم، مما لا شك فيه أن ربيع الأول ليس مجرد شهر في التقويم الهجري، بل هو نور وسراج ينبع منه ماء القيم الإنسانية من الرحمة والصدق والعدل والتسامح والأمانة، بحيث يروي الصخر قبل أن يروي العطشان. وقد رُجّح أن ربيع الأول هو شهر ميلاد محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، إجماعًا على الأصح، لكن اختلف الأئمة في تعيين يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم، والرأي الأشهر عند أهل السنة والجماعة أنه في الثاني عشر من ربيع الأول، ويذكر آخرون أيامًا مختلفة مثل الثامن والتاسع والعاشر من الشهر. فكان ربيع الأول شمسًا أذابت أشعتها اللامعة الساطعة الوهاجة طلاء الباطل وزخارفه.
حقبة جديدة: من ظلام الجاهلية إلى فجر النور
من الواقع المرير المؤلم أن القوم الجاهلي مرَّ بأخطر مرحلة من مراحل تاريخ الإنسان، حيث انهمكوا في شرب الخمر والزنى، وحُفرت الأغوار للبنات حيّاتٍ عقب ولادتهن. عاشوا في زمن قد أصابه الجمود في دَوْره ودياره، وأحاطت به أصفاد الوجل والشلل في حركاته وحدقاته، وتوترت أيادي أغنياء القوم على فقرائهم توترًا تُقشعرّ منه الجلود وتنخلع له الأفئدة وتبلغ به القلوب الحناجر.
فكانت ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقطةَ تحوّل جذرية، وكان نورًا أضاء مشارق الأرض ومغاربها من رحم السيدة آمنة رضي الله عنها، حيث انطفأت نار فارس، وانكسر عرش كسرى، وسقطت الأصنام في الكعبة، وغاضت بحيرة ساوة، ورُمِيَت الشياطين بالشُّهب. وكما قال الشاعر:
| ولد الهدى فالكائنات ضياءٌ | وفمُ الزمان تبسُّمٌ وثناءُ |
| الروح والملأُ الملائكُ حولهُ | للدين والدنيا به بُشراءُ |
فهذا البيت الشعري من الأدلة الدالة على التغيرات الملحوظة التي شهدها العالم حين ولد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث انطفأ سراج الجهل واتقد سراج النور في أرجاء العالم.
قدوة ملهمة في الأخلاق المحمودة والقيم الإنسانية
أجل، عندما نودّع ربيع الأول، علينا أن نجعل النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضلَ قدوةٍ في تشكيل الأخلاق وبناء مجتمعٍ مثقفٍ متماسك. وما أصدق ما قال الله تعالى في كتابه العزيز: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا}.
فهذه الآية أصلٌ كبير في التأسي بأقواله وأفعاله وأحواله، لا مجرد تلاوة، مما يبرز قيمة اختيار أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أسوةً حسنةً تؤدي إلى النعيم المقيم.
وعندما نمعن أنظارنا ونلاحظ أفكارنا في صفحات تاريخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نجدها مليئة بالقيم الإنسانية؛ فقد كان رمزًا للرحمة والعدل والتسامح والأمانة. كانت حياته مدرسةً روحيةً وحضارية، ومما لا يخفى علينا أن محمدًا صلى الله عليه وسلم لم يكن قائدًا روحيًّا فقط، بل كان زعيمًا حضاريًّا. وكان أصلاً كبيرًا في التأسي بحضارته العظمى من خلال مساعدة المحتاجين، وتحسين البيئة المحيطة بنا، ونشر ثقافة الاحترام المتبادل، وعدم التفرقة بين الناس، والتعاون والمساواة في الحقوق والواجبات.
وقد حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على الرحمة غاية الحث، ففي حديثه الشريف: “من لا يرحم لا يُرحم”، وفي حديث آخر: “ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”، وهذان الحديثان يوضحان أهمية الرحمة، إذ تُعد جزءًا لا يتجزأ من حياة الإنسان.
كما ورد في حديثه الشريف: “اذهبوا فأنتم الطلقاء”، وهو ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وكانت تلك فرصةً للمسلمين للانتقام، لكنه عفا عنهم قائلًا: “اذهبوا فأنتم أحرار معفو عنكم”. فهذا الحديث يُبرز قيمة التسامح حتى مع الأعداء والعفو في الإسلام.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب أمانة عظيمة، حتى لُقّب بـ”الأمين” من لسان العرب، وكان صادقًا مصدوقًا لم يكذب قط، وعادلاً بين الأزواج والأبناء والأقرباء على حدٍّ سواء. رفع مجد القيم الإنسانية إلى عنان السماء بإطعامه بلال بن رباح رضي الله عنه الأسود، وسلمان الفارسي رضي الله عنه الأبيض، في صحنٍ واحد. وقد صدق الشاعر حين قال:
| محمدٌ بشرٌ لا كالبشرِ | ياقوتُ حجرٍ لا كالحجرِ |
فهذا البيت الشعري يُظهر أن محمدًا المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس كالبشر العاديين، بل هو خير خلق الله وخاتم أنبيائه، كما أن الياقوت ليس كالحجر العادي، بل يحمل ميزاتٍ متميزةً ذاتية.
فهذه الأسوة والقدوات ليست للتعليم أو الحكاية فقط، بل للانتفاع والاستفادة وتجسيدها في حياتنا الواقعية. فإن ربيع الأول قد ذكّرنا وحقق فينا كل هذه المعاني السامية والأخلاق النبوية من خلال أعمالنا المختلفة المتنوعة.
دروس وعبر من الهجرة النبوية
مما لا يدع مجالاً للشك أن شهر ربيع الأول قد شهد حادثة عظيمة، تم توثيقها بأحرف سانحة في صفحات تاريخ الإسلام، وهي الهجرة النبوية. فعندما اشتدت العقلية الجاهلية التي يغلب عليها الحماقة والغباوة على المسلمين، وظلّوا ضحايا صيد الأعداء، وغلبت المعارك الحمراء والصدامات الدموية التي يرقص فيها الغرور والسفهاء على جراح المسلمين وفتنتهم في الأموال والأولاد، أذِن الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالهجرة.
فهاجروا من مكة إلى المدينة، فكانت الهجرة انتقالاً من الخوف إلى الأمن، ومن القلة إلى الكثرة، ومن الهوان إلى العز، ومن الضعف إلى القوة. ومنذ تلك الهجرة تم تنظيم التقويم الهجري، فأصبح كل ربيع أول يعلّمنا دروسًا باقية من الهجرة المباركة.
ومن الجدير بالذكر أن الهجرة أُذِن بها للنبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتدت تعرضاته وأصحابه للاضطهاد والأذى والمشكلات والهجمات. حينئذٍ وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم خطة متميزة، حيث رحل من مكة ليلاً مختبئًا في غار ثور، وهذا مما يُظهر أهمية التخطيط في كل أمورنا. وعلى الرغم من التخطيط الجيد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوكل على الله توكلاً تامًّا، فيعلّمنا بذلك الموازنة بين التخطيط المتقن والتوكل الصادق.
ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون من مكة إلى المدينة، استقبلهم الأنصار بحب وكرم، واستضافوا ضيوفهم، وأسس النبي صلى الله عليه وسلم الإخاء والكرامة والمودة بين المهاجرين والأنصار، وهذا مما يبرز قيمة الأخوة والتعاون والاستضافة.
ولما سيطر الأعداء على المسلمين، صبَر محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلّم الصبر لأصحابه الغُرِّ الميامين، وهذا مما يبرز أهمية الصبر وانتشاره في المجتمع. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على توحيد صفوف الصحابة سواء كانوا مهاجرين أو أنصارًا، مما يدل على أهمية الوحدة والتماسك الاجتماعي.
وبعد وصوله إلى المدينة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بناء المسجد النبوي، ولم يكن المسجد مجرد مكان للصلاة، بل مدرسة اجتماعية للتعليم، وحل النزاعات، واتخاذ القرارات. وهذا مما يُظهر شمولية بناء المؤسسات الإسلامية ودورها في بناء مجتمع مثقف متماسك.
فالتوكل، والتخطيط، والتعاون، والوحدة، وسائر الدروس والعبر التي تقدمها الهجرة النبوية، هي عناصر مهمة في حياتنا الواقعية. وفي الوقت نفسه، فإن ربيع الأول هو الشهر الذي توفي فيه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن كل ناحيةٍ نقول: إن ربيع الأول قد رحل، لكن رسائله تبقى خالدة مدى الدهور.
وداعًا يا ربيع الأول، وداعًا يا شهر النور والسرور والحبور، رحلت أيامك ولكن تركت في قلوبنا نورًا لا يزال، وعهدًا لا ينقطع، فلنحمل دروسك معنا على مر العصور، ونظل نردد قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ}.
وعندما نودّع ربيع الأول، يجب علينا أن نتخذ قرارات جديدة بمناسبة وداعه؛ فلنساعد الفقراء والمظلومين والمحتاجين، ونتبع سننه السنية، ونتعاون فيما بيننا، ونعمل على نشر رسائل ربيع الأول.
وعندما تصبح القيم الإنسانية التي غرسها ربيع الأول جزءًا من حياتنا اليومية، سنشهد مجتمعًا أكثر أمانًا وازدهارًا وقدرةً على مواجهة تحديات العصر الراهن.
فلندعُ إلى الإسلام بأخلاقنا، لأنها أبلغ وسيلة للتأثير والدعوة، ولنكن نموذجًا يحتذى به في مجتمعاتنا، ولنتعاهد مع من قال فيه ربنا عز وجل: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ}.