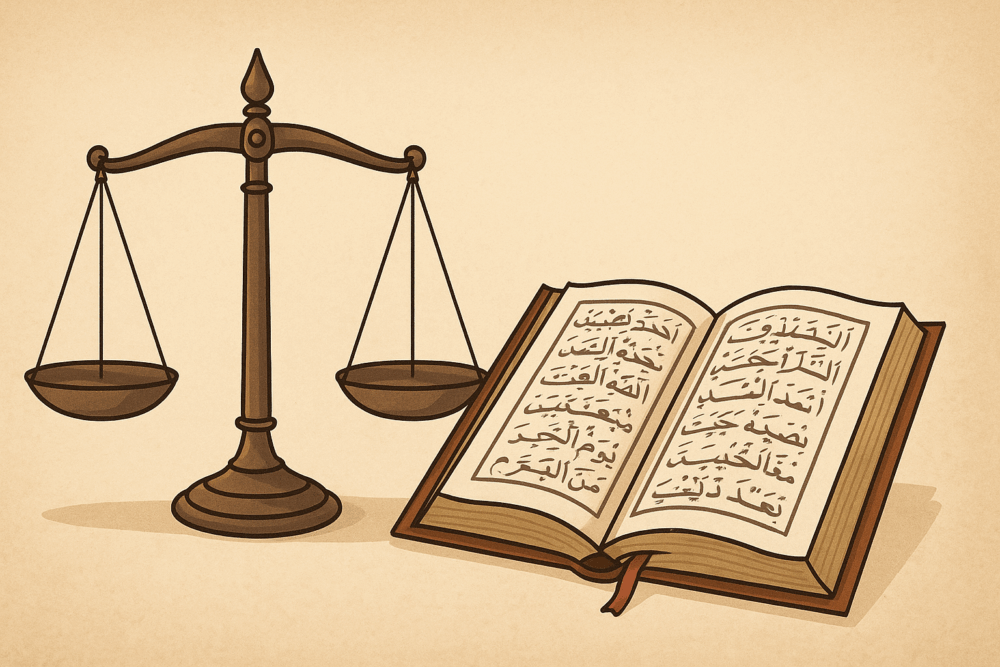يتميز التشريع الإسلامي بقوة إلزامية إيمانية، جعلت الإنسان المسلم يتقيد بنظم الشريعة، لا خوفًا من العقوبات البشرية فقط، ولكن لما يترتب على التشريع من الأجر أو الإثم. وبنفس الوقت، اقترنت الضوابط الشرعية في أغلب الأحيان بالجوانب الإيمانية الغيبية، المؤدية بالمسلم إلى الالتزام بها حتى في ظل غياب المراقبة البشرية، أو إحاطة أيٍّ من القوانين والأنظمة، حيث إنه يرى أن ذلك يعد في الأساس من تمام عبودية الله تعالى.
وعند إجراء مقارنة بين ضوابط حرية الرأي في الإسلام، ونفس الضوابط المعمول بها في الدول الغربية المعاصرة، يتضح أن الشريعة الإسلامية تميزت بوجود ضوابط لحرية الرأي، ما يعني قيام الرأي بوظيفته المرجوة، وتحريره من كل القوى الخارجية والداخلية، وخضوعه في نفس الوقت لأمره سبحانه وتعالى. وذلك على العكس تمامًا مما يحدث في دول الغرب بإقرارها دساتير توسعت في إعطاء حرية الرأي والاجتماع وحرية الصحافة.
لكنها في ذات الوقت اقتصدت كثيرًا في غرض القيود على تلك الحريات، وبما ينسجم مع فلسفة المذهب وتقديسًا لحريات الأفراد. كما نلحظ في الوقت نفسه العديد من مظاهر الملل والقلق في النظم الديمقراطية، التي عدّت نفسها نظمًا عريقة. حيث إن بعض النظم الشمولية، وبهدف التحرر وإقامة الديمقراطيات، أنتجت حالات كثيرة من الفوضى والعنصرية والبربرية، لتشابهها إلى حد كبير مع القبلية القديمة. وهو ما ظهر جليًّا في دول أوروبا الشرقية، التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفيتي (روسيا حاليًا).
ومن قبل، عاش العالم عدة تجارب للنظم التدخلية والشمولية، ومحاولتها ارتداء عباءة الديمقراطية، ومن أهم تلك النظم الفاشية والنازية. لكن سرعان ما انهارت تلك النظم وقُضي عليها تمامًا عقب نهاية الحرب العالمية مباشرة. وتُعد اليابان مثالاً واضحًا على ما سبق، ففي فترة ما قبل عام 1945م توجهت اليابان إلى الشمولية السياسية والقومية المتطرفة والفاشية، وبلغت أعلى مراحلها في الغزو الياباني للعديد من دول جنوب شرق آسيا بثلاثينيات القرن العشرين. وكان ذلك جزءًا من فترة عالمية من الانتفاضات الاجتماعية والصراعات، التي شملت ما عُرف بـ (الكساد العظيم)، وكانت من أهم أسباب نشوب الحرب العالمية الثانية.
لكن الإسلام شمل كل ما يخص الفرد والمجتمع، أي إنه كما يُقال: دين ودولة. والإسلام رفض على سبيل المثال مبادئ العلمانية وكل ما شابهها، وهي مبادئ قائمة على فصل الحكومة ومؤسساتها، وفصل السلطة السياسية عن السلطة الدينية. لكن الشريعة الإسلامية كانت أسبق الشرائع في تقرير الديمقراطية الإنسانية، وهي الديمقراطية النزيهة التي يكسبها الإنسان، لأنها حق له يخوّله أن يختار حكومته، وليست حيلة من حيل الحكم لاتقاء شر أو حسم فتنة، ولا هي إجراء من إجراءات التدبير، التي تعمد إليها الحكومات لتسيير الطاعة والانتفاع بخدمات العاملين وأصحاب الأجور.
الله واهب القوانين الإنسانية
وفي تعريفها المبسط، فإن الديمقراطية تعني: (حكم الشعب)، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو عبر ممثلين منتخبين. ما يعني أن الانتخابات التي تعبر عن الموافقة الشعبية، وحرية التعبئة السياسية والاجتماعية، والمساواة بين كل المواطنين بظل حكم القانون، تصبح مكونات أساسية للديمقراطية السليمة والفاعلة. وذلك يتفق مع الشريعة الإسلامية، وحالة ما إذا كان رأي الأغلبية لا يخالف الثوابت الدينية، فلا مانع من إقرار القانون. أما إن خالفه، فيُحرَّم إقراره، فمن المقرر في أصول الشريعة الإسلامية أنه “لا اجتهاد مع نص”. فالحكم في الشريعة الإسلامية قائم على الشورى، بقوله تعالى:{وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}(الشورى: 38)، وقوله تعالى:{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}(آل عمران: 159).
ونرى في الآيتين الكريمتين تأكيد القرآن الكريم على مبدأ التشاور، لتقرير كافة شؤون المجتمع، بما في ذلك اختيار القادة لتمثيل المجتمع والحكم نيابة عنه، ولكن بتطبيق قوانين الله مثلما وردت بالقرآن والسنة.
ويستلزم دور الإنسان الذي أُعطي منصب خليفة الله أو ممثله على الأرض، قوله تعالى:{وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ}(البقرة: 30).
ونظرًا لتفوق الإنسان العقلي وقدرته على اكتساب المعرفة وممارسة الإرادة الحرة، وكل تلك الصفات التي وهبها الله للإنسان، فإنها لا تمكنه فقط من تطبيق الشريعة الإلهية، بل تمكنه أيضًا من تفسير تلك الشريعة واستخلاص المبادئ الحكيمة والنزيهة من المصادر المقدسة، التي تشكل أساس القوانين الجديدة اللازمة لعالم متغير بشكل مستمر، مع تعقيدات أخلاقية ومعنوية جديدة.
وأما إذا ارتضت الأغلبية سن القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية، كإباحة الزنا وشرب الخمور والإجهاض وغيرها من الأشياء التي حرمها الإسلام وجرمها كليًّا، كما يحدث في الدول الغربية باسم الديمقراطية والحرية وحماية حقوق الإنسان، فهو أمر يرفضه الإسلام شكلاً وموضوعًا، ولا يمكن أن يقبله المجتمع الإسلامي، لأنه يؤدي إلى شيوع الرذيلة والفاحشة في المجتمع. وعلى أثره، فإن النظام الديمقراطي الإسلامي لا يستلزم وقوع صراع أو منافسة على السلطة بين شريعة الله والإنسان.
بل إن شريعة الله والإنسان يعملان معًا لتحقيق هدف موحّد، يتمثل في جلب المنافع الاجتماعية، وسن قوانين تعزز الحضارة للعالم. أي إن الله هو واهب القوانين التي تقع عليها السلطة الوحيدة، بينما يقوم الإنسان – كونه جسدًا جماعيًّا – بتفسير وتنفيذ تلك القوانين باعتباره ممثلاً لله على الأرض. وعليه، فإن المثل الديمقراطي المتمثل بحكم الشعب، يتوافق مع المفهوم القرآني لدور الإنسان على الأرض، وبالتالي يتوافق مع مفهوم الديمقراطية في الشريعة الإسلامية.
خير مثال للديمقراطية في الإسلام
هناك نموذج يُحتذى به في التاريخ الإسلامي، استخدمه المسلمون في اختيار خليفة جديد بالتشاور المتبادل. فعندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم على فراش الموت، حثه نفر من أصحابه على تسمية خليفة يقود الأمة، لكن الرسول الكريم رفض ذلك الطلب، ما يشير بوضوح إلى أنه كان يريد اختيار الخليفة القادم بالتشاور المتبادل، بدلاً من فرضه على الأمة الإسلامية. وعليه، فإن القضية الأكثر إلحاحًا بالنسبة للأمة حين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت اختيار الخليفة القادم، وقد رُشّح ثلاثة من صحابته لتولي المنصب.
وفي النهاية، تم اختيار أبي بكر الصديق أقرب صحابته صلى الله عليه وسلم، ليصبح الخليفة الجديد للأمة الإسلامية. كما اختير أبو بكر وخلفاؤه الثلاثة مجتمعين، والمعروفون بـ (الخلفاء الراشدين الأربعة)، بطريقة مماثلة تعكس الموافقة الشعبية. وعليه، فإن فكرة اختيار الخليفة أو القائد وفقًا للإرادة الشعبية، ليست فكرة جديدة في تقاليد الإسلام، ما يعني أن فكرة الانتخابات تتوافق تمامًا مع مفهوم الديمقراطية الإسلامية.
ولهذا قال عمر بن الخطاب في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: “ليس فيكم من تُقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر”. ومن جانبه، يصور الصحابي الجليل سالم بن عبيد هذا الانتخاب الجلل، فيقول: “فبايع الناس أحسن بيعة وأجملها”. وواضح أن أحدًا ممن حضر السقيفة لم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصّ على خليفته، مع قرب العهد وتوفر الداعي لذلك وشدة الحاجة إليه، وإنما تناقلوا أحاديث تفيد أفضلية أبي بكر رضي الله عنه، وفهموا منها بدلالة الإشارة أنه أولى بالخلافة من غيره.
وزاد ابن القاسم حديثه ليقول: فلو وجد نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “هذا خليفتي من بعدي”، لذَاع الخبر وشاع، ولظهر واشتهر، ولجُري له ذكر في السقيفة. فمثل هذا الخبر في أهميته ليس مما يمكن إخفاؤه، ومحال كذلك أن يُخفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يُسرّ به لبعض أصحابه. فهو أمر يتعلق بعموم المسلمين لا بفرد منهم.
فكان تشاور الصحابة الكرام لاختيار من يولونه أمرهم بمنزلة الإجماع منهم، على أن أحدًا منهم لا يعلم نصًّا في ذلك. وهكذا انقادت الأمة كلها لأبي بكر رضي الله عنه، فبايعوه لما وهبه الله من صفات تؤهله لذلك. فقد كان معظمًا في الجاهلية، فكان من أهل العقل والجاه والمال قبل الإسلام، وكان ممن تجتمع إليه العرب، يسألونه عن أخبارهم وأنسابهم رضًا بما يقول. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُجلُّه ويدنيه إليه، ويستشيره في كافة الشؤون.
أسس الديمقراطية الإسلامية
قامت الديمقراطية الإسلامية الهادفة إلى دوام وضمان المنفعة للإنسان، على أربعة أسس لا تقوم أي ديمقراطية أخرى على غيرها، وهي: (المسؤولية الفردية)، و(عموم الحقوق وتساويها بين الناس)، و(وجوب الشورى على ولاة الأمور)، و(التضامن بين الرعية على اختلاف الطوائف والطبقات). وكل تلك الأسس أظهر ما تكون في القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، والتقاليد المأثورة عن عظماء الخلفاء.
فالمسؤولية الفردية مقررة في الإسلام على نحو صريح وبآيات متكررة تحيط بأنواع المسؤولية من جميع الوجوه. فلا يمكن أبدًا محاسبة إنسان بذنب إنسان آخر، مصداقًا لقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}(فاطر: 18).
ولا يمكن محاسبة إنسان بذنب آبائه وأجداده، أو بذنب وقع قبل مولده، يقول تعالى: {تِلْكَ أُمَّةٞ قَدۡ خَلَتۡ}(البقرة: 134).
وألا يُحاسَب إنسان بغير عمله، لقوله تعالى: {وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ}(النجم: 39). وقوله تعالى:{كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا كَسَبَتۡ رَهِينَةٞ}(المدثر: 38). وقوله تعالى: {ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ}(البقرة: 281).
يجب أن يكون الحكم وفقًا لتعاليم القرآن والسنة التي تشكل أساس دستور الدولة الإسلامية. يقول تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلٗا}(النساء: 59).
والقرآن الكريم يأمر الخلفاء والقادة بأداء أماناتهم إلى أهلها، بقوله تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا}(النساء: 58).
وهكذا تتجلى الديمقراطية في أبهى صورها، حين تُبنى على عدل يحيي النفوس، ومساواة ترفع الإنسان، وشورى تُنير الطريق، ومسؤولية تحفظ للناس كرامتهم، فتغدو حياة الأمة أكثر صفاءً، ومجتمعها أكثر تماسكًا ورسوخًا.
المصادر
1- الإسلام والديمقراطية، فهمي هويدي (طـ 1)، مركز الأهرام للترجمة والنشر (القاهرة) 1993م.
2- الديمقراطية في الإسلام، عباس محمود العقاد، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة (القاهرة) 2014م.
3- عن الديمقراطية الليبرالية قضايا ومشاكل (طـ 1)، د. حازم الببلاوي، دار الشرق (القاهرة) 1993م.
4- الشورى في الإسلام، سعد عبد السلام حبيب، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (القاهرة) 1976م.
5- الديمقراطية والشورى.. أيهما أقرب للإسلام؟، د. محمد نور حمدان، موقع الجزيرة نت، 17/5/2018م.