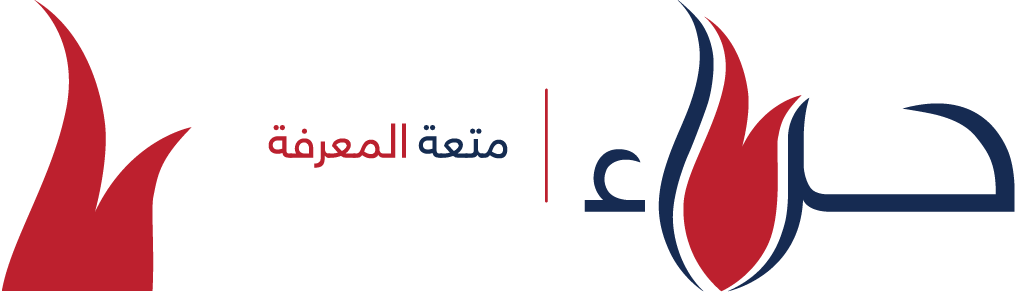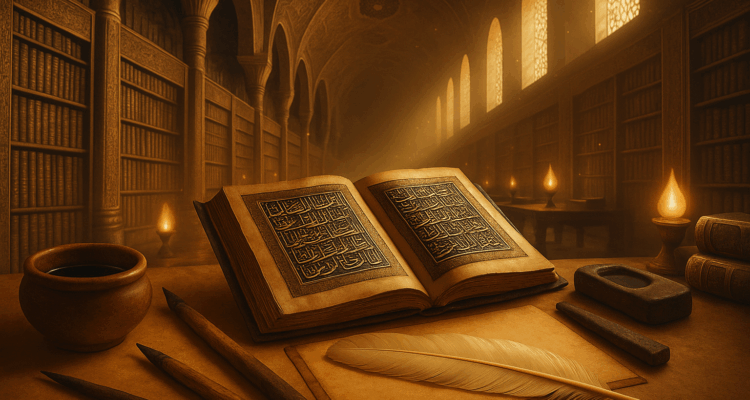منذ آلاف السنين، استخدم المصريون والإغريق والرومان أنبوب الكتابة الذي كان يُعرف بـ (الكامولوس)، والمكوَّن من أنبوب ذي طرف مسطّح. وكما هو الحال مع الريشة، كان يُغمس طرف الأنبوب في الحبر، ما يسمح باستخدامه لكتابة بضع كلمات فقط. وكان طرف الكامولوس مائلاً قليلاً إلى أحد الجانبين، وذلك بحسب سُمك الخط المطلوب كتابته.
ذكر القلم في القرآن والسنة
في عصر الجاهلية كان القلم، المعروف بـ (المِزبر أو اليراع)، هو أهم أداة للكتابة، حيث كتب به العرب كافة مخطوطاتهم ورسائلهم. حتى جاء الإسلام ليحمل معه أهمية كبرى للقلم في الكتابة والتدوين، وذلك بذكره في القرآن الكريم: ﴿نٓۚ وَٱلۡقَلَمِ وَمَا يَسۡطُرُونَ﴾(القلم: 1).
والإعجاز هنا أن أحد العلماء قال في تفسير (نٓۚ): إنها الدواة، التي كان يستقي منها القلم للكتابة بأمر الله عز وجل.
وقال تعالى: ﴿ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ﴾(العلق: 3 – 5).
ويقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن أول ما خلق الله القلم، وهو أداة الكتابة للمقادير التي يأمره الله بها، فقال له: اكتب، قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» (أخرجه الترمذي).
أي: إن الله أمر القلم أن يكتب مقادير كل شيء في الكون، بالطريقة والكيفية التي أمره الله أن يكتب بها ما أراد الله إيجاده إلى يوم القيامة.
وقال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿قَالَ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٞ﴾ (يوسف: 55): أي: كاتب حاسب. ومن جلالة القلم أنه لم يكتب الله عز وجل كتابًا إلا به.
وفي تفسير قوله تعالى: ﴿أَوۡ أَثَٰرَةٖ مِّنۡ عِلۡمٍ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ﴾(الأحقاف: 4)، يقول ابن عباس: أي الخط الحسن.
وجاء في تفسير قوله تعالى: ﴿إِذۡ يُلۡقُونَ أَقۡلَٰمَهُمۡ أَيُّهُمۡ يَكۡفُلُ مَرۡيَمَ﴾(آل عمران: 44): أنها كانت عيدانًا كُتب على رؤوسها أسماؤهم.
أما قوله تعالى: ﴿وَلَوۡ أَنَّمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ مِن شَجَرَةٍ أَقۡلَٰمٞ وَٱلۡبَحۡرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦ سَبۡعَةُ أَبۡحُرٖ مَّا نَفِدَتۡ كَلِمَٰتُ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ﴾(لقمان: 27)، فدليل على عظمة الكلمات الإلهية التي لا تفنى.
ويُروى أن النبي ﷺ قال لبعض كتّابه: «ألق الدواة، وحرف القلم، وانصب الباء، وفرّق السين، ولا تعوّر الميم، وحسّن الله، ومدّ الرحمن، وجود الرحيم، وضع قلمك على أذنك اليسرى، فإنه أذكر لك».
الأقلام تبسم الكتاب
في مجمل حديثهم عن الأقلام، يقول بعض البلغاء: «الأقلام تبسم الكتاب، والقلم صائغ الكلام، يفرغ ما يجمعه القلب، ويصوغ ما يسكبه اللُب».
وقال آخر: «ما أثمرته الأقلام لم تطمع في دروسه الأيام». أي إن ما أنتجه الفكر والإبداع ممثلاً بالقلم يظل باقيًا، لا يمحوه مرور الزمن.
شأن القلم والمداد
في بادئ الأمر كانت الأقلام تُصنع من مواد طبيعية، كالسعف أو الغاب أو القصب، يُقط أو يُبرى أو يُقلّم، لذلك سُمّي (قلمًا). ثم يُغمس في المداد (الحبر) ليُكتب به.
والمعلوم أن القلم هو أشرف أدوات الكتاب وأعلاها شأنًا، وهو المباشر للكتابة دون غيره من الأدوات. وكان القلم الجيد يُتخذ من القصب الأقل عقدًا، والأكتف لحمًا، والأصلب قشرًا، والأعدل استواءً.
ومن العجيب أن ريشة الأوزة كانت أداة الكتابة الشائعة في العصور الوسطى، وتُعرف أيضًا بـ (قلم الريشة). ولم يكن بالإمكان استخدام سوى أربع ريشات جناح كبيرة لكل أوزة. كانت تُنتزع الريشات، ويوضع طرفها في رمل ساخن ليتصلب، ثم يُقص حسب الحجم المطلوب.
ويُعد ريش الإوز من أقدم أنواع أقلام الحبر. وكان مستخدمو اليد اليمنى يحرصون على ريش الجناح الأيسر للأوزة، والعكس لمستخدمي اليد اليسرى، وذلك لسهولة الاستخدام بحسب الاتجاه.
أما المداد فهو الحبر الذي يُكتب به. سُمّي مدادًا لما تمد به الدواة الكاتب، وسُمّي حبرًا نسبة للحُبار وهو أثر الشيء. وهو سائل يحتوي على مكونات صبغية وكيميائية وجزيئات متنوعة، يُستخدم في الكتابة والطباعة لإظهار النصوص والرسوم.
وكان العرب يجلبون الأحبار من الصين، كما كانوا يصنعونها من مواد نباتية ومعدنية، وأحيانًا حيوانية مثل عسل النحل. ومن أبرز المكونات: العصف، الصبار، الزاج، الصمغ، الأسى، الكافور وغيرها. تُستخدم وفق مقادير دقيقة تؤثر في لون الحبر وبريقه وقوامه.
أما مصطلح المداد فيأتي من فكرة الامتداد (يمدد)، أي المساعدة. فيُطلق على أي مادة تمد شيئًا آخر. فيقال: الزيت مداد المصباح، والحبر مداد القلم.
عن المحابر والأدوات المساعدة
على مرّ التاريخ الإنساني، كانت القراءة والكتابة تُعَدّان من الكماليات التي يصعب على كل الناس امتلاكها؛ ففي العصور القديمة كانت القراءة والكتابة حِكرًا على مجموعة من الكَتَبة والكهنة والتجار والملوك والمقرَّبين منهم. كما كانت القدرة على الكتابة مرتبطة بالطبقات الاجتماعية والعرقية، وبإمكانية الحصول على التعليم. وفي ذلك الوقت كان امتلاك مكتب وقلم وحبر خاصَّين يعني الكثير؛ إذ كان يشير إلى مستوى معيَّن من الثراء، وإلى امتلاك شيء يستحق أن يُقال، وحرية التعبير عنه على الورق.
وبالحديث عن الأدوات المساعدة في الكتابة، فهي متعدّدة ومتنوعة، لكل منها دور يختلف عن الآخر. أولها الدواة أو المحبرة، وهي عبارة عن وعاء صغير يوضع فيه الحبر. في بادئ الأمر كانت الدواة تُصنع من الخشب، ثم تطوّرت إلى محابر من النحاس والفضة والزجاج، يُغمس فيها القلم كل بضع كلمات. وكثير من تلك المحابر كانت مَزوّدة بأغطية لمنع تبخّر الحبر أو انسكابه. وهناك أيضًا المَقَط أو المعصَمة، وهي قطعة صلبة من الحجارة أو الرخام، تُستخدم لبَرْي القلم وجعله مستويًا.
أما المسقاة، فهي آلة مصنوعة من النحاس تُستَخدم لصبّ الماء في المحبرة، وكانت تُسمَّى أحيانًا الماوردية لأنه كان من المعتاد وضع ماء الورد في المحابر عوضًا عن الماء. وهناك المنشفة، وهي تُستخدم لتنظيف سنّ القلم بين كل غمسة وأخرى؛ بعضها كان مصنوعًا من القماش أو اللِّباد، وبعضها الآخر كان مَحكوكًا. كما وُجدت المصقلة، وكانت تُستخدم لصقل الذهب بعد استعماله في الزخرفة أو الكتابة، وغالبًا ما كانت تُصنع من النحاس.
ومن الأدوات أيضًا المرملة، وهي وعاء يُوضَع فيه الرمل لتجفيف الكتابة، وهناك نوع آخر من أدوات تنشيف الكتابة يتمثّل في أداة خشبية ذات مقبض مُنحنٍ، وقاعدة من اللِّباد أو الورق، تُلفّ بعد الكتابة أو تُضغط برفق على الحبر لتجفيفه ومنع تلطيخه. وأخيرًا المقلمة، وهي التي تُوضَع فيها الأقلام.
محبِّرون وعلماء لصناعة المخطوطات
يُشهَد للخط العربي أن مبادئه الجمالية كانت – وما زالت – لا حدود لها، لأنه ينتمي إلى عالم الإبداع والحسّ والجماليات. وقد تجلّت هذه السّمات الفنية في إعداد المخطوطات الإسلامية بعد القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي، من خلال التنوّع الكبير في الألوان التي زيّن بها النُّسّاخ والمزخرفون والمذهِّبون أعمالهم. وسرعان ما تجاوزت تجارب المُحبِّرين بداياتهم المحدودة، إذ اتّسعت خبرتهم لتشمل مَزج درجات مختلفة من الألوان، ولم يقتصر الحبر الملوّن على تجربة واحدة، بل نجد عِدّة طرق مختلفة للوصول إلى اللون نفسه، سُجِّلت في مناطق متباعدة من العالم الإسلامي، كل منها توصّل إليها باستخدام المواد المتاحة في تلك المنطقة.
ومن بين هؤلاء المُحبِّرين الذين احتلوا مكانة مرموقة في عالم صناعة المخطوطات، كان بعضهم من العلماء، وكانوا يدوِّنون تجاربهم في الكتب والأدلّة التي وُضِعت لتعليم أمناء الحكومة المُرشَّحين لأهم سمات فنهم. ومن أمثلة ذلك: أعمال أبي بكر الصولي، وقدامة بن جعفر، وابن دُرُستُويه، والنويري، والقلقشندي، والمراكشي، حيث تميّز عمل الأخير بتغطيته لعدد من خصائص المواد المستخدمة في صناعة الأحبار، وذلك لخبرته العملية في الكيمياء.
فعلى سبيل المثال، يقول المراكشي عن الحبر الأسود الداكن ذي المحتوى العالي من الزاج: (إنه يحرق الورق بسبب محتواه العالي من الزاج، ويتآكل بالمناطق التي كُتب عليها، ويقطع الورق تمامًا). كما يقول في موضع آخر عن الصمغ العربي: (الفائدة الوحيدة للصمغ العربي في الحبر هي أنه يحمي النص في حال سقوطه في الماء من التشويش والتلطيخ، وأن الصمغ العربي يطرد الزاج).
إبراز جمالية المخطوط الإسلامي
جرى استعمال لفظ المخطوطة في النشر الأكاديمي للدلالة على النص المُقدَّم إلى الناشر أو المطبعة، وهو في طور الإعداد للنشر. وقد يُطلَق اللفظ أيضًا على الجزء المؤلَّف من قانون أو نصّ مكتوب بخط اليد بدلاً من طباعته. ويعني ذلك أن المخطوط أو المخطوطة (وجمعها مخطوطات) هي أي وثيقة مكتوبة بخط اليد، سواء على أوراق البردي، أو الرقوق، أو الورق العادي. والمخطوط يُعدّ وحدة تاريخية متكاملة، يحمل بين سطوره أثر الأجيال السابقة من خلال نوعية أوراقه وأحباره ووسائل كتابته، وغيرها من خصائص عصره.
ويُعَدّ تراث المخطوط الإسلامي أنفس وأضخم تراث مخطوط على مستوى العالم، وهو جزء لا يتجزأ من ذاكرة الأمة الإسلامية، يُوضّح إسهامها العلمي الأصيل في الماضي، الذي لا نزال نستفيد منه في الحاضر، وسنظل نستفيد منه في المستقبل. وقد ارتبطت المخطوطات الإسلامية – دون غيرها – بالعديد من الفنون التي كان لها دور في إبراز قيمتها الجمالية، ومنها فنون الخط العربي، التي بلغت ذروتها في المخطوطات الإسلامية.
وللارتقاء بالمخطوط الإسلامي استخدم الكَتَبة والحِرفيون الأوائل أدوات الكتابة السابقة ذكرها ليسطروا كلمات بقيت حيّة في وجدانهم حتى رحيلهم، وما زالت حتى الآن راسخة في ذاكرة شعوب العالمين العربي والإسلامي. وكانت كتابة المخطوط الإسلامي بمثابة دلالة سيميولوجية واضحة، توحي بكثير من المعاني، منها ميول أرباب الحِرف لمجاورة الدول التي امتهنت هذه الصناعة، واحتكاك أصحاب الحِرفة فيما بينهم، واقتسامهم مجالات خبراتهم أثناء تنقّلاتهم في أقطار العالم الإسلامي الشاسع.
ولهذا، فإن الأدوات والآلات المستخدمة في كتابة المخطوط الإسلامي تُعدّ شواهد بصرية قائمة بذاتها، ثابتة زمانيًّا ومكانيًّا، إذ وُظّفت في فن الخط الإسلامي ليُحوِّل الحرفي من خلالها أبسط الأشياء إلى عمل فني حقيقي، يُبرز المظاهر الجمالية في حرفته، ويوصلها إلى المتلقّي عبر الاستغلال الأمثل للمواد المتاحة وخصائصها الإدراكية الحسية.
وفي مؤلَّفه “التطور التاريخي لصناعة المخطوط: قراءة في تصنيع الورق وتزيين المخطوط في الحضارة الإسلامية”، يؤكد الدكتور صالح محمد زكي اللهيبي أن المسلمين لم يكتفوا باهتدائهم إلى صناعة الورق، بل ارتقوا بها إلى مستوى من الجمال والابتكار، ما جعل من المخطوطة والكتاب قيمة متعددة الأبعاد، تبدأ من المعرفة ولا تنتهي عند حدود. فالمخطوط في الحضارة الإسلامية لم يكن مجرد وعاء علمي، بل تحوَّل إلى تحفة جمالية تفيض بأسرار الصنعة وإبداع الحِرف، حتى غدت صفحاته مرآة لعصور من النهضة والمعرفة، التي تميّزت بروعة التعبير ودقة التزويق، وصَعُب على حضارات أخرى مجاراتها أو الإتيان بما يماثلها.
مصادر وهوامش
(*) الزاج: مصطلح قديم يُطلق على مجموعة من الأملاح المعدنية مثل كبريتات المعادن، ويشمل: الزاج الأبيض (كبريتات الزنك)، والأخضر (كبريتات الحديدوز)، والأزرق (كبريتات النحاس). كما يُطلق مصطلح زيت الزاج على حمض الكبريتيك المركز.
(*) رئيس قسم البحوث والدراسات بمركز الأمير عبد المحسن بن جلوي للبحوث والدراسات الإسلامية بالشارقة.
(1) المخطوطات العربية، السيد السيد النشار، دار الثقافة العلمية، الإسكندرية، 1997م.
(2) علم المخطوط العربي: بحوث ودراسات، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (قطاع الشؤون الثقافية)، الكويت، 2014م.
(3) أدوات الخط وآلات الكتابة: دراسة في سيميولوجية آلات فنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية، د. بدر الدين شعباني، جامعة قسنطينة، الجزائر، 2019م.