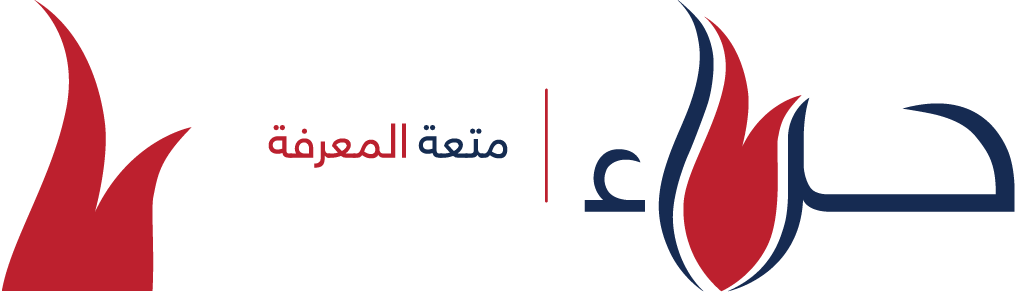الهجرة رؤية استراتيجية ورسالية
حين نقف على محطة الهجرة النبوية، لا ينبغي أن نراها حدثًا عارضًا في سياق اضطهاد قريش، بل هي انعطافة استراتيجية كبرى في مشروع بناء الأمة. الهجرة تجسد الانتقال من الدعوة المستضعفة إلى الدولة المؤسسة، من البلاغ الفردي إلى التنظيم الجماعي، ومن التبشير الإيماني إلى الهندسة السياسية.
لقد نظر النبي ﷺ إلى المدينة المنورة ليس فقط بوصفها ملاذًا آمنًا، بل بوصفها قاعدة انطلاق حضاري. اختارها بعد سنوات من التواصل السياسي والدعوي مع أهل يثرب، وبايعهم بيعة العقبة الكبرى على النصرة والتأييد، وبهذا ضرب مثلاً في بناء التحالفات على قاعدة الدين والمصلحة العليا للمشروع [1].
هذا الاختيار يعكس بصيرة القائد الرسالي، الذي لا يتحرك بردة فعل، بل برؤية مستقبلية. وقد عبّر الإمام الغزالي عن ذلك بقوله: “النبي ﷺ لم يكن نبيًّا فحسب، بل كان معلمًا ومربيًا ومؤسسًا لدولة قامت على الإيمان والعقل والتدبير.” [2].
السرية والتنظيم في إدارة الرحلة
لم تكن الهجرة حركة عفوية، بل كانت نموذجًا في إدارة الأزمات والعمل السري المنضبط. تأمل هذا الترتيب الدقيق:
• الخروج ليلاً من باب خلفي غير معروف.
• سلوك طريق الجنوب إلى غار ثور، في مخالفة للمسار الطبيعي.
• اختيار دليل غير مسلم لكنه محترف: عبد الله بن أريقط.
• توزيع المهام: عبد الله بن أبي بكر ينقل الأخبار، أسماء تحمل الطعام، عامر بن فهيرة يمحو الآثار [3].
هذا نموذج متكامل لما يسميه علماء الإدارة بـ”خطة الطوارئ البديلة” (Contingency Plan) و”التفويض الفعّال للأدوار”، وهو ما عبّر عنه ابن القيم في قوله: “كان تدبير النبي ﷺ في هجرته آية في حسن التقدير والحيطة.” [4].
القائد الذي يصنع القادة
النبي ﷺ لم يكن قائدًا منفردًا، بل كان باني فريق، يفوض، يثق، ويرشد. لم يعتمد على نفسه فقط، بل جعل من التنظيم الشبكي ركيزة للعمل:
• جعل لكل فرد في فريق الهجرة وظيفة محددة، مع مراعاة قدراته.
• استطاع تحويل الأزمة (مطاردة سراقة) إلى فرصة، فوعده بسواري كسرى، فآمن وسكت عن الخبر [5].
هذه المرونة القيادية و”الذكاء العاطفي” في الميدان تعكس شخصية القائد الذي يحكم بالمحبة لا بالقوة، ويسيطر بالحكمة لا بالتهديد. وقد أشار عبد الكريم بكار إلى أن الهجرة: “أظهرت عبقرية النبي ﷺ في تحويل خصوم اللحظة إلى أعوان المستقبل.” [6].
البناء المؤسسي بعد الوصول
بمجرد الوصول إلى المدينة، لم ينتظر النبي ﷺ كثيرًا، بل بدأ في بناء مؤسسات الدولة الوليدة:
• بناء المسجد: مركز العبادة والتعليم والإدارة.
• المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، لإذابة الفوارق الاجتماعية.
• كتابة وثيقة المدينة، أول وثيقة دستورية مدنية تجمع بين عقائد مختلفة في إدارة جماعية [7].
هذه الخطوات تؤكد أن النبي ﷺ لم يؤسس دولة على القوة، بل على القيم والمشاركة. وكان المسجد نواة مؤسسة الحكم والتربية والمشورة. وقد وصف فريد الأنصاري هذا الحدث بقوله: “المسجد في المدينة كان مصنع الإنسان، ومركز القرار، وساحة التربية.” [8].
توكل لا تواكل
من أعظم دروس الهجرة أن النبي ﷺ جمع بين العمل بالأسباب والتوكل الخالص. كل خطة الهجرة كانت بشرية: تكتم، تخطيط، تنسيق، ثم في لحظة الخطر قال لرفيقه: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾[التوبة: 40].
وهذه العبارة تُدرّس اليوم في علم القيادة على أنها تعبير عن الثقة القيادية العليا. القيادة النبوية لا تترك الأمور للصدفة، لكنها لا تؤلّه الوسائل، بل تضعها في إطار السنن الإلهية.
قال ابن تيمية: “النبي ﷺ كان أكمل الناس توكلاً، ومع ذلك أخذ بالأسباب، ففعل ما يقدر عليه، وفوّض إلى الله ما لا يقدر عليه.” [9].
خلاصة تربوية وإدارية
إن الهجرة ليست ذكرى، بل خطة قابلة لإعادة القراءة والتطبيق، خاصة في واقع الأمة المعاصر، المتعطش إلى قيادة راشدة، تتوكل بلا عجز، وتخطط بلا استعجال. وقد جمع هذا الحدث بين ستة عناصر رئيسية:
| المبدأ الإداري | تجليه في الهجرة |
|---|---|
| التخطيط الاستراتيجي | اختيار المدينة، بيعة العقبة، التوقيت |
| إدارة الأزمات | الغار، سراقة، الحصار |
| القيادة التشاركية | توزيع المهام، إشراك النساء |
| التنظيم المؤسساتي | المسجد، المؤاخاة، الوثيقة |
| الذكاء العاطفي | تهدئة الصاحب، احتواء سراقة |
| التوازن بين العقل والروح | التوكل والتخطيط |
“الهجرة ليست هروبًا من الاضطهاد، بل انتقال بالرسالة من طور البلاغ إلى طور البناء.” [10].
الخاتمة
إن الهجرة النبوية الشريفة ليست مجرد حادثة من حوادث التاريخ، بل هي منهج حياة، ودرس متجدد في القيادة الواعية والإدارة الربانية. لقد علّمتنا أن النهضة لا تُبنى على العاطفة وحدها، ولا على التخطيط وحده، بل على إيمانٍ واعٍ، وعقلٍ يقظ، وقيادة تبني الإنسان قبل البنيان.
في الهجرة تتجلى سنن التغيير الحضاري: كيف ينتقل الإنسان من الضعف إلى القوة، ومن العزلة إلى التأثير، حين يكون متوكلاً على ربه، آخذًا بكل أسباب النجاح، عاملاً في صمت، طامحًا في رضى الله لا تصفيق الناس.
فلنتعلم من الهجرة كيف نربي أنفسنا، وكيف نبني مشاريعنا، وكيف نقود أوطاننا، بما يرضي الله، وينهض بالإنسان، ويبعث في الأمة روح العمل والمبادرة.
الهوامش:
[1] ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص36–42.
[2] الغزالي، إحياء علوم الدين، ج2، ص249.
[3] ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص99–105.
[4] ابن القيم، زاد المعاد، ج3، ص6.
[5] ابن كثير، البداية والنهاية، ج3، ص223.
[6] عبد الكريم بكار، تجديد الوعي، ص132.
[7] محمد حميد الله، الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة، ص45–53.
[8] فريد الأنصاري، بلاغ الرسالة، ص117.
[9] ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج8، ص528.
[10] محمد البهي، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، ص211.