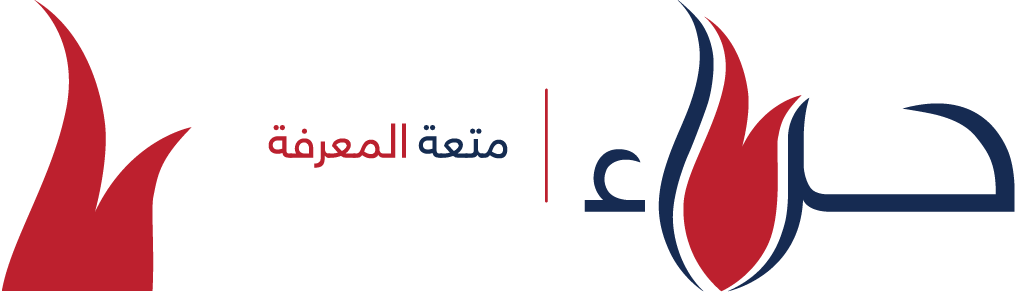يقول ابن عربي في شجرة الكون: “أقسم بعلي عزته، قوي قدرته، لقد خلقني وفي أحذيته غرقني، وفي بيداء أبديته حيّرني، تارة يطلع من مطلع أبديته فينعشني، وتارة يدنيني من مواقف قربه فيؤنسني، وتارة يحتجب بحجاب عزته فيوحشني، وتارة يناجيني بمناجاة لطفه فيطربني، وتارة يواصلني بكاسات حبه فيكسرني، وكلما استعذبت من عربدة سكر، قال لسان أحديته: “لن تراني”، فذبت من هيبته فرقًا، وتمزقت من محبته قلقًا، وصُعقت عند تجلي عظمته كما خرّ موسى صعقًا، فلما أفقْتُ من سكرة وجدي به، قيل لي: أيها العاشق، هذا جمال قد صُنّاه، وحسن قد حجبناه، فلا ينظر إلا حبيب قد اصطفيناه”.
يرسم هذا النص أبعاد العلاقة الوثيقة بين المعرفة الصوفية ومسالكها الوجدانية باتجاه المطلق، من خلال هذا التجلي الجمالي، بمعابره العشقية الآسرة، الملتذّة بالجميل، التائهة الحيرى في دروبه؛ أي هذا الفيض الوجداني المضمخ بالأسرار الوجودية، المتراوحة بين: الغرق والانتعاش، القرب والحجاب، الأُنس والوحشة، الطرب والحب، السكر والعربدة، القلق والوجد.
إن تجربة الذات الصوفية المفعمة بهذا التعالي والتجاوز في اختراق طبقات الوجود ومعانيه، ورغبتها في الوصول إلى الحضرة الإلهية، تستند إلى مبدأ الحب والعشق كمحرّك أساس. ولعل هذا ما يدعونا إلى تثمين قول منصف عبد الحق: “وإذا جاز لنا أن نؤكد على أهم مبدأ من مبادئ الحب الصوفي لقلنا إنه يكمن في الإحساس بالاغتراب المؤسس لوجود الإنسان، ومن هنا كان الحب فعلًا أساسيًا من أفعال تجربة الفناء الصوفي”. (كتاب أبعاد التجربة الصوفية).
ما هي خصائص الحب الصوفي الأندلسي ومدارجه؟ ما الذي يميّزه عن الحب الطبيعي والحب الروحي؟ كيف عكس الرؤية الاغترابية للصوفي الأندلسي؟
يمكن أن نعتبر ابن عربي الأوحد من بين متصوفة الأندلس، الذي أنعم النظر عميقًا في ظواهر الحب. وإذا كان يشترك مع بقية المتصوفة الآخرين في معاناة تجربة الحب بكل تفاصيلها، فإنه ينفرد عنهم بالتنظير للحب. وفي هذا الصدد، نجد أنه يميز بين ثلاثة أنواع للحب هي بمثابة ثلاث مراتب للوجود:
أ- حب إلهي
هو من جهة حب الخالق للمخلوق الذي يُخلق في ذاته، بمعنى المخلوق الذي يظهر الشكل الذي يتجلى فيه، ومن جهة أخرى حب هذا المخلوق لخالقه. هذا الحب ليس سوى شوق الله المتجلّي في مخلوقه، والمتطلع إلى العودة إلى ذاته، بعد أن تطلع كإله خفيّ إلى أن تتم معرفته في المخلوق. إنه الحوار الأزلي للاتصال الإلهي- الإنساني.
ب- حب روحي
مركزه في المخلوق الباحث دومًا عن الوجود الذي يكتشف فيه الصورة، أو الذي يكتشف فيه نفسه وكأنه الصورة. هذا المخلوق ليس له من همّ أو هدف أو إرادة سوى إرضاء المحبوب إلى درجة أن يفعل به محبّه ما يريد.
ج- حب طبيعي
هدفه التملك واستيفاء رغبات المحب الذاتية دون الاكتراث بلذة المحبوب. شكل الحب أساس التجربة الصوفية التي جعلت من السلوك الصوفي نوعًا من التحلي بالأخلاق الإلهية. وعليه، سيصبح الحب الصوفي هو سبيل الرقي بهذه التجربة من المستوى البشري إلى مستوى سامٍ جدًّا، يتمثل في التشبه بالحب الإلهي الأزلي. ولعل هذا ما يعلنه ابن عربي صراحة في قوله: “واعلمْ أن التصوفَ تشبيهٌ بخالقنا *** لأنه خلقٌ فانظر ترى عجبًا”
هي المحبة الإلهية إذن أساس الوجود واغتراب الكائنات، إذ إن الله أحب أن يُعرف، فكان تجليه في الكائنات لأجل هذه الغاية: “ولما علم الحق نفسه، فعلم العالم من نفسه، فأخرجه على صورته، فكان له مرآة يرى صورته فيه، فما أحب سوى نفسه… لأنه لا يرى سوى نفسه”. (الفتوحات المكية).
بناء على ذلك، يصبح الحب رابطة أساسية بين الخالق ومخلوقه: “اعلم وفقك الله أن الحب مقام إلهي، فإنه وصف به نفسه، وتسمى بالودود، وفي الخبر: بالمحب، ومما أوحى به إلى موسى في التوراة: يا ابن آدم، إني وحقي لك محب، فبحقي عليك كن لي محبًّا”. (الفتوحات المكية).
جدل الحب هذا هو ما استقصاه هنري كوربان بقوله: “ما نسميه حبًّا إلهيًا له مظهر مزدوج:
الأول هو شوق الله إلى الخلق (المخلوق)، حنين الألوهية إلى جوهرها (الكنز المخفي) المتطلع إلى التجلي في الكائنات لكي يتمظهر لهم وفيهم.
والثاني هو شوق الخلق إلى الله، وبالتالي فهو حنين الله نفسه المودع في الكائنات، والمتطلع إلى العودة إلى نفسه ذاتها.
في الواقع، إن المُشَوِّق هو المُشَوَّق إليه، حتى وإن كان آخرًا في التعيين… هكذا فإن الحب يوجد أزليًا كتبادل واستبدال بين الله والخلق”. (الخيال الخلّاق عند ابن عربي).
استغرق الحب الإلهي قصائد المتصوفة الأندلسيين، الذين عاشوا نشوة وجد عارمة نتيجة انغمارهم في هذا الحب الاستثنائي، وهم في مقام المجالسة والمؤانسة داخل الحضرة الإلهية، يتغنون بعشقهم دون رهبة، لأن المحبة “مقامها شريف وأنها أصل الوجود” (الفتوحات المكية).
يقول ابن خاتمة:
وشَى بسرك دمع ظل ينسكبُ
وغال صبرك صدع ليس ينشغِبُ
فما اعتذارك للأحي وقد هتكت
عنك الحجاب أمور ليس تنحجبُ
تيمات الألم، الوجد، الجوى، والسُكر تتكرر، لتعبر عن تجربة وجدانية تذيب ذات الشاعر في محبوبه، وتمنحه شرف العشق الإلهي. فالعاشق عند ابن خاتمة يفنى في محبوبه، فيغدو الحب سبب اغترابه ووسيلته للاتصال بالجمال الإلهي:
فمن يكن عاشقَها مثلي يحق له
ألا يُبالي أقام الحي أم ذهبوا
ويقول أيضًا:
وجهٌ إذا انتسبت كل الوجوه له
حسنٌ، فما لسواه الحسن يُنتسبُ
هنا يغدو محبوب الشاعر صورة للجمال الإلهي الخالص، تُعجز الأقلام عن وصفه، ويغدو حديث غيره محرّمًا عليه، إذ امتلأت روحه بمحبوبه.
ويستمر:
وعاذل ما درى مقدار موجدتي
يظن أني ممن سعيه خَبَبُ
لقد تفرد الشاعر بمرتبة من اللوعة والوجد لا يشاركه فيها أحد، وهو بذلك يعبر عن تجربة صوفية خالصة، تلتقي مع رؤى كبار المتصوفة كالحلاج وجلال الدين الرومي.
إن الذي صان قلبي في طويته
أحيا إذا متّ من شوقي لرؤيته
فهو يرى أن في فناء النفس حياةً، وفي السُقم عجب، إذ الحياة الحقيقية تكمن في المحبة الإلهية.
أما أبو الحسن الششتري، فيرسم ملامح الاغتراب الصوفي في شعره:
سلوي مكروهٌ وحبك واجب
وشوقي مقيم والتواصل غائب
ويؤكد أن الجمال الإلهي مصدر الحب، وأن التعلق بهذا الجمال هو سبيل النجاة، حيث يقول:
نظرت فلم أنظر سواك أحبّه
ولولاك ما طاب الهوى للذي يهوى
ويفسّر الصوفية “خلع النعلين” –الذي يرد كثيرًا في شعر الششتري– على أنه رمز لترك الدنيا والآخرة والاتجاه كليًّا إلى الله، حتى يتحقق الفناء في حضرته ثم البقاء به.
الششتري، وإن أكّد على دور الذات في بلوغ المقام، فإنه كسر الطقوس الدينية السائدة تعبيرًا عن صدق تجربته، على نحو ما يقوله:
خلعتُ عذاري في هواك ومن يكن
خليعَ عذاري في هوى سره النجوى
يستعرض الششتري حالة من الاتحاد بين الحق والخلق، حيث يتلاشى الزمان والمكان، ويكون العبد حرًّا بفعل فنائه:
إذا غاب الوجود وغبت عنه
فلم تعلم أبعُدٌ أم تدانِي
هكذا يخلص الحب الصوفي الأندلسي إلى الارتقاء نحو كونية الجمال الإلهي، رابطًا بين الاغتراب الوجودي وحركة الوجود، ومحولاً الجمال إلى بوابة اتصال بين الخالق والمخلوق، ليتجلى في كل الكائنات والمظاهر: في طلل، أو مشهد طبيعي، أو امرأة، أو غلام…
كما قال منصف عبد الحق في أبعاد التجربة الصوفية: “مطلق الجمال الإلهي سيتناهى ليتجلى في مظاهر كونية… وهو افتتان بجمالية الكون، ولكنه أيضًا رد فعل على الإحساس بالاغتراب والانفصال المؤسسين لوجود الإنسان والكائنات”.
من ذلك تمثيلاً لا حصرًا قول الششتري:
غيرُ “ليلى” لم يرَ في الحيِّ مَيٍّ ** سلْ متى ما ارتبتَ عنها كلَّ شي
كلُّ شيءٍ سرُّها فيها سرى ** فلذا يثني عليها كلُّ شي
ليلى الحبيبة يغطي وجودها الحي الكون بأكمله، إنها سر الوجود وموئل الجمال الكوني المشع الذي يغمر كل شيء:
هي كالمرآة تبدي صورًا ** قابلتها وبها ما حل شي
هي مثل العين لا لون لها ** وبها الألوان تبدي كلَّ زي
كائن نوراني مأهول بأسرار إلهية ما يني ينتشر في العالم ليكشف المحجوب، يبدي الحقيقة المطلقة، بل إنه الحقيقة المطلقة ذاتها:
هي في مرابعها لا غيرها ** فلذا تُدعى بلا شيء سوي
لبسها ما أظهرت من لبسها ** فلها في كل موجودٍ مَري
أسفرت يومًا لقيس فانثنى ** قائلاً: يا قوم أم أحببتُ سِواي
أنا ليلى وهي قيس فأعجبوا ** كيف مني كان مطلوبي إلي
نلاحظ أن الششتري وظف في شعره حكاية من حكايات الحب العذري، حكاية قيس وليلى، وأكسبها دلالات جديدة موسومة بطابع التلويح والرمز. يُفاجَأ جمالُ ليلى قيسًا في حضرة مشاهدتها، عندئذٍ تدهش الذات وتهيج، ويستتر نور العقل المُميِّز بين الأشياء محسوسها ومعقولها بغلبة الدهشة والحيرة في مطالعة الجمال… وتلك هي حالة السكر المتولدة عن صدمة نور الجمال.
من هنا تنكشف الأنثى بوصفها تجسدًا للحب الإلهي الذي يُحيل إلى تجلّي العُلو في الصورة الفيزيائية المحسَّة، وشفرة استيطيقية توحي بانسجام الروحي والمادي، والمطلق والمقيد، في الأشكال المتعينة، وهذا ما يشير إليه عاطف جودة نصر في كتاب: الرمز الشعري عند الصوفية.
ولعل هذا ما نستشفه من قول ابن عربي وهو يتحدث عن التجلي الإلهي في الأنثى/المرأة قائلاً: “فإذا شاهد الرجلُ الحقَّ في المرأة، كان شهوده في منفعل، وإذا شهده في نفسه من حيث ظهور المرأة عنه، شاهده في فاعل، وإذا شاهده من نفسه من غير استحضار صورة ما تكون عنه، كان شهوده في منفعل عن الحق بلا واسطة.
فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل، لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعلٌ منفعل، ومن نفسه هو منفعلٌ خاصة. فلهذا أحب النساء لكمال شهود الحق فيهن، إذ لا يُشاهد الحق مجردًا عن المواد أبدًا، فإن الله تعالى بالذات غنيٌّ عن العالمين. فإذا كان الأمر في هذا الوجه ممتنعًا، ولم تكن الشهادة إلا في مادة، فشهود الحق في النساء أعظمُ الشهود وأكمله”. (ابن عربي، فصوص الحكم).