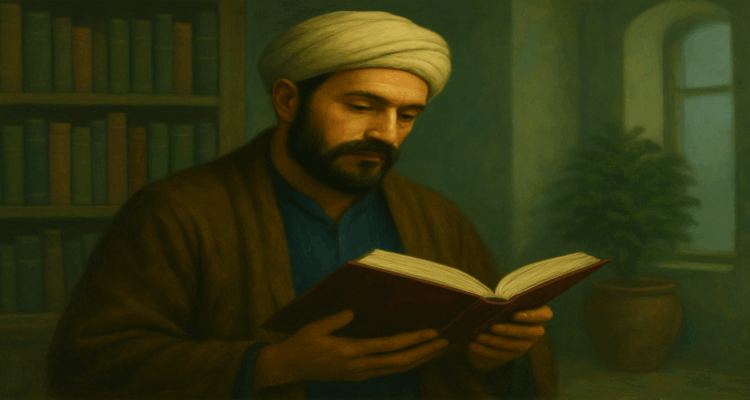تُعدّ مختلف أصناف الآداب والفنون من بين أبرز الوسائل التي تمكّن الإنسان من اكتشاف ذاته، واسترداد إنسانيته المختطفة والمغيبة في العصر الحديث، تحت وطأة الضغوط في الحياة والواقع المعيش. إذ بإمكان هذه الآداب والفنون إعادة تشكيل الحياة على أحسن ما يكون، وذلك من خلال إعادة هندسة المشاعر، وصفاء النفس، وجلاء الروح من صدأ الدنيا، فتغسل الذات باليقين، وتنعش الآمال، وتجدد الثقة بالمستقبل.
الرواية والمعرفة الإنسانية
تُعتبر الرواية وصفة للعقلنة والأنسنة، ليس لأنها تشكل مسبارًا يستقصي عتبات النفس القصية، ويعري أعطابها، فتفضح الزيف والنفاق الاجتماعي، وتقدم إضاءة ساطعة على قباحات الواقع، وتكشف المستور منها وراء تقاليد المجتمع البالية، المتدثرة بأنساق ذهنية عقيمة تعطل الوعي وتشل الفاعلية الإنسانية، وإنما لأنها أشبه بذلك الكشاف الساطع للمستقبل، لكونها تفتح الباب واسعًا على الاحتمالات الإنسانية الممكنة، لتقدم أنماطًا مغايرة من التفكير، وبدائل مختلفة عن الواقع. وهي بهذا، تعيد صياغة إنسانية الإنسان، وتهندس مشاعره، وتصوراته، وأفكاره على نحو جمالي؛ بمعنى على نحو أفضل مما يمكن أن يكون عليه الإنسان.
لهذا، فإذا كان المسرح أبو الفنون، فإن الرواية هي أم الآداب. وإذا كان الشعر قد لعب دورًا حاسمًا في إنضاج مرحلة عصر النهضة إلى جانب الفنون الأخرى، فإن الرواية لعبت الدور الأهم في حراك التنوير الغربي. وإذا كانت الرواية، باعتبارها جنسًا أدبيًا ينتمي للأزمنة الحديثة، فهي ليست ابنة الحداثة، بل هي صانعة لها؛ لأنها على الأقل تقترح النموذج الأفضل والأكمل والأجمل للإنسان. مما يعني أن وظيفة الرواية بالمعنى الإبداعي/الجمالي لا تختلف عن دور الفنون في بناء الإنسان والسمو به على نحو أرقى، لكنها تختلف عن الفنون الأخرى من حيث القدرة على استيعاب جميع أنواع المعرفة، كما تختلف عنها كذلك من حيث إمكانياتها غير المحدودة في تقديم المعرفة الإنسانية بأسلوب سردي جذاب ومحبوب في الفطرة الإنسانية(1). وبما أن الإنسان كائن حكّاء، فإن سلاحه المنطقي والفعّال هو الحكي.
الرواية وإعادة بناء القيم الإنسانية
لا تختلف الآداب عن باقي الفنون الأخرى في فتنتها وغوايتها للوعي الإنساني، على الرغم من تباين تعبيراتها في التمرد ورفض قباحات وبشاعات الواقع، والتبشير بواقع جديد ومستقبل أفضل وأجمل. كما لا تقل فاعليتها على مستوى اكتشاف الذوات واستعادة إنسانيتها وسمتها الفاعلة.
فقد لعب الشعر دورًا بارزًا في صياغة عصر حركة النهضة الأوروبية، وكان من أبرز رموزه دانتي وبترارك، غير أن الرواية كان لها الدور اللاحق، حيث تركت بصمتها اللافتة على حركة التنوير الغربية؛ لأنها صاحبت الإنسان، بتعبير الفيلسوف هوسرل، حيث تم وضع “عالم الحياة” تحت إنارة مستمرة من خلال اكتشاف ما يمكن للرواية وحدها، دون سواها، أن تكتشفه، على حد تعبير هيرمان بروخ.
يشير ميلان كونديرا في كتاب فن الرواية إلى أن الرواية قد اكتشفت، واحدة بعد أخرى، بطريقتها الخاصة، مختلف جوانب الوجود الإنساني، حيث تساءلت مع معاصري سرفانتيس عن ماهية المغامرة، وبدأت مع صموئيل ريتشاردسون في فحص ما يدور في الداخل (داخل النفس الإنسانية)، وفي الكشف عن الحياة السرية للمشاعر، واكتشفت مع بلزاك تجذر الإنسان في التاريخ، وسبرت مع فلوبير أرضًا كانت حتى ذلك الحين مجهولة، هي أرض الحياة اليومية، وعكفت مع الروسي ليون تولستوي على تدخل اللاعقلاني في القرارات والسلوك البشري، وعملت على استقصاء زمن اللحظة الماضية التي لا يمكن القبض عليها مع مارسيل بروست، واللحظة الحاضرة التي لا يمكن القبض عليها مع جيمس جويس، واستوجبت مع توماس مان دور الأساطير الآتية من أعماق الزمن، والتي تهدي خطانا.
لهذا، فإن الرواية التي لا تكتشف جزءًا من الوجود لا يزال مجهولاً، هي بمثابة رواية لا أخلاقية.
يذهب الروائي ميلان كونديرا إلى أبعد من ذلك، حين اعتبر الرواية هي مبدع أوروبا وهادي اكتشافاتها.
لعل هذا ما يجعل الرواية تنطوي على إمكانيات كبيرة في التعبير عن القيم، من خلال ما يمكن أن يقدمه الروائي من القيم الإنسانية الإيجابية التي لها علاقة وثيقة بما يَحلمُ به الفرد في صراعه مع العالم الذي يعيشُ فيه(2).
لهذا، فإن الرواية عندما تفتحُ عوالمها لاحتضانِ القيم الإنسانية الإيجابية التي تقعُ في صميم الجدوى من الأدب، فإنها تنتجُ معرفة مختلفة، تتعينُ بوصفها ردًا على القيم المضادة أو السلبية.
وفي هذا السياق، يعدّ دور الروائي المثقف أساسيًّا وفاعلاً بحكم القيمة التي ينطوي عليها الأدب بالنسبة للمتلقي.
إن ما يزكّي هذا التصور هو أن الرواية تُعدّ من أبرز الخطابات تأثيرًا في الإنسان، لأنها تقدم عالمًا واسعًا متنوعًا، يحتضنُ الأحلام والرؤى، والتوترات والصراعات. لذلك، يجد فيها القراء بمختلف مراتبهم أجوبة للأسئلة التي تدفعهم إلى قراءتها، بدءًا من الأسئلة البسيطة المرتبطة بالبحث عن معرفة محددة، إلى الأسئلة المعقدة التي تتصلُ بمتخيل الرواية وعلاقتها بالواقع.
الحكي وترويض النفس الإنسانية
تمكنت عملية الحكي على لسان شهرزاد في حكايات ألف ليلة وليلة من ترويض وحشية شهريار، وكبح جماحه للعنف/القتل، ولجم نزعاته الدموية، من خلال سلاحها الوحيد المتجلي في الحكي.
لأن الإنسان يميل إلى الحكي بطبعه، ويميل إلى البوح بشكل غير مقصود، من خلاله دوافعه اللاواعية، من أجل التخفيف من وطأة عذاباته، والتلطيف من بشاعات حياته.
فإذا كان ديكارت يعتقد أن عدد الفلاسفة هو المقياس الحضاري، فيمكن أن نذهب إلى أن عدد المبدعين الروائيين الخلاقين، يؤشر على أهم المؤشرات على مدى صواب عملية التنمية الإنسانية الناجزة، وخاصة في المجتمعات العربية. لأن العقل العربي قتل الفلسفة منذ مدة، ولهذا لا طريق لإعادة بناء القيم الإنسانية إلا من خلال الآداب والفنون المختلفة.
غالبًا ما تكون النصيحة المباشرة ثقيلة على النفس لدرجة أنها تصبح غير ذات قيمة في بعض الأحيان، مما يجعل لها آثارًا عكسية في أحايين أخرى.
ولأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان ويعلم الطبيعة البشرية التي فطر البشر عليها، فقد كانت قصص القرآن بما تنطوي عليه من قيم راقية ومعانٍ أخلاقية سامية، هي الوسيلة الأسرع في ترسيخ ما تحمله بين جنباتها من أخلاقيات في نفوس الناس على مر السنين.
وإذا ما أردنا تطبيق القاعدة السابقة على ما تنتجه قرائح البشر من إبداعات أدبية، لوجدنا أن تأثير رواية أو قصة قصيرة أو قصيدة شعرية قد يوصل أفكارًا إنسانية عامة، وقيما أخلاقية بأسرع مما لو كان في صورة وعظ مباشر أو مما تستطيعه خطبة أو محاضرة.
كما يمكن القول إن النكتة (ضمن الفنون الشعبية الساخرة)، باعتبارها موقفًا أخلاقيًا كما يشير ميخائيل باختين، يمكن أن تقوم بالوظيفة نفسها.
وإذا ما تناولنا الأمر من زاوية أخرى، لوجدنا أن الأعمال الأدبية والفنية لديها القدرة على البقاء في وجدان المتلقي أطول من جميع النصائح وكلمات الوعظ والخطب والمحاضرات. لهذا، كانت قصائد شوقي وإليوت، ومسرحيات شكسبير وسعد الدين وهبة، وروايات نجيب محفوظ وديكنز، خير شاهد على ذلك.
مما يفسر سرّ تهافت الإنسان في جميع أنحاء العالم على اقتناء الأعمال الأدبية المحترمة أو الوقوف في صفوف طويلة للحصول على تذكرة لمشاهدة إحدى المسرحيات، كما يحدث في عاصمة الأنوار باريس على وجه الخصوص.
ولا يُعقل أن تكون تلك الملايين، في جميع أنحاء العالم وعلى مرّ السنوات، تبحث عن التسلية أو المتعة فقط، إذ لا يمكننا إغفال هذا الجانب المرتبط بقيم الحق والخير وكذا الجمال، فضلاً عن القيم الروحية والأخلاقية الملتحمة بمختلف قضايا المجتمع.
الرواية ورهانات الرقي بالقيم الإنسانية
كل حديث عن علاقة الإبداع بالقيم، يضعنا أمام سؤال جوهري مفاده: هل كل الأعمال الإبداعية تكون دائمًا مرتبطة بالراقي من القيم والأخلاق؟
بمعنى: عندما يكتب الأديب أعماله، وعندما يخرج الفنان روائعه من مسرحيات وأفلام، هل تحضر في ذهنه الأخلاق والقيم المجتمعية والمبادئ؟
غالبًا ما تكون الإجابة بالنفي، لأن ذلك يمكن أن يسبب في تعطيل قريحته عن الإبداع. لكن على الرغم من ذلك، فإن المبدع يضع لنفسه أطرًا معينة يستطيع من خلالها الوصول إلى وجدان المتلقي والتأثير فيه دون الخروج عمّا اختطه لنفسه. وبمرور الوقت يعتاد ذلك ولا يخرج عنه، واضعًا في الحسبان أنه ليس كل ما هو غريب أو مختلف قادر على اجتذاب الجمهور.
وهذا بالطبع لا يتفق مع الأعمال الأدبية والفنية الهابطة، التي لا ترقى لمسمى الأدب أو الفن، وتحمل من التسطيح والسذاجة واختراق أخلاق المجتمع وقيمه بدعوى الواقعية، فتقدم للمتلقي الشاذ من الأخلاق، والغريب من التصرفات. ولا يمكن أن يكون ذلك دعوة لهؤلاء بالخروج من عزلتهم وتغيير نمط حياتهم والالتحام بالقضايا الواقعية، لأن في هذا تزييفًا للحقائق.
لأنه، على الرغم من أن المبدع يدرك قبل غيره أن الخير والشر متلازمان منذ بدء الخليقة، فإنه يدرك أن الإبداع تهذيب للنفوس، وترسيخ للفضيلة والأخلاق، ورقي بالمشاعر دون إسفاف أو مخاصمة للقيم التي تعلي من شأن الإنسان.
لهذا، يتم الإجماع على أن الكتابة والقراءة يحققان البناء التربوي والتعليمي والفكري والثقافي لجميع فئات المجتمع، ولهما أثرهما المستدام الحي في التنمية الحضارية ذات البناء الإيجابي الفاعل، من خلال تثبيت المبادئ والقيم.
وقد صدق الشاعر المتنبي حين قال: أعزّ مكانٍ في الدُّنى سرجُ سابحٍ … وخيرُ جليسٍ في الزمانِ كتابُ
خاتمة
نخلص من خلال ما سبق إلى أن كل حديث عن العلاقة الممكنة بين الرواية والقيم يتم انطلاقًا من مستويين أساسيين:
- يتجلّى الأول في دفاع الرواية عن القيم الإنسانية الإيجابية التي يحرص الأفراد والجماعات على التمسك بها والحفاظ عليها، لأنها سلاحهم الوحيد لبناء المجتمع الذي يحلمون بالعيش فيه.
- أما الثاني، فيتمثل في الثورة على القيم المضادة التي تعوق الذات عن تحقيق تطلعاتها.
من هنا، نجد أنفسنا في صلب المفهوم المعاصر للرواية، التي تبدو، بما تمتلكه من مرونة وانفتاح، الجنس الأدبي الأقدر على تشخيص صراع الفرد والجماعة ضد القيم المضادة.
والرواية، سواء عبّرت عن تجربة الفرد الحميمة أم عن تجربة الجماعة، تستطيع بأسلوبها وخصائصها الفنية، الكشف عن اللامرئي والمخبوء، وتلمّس التطلعات والرؤى الكامنة في أعماق الفرد والجماعة. لأن الرواية تُعدّ من أبرز الخطابات تأثيرًا في الإنسان، لأنها تقدم عالمًا واسعًا متنوعًا، يحتضن الأحلام والرؤى، والتوترات والصراعات.
الإحالات
(1) لطيف زيتوني، الرواية والقيم، ط1، دار الفارابي، بيروت، 2028، ص: 50
(2) إرنست كاسيرر، فلسفة التنوير، ترجمة: إبراهيم أبو عثمان، ط1، المركز العربي للأبحاث، 2017، ص: 88