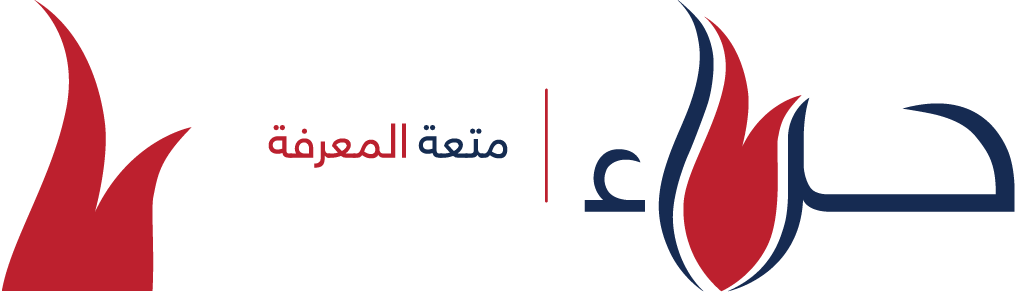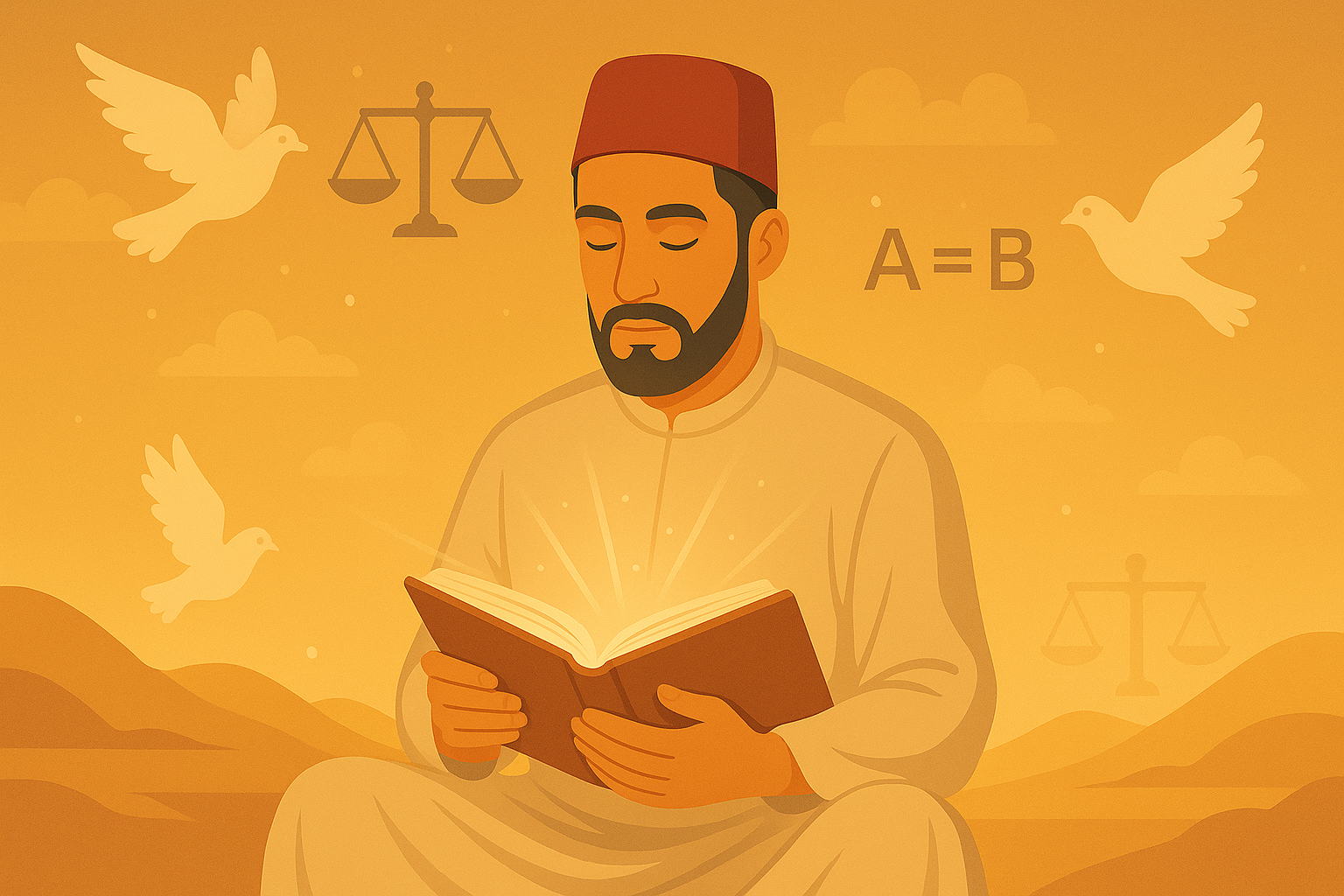القياس أصل من أصول التشريع الإسلامي فيما يتعلق بانتزاع الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية، والحديث عنه ههنا ليس حديثًا عن طبيعته التشريعية في الدرس الأصولي، بقدر ما هو حديث كاشف لما يجري في ثناياه من المعاني التربوية، والمقاصد التزكوية، والأبعاد الإيمانية التي تنطوي عليها مسائله.
إنّ البعد المعرفي “للقياس” في علم الأصول، لم يكن لينفك عن بُعده الأخلاقي والتربوي، شأنه في ذلك شأن بقية الأصول، وإن العودة إلى الاستعمال القرآني لمفهوم القياس بمعناه الواسع لَتُفْسِح الآفاق للوقوف على هذه المقامات التربوية والمسالك التخلّقية؛ بدءًا من مفهوم الاعتبار القرآني المتسربل بالمداليل الاتعاظية لتنوير البصائر والوصول بها إلى الحقائق الإيمانية، في قوله: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾[الحشر: 2]؛ إذ الاعتبار ههنا لا يُخْلِف دلالةَ العبور القياسية من الشاهد إلى نظيره، ومن الشاهد إلى الغائب، واعتبارِ الشيء بمثله ومقايسته به، وتعدية حكمه إليه.
وما زالت حجج القائسين القرآنية تفيض بهذه المعاني الاعتبارية لذوي البصائر، ومنها استدلالهم على حجيته بقوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾[يس: 78-79]، “فجعل خلق الأشياء دليلاً على إحياء الموتى، وهذا قياس يستمر في قضايا العقول، ولولا القياس ما صار دليلاً”.
فجملة ما جاء في كتاب الله تعالى من دعوة الناس إلى التأمل في عالم الشهادة: في وجود الحياة والموت، وخلق السماوات والأرض، وخلق الإنسان وغيره، وإحياء الأرض بعد موتها، واليقظة بعد النوم… إنما هي إشارات وإرشادات قرآنية إلى “القياس”؛ فإن الله عز وجل “قد أرشد عباده إليه في غير موضع من كتابه، فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان، وجعل النشأة الأولى أصلاً، والثانية فرعًا عليها؛ وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنبات، وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السماوات والأرض، وجعله من قياس الأَولى، كما جعل قياس النشأة الثانية على الأولى من قياس الأَولى؛ وقاس الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم، وضرب الأمثال، وصرفها في الأنواع المختلفة، وكلها أقيسة عقلية، يُنبه بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله، فإن الأمثال كلها قياسات، يُعلَم منها حكم المُمَثَّل من المُمَثَّل به، وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلاً، تتضمن تشبيه الشيء بنظيره، والتسوية بينهما في الحكم، وقال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾[العنكبوت: 43]؛ فالقياس في ضرب الأمثال من خاصة العقل”.
وهو – بهذا المعنى – من دلائل سلامة الفطرة الإنسانية لانسجامها مع القياس، وقد اعتبر القائسون هذا الانسجام دليلًا ينصر مذهبهم في الاحتجاج به، خاصة إذا اعتضدت الفطرة بالمنطق الصحيح؛ فإنه “قد ركز الله فطر الناس وعقولهم على التسوية بين المتماثلين، وإنكار التفريق بينهما، والفرق بين المختلفين، وإنكار الجمع بينهما”، وهو ما ينسجم وضروب القياس الأصولي؛ ذلك أن “مدار الاستدلال جميعه على التسوية بين المتماثلين، والفرق بين المختلفين؛ فإنه إما استدلال بمعين على معين، أو بمعين على عام، أو بعام على معين، أو بعام على عام؛ فهذه الأربعة هي مجامع ضروب الاستدلال”.
ومن ثم اعتبر الأصوليون القائلون بالقياس، أن “القياس دليل تؤيده الفطرة السليمة والمنطق الصحيح”، ومن صور هذا المعنى – مثلاً – أن “من نُهي عن شراب؛ لأنه سام، يقيس بهذا الشراب كل شراب سام، ومن حرم عليه تصرف؛ لأن فيه اعتداء وظلمًا لغيره، يقيس بهذا كل تصرف فيه اعتداء وظلم لغيره، ولا يُعرَف بين الناس اختلاف في أن ما جرى على أحد المثلينِ يجري على الآخر، ما دام لا فارق بينهما”.
والفطرة في هذا السياق، هي ميثاق أزلي بين العبد وربه، كما قال ابن السمعاني: “وأما الفطرة فتأويلها أن الآدمي يُخلق وعليه أمانة الله، التي قبلها آدم، عليه السلام، فيكون على فطرة الدين ما لم يخن فيما عليه من الأمانة، وكان على عذر في ترك الأداء عن عجز”.
وقد يُستعمل العقل أحيانًا مرادفًا لها في بعض الإطلاقات، من ذلك قول الغزالي، رحمه الله: “أما العقل فأعني به الفطرة الغريزية والنور الأصلي الذي به يُدرك الإنسان حقائق الأشياء؛ فالفطنة والكيس فطرة، والحمق والبلادة فطرة، والبليد لا يقدر على التحفظ عن الغرور، فصفاء العقل، وذكاء الفهم، لا بد منه في أصل الفطرة؛ فهذا إن لم يُفطر عليه الإنسان فاكتسابه غير ممكن، نعم إذا حصل أصله أمكن تقويته بالممارسة، فأساس السعادات كلها العقل”.
ولا شك أن مما فُطر عليه الإنسان أن يُلحِق الأشباه بنظائرها ويعتبر بعواقبها. ومن جملة الغايات السامية للقياس الدعوة إلى التأمل وإعمال النظر، وهو مقصد إسلامي رفيع، وأصل من أصوله؛ ذلك أن “من أصول الشريعة الإسلامية الدعوةُ إلى إعمال النظر والحض عليه، والإعلاء من شأن أهله، والتحذير من مغبة تعطيل هذه النعمة الإلهية، وتقريع المتكاسلين عن أهلها”.
وما ذلك كله – كما يذكر الأخلاقيون – إلا لأن “إعمال النظر مظنّة صحة النفس؛ لجريانه لها مجرى الرياضة، التي تحفظها من البلاهةِ والبلادةِ، وكلِّ مساوئِ الأخلاقِ التي تجرّها عليها العطالةُ والكسلُ؛ وذلك ما تثبته تجارب الحياة؛ فإن النفس متى تعطلت من النظر، وعدمت الفكر والغوص على المعاني، تبلدت وتبلهت، وانقطعت عنها مادة كل خير. وإذا ألفت الكسل، وتبرمت بالروية، واختارت العطلة، قَرُب هلاكها؛ لأن في عطلتها هذه انسلاخًا من صورتها الخاصة بها، ورجوعًا منها إلى رتبة البهائم، وهذا هو الانتكاس في الخلق، نعوذ بالله منه”.
ومن هذا المنطلق ينصح أهل التربية بتعويد النشء على النظر والتفكير لدفع البلادة والبلاهة، واكتساب الفضائل؛ فإنه “إذا تعوّد الحديث الناشئ من مبدأ تكوينه الارتياض بالأمور الفكرية… أَلِفَ الصدقَ، واحتمل ثقلَ الروية والنظر، وأَنِسَ بالحق، ونَبَا طبعُه عن الباطل، وسمعُه عن الكذب”.
إن القياس الأصولي بهذه النظرة التربوية دعوةٌ إلى:
1- النظر والتفكر.
2- الاعتبار والاتعاظ.
3- تحصيل الفضائل الأخلاقية.
4- صحة النفس وحفظها من البلاهة والبلادة.