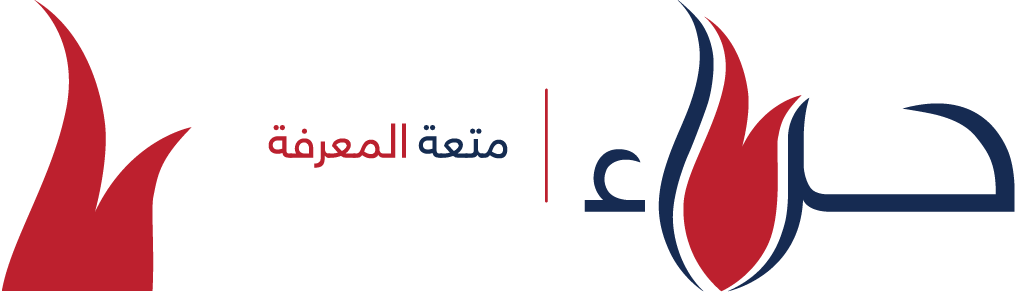كانت الكتابة قليلة في بلاد العرب حين ظهر الإسلام، وكان الكُتَّاب في مدن الجزيرة العربية آنذاك أفرادًا معدودين. وقال “البلاذري” وهو يتحدث عن الكتابة في مكة: “دخل الإسلام وفي قريش سبعة عشر رجلاً كلهم يكتب”، وقال عن الكتابة في يثرب: “إن الإسلام جاء وفيهم عدة يكتبون”، وذكر منهم أحد عشر كاتبًا، هم أُبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وعثمان بن عفان، وشرحبيل بن حسنة، وجهيم بن الصلت، وخالد بن سعيد، وأبَان بن سعيد، والعلاء بن الحضرمي، ومعاوية بن أبي سفيان، وحنظلة بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين. أما الطبري فقد ذكر أسماء عشرة من كتابه، مضيفًا علي بن أبي طالب، ومختزلاً شرحبيل بن حسنة، وجهيم بن الصلت.
وذكر المسعودي أسماء ستة عشر كاتبًا، مضيفًا إلى قائمة البلاذري والطبري الأسماء الآتية: المغيرة بن شعبة، والحصين بن نصيرة، وعبد الله بن الأرقم، والعلاء بن عقبة، والزبير بن العوام، وحذيفة بن اليمان، ومعيقيب الدوسي رضي الله عنهم. وقال المسعودي مبينًا وجهة نظره في عدد الكتَّاب الذين ذكرهم: “وإنما ذكرنا من أسماء كتابه من ثبت على كتابته، واتصلت أيامه فيها وطالت مدته، وصحت الرواية على ذلك من أمره دون من كتب الكتاب أو الكتابين والثلاثة، إذ كان لا يستحق بذلك أن يسمى كاتبًا ويضاف على جملة كتَّابه”.
ونلاحظ من كلام المسعودي أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب، ليس للرسائل فقط، بل هناك من كتَّاب الوحي، أو الرسائل، أو الصدقات، أو المعاملات، أو المداينات، أو المغانم، أو لأغراض إحصائية، وما إلى ذلك.
أما ابن عبد البر، فقد سمّى لنا ثلاثة وعشرين كاتبًا، وإذا استبعدنا من قائمته الذين ذكرهم البلاذري والطبري والمسعودي، نجد أن قائمته تزيد على قائمتي الطبري والمسعودي بالأسماء الآتية: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وخالد بن الوليد، وعبد الله بن رواحة، ومحمد بن مسلمة، وعبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول، وعمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين.
وذكر الديار بكري أسماء أربعة وثلاثين كاتبًا استوعبت القوائم المشار إليها، مع زيادة متمثلة في طلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، والأرقم بن أبي الأرقم، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه، وسعيد بن العاص، وحويطب بن عبد العزى العامري، وأبي سلمة بن عبد الأسد، وحاطب بن عمرو بن حنظلة رضي الله عنهم أجمعين، وقال: “قيل: إن كتَّابه نيف وأربعون، وأكثرهم ملازمة له زيد بن ثابت، ومعاوية بن أبي سفيان بعد الفتح”. وأوصلهم العراقي إلى اثنين وأربعين.
ويفهم من هذه النصوص أن كُتَّاب الوحي المعتمَدين هم: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وإن غاب هؤلاء تولى الكتابة من حضر من الكُتَّاب، وهم: معاوية بن أبي سفيان، وخالد بن سعيد، وأبان بن سعيد، والعلاء بن الحضرمي، وحنظلة بن الربيع رضي الله عنهم. وكان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب الوحي ثم ارتد عن الإسلام، ثم رجع إلى الإسلام يوم فتح مكة وحسن إسلامه. قال ابن تيمية: “وكان حنظلة بن الربيع، خليفة كل كاتب من كُتَّابه إذا غاب عن عمله”.
خصائص كُتَّاب الوحي
لم يكن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لكُتَّاب الوحي اختيارًا عشوائيًّا، بل كان مبنيًّا على ضوابط دقيقة. وربما يكون هؤلاء الكتبة ممن ذكرهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم تشريفًا لهم وإعلاءً لقدْرهم في هذه الأمة الربانية. ومن ثَم، تميَّز كُتَّاب الوحي بعدة خصائص، منها:
١- قوة الحفظ والتذكُّر: كان أول عهد الصحابة بالقرآن حفظه في الصدور، وحينما أُمروا بحفظه في السطور أظهروا براعة في كليهما، مما يدل على قوة الحفظ والتذكُّر، وهي مَلَكةٌ ضرورية لكتَّاب الوحي. وقد ساعدت هذه الملكة لاحقًا في تيسير جمع القرآن في مصحف واحد.
ومن دلائل هذه المهارة، أن زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، كان عمره عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سنة. استصغره النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فردَّه، ثم شهد غزوة أُحد -وقيل لم يشهدها- وكانت أول مشاهده غزوة الخندق. وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتعلُّم السريانية فتعلمها، ثم أصبح كاتبًا للوحي، وكتب بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
وكان زيد بن ثابت بن الضحاك حافظًا لبيبًا عالمًا عاقلاً. وقد ورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بتعلُّم كتاب يهود، ليقرأه عليه إذا كتبوا إليه، فتعلَّمه في خمسة عشر يومًا. وروى الإمام أحمد عن زيد قوله: ذُهِبَ بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأُعجب بي، فقالوا: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار، معه مما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة. فأُعجب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: “يا زيد، تعلَّم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتابي”. قال زيد: فتعلمت كتابهم، وما مرَّت خمس عشرة ليلة حتى حذقته، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه، وأجيب عنه إذا كتب”.
٢- سرعة البديهة والإدراك: تميَّز كُتَّاب الوحي رضي الله عنهم بسرعة الانتباه، وإدراك ما لا يدركه الآخرون، نظرًا لعِظَم الأمانة التي تحملوها. ومثال ذلك، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سُئل: ما حملكم على أن عمدتم إلى سورة الأنفال -وهي من المثاني- وإلى سورة براءة -وهي من المئين- فقرنتم بينهما، ولم تكتبوا بينهما “بسم الله الرحمن الرحيم”، ووضعتموهما في السبع الطوال؟
فقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيءٌ دعا من كان يكتب، فيقول: “ضعوا هذه الآيات في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذا”، وإذا نزلت عليه الآية يقول: “ضعوا هذه الآية في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذا”. وكانت “الأنفال” من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت “براءة” من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فقُبِض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يُبيِّن لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنتُ بينهما، ولم أكتب بينهما “بسم الله الرحمن الرحيم”، ووضعتهما في السبع الطوال.
٣- المعرفة التامة بعلوم القرآن: لما كان كُتَّاب الوحي هم أول من خطَّت أقلامهم الآيات فور نزولها، أصبحوا من أكثر الصحابة معرفة بالقرآن الكريم، ومثال ذلك ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حين سُئل: “لِم لَم تُكتب “بسم الله الرحمن الرحيم” في سورة براءة؟، فقال: لأنها أمان، وبراءة نزلت بالسيف.
كما رُوي عنه أنه حينما سُئل عن معنى قوله تعالى: (وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً)(الفرقان:٣٢)، قال: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف.
وقال الأئمة: لا يجوز لأحد أن يفسِّر كتاب الله إلا بعد أن يعرف الناسخ والمنسوخ.
٤- الطلاقة اللغوية: لما كان القرآن الكريم معجزًا بلاغيًّا، كان لا بد أن يتميز كُتَّاب الوحي بالفصاحة والبيان. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أفصح العرب، وهو صاحب “نهج البلاغة”.
ويُروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “أنا أفصح قريش كلها، وأفصحها بعدي أبَان بن سعيد بن العاص” (تفسير القرطبي).
٥- تحمُّل المسؤولية: تُعد كتابة القرآن وجمعه من أعظم المهام في تاريخ الأمة، إذ إن ضياع حرف واحد يعرِّض الرسالة كلها للتحريف. وكان كُتَّاب الوحي على قدر هذه المسؤولية، كما يتضح من قول زيد بن ثابت رضي الله عنه عندما كُلِّف بجمع القرآن: والله، لو كلفوني نقل جبل من الجبال، ما كان أثقل عليَّ مما أمرني به من جمع القرآن.
٦- علو الهمة: أنزل الله القرآن الكريم ليتدبره الناس ويعملوا به، وكان كُتَّاب الوحي من أسبق الصحابة إلى الخيرات. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يملك أربعة دراهم، فتصدَّق بدرهم ليلاً ودرهم نهارًا، ودرهم سرًّا ودرهم علانية، فنزلت فيه الآية: (الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)(البقرة:٢٧٤).
وعن حنظلة الكاتب الأسيدي رضي الله عنه، وكان من كُتَّاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا الجنة والنار حتى كأنَّا نراها رأي العين، فلما خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد فنسينا. فقلت لأبي بكر: نافقتُ! فقال: وما ذاك؟ قلت: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكِّرنا الجنة والنار حتى كأنَّا نراها رأي العين، فإذا خرجنا عافسنا الأزواج والأولاد فنسينا. فقال أبو بكر: إنا لنفعل ذلك. فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، فقال: “يا حنظلة، لو كنتم عند أهليكم كما تكونون عندي، لصافحتكم الملائكة على فُرُشِكُم وفي طُرُقِكُم، ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة” (رواه مسلم).
بهذا، يظهر جليًّا أن كُتَّاب الوحي كانوا نخبةً من الصحابة، اجتمع فيهم العلم والفصاحة، والورع وحُسن الفهم، وتحمل الأمانة العظيمة التي خُصُّوا بها في كتابة القرآن الكريم وحفظه للأجيال القادمة.
(*) أستاذ جغرافيا الأديان، وكيل كلية الآداب، جامعة دمنهور / مصر.
المراجع
(1) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، الدمياطي، تحقيق: أنس مهرة، ط1، دار الكتب العلمية، 1998م.
(٢) أسباب النزول، الواحدي، دار الكتب العلمية، 1980م.
(٣) أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير، تحقيق: خليل شيحا، مؤسسة الرسالة، 1990م.
(٤) إعراب القرآن، النحاس، تحقيق: زهير زاهد، عالم الكتب، 1988م.
(٥) الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ط3، مصطفى البابي الحلبي، 1959م.
(٦) البداية والنهاية في التاريخ، ابن كثير، مصطفى البابي الحلبي، 1358هـ.
(٧) البرهان في علوم القرآن، الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، 1972م.