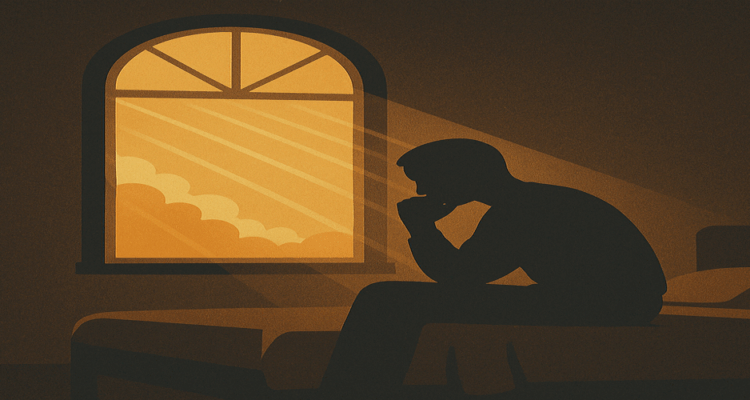تُعدّ الأمراض جزءًا لا يتجزأ من الحياة، فهي تصيب الإنسان في مراحل مختلفة من عمره. ومن المعلوم أن معرفة النفس تُعين على معرفة الله، كما تفضي إلى التطوير الذاتي والتنمية الشخصية. والأمراض تصيب النفوس بأشكال وأنواع متعددة، مما يجعل فهم أبعادها أمرًا ضروريًّا لاكتشاف أعماق الذات.
تتنوع نظرة الناس تجاه المرض؛ فبعضهم يرى فيه محنة، بينما يعتبره آخرون منحةً تحمل في طياتها دروسًا وحِكَمًا. والأجدر بالإنسان أن يتبنى رؤية متوازنة، ينظر من خلالها إلى المرض نظرةً صحيحة. فبالنسبة للمؤمن، يمكن أن يكون المرض وسيلةً للتقرب إلى الله، فكيف يكون ذلك؟
الإجابة واضحة: على الإنسان أن يدرك أن المرض قَدَرٌ من الله، وأنه سبحانه أعلم بحاله وما يصلحه أكثر من نفسه. فإذا ترسّخ هذا الفهم في قلبه، فلن يصيبه اليأس عند وقوع الابتلاءات، بل سيعينه ذلك على الصبر والثبات، فينال بذلك الأجر والثواب. فالله لا يبتلي عباده إلا ليختبر صبرهم ويجزيهم عليه، كما قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ﴾(محمد: 31).
لا ينبغي للمسلم أن يفقد الأمل في الشفاء، فالأمل الدائم يزيده قوة، حتى وإن وجد نفسه وسط لهيب المحن والصعاب. لذا، اجعل الأمل رفيق دربك وقائد مسيرتك، فهو أنيسك في الوحدة، وسندك في الشدائد، يمنحك القوة، ويمحو عنك الضعف، يجدّد روحك، ويهديك دروسًا وعِبَرًا تعينك على مواجهة المستقبل بثبات ويقين.
أما اليأس، فهو عدوٌّ واضح، يقف حاجزًا أمام التفاؤل، فلا تمنحه مدخلاً إلى قلبك، واحذر أن يجد له موطئ قدم في حياتك، حيث ينبغي أن تكون مقاعدها محجوزة للقيم السامية. حسن الظن بالله هو الدواء الأمثل لمقاومة اليأس والقنوط والتحسر والتشاؤم، فلا تنسَ أبدًا أن قدرة الله مطلقة لا يحدّها شيء، لا يعترضها قيد ولا مانع. والمؤمن لا يليق به اليأس أبدًا، فقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾(يوسف: 87).
الصبر على الأمراض والأسقام والابتلاءات يجعل المسلم محمودًا عند الله، مهذب النفس، مرفوع الدرجات، لأن ما يصيبه من مشاق المرض وأضراره يكون سببًا في مغفرة ذنوبه وتكفير سيئاته. غير أن تكفير الذنوب ليس بالأمر الهيِّن كما يظن البعض، بل هو فضل من الله ورحمة يمنحها لمن خصّه بمحبته وأدخله في عنايته. وحينما يمرض الإنسان، تدفعه حالته إلى التأمل في ذنوبه، فيتوب إلى الله، ويجتهد في اجتناب ما نهاه الله ورسوله عنه.
فكثيرًا ما يكون الغرور والاستكبار ناتجًا عن جهل الإنسان بضعفه، أو غفلته عن حقيقته البشرية، فيحتاج إلى ما يوقظه من سباته، وينبّهه إلى فقره وحاجته إلى الله. وهنا، يأتي المرض ليكون تذكرةً له، يهمس في قلبه وعقله، فيدفعه إلى إعادة النظر في حياته، ليقترب خطوةً بعد خطوة من ربه. وليس المرض إلا سببًا من أسباب تكفير الذنوب، كما أُشير إليه سابقًا، وهذا ما أوضحه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾(الشورى: 30).
قد يكون المرض عقابًا من الله لعبده، وقد يكون ابتلاءً وتمحيصًا له. فالمذنب والعاصي قد ينال عقاب الله بصورة المرض بسبب زلاته وعثراته، فتُكفَّر سيئاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “ما من مسلم يُصِيبُه أذًى من مرض، فما سواه إلا حطَّ الله به سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها” (رواه البخاري ومسلم).
أما المصلح التقي، الذي تغلب الحسنات على طبعه، فإنه أيضًا يصاب بالأمراض، لكنها تزيد من ثوابه، وترفع درجاته، وتجعل منه قدوةً لغيره في الصبر والاحتساب. وهذا يجيب عن تساؤلات البعض حول ابتلاء الأنبياء والأولياء والصالحين. فهناك من يدّعي أن الله قاسٍ حتى على عباده المقربين، وأنه غير عادل لأنه يبتلي الصالحين كما يبتلي الطالحين، ويضعهما في كفة واحدة من حيث المرض.
لكن إذا سُئلوا: “هل وعد الله بعدم ابتلاء الصالحين والمقرّبين إليه أبدًا؟” فلا يجدون جوابًا، فيلوذون بالصمت، ثم ينصرفون وكأنهم يريدون أن يدبّر الله الأمور وفق أهوائهم. ومن هذه الحقيقة، ندرك أن الفرق لا يكمن في الصلاح أو العصيان بحد ذاته، وإنما في ما يترتب على المرض؛ فبالنسبة للمذنب، يكون تكفيرًا للسيئات والذنوب، وأما الصالح، فيكون رفعًا للدرجات وزيادةً في الأجر.
ويجدر بالذكر هنا الصبر وعظمته عند الله وأهميته في حياة الإنسان، فقد قسّمه العلماء إلى ثلاثة أنواع: الصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي، والصبر على المصائب. تأتي المصائب في صور متعددة، مثل الابتلاءات، والامتحانات، والأمراض، والحوادث، والكوارث وغيرها. لذا، على المسلم أن يدرك أن هذه الدنيا دار اختبار وابتلاء، ولا تدوم على حال واحدة؛ فقد تتسع له اليوم وتضيق عليه غدًا، ولا يمكنه التنبؤ بما تخبئه الأقدار.
المؤمن يواجه المصائب بالرضا والتسليم، فلا ينساق وراء الغضب، ولا يرتكب ما يخالف شرع الله، لأنه يعلم أن ما ينزل به من شدائد ليس انتقامًا، بل تطهيرٌ لذنوبه ورفعٌ لدرجاته. فإن صبر ورضي بحكم الله، فلن تضعفه الأوهام، ولن تعرقله الأفكار الخاطئة. فالمرض، مهما كان شاقًّا، قد يكون فرصةً ثمينةً للتأمل والمراجعة، وليس مجرد ضيف ثقيل حلّ بلا دعوة. ولعظمة الصبر وعلو منزلته، ذكره الله في القرآن نحو تسعين مرة، مما يدل على رفعة مقامه وسمو أثره في حياة الإنسان.
الإحساس بالألم ضرورة لبقاء الإنسان حيًّا وسليمًا، فهو ينبهه إلى الخطر، ويدفعه للبحث عن العلاج في الوقت المناسب. فإذا أصيب الجسد بمرض دون أن يشعر صاحبه بأي ألم، فقد يظن أنه في صحة جيدة، بينما يزداد المرض تفاقمًا دون أن يدرك، حتى ينتهي به الأمر إلى الهلاك. لكن حين يشعر بالألم، يدرك وجود الخطر، فيسعى إلى التشخيص والعلاج قبل فوات الأوان.
وبهذا المعنى، يصبح الألم نعمةً من الله، فهو لا يحذر الإنسان من الخطر فحسب، بل يحثه أيضًا على مراجعة الطبيب واتخاذ الخطوات اللازمة في وقتها. فالتشخيص المبكر ضروري، إذ إن التأخر في العلاج يزيد من تفاقم المرض ويقلل من فرص الشفاء. فالألم ليس مجرد إحساس مزعج، بل هو صوت الجسد، يذكّرك بما غفلت عنه، ويدلّك على الطريق نحو التعافي.
إذا لجأت إلى الوسائل الدنيوية للشفاء، فلا تعتمد عليها وحدها، ولا تتعلق بها حصرًا، بل تذكّر دائمًا أن الشفاء بيد الله. فالاعتماد المطلق على الأسباب الدنيوية دون الالتفات إلى قدرة الله ينافي التوكل الحقيقي، كما أن التواكل وترك البحث عن العلاج ليس أمرًا محمودًا. لا يليق بالمسلم أن يعتقد أن الطب وحده هو الذي يشفيه ويمحو عنه آثار المرض، بل عليه أن يجمع بين الأخذ بالأسباب والثقة برب العالمين. فالدين لا يمنع الإنسان من طلب العلاج، بل يحثه على السعي للحفاظ على صحته بكل الوسائل المشروعة، لأن الجسد أمانةٌ يجب العناية بها قدر المستطاع.
المرض يوقظ فيك الشعور بمعاناة الآخرين، فيذكّرك بإخوانك المرضى الذين كانوا يعيشون حولك، يحتاجون إلى الرعاية والمساندة، بينما لم يخطر ببالك أحدهم، ولم تسأل عنهم أو تزُرهم يومًا. لكن حين يصيبك المرض، تزول غفلتك، وتتفتح عيناك على معاناتهم، فتحدد وقتًا لزيارتهم، وتسعى لمساعدتهم، وتدعو لهم بالشفاء والعافية. من خلال تجربتك في تحمّل الألم ومشقة المرض، تدرك حقيقة ما يمرون به، بعدما كنت تراه مجرد إشاعة أو أمرًا بعيدًا عنك. فكيف يمكنك بعد ذلك أن تدّعي أن المرض لا يحمل لك أي فائدة؟
عندما أزور جدي وأسأله عن مرضه وآلامه، يشكو عجزه عن أداء العبادات والواجبات كما كان يفعل قبل اشتداد المرض. فأحاول أن أواسيه وأطمئن قلبه بأن الله يثيبه حتى وإن لم يتمكن من أدائها في مرضه، لأن الأعمال الصالحة التي اعتاد عليها تُكتب له كما لو كان يؤديها. فقد جاء عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إذا ابتلى اللهُ العبدَ المسلمَ ببلاءٍ في جسده، قال للملَك: اكتبْ له صالحَ عمله الذي كان يعملُ، فإن شافاه، غسله وطهره، وإن قبضه، غفر له ورحمه” (مسند أحمد).
لا تظن أن المرض يقرب الإنسان من الموت، ولا أن الصحة تبعده عنه، فكم من صحيحٍ مات بلا علة، وكم من مريض نجا من داءٍ عضالٍ وعاش سنين طويلة. كما يقول الشاعر:
| كَمْ مِنْ صَحيحٍ ماتَ مِنْ غيرِ عِلَّةٍ | وَكَمْ مِنْ عَليلٍ عاشَ حِيناً مِنَ الدَّهْرِ |
| وَكَمْ مِنْ فَتًى يُمْسي ويُصبِحُ آمِنًا | وقد نُسِجَتْ أكفَانُهُ وَهُوَ لا يَدْرِي |
قد يحرمك المرض بعض حظوظ الدنيا، فتشعر بالحسرة، وتظن أن الأقدار قد وقفت ضدك، لكن هذه الأفكار لا تسيطر عليك إلا إذا كنت ترى الدنيا غايةً كبرى. فالأجدر أن تصغّرها في عينك، فهي لا تستحق الحزن على فقدانها.
لا تنسَ أن المرض سُنّة من سنن الله في خلقه، لا يسلم منه أحد، لكنه يختلف من شخص لآخر. فكن راضيًا بقضاء الله، وادعه أن يرزقك السكينة والطمأنينة، وإن شُفيت، فاذكر أن الشفاء من عنده، واشكره على نعمه التي لا تُحصى.