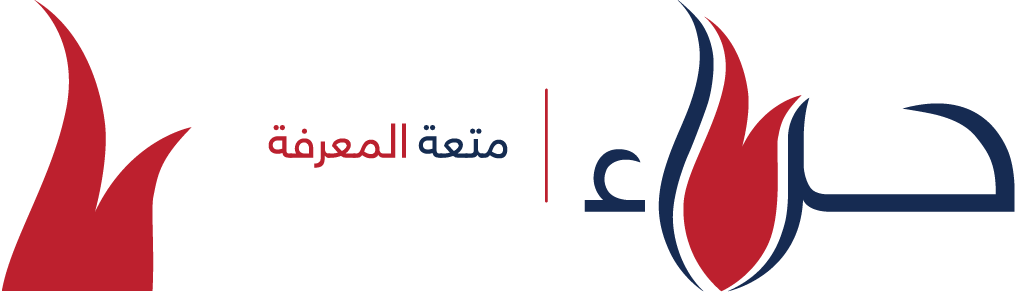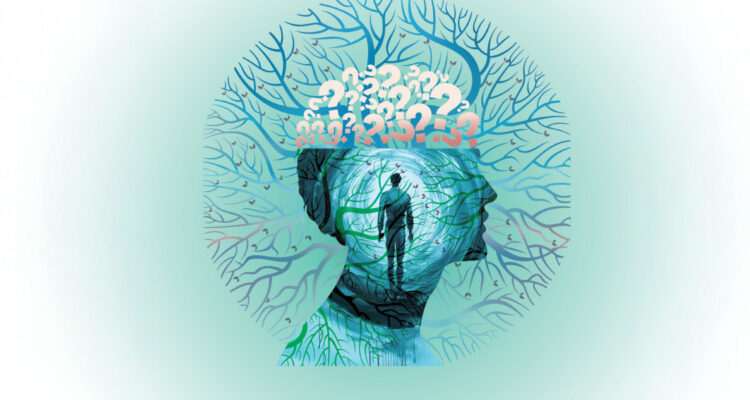لا شك أن الارتباط بين العلم والحياة، هو تلك الوشيجة التي يصبح فيها كل منهما مصدرًا للآخر، حيث تبدو نقطة الانطلاق من الحياة وتجاربها الصعبة واحتياجاتها المتعددة لسبر غور إشكاليات وتعقدات علاقاتها الحسية والمادية. وربما كان فقه التعامل بين البشر قائمًا على تلك الجدلية، وهي العلاقة بين الوجدان والشعور من جهة، ومواقف وتحولات الحياة من جهة أخرى.
ومن هنا تأتي أهمية العلم والبحث العلمي في جميع المناحي التي تختص بتلك التعاملات، انطلاقًا من حالة اجتماعية ونفسية ربما اتسمت بالمرض/الشذوذ عن النسق السوي للإنسان، من خلال انفعالاته التي هي محصلة دوافعه النفسية والعصبية، وانطلاقًا مؤسسًا من عواطفه التي تحتاج إلى العلم كي يعيد إليها اتزانها، أو درسها على النحو الصحيح، مع تقدم الزمن وتقدم البحوث، وتزايد الحاجة الملحة لتوسيع دائرة البحث العلمي والطبي المرتبط بوجود البشر، وزيادة في الارتباط الوثيق في تلك الحالة الإعجازية التي أتى بها القرآن الكريم مصداقًا لقوله تعالى: (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ)(فصلت:53).
“على الرغم من أن عقد الثمانينيات قد حمل إلينا أخبارًا سيئة، فإنه قد شهد أيضًا زيادة غير مسبوقة في الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بعواطف الإنسان، وربما تمثلت النتائج الأكثر إثارة لتلك الأبحاث في تلك اللمحات المصورة للمخ وهو يعمل، والتي أصبح إنجازها ممكنًا بفضل وسائل وأساليب مبتكرة حديثة”.. ربما كان هذا مدخلاً علميًّا مهمًّا لعلاقة العواطف الإنسانية/النفس التي أشارت إليها الآية الكريمة، بالعملية الفيزيائية الصرفة التي يسعى العلم للربط بينها، والعمل على تأصيل تلك الدراسات والأبحاث لخدمة الإنسانية، ومدى استفادة الحياة من تطورات العلم.. فهذا الحقل المهم من الدراسات، لم يكن مُدرجًا ضمن اهتمامات أبحاث علم النفس، ومن أجل إيجاد الرابط بين ما يحدث من تصرفات البشر وانفعالاتهم، وبين الجهد العلمي لمعرفة أسباب تلك الانفعالات، والقدرة على التحكم فيها وتوجيهها، فثمة عناصر مهمة تدخل في هذا السياق لتقنن أسباب ما يمكن تسميته بالانحراف العاطفي، من خلال التقارير العلمية والبحثية المواكبة للعديد من الأمراض النفسية التي تصاحب البشر، مثل حالات الاكتئاب التي تجتاح العالم، التي تنضوي تحتها تصرفات المراهقين وحوادث الطرق وتداعيات مشاكل الموظفين، التي أدت إلى ظهور عدة مصطلحات، مثل “الإساءة العاطفية”، و”توتر ما بعد الصدمات” الذي يجعل دخول هذه الإشكالية ومن ثم مصطلح “الذكاء العاطفي”، في مضمار علم النفس واجبًا وضروريًّا.
المخ والانفعال
“إن فهم التفاعل بين تراكيب المخ التي تحكم لحظات غضبنا وخوفنا أو لحظات الحب والفرحة، يكشف عن الكثير فيما يتعلق بكيفية تعلمنا للعادات العاطفية التي يمكن أن تقوض أفضل أهدافنا، وكذلك ما الذي بوسعنا أن نفعله للسيطرة على انفعالاتنا العاطفية الهدَّامة والمسببة للإحباط.. والأكثر أهمية هنا، أن معطيات دراسة الجهاز العصبي تتيح مجالًا واسعًا لإمكان تشكيل العادات العاطفية لأطفالنا”.. ذلك ما يؤدي بنا لمحاولة معرفة إدارة حياتنا العاطفية بذكاء.. فالعواطف بحسب الرؤية الأرسطية في الفلسفة، هي التي تقود التفكير والقيم وصراع البقاء، وسلامة هذه العاطفة وكيفية التعبير عنها، فعملية إسباغ الذكاء على العواطف تتماثل وتتوازى مع حالات طبع التحضر والمدنية، ومن ثم تطبيق الذكاء على الاهتمام والتعاطف لحياتنا الاجتماعية المشتركة، وهو ما يجعلنا نلج منطقة انفعالات تتأرجح فيها العاطفة بين العقل والقلب ومن ثم التقسيم إلى عاطفي ومنطقي، وبين مدركات الإنسان الحسية وانفعالاته الناتجة عن ذلك في عملية كيميائية جديدة ومتطورة:
“وقد نشأت الطبقات الرئيسية للعقل الانفعالي مع ظهور الثدييات، وهي الطبقات المتحلقة حول جذع المخ، وتشبه عمامة صغيرة بأسفلها تجويف يستقر فيه الجذع. ولأن هذا الجزء من الدماغ يلتف ويحيط بجذع المخ، أطلق عليه “الجهاز الحوفي” (Limbic System)، وهو مشتق من الكلمة اللاتينية “Limbus” ومعناها “دائرة”. هذه الأرض الجديدة الخاصة بالأعصاب، أضافت إلى سجل المخ التاريخي عواطف وانفعالات متميزة؛ فالجهاز الحوفي هو الذي يتحكم فينا حين تسيطر علينا الشهوة أو الغضب، أو الوله في الحب، أو التراجع خوفًا”. ما يشير إلى أن الانحياز العاطفي لا يأتي إلا من خلال سلسلة من التفاعلات أو الانفعالات التي للعملية الفيزيائية دور فعال فيها، حيث تمثل كل الانفعالات سجلاًّ لحالات الإنسان وحواسه المتباينة التي تظهر على السطح وتؤثر في علاقاته الاجتماعية والنفسية، تدفع به في اتجاه تنظيمها والعمل على الاستفادة منها في ضبط إيقاع المواقف المختلفة التي تظهر بها انفعالات البشر.
لذا فالتحكم في الذكاء العاطفي/الانفعالي، يعتمد على تدريبات عميقة وطرائق تحليل يعمل البحث العلمي على استقصائها وتطويرها من خلال ما يسمى “تشريح النوبات الانفعالية”، حيث تمثل العلاقات الإنسانية نوعًا من انفجارات انفعالية تمثل في حقيقتها نوبات عصبية: “وفي مثل تلك اللحظات يعلن المركز الحوفي حالة الطوارئ، وفي لحظة واحدة تحدث النوبة بإثارة لحظات الانفعال الحرجة، قبل أن يُتاح للقشرة الجديدة -وهي العقل المفكر- الحصول على فرصة لتأمل ما يجري، لينفرد بقرار يحدد فيه إذا كانت تلك النوبة الانفعالية فكرة طيبة أم لا. إن هذه النوبات الانفعالية ليست مجرد أحداث منفصلة ومرعبة تؤدي إلى جرائم وحشية، إنما هي أيضًا أحداث تتكرر معنا في صورة أقل مأساوية وإن لم تكن أقل حدة”.
هذا ما يبين إلى حد بعيد آثار تلك العملية الكيميائية التي تحدث داخل العقل؛ لتؤثر مع الانفعالات على مصير الخارج منها، وهو اجتراح الجرائم -مثلًا- أو الخروج عن التقاليد السوية والطباع القويمة المتزنة التي تسمى عملية الذكاء التي يراد بها في الأخير تطوير حالة التكيف مع الواقع بعيدًا عن تلك الاضطرابات التي تؤدي إلى العكس، أو التي ترسل الفرد إلى الجانب الأسوأ في علاقاته الأزلية والطارئة على حد السواء مع الآخرين.. ذلك أن انفجار الغضب في اللحظات الحاسمة وغير المحسوبة، يؤدي إلى اختلال معيارية العلاقات التي تتباين فيما بين الهجوم أو الدفاع عن النفس في صورة هيستيرية يسيطر عليها الانفعال، وما يؤدي -على نحو آخر- إلى العجز عن تقدير المشاعر العاطفية إلى أن يفقد الإنسان القدرة على التواصل مع الآخرين، وهو الجانب الإيجابي للذكاء العاطفي الذي يلعب دوره في تصويب تلك المؤثرات أو الانفعالات التي تؤدي إلى هذه الحالة من الانحراف ثم الشذوذ والانعزال.
فلا شك أن ما يثير الفضول لتفهم وتقدير قوة العواطف وتأثيرها في حياتنا العقلية، هو تلك اللحظات التي تثير المشاعر، ثم نندم عليها بعد أن ينقشع عنها “غبار الانفعال”، ويكون تذكرها فيما بعد أمرًا شديد الوطأة على النفس.
“ومن أكثر الاكتشافات قوة حول العواطف في عقد الثمانينيات، الاكتشاف الذي توصل إليه “جوزيف لودو” (Joseph Le Doux) وأظهر به كيف منح المخ “الأميجدالا” مركزًا متميزًا، كحارس عاطفي قادر على القيام بتجنيد وظائف الدماغ”.. على أن الدور الذي تقوم به “الأميجدالا” الحارسة من تخزين الذاكرة والدلالات العاطفية التي تصحب الأفكار اللاواعية، ودور الحارس الذي يقوم به هذا الجزء المهم للحفاظ على المدركات الحسية ومن ثم الانفعالات، هو الدور المحوري الذي يجمع بين كل المكونات الحسية التي تكمن في الذاكرة الباكرة. ويبدو أن إثارة وإيقاظ “الأميجدالا” يعملان على تسجيل لحظات الإثارة الانفعالية مضافًا إليها درجة من القوة، وهذا هو السبب المرجح للقدرة على تذكر الأشياء والصدمات الاستثنائية. وبقدر شدة إثارة “الأميجدالا” تكون قوة انطباع الحدث في الذاكرة، فالخبرات التي تخيف وتهز الحياة هي أكثر الذكريات التي لا تمحى من الذاكرة.
طبيعة الذكاء العاطفي
“هناك بالتأكيد علاقة بين مُعامل الذكاء (I.Q) وظروف الحياة بالنسبة لمجموعة واسعة من الناس بصورة عامة، ذلك لأن كثيرًا من أصحاب مُعامل الذكاء المنخفض يشغلون وظائف متواضعة، بينما يحصل أصحاب مُعامل الذكاء المرتفع على وظائف ذات أجور مرتفعة، ولكن الأمور لا تكون على هذا النحو على الدوام”.
تبدو علاقة الذكاء بالحياة قياسية إلى حد بعيد، حيث تلعب الظروف الأساسية التكوينية للبشر دورًا مهمًّا في توظيف نسبة الذكاء بحسب طبيعته وبحسب تلك النشأة الفطرية، التي لها عوامل نشوئها ومحاولات ارتقاء أصحابها كي ينالوا مواقعهم في الحياة، فضلاً عن وجود استثناءات للتنبؤ بالنجاح. فقد تبين أن الغالبية العظمى من أصحاب المراكز المتميزة في المجتمع، لم تحدد تجارب مُعاملات الذكاء مدى نبوغهم أو تميزهم، بل تدخلت في هذا النجاح عوامل أخرى طبيعية وغير طبيعية، قد تتخطى جانب الطبقة الاجتماعية وعامل التوفيق وعدم التوفيق أو نسبة الحظ.
“الواقع أن هذه هي المشكلة، فالذكاء الأكاديمي لا يُعد المرء في الواقع لما يجري في الحياة بعد ذلك من أحداث مليئة بالاضطرابات والتقلبات، أو لما تتضمنه من فرص، ومن ثم فإن أي ارتفاع في مستوى الذكاء لا يضمن الرفاهية أو المركز المتميز أو السعادة في الحياة، ذلك أن المؤسسات التعليمية وثقافتها تقف في ثبات عند القدرات الأكاديمية، متجاهلة الذكاء العاطفي، والذكاء العاطفي مجموعة من السمات الشخصية”. ما يعطي مؤشرات شخصية بحتة لذكاء عاطفي يكفل للشخصية سبل النجاح في ترسم الخطوات، والحصول على فرص في الحياة قد تتخطى إلى حد بعيد -وفارق- فرص الذكاء الأكاديمي الممنهج، الذي يقوم على الدراسة المنهجية والقياسات العقلية المبنية على قواعد الدراسة ومداخل كل فرع منها وأساسياته، فضلاً عن العملية التحفيزية الأكاديمية القائمة على خطط رياضية مدروسة ممنهجة، بعيدًا عن التفاعلات الداخلية التي يكتسبها العقل من ممارسات الحياة مع كيمياء المخ ومعدلات الإدراك والذكاء الفطريين الداخليين: “يقف “هوارد جاردنر” (Haward Gardener) العالم السيكولوجي بكلية التربية بجامعة هارفارد، وراء مشروع تحليل القدرات والمواهب “لقد حان الوقت لنوسع فكرتنا عن تحليل القدرات والمواهب”، والواقع أن الإسهام الأهم الوحيد للتعلم بالنسبة لنمو الطفل، هو مساعدته على التوجه إلى مجال يناسب مواهبه، ويشعر فيه بالإشباع والتمكن”، وهي الطريقة المثلى التي يمكن من خلالها توجيه الطاقة البشرية الكامنة توجيهًا صحيحًا يمثل اتجاهًا منهجيًّا من نوع خاص، ومختلفًا عن السياق الأكاديمي الصرف بفتح القنوات للداخل الموهوب القائم على رصد وتحليل يجمع بين مادية العلاقة ومعنوياتها، منذ البدايات الباكرة من العمر، حيث يسهل التشكيل بما يتواءم مع فطرية العلاقة مع الموهبة وطزاجة عقل ووجدان يفجر طاقات الإبداع والتوجيه لإنشاء علاقة عاطفية ناجحة مع من حوله، ومع ميوله التي تبعد عن عدوانية وانفعالات غير محببة تؤدي إلى تشوه/تدمير العلاقات مع الآخرين.
من دروب الذكاء العاطفي
“وقد لاحظ “جاردنر” أن أساس الذكاء في العلاقات بين البشر، يشمل القدرة على أن تميز وتستجيب استجابة ملائمة للحالات النفسية والأمزجة والميول والرغبات الخاصة بالآخرين، ويضيف أن مفتاح معرفة الذات في ذكاء العلاقات الشخصية، هو التعرف على المشاعر الخاصة والقدرة على التمييز بينها، والاعتماد عليها في توجيه السلوك”.. ما يدعو بشكل كبير إلى أهمية بعد الذكاء الشخصي الذي تلعبه العواطف الإنسانية، لأن أبحاثه ترتكز على نموذج معرفي في العقل يؤكد على الإدراك والمعرفة، وأن الإنسان لا بد وأن يتفهم ذاته ودوافع الآخرين فيما يتعلق بعاداتهم في العمل، واستخدام هذه البصيرة في تيسير أمور حياته الخاصة والتواصل مع الآخرين كغاية من غايات الذكاء العاطفي؛ “فعالم الإنسان العاطفي يتجاوز مدى اللغة والمعرفة”، حيث يتطلب الاطلاع إلى آفاق متجددة لتجدد العلاقات مع الذات ومع الآخرين.
تلك الأيديولوجيا التي يتعامل به النموذج الإنساني مع الواقع، لخلق جو مفعم بالتفاهم والانسجام في مواجهة عراقيل واضطرابات نفسية تعترضه بمنغصاتها وانفعالاتها وردود أفعالها الضارة، بل والكارثية في كثير من الأحيان.
“والواقع أن مراقبة الذات على أحسن الفروض، تحقق إدراكًا رصينًا للمشاعر المضطربة والمتقدة، إنها في أقل تقدير تقدم نفسها في صورة ظاهرية وبسيطة، وكأنها عائدة لتوها من خبرة ما، هي مجرى يوازي الوعي، أي ما بعد توزع الانتباه في مجرى الوعي الرئيسي أو بجانبه، مدركة الحدث الجاري أكثر من انضمامها إلى هذه المشاعر وضياعها فيها”.. نلاحظ هنا هذه العلاقة المتأرجحة بين الشعور والانفعال، وتحكيم الوعي المكتسب بأي طريقة من الطرق، حيث يراهن عليه العقل في إدراك هذه التوافقية التي تميز الإدراك والانتباه حتى على سمة الشعور انحيازًا إلى الحدث الجاري، كما تشير تلك النقطة السابقة، وتستنبط طريقة من طرق التعامل مع الغاية، التي هي التحكم في المشاعر من أجل إكسابها سمة من سمات الذكاء الانفعالي أو العاطفي في أبعد صوره عن الانفعال، وأقربها إلى التعقل وإعطاء فرصة للوعي والتوقع والحدس لإدراك الصواب.. ذلك ما نسعى إليه غالبا!
فهكذا يعني الوعي الذاتي: “أن نكون مدركين لحالتنا النفسية وتفكيرنا بالنسبة لهذه الحالة المزاجية النفسية”، وهو ما يشير إليه “جون ماير” العالم السيكولوجي بجامعة هامبشير، الذي قام بوضع نظرية الذكاء العاطفي مع “بيتر سالوفي” بجامعة ييل: “ولا شك في أن الوعي بأنفسنا أمر جوهري للبصيرة النفسية، أي المقدرة الذهنية التي تعززها معظم عمليات العلاج النفسي. ويعتبر الدكتور “هوارد جاردنر” نموذج “سيجموند فرويد” هو النموذج الأمثل لذكاء النفس الكامن، إن “فرويد” هو الذي رسم خريطة ديناميات النفس الإنسانية الخفية، وقد أوضح أن حياتنا العاطفية في معظمها حياة لا شعورية، عبارة عن مشاهد تتحرك بداخلنا لا تتخطى دائمًا عتبة الوعي”.
(*) كاتب وناقد مصري.
المرجع
(1) الذكاء العاطفي، دانييل جولمان، ترجمة: ليلى الجبالي، سلسلة عالم المعرفة.