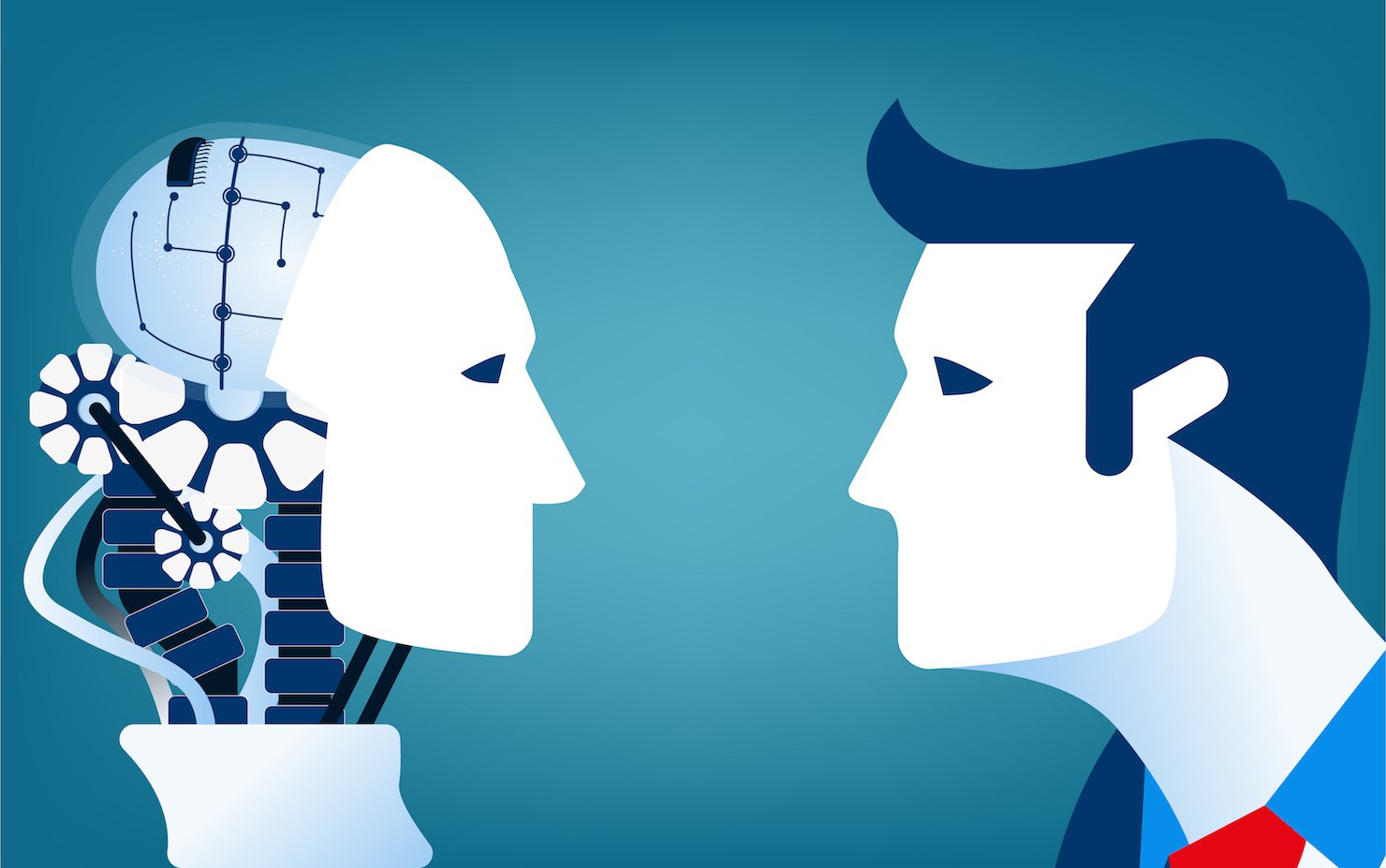زراعة الأعضاء والأنسجة واحدة من أكثر مجالات الطب والجراحة أهمية. لما لها من جوانب مهنية، وأخلاقية، وقانونية، واستشرافية. فعبر عقود.. يشهد هذا المجال تراكماً مهنياً وتقنياً باهراً، ومتلاحقاً، ومتطوراً. لذا فمن المحتمل، قريباً، أن يكون هناك “الإنسان الأعلى” (السوبرمان) المتكامل وراثياً وإحيائياً، و”الإنسان الآلي” (الفائق الذكاء، والثقافة، والأداء)، و”السيبورج” الخليط من العقل البشري والأعضاء الطبيعية، والأجهزة الصناعية.
تتنوع عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة. فقد يتم نقل جزء من جسم المريض إلى موضع آخر جسده (طعماً ذاتياً (Autograf وقد يُستبدل عضو/ نسيج “تالف أو غائب” بآخر من شخص حي أو متوفٍ دماغياً، كطعم مغاير (Allograft) وتندرج أغلب عمليات الزراعة ضمن الطعوم المغايرة. لكن للاختلاف الجيني بين العضو المزروع وجسد المتلقي دوره الهام. وسيعمل الجهاز المناعي للمتلقي مع العضو المزروع كجسم غريب، يرفضه، ويتصارع معه للقضاء عليه. لذا يتم تناول المثبطات المناعية، مما قد يجعل الجسم عرضة لغزو عوامل ممرضة أخري. لكن عندما يتم الاستزراع المغاير لكن بين متطابقين وراثيًا، كالتوائم المتماثلة، يسمي ذلك بالطعم المماثل (Isograft). إلا أنها لا تثير رد فعل مناعي، كسابقه.
أما زراعة طُعم أجنبي (Xenograft) فيحدث عند النقل من سلالة إلى سلالة مغايرة. كزراعة صمام قلب خنزير في جسد إنسان (من العمليات الشائعة والناجحة). وتعتبر الخنازير من أهم مصادر إنتاج الأعضاء المهندسة بيولوجياً، لتشابه حجم أعضائها مع مثيلاتها البشرية. فضلاُ عن سهولة تربيتها، وسرعة نموها، وقصر فترة حملها، وكثرة أعداد إنجابها، عدم تعرضها للانقراض كالشمبانزي، أو للنقد المجتمعي/ البحثي كما في القرود. وهناك محاولات زراعة أنسجة (كأنسجة البنكرياس) أو المعزولة من أسماك إلى كائنات غير بشرية من فصيلة الرئيسيات. وحال نجاحها.. ستمهد الطريق لتطبيقها على الإنسان. وتنطوي زراعة الطعوم الأجنبية على قدر من المخاطر الطبية، لتزايد احتمالات عدم التوافق والرفض المناعي، والإصابة بعدوى مرضية. عموماً، في ظل توفر مهارات جراحية وتقنية.. تراكمت نجاحات، مع القدرة على التحكم في الرفض المناعي، والآثار الجانبية لإنقاص المناعة (مشكلتي العدوى، واعتلال الكلى).
أعضاء وأنسجة تحت الطلب
تشمل الأعضاء التي يمكن زراعتها: الكلي، والقلب، والكبد، والرئتين، والبنكرياس، والأمعاء، والغدة الزعترية. وتشمل الأنسجة كلاً من العظام، والعضلات، والأوتار، والقرنية، والجلد، وصمامات القلب، والأوردة. وتعد زراعة الكلى من أكثر العمليات شيوعًا على مستوي العالم. وتفوقها عمليات زراعة العضلات والعظام بأكثر من عشرة أضعاف. ويمكن الحصول على أنسجة المتبرعين المتوفين بأزمات قلبية في غضون 24 ساعة من توقف القلب. وعلى عكس الأعضاء، يمكن حفظ معظم الأنسجة (باستثناء القرنية) وتخزينها في “بنوك” لفترة تصل إلى 5 سنوات.
وتسمح أبحاث الطب التجديدي بإعادة تكوين أعضاء من الخلايا الخاصة بالمريض نفسه، كالخلايا الجذعية، أو خلايا مستخرجة من أعضاء مصابة بقصور. وفي عام 2007 تمكن فريق بقيادة “دوريس تايلور” مديرة مركز أبحاث الطب التجديدي بمعهد “تكساس” لطب القلب في “هيوستن”، بعزل قلب فأر وإزالة خلاياه (بمنظفات حيوية)، لتكوين هيكل داعم/ سقالة (Scaffold). وتم عليه استنبات خلايا قلب فأر جديدة لمدة 28 يوماً في “مفاعل حيوي”((Bioreactor. وخفق القلب، في اليوم الرابع لهذا الاستنبات، وبينما بلغت قدرته على الضخ، في اليوم الثامن، نحو 2% من قدرة قلب فأر ناضج. وفتحت هذه المبادرة الباب، واسعاً، لتعميم التجربة على الأعضاء الأخرى كالكلي، والرئة، والكبد. ولسد الفجوة بين المتبرعين وقوائم الانتظار الطويلة.
لوائح وقوانين منظمة
يثير موضوع زراعة الأعضاء العديد من القضايا المهنية والأخلاقية والقانونية، بما في ذلك تعريف “الوفاة”. وتوقيت وكيفية التصريح بزراعة الأعضاء، و”التبرع الخيرّ”، و”التبرع مدفوع الأجر/ البيع/ التجارة”، والتبرع الموجه/ الإجباري، والسياحة القائمة على زراعة الأعضاء، والسياق الاجتماعي- الاقتصادي الذي تُجرى في إطاره عمليات نقل أو زراعة الأعضاء. وتعاني معظم الدول عجزاُ في عدد الأعضاء المتوفرة للزرع، مع قوائم انتظار طويلة. وقد ساهمت شبكة الإنترنت والإعلانات الشخصية، والإغراءات المالية من قبل المنتظرين إلى زيادة الاهتمام بمخاطر بيع الأعضاء.
وفي الولايات المتحدة، تختص إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) بتنظيم وتأمين عمليات زراعة الأنسجة، فقط. وتهدف للوقاية من انتشار الأمراض المعدية، وفحص المتبرع، وتجهيز وتوزيع طعوم الأنسجة. وقد حظر القانون الوطني لزراعة الأعضاء عام 1984 بيع الأعضاء. وفي المملكة المتحدة، صدر قانون مماثل عام 1989، لكن حل محله قانون الأنسجة البشرية عام 2004. وفي عام 2007، صدرت توصيات مناهضة لبيع الأعضاء عن إثنين من أكبر المؤتمرات الأوروبية.
محطات تاريخية
تشير كتابات إلى أن الجراح الهندي “سوشروتا” (عاش في القرن الثاني ق م) قد أجرى زراعة جلد (بطعم ذاتي) لتجميل الأنف. لكنه لم يُوثق نجاح أو فشل محاولته. وبعد مضي قرون، أجرى الجراح الإيطالي “جاسبارو تاجلياكوزي” زراعة جلد ناجحة بطريقة الترقيع الذاتي؛ وفشل في الطعم المغاير لرفض الجسم لها. وأرجع ذلك إلى “القوة، والسلطة الفردية” (ذكر ذلك عام 1596 في كتابه De Curtorum Chirurgia per Insitionem). وكانت فترة الحرب العالمية الأولى قد شهدت خطوات بارزة في زراعة الجلد، ولا سيما ما أجراه النيوزيلاندي السير “هارولد جيليز” في “إلدرشوت” التابعة لبريطانيا العظمى. وكان “إدوارد زيرم” قد أجري، عام 1905، أول زراعة/ ترقيع قرنية ناجحة في عين إنسان، في “أولوموك” بجمهورية التشيك. ولكل من “أليكسيس كاريل”، و”تشارلز جوثري” ريادة ناجحة في عمليات زراعة الشرايين والأوردة في بدايات القرن العشرين. وأدت مهارات توصيل الأوعية الدموية، إلى جانب تقنيات الخياطة الجراحية لتمهيد الطريق لجراحات زراعة الأعضاء لاحقًا. وأسهم ذلك في حصول “كاريل” على جائزة نوبل (1912). وهو الذي بدأ، منذ عام 1902، بتجارب لزراعة الأعضاء في الكلاب، مع نجاحه في نقل الكلى، والقلب، والطحال. وهو من أوائل الذين تنبهوا لمشكلة رفض الجسم للعضو المزروع.
وثمة محطات تاريخية أخري لعمليات ناجحة ورائدة في زراعة الأعضاء: فأول زراعة كـُلية كانت عام 1954، قام بها “جوزيف موراي” (بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية). وفي عام 1966 زرع أول بنكرياس قام به “ريتشارد ليلهاي”، و”وليام كيلي” (مينيسوتا، الولايات المتحدة الأمريكية). وأجريت أول زراعة كبد عام 1967 علي يد “توماس ستارزل” (دينفر، الولايات المتحدة الأمريكية). وفي نفس العام تم زراعة قلب أجراها “كريستيان برنارد” (كيب تاون، جنوب أفريقيا).
أما عام 1981 فكانت أول زراعة قلب / رئة ناجحة قام بها “بروس ريتز” (ستانفورد، الولايات المتحدة الأمريكية). وبعد عامين تمت زراعة أحد فصي الرئة أجراها “جويل كوبر” (تورنتو، كندا). وقام نفس الجراح، عام 1986، بزرع رئتين للسيدة (آن هاريسون). أما أول استئصال كلية بالمنظار من أحد المتبرعين الأحياء فكانت عام 1995، علي يد “لويد راتنر”، و”لويس كافوسي” (بالتيمور، الولايات المتحدة الأمريكية). وبعد ثلاث سنوات أجريث زراعة بنكرياس جزئية من أحد المتبرعين الأحياء قام بها “ديفيد ساذرلاند” (مينيسوتا، الولايات المتحدة الأمريكية). وفي فرنسا عام 1998 تمت أول زراعة يد ناجحة. وبعد عام كانت زراعة مثانة ذات أنسجة معدَّلة وراثيًا أجراها “أنتوني عطا الله” (في بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية).
وفي 2005 تم زراع وجه جزئي (فرنسا). وبعد عام كانت أول زراعة فك باستخدام النخاع العظمي للمريض، وأجراها “إريك إم. جيندين” (مستشفى ماونت سيناي في نيويورك). أما أول زراعة ذراعين كاملين فكانت عام 2008 علي يد “إدجار بيمار” و”كريستوف هانكه”، و”مانفريد ستانجل” (ميونيخ، ألمانيا). وفي عام 2008 ولد أول طفل من إمرأة زرع لها مبيض. وفي نفس العام زراعت قصبة هوائية باستخدام الخلايا الجذعية للمريض نفسه أجراها “باولو ماتشياريني” (برشلونة، أسبانيا). وفي عام 2010 تمت أول زراعة وجه بالكامل، علي يد “جوان بيري باريت” وفريقه (برشلونة، أسبانيا). كما منحت المنظمة الوطنية الإسبانية لزراعة الأعضاء تصريحًا لمستشفى La Fe في فالينسيا لإجراء أول عملية لزراعة ساقين كاملين.
نحو “السيبورج“
بناء على هذه الخبرات السابقة يمضي قطار الطموح العلمي والمشتغلين بالبحث العلمي سريعاً، ووصولا “للسيبورج”. ويأتي تخليقه ضمن البحوث الإحيائية والسيبرنية. وهي مجالات تهتم بآليات الاتصالات والسيطرة لدي الكائنات الحية، ولدي الآلات. فسيستطيع هذا “السيبورج”، رغم احتفاظه بما للعقل البشري من مرونة وقدرة على التخيل، العيش في وسط غير معتاد عليه. جو خال من الأكسجين، ودرجات حرارة وضغوط عالية. كما سيتميز بحيوية كبيرة، وطول عمر مديد، مُتكيفاً من التغيرات البيئية. ويطمح العلماء لإيجاد “سيبورج فضاني” لا يتنفس، وذو دم مبرد صناعياً، وبدون أعضاء حس، لكنه مطعم بإلكترونيات الهدف منها الحفاظ على التوازن الأيضي، وترميم الأعضاء العليا والسفلي، والتغذية عن طريق الضخ (الحقن)، مع اعادة استخدام الفضلات.
وأخيرًا أجراء عمليات النقل عن طريق نبضات الكترونية مستقبلة ومبعوثة بواسطة جهاز مثبت بالدماغ. وهذا الكائن سيتحرك بسهولة في أوساط فضائية بين الكواكب أو فوقها مع تباين في الجاذبية. ولعل رواد كائنات “السيبورج” هم من أجريت لهم عمليات جراحية. ويعيشون بأجهزة معقدة خارج وداخل أجسامهم. مع دقة واستمرارية وتطور عمليات زرع الأعضاء، والمواد الاصطناعية قد يصبح من الممكن إزاله أكبر قدر من الفوارق بين الأجهزة الطبيعية والاصطناعية للكائنات البشرية. ولا شك أن الطموح العلمي والبحثي ليس له حدود. ولعله، قريباً، تُحل، مشكلة نقص الأعضاء والأنسجة المعروضة، وقوائم الانتظار الطويلة. وتُـنشر لافتات وإعلانات في المراكز والمستشفيات، وفي الصحف والمجلات: “أعضاء تحت الطلب، مساهمة في إنتاج السيبورج”!
غرور وتواضع
تبقي المفارقة بين ما قد تسببه “عبادة العقل، وتأليه العلم، وسطوة التقنية، وحب السيطرة” من كبرياء وغرور واستطالة وعلو في الأرض، ومحاولة “فصلها، وفصمها” عن السماء. وبين التواضع أمام هبات الله تعالي، ونعمه، ومنحه، وأفضاله :(يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ * فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ)(الإنفطار:6-8). أما الذين عرفوا حدودهم فتواضعوا فقد سموا ووصلوا وسعدوا بالقرب الإلهي. يقول الأستاذ فتح الله كولن: “الذين يلصقون خدودهم بالأرض، هم أصحاب المراتب العليا عند الحق تعالى وعند الناس… أما الذين يفتتنون بأنفسهم، ويعجبون بها، ويعظمونها فيبرهنون على نقصان عقولهم، وخواء أرواحهم. فالإنسان العاقل والناضج روحياً يعلم أن كل مزية من مزاياه إنما هي هبة من الله تعالى، فتراه في شكر دائم وفي خضوع وخشوع أمامه”. حقاُ.. إن التواضع ـ الفردي، والجمعي، والحضاري ـ علامة على نضج وفضيلة أصحابها. بينما الكبرياء (وهو من صفات الألوهية)، والغرور، والتعالي (بالعلم وغيره من ماديات الحياة) علامة نقصان، بل وخسران.