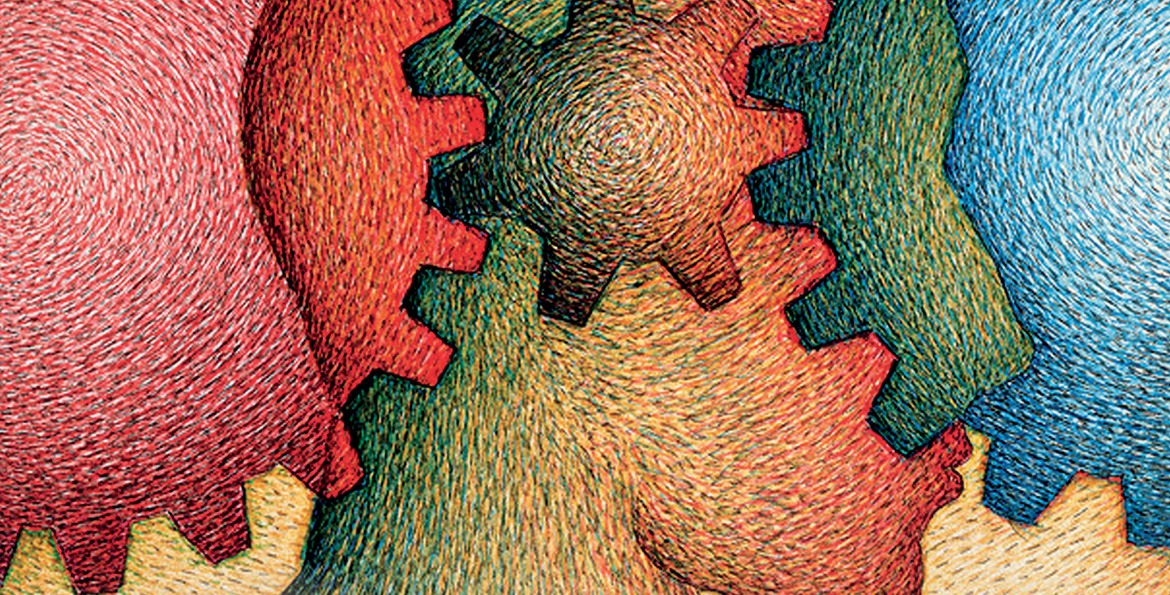لم يكد المشهد الثقافي العالمي ينتعش، حتى تطل برأسها من جديد أزمات تتجدد بتجدد العصور، التي تكتسب منها أنماطًا وأشكالًا مغايرة تجعلها أكثر تعقيدًا وتراكبًا.
فمع بزوغ فجر الثقافة -لا سيما في الوسط الإسلامي- وانتشارها لتطور وسائل نقلها، أخذت أزمات العصر الثقافية حظها من هذا التطور وتلك الحالة. ففي عصر العولمة وعصر السماوات المفتوحة، ما يغري لاكتساب المعارف وتبادل الثقافات، وهو تربة خصبة للنقاش والتحاور الذي أضحى فريضة وقتية، وضرورة حتمية على جميع المستويات، ليس بين الأفراد فحسب، بل بين الدول وبعضها.
وهنا تبرز أزمة قديمة حديثة، وهي أزمة تحرير المصطلح وتوضيح الدلالة منه، فبدون ذلك تظهر هوة سحيقة في الأوساط العلمية والثقافية -لا سيما في المجتمعات الإسلامية موضوع حديثي- عند طرح قضية للنقاش، أو لمعرفة حكم ما في نازلة، أو واقعة مستجدة؛ إذ كيف يحدث النقاش دونما تحديد لمقصودٍ معروف دلالته يتفرع عنه النقاش للوصول إلى جواب؟ من هنا دعت الحاجة لتحرير المصطلحات قبل الخوض في أي جدل أو محاورة.
إن مسألة توحيد المصطلح ضرورة تحفزنا للسعي إلى تحقيقها؛ لندرك غاية تتصل بهوية هذه الأمة، وإشاعة العلم الجديد بينها، ومن ثم يكون لها مكان خاص في هذا العالم الجاد المتطلّع إلى الجديد
من أسباب الأزمة
ومن أسباب الأزمة أن فهم المصطلح وانتشار مدلولاته، هو نتاج طبيعي لتغير الظروف واتساع مدارك العقل البشري، بالإضافة للاعتماد على التجربة البشرية المتغيرة، وهنا تظهر المعضلة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاختلاف في أحد جوانبه، مفتعل لمصالح أيديولوجية ضيقة حزبية كانت أو شخصية، كما لا يخفى ما للمنظمات العالمية -ذات المرجعية غير الإسلامية- من دورٍ في استغلال هذا لترويج سلعتهم الرديئة بتفتيت المجتمع المسلم وتقويض الأسرة باسم حقوق المرأة والطفل لمطاطية مصطلح حقوق هذه الفئات وغيرها.
من صور الأزمة
وقد اتخذت الأزمة أشكالاً وصورًا متعددة، وانصبت جهود العلماء والمفكرين على معالجتها بتعدد صورها؛ فمنهم من نظر لها من جهة تحرير المصطلحات العلمية لا سيما في مجالي الطب والهندسة، وهؤلاء نادوا بضرورة “تعريب العلوم”. وقد بذلت مجهودات ضخمة لاستيعاب الأزمة وتحرير مصطلحات العلوم، إلا أنها تبدو هزيلة إذا ما قورنت بحجم الأزمة نفسها، يقول أحمد الأخضر غزال(1): “إن كل المحاولات الكثيرة والحثيثة نحو تعريب المصطلح العلمي وتوحيده فردية كانت أو جماعية، مؤسسية أو مجمعية، لم تحقق أهدافها من قريب أو من بعيد، بل زادت الطين بلة في إيجاد مترادفات متعددة ومتنوعة للمفهوم الواحد، غدا إزاءها الدارس في حيرة في التعامل مع هذا المصطلح أو ذاك، فكانت النتيجة المنتظرة من ذلك كله هزيلة إذا قورنت بضخامة المشكلة، وبالمجهودات الصادقة التي تبذل”(2).
ولعل هذا يرجع إلى أن الجهود المبذولة تنبع ممن دون الدولة حتى وإن أخذ شكل جماعات وهيئات. لكنّ القضية أعمق من هذه وتحتاج لحلها إلى قرار سيادي، وهو ما يعني طراوة الحلول أمام صلابة المشكلة، وهنا يتأخر الحل، يقول الدكتور عبد الكريم خليفة: “إن قضية التعريب قضية تتصل -من حيث الأساس- بالإرادة السياسية للدولة، وبقرار سياسي تتخذه الدولة في أعلى مؤسسات السلطة”(3)، وهذه لا تبعد كثيرًا عن مسألة نَشْر المصطلح وتعْميمه بعد توحيده لا من قريب ولا من بعيد.
فيما نظر آخرون لهذه الأزمة -التي اكتوى بنارها المجتمع واصطلى بلهيبها المثقفون- باعتبار البعد الثقافي، لتباين دلالات المصطلحات التي تمثل قاسمًا مشتركًا للحوار بين أكثر من مجتمع، ومن ثم يزداد التعقيد ويكثر اللغط. ولعل الاختلاف على مفاهيم مصطلحات مثل “الحرية” و”الإرهاب” و”الديمقراطية” و”الحضارة” و”الإصلاح” و”التقدم” و”العلمانية” وغيرها، بات يهدد ثوابت العلاقات بين مجتمعات عدة، والسبب الرئيس في هذا، ليس إلا عدم تحرير دلالة مثل هذه المصطلحات، ما ينذر بتفاقم الأزمة ويقلل مساحة التعاون بين البلدان.
تأثيرها في المجتمع المسلم
هذا، ولا يخفى ما لخطورة عدم ضبط دلالات الألفاظ الدينية والمصطلحات التي تعنى بالتشريع والأحكام على المجتمعات -لا سيما الإسلامية- لما يتفرع عن هذه الأزمة من تفريعات وجماعات، يأخذ كل منها ما يناسبها، ومن ثم ندور في فراغ، ونكون كمن يحرث في الماء. ومكمن الخطورة هنا، في إضفاء قدسية على ما يذهب إليه الجميع باسم الدين. ومن الأمثلة هنا، اختلافهم حول مفاهيم مثل “الجهاد” و”زواج المسيار” و”مفهوم دار الحرب” و”دار السلم” و”مفهوم الشورى” و”الانتخاب” وغير ذلك.. بل وصل الخلاف في تحديد معنى “الدولة الإسلامية” و”الدولة المسلمة” و”الدولة المدنية”. ولك أن تتصور ما يتفرع عن هذا الاختلاف من تقسيمات وفرق وأحزاب، حتى بات أمر اجتماع المسلمين -على اختلاف بلدانهم – على فهم مصطلحات بعينها، مثل “الخلافة الإسلامية” ضرورة؛ لتخفيف حدة الاحتقان الناتج عن فردانية الفهم والتأويل والتنزيل لأحكام الله.
وقد بدأت جهود العلماء مبكرة، لوضع حل لهذه المعضلة التي تنبأوا بضراوتها، وبدأت الشعوب العربية تشعر بالحاجة إلى توحيد المصطلحات -لا سيما العلمية منها- منذ انفصال الدول العربية عن الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى.
إن كل المحاولات الكثيرة والحثيثة نحو تعريب المصطلح العلمي وتوحيده فردية كانت أو جماعية، مؤسسية أو مجمعية، لم تحقق أهدافها من قريب أو من بعيد، بل زادت الطين بلة في إيجاد مترادفات متعددة ومتنوعة للمفهوم الواحد
ضرورة الخروج منها
ولما كان من مبادئ ديننا الحنيف مبدأ النقاش والمشورة والمحاورة، ليس بين المسلمين وبعضهم فقط، بل وبينهم وبين أهل الكتاب، كما قال تعالى: (وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)(العنكبوت: 46)، أضحى حل قضية المصطلحات وتحريرها وتحديد معانيها ودلالاتها الجامعة المانعة، ضرورة في مجتمعنا الإسلامي الذي ينطلق نحو التعددية والانفتاح، حتى لا نقع في اللبس الفكري، وندور في الفراغ دونما فائدة تذكر. يقول “الزركان”: “إن مسألة توحيد المصطلح ضرورة تحفزنا للسعي إلى تحقيقها؛ لندرك غاية تتصل بهوية هذه الأمة، وإشاعة العلم الجديد بينها، ومن ثم يكون لها مكان خاص في هذا العالم الجاد المتطلّع إلى الجديد”(4).
فمع تقنيات العصر الحديث، وتطور الأداء اللغوي، وانتشار الفهوم، وتعدد الأفكار وسط الاتساع الجغرافي، والتمدد الحضاري، والانفتاح على الآخر غير سابق النظير.. كل هذا وغيره، يدعونا نحن المسلمين، لاستكمال وضع النقاط فوق الحروف، والخروج بأمتنا من هذه الأزمة بأقل خسائر، حتى نعود وحدةً متماسكةَ البنيانِ شكلاً ومضمونًا. فقد بات ضروريًّا أن تخطَّ الأمةُ طريقَها بنفسها، وتستعيد مراكز الريادة والصدارة وسط عالم تحرقه نيران الفُرقة، وتمزقه المصالح الخاصة؛ لتأخذ سبيلها لإرشاد العالم من جديد.
الهوامش
(1) عالم لغوي مغربي (1917-2008م).
(2) المنهجية العامة للتعريب المواكب، معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، لأحمد الأخضر غزال، الرباط، 1977، ص:39.
(3) انظر: اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث، للدكتور عبد الكريم خليفة، ص:244.
(4) الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث، لمحمد علي الزركان، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق.