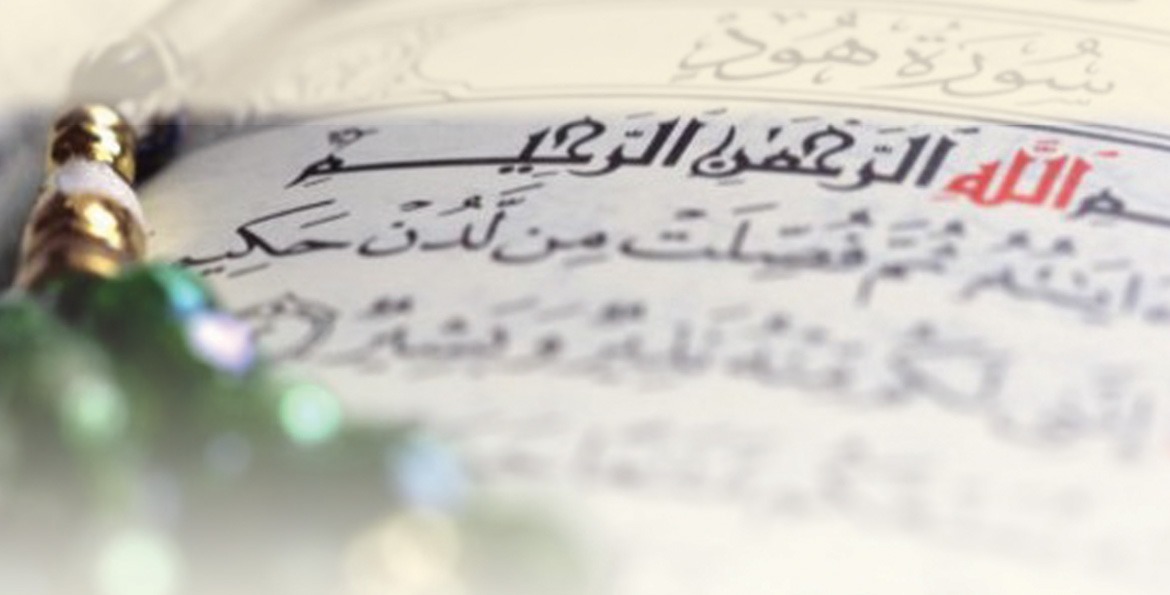حين نريد الحديث عن التأصيل الشرعي لحماية الفكر، يجدر أن نَتقدَّم بالحديث عن ماهية الفكر الذي تطمح الشريعة إلى حمايته؛ ويمكن القول بأنه نشاط الذهن الإنساني، والذي عبرت النصوص القرآنية عن أصحابه بأنهم أولو الألباب، وأولو النهى، وقوم يتفكرون، والمتوسمون، وقوم يعقلون.. في آيات كثيرة جدًّا من القرآن الكريم. وليس المقصود بهؤلاء، صنف واحد من البشر متفوق على غيره في الذكاء دون الآخرين، لأن خطاب الشريعة الإسلامية بمجمل التشريع عام، وأما في تفاصيله فيدخل فيه الخطاب الخاص والعام، ومن يتتبع الآيات التي ذُكِر فيها أصحاب العقول، وجاء الأمر فيها بالتفكر، يجد أن معظم الأحكام التي جاء الأمر بالتفكر في سياقها، مما هو موجه للبشر عامة؛ كالأمر بالتقوى، والتكليف بالتوحيد، والتحذير من الشرك، والتوجيه بتدبر الآيات الكونية.
فكما أن النصوص القرآنية أشادت بأرباب العقول، فقد حرصت على حماية هذا النشاط الذهني من الزلل.
ويمكن أن نصنف النصوص الشرعية التي حماها الشرع من تدخلات العقل كما يلي:
١- النصوص التي لا تقبل التأويل وهي المحكمات، فلا يجوز للعقل العمل على تأويلها وصرفها عن معناها المحكم إلى سواه.
٢- النصوص التي تقبل التأويل، لكن يراد تأويلها بغير الطريق الصحيحة للتأويل.
فقد جاءت الشريعة حامية لهذين الصنفين من النصوص من تدخلات العقل، وجعلت النشاط الذهني المَعْنيّ بها منحصرًا في:
أ- تأويل النصوص القابلة للتأويل، لكن منعت أن يتم هذا التأويل بغير قواعد التأويل الصحيحة، والتي يمكن تلخيصها في رد المتشابهات إلى المحكمات، والتي أشارت إليها الآية الكريمة: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ)(آل عمران:7). فطريقة الراسخين في العلم في تأويل النصوص، تعتمد على رد المتشابهات إلى المحكمات، منطلقة من الإيمان بأن القرآن كل من عند ربنا، وهذا الإيمان بالكلية يمنع من ضرب النصوص ببعضها عن طريق معرفة الناسخ والمقيِّد والمخصِّص والمُبَيِّن، ومعرفةُ ماذا يتبقى من أحكام النص المنسوخ بعد ورود الناسخ، وكذلك ما يبقى من أحكام المطلق والعام، وماذا يُستفاد من المُجمَل بعد بيانه.
بـ- استنباط الأحكام الظاهرة وإعطاؤها درجتها حسب تقييمهم لدلالات الألفاظ، وغير الظاهرة وفق تقييمهم للنصوص المأوِّلَة ودواعي التأويل، أي دواعي صرف اللفظ عن ظاهرة، أو الاستنباط من دلالة السياق أو اللحاق أو السباق.
وهذا جزء مما دل عليه قوله تعالى: (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً)(النساء:83)؛ والشاهد من هذه الآية قوله تعالى: (الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ)، وهم في كل فن الذين لديهم ملكة استخراج أحكامه.
والخلاف السائغ في الشريعة لا يكون غالبًا إلا عبر هذين المسلكين، وهما الخلاف في تأويل ما يقبل التأويل، والخلاف في الاستنباط من دلالة النصوص الظاهرة أو الخفية أو من دلالة السياق. ويدخل في هذين المسلكين، الاختلاف في الأقيسة، والاختلاف في تقدير المصالح وتقدير المفاسد، والاختلاف في عدد من الأدلة التي سماها الأصوليون “أدلة إجمالية”؛ كالاستحسان والاستصحاب والمصلحة المرسلة وقول الصحابي والاستقراء والأخذ بأقل ما قيل.
كما أن كثرة الآيات التي تنص على عربية القرآن وإبانته، مؤكدة على أن فهم النصوص لا بد أن يكون وفق أفهام العرب الذين نزل القرآن بلسانهم. فاللغة ليست مجموعة ألفاظ لها دلالتها المفردة وحسب، بل هي طريقة فهم أيضًا. فما كان حقيقة عند العرب، لا يمكن أن يفهم على أنه ورد في القرآن مجازًا، والعكس صحيح، وما كان منقولاً عن دلالته الأصلية عند العرب، لا يمكن فهمه وفق الدلالة الأصلية، وما كان في فهم العرب عامًا، لا يمكن أن يكون في النص خاصًّا والعكس، وما كان في أفهام العرب مطلقًا، لا يمكن أن يفهم مقيَّدًا، والعكس صحيح.
ولذلك قام العلماء بضبط هذه الأمور في عدد من العلوم الإسلامية على رأسها علم أصول الفقه وعلم فقه اللغة وعلم البلاغة؛ فقسَّم الأصوليون الألفاظ والسياقات -بالنسبة إلى معانيها- إلى نص وظاهر وخفي ومجمل ومبين ومشترك ومنقول، وقسموها -بالنسبة لما تتضمن من الأفراد- إلى مطلق ومقيد وعام وخاص، وقسم البلاغيون الألفاظ -بالنسبة لمعانيها- إلى صريح وكناية وحقيقة ومجاز، وانصرف علماء فقه اللغة إلى تعداد الألفاظ وحقائقها ومجازاتها ومرادفاتها ومراتب دلالاتها.
فإذا خرج العقل في تعامله مع النصوص عن تلك الدائرة التي تقدم إيجازها، فكل نشاطاته تكون داخلة في اتباع الشبهات.
وهنا، لا بد أن أقف عند نقطة هامة؛ وهي أن دين الإسلام -فيما دلت عليه النصوص القاطعة أو الظاهرة أو المبينة- يؤكد على أنه هو الحق الذي لا يجوز خلافه، وذلك في عدد من النصوص، كقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ)(النساء:170)، ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾(آل عمران:85).
وانحصار الحق في الإسلام ليس مقتصرًا على الجانب العقدي، بل يشمل الجانب الفقهي أيضًا، فالأحكام الفقهية هي حدود الله التي يَحرُم تعدّيها أو الاعتداء عليها(تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(البقرة:229)، وهذا الأصل هو المنطلق لفهم الأحكام الشرعية الصارمة التي يتطلع الشرع من خلالها لحماية الأمة من أصحاب الأهواء الفكرية، والتي تفهمها الثقافات الأخرى على أنها حجر على حرية الفكر.
أعود للحديث عن الشبهات وهي قد تطلق -أي الشبهات- على ما لم يتضح حكمه لغير المجتهدين أَحَلال هو أم حرام، أو ما لم يترجح فيه عند المجتهد أحد الرأيين. وحديثي هنا ليس عن هذا الجانب.
بل أتحدث هنا عن مصطلح الشبهة الذي يعني نوعًا من الحُجَج، يتوهم غير الفاحص المؤهل أنها دليل وليست دليلاً، أو يتوهم أنها ناقض لدليل سابق وليست كذلك. ويمكن أيضًا القول، هي مجموع ما يتوصل العقل به إلى ما يخالف محكم النصوص أو ظاهرها، أو يخالف المؤول منها عبر استخدام منهج خاطئ في التأويل.
ولا بد من التأكيد هنا على أنه لا يستطيع التمييز بين الشبهة والدليل الصحيح، إلا من اتصف بصفتين:
الصفة الأولى، العلم بالمسألة التي يدور الاحتجاج حولها؛ فإن كثيرًا ممن تستهدفهم الشبهات وينساقون إليها، لا يعلمون حقيقة المسألة التي تدور حولها الشبهة، وربما لو عرفوا حقيقتها، لم يقبلوا ما يُساق حولها من شبه، وذلك كمن يقعون في بعض المخالفات العقدية ويتعلقون بشبهات، ولا يعلمون أن حقيقة المسألة هي إنكار لوجود الخالق مثلاً.
الصفة الثانية، المعرفة بمناهج الاستدلال ومسالك الأدلة؛ فمن لا يفرق بين القطعي من الأدلة من الظني والوهمي، لن يستطيع تقدير الأدلة حق قدرها، كما أنه لن يستطيع وضع الأدلة في موضعها، فقد يستدل بالظني على أمر لا يُغني فيه غير القطع، والعكس أيضًا صحيح.