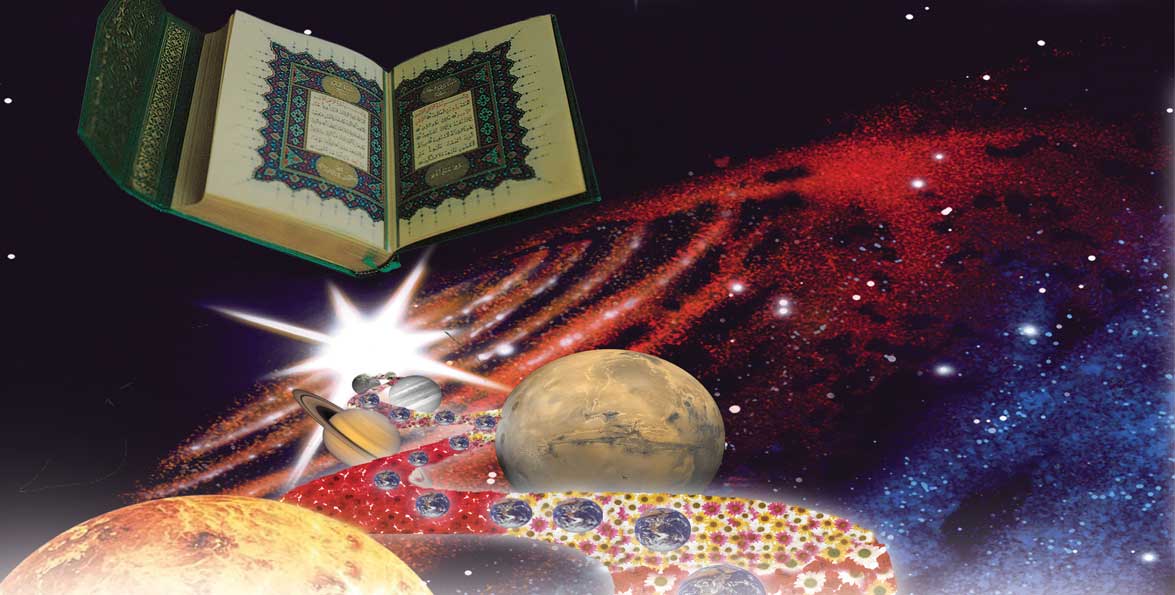للإنسان في هذه الحياة رسالة ذات وجهين: أولهما عبادة الله تعالى بما أمر، وثانيهما حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة عدل الله فيها.
وهذه الرسالة بشقيها لا يفهمها فهمًا كاملاً إلا أبناء وبنات الجيل القرآني الذين تربوا على هذا الكتاب العزيز. ومن هنا كان الحرص على العودة بأجيال أمة الإسلام إلى هذا الجيل القرآني واستكمال بنائه العلمي والتربوي حتى يعود للأمة مجدُها التّليد، ودورها في هداية البشرية الضالة التائهة.
بعث النازع العلمي في رجل القرآن
تعرف “العلوم” لغة بأنها مجموع ما علمه الإنسان من معارف وأخبار تجمعت له عبر الزمن في مختلف الأماكن والعصور مرتبة حسب ما تتعلق به من أمور. ويشمل ذلك كلا من المعارف الموهوبة التي علمها الله تعالى لأبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وورّثها لبنيه من بعده، وأنزلها على عدد من أنبيائه ورسله؛ كما يشمل المعارف المكتسبة والتي جمعها الإنسان عبر العصور من تجاربه في هذه الحياة ومن استقرائه لسنن الله في الكون، ومحاكاته لما أوجد الله تعالى فيه من خلق. ويشمل ذلك هداية الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على سلسلة طويلة من أنبيائه ورسله، وأكملها وأتمّها في القرآن الكريم وفي سنّة خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. كما يشمل كل المعارف المكتسبة وميراث البشرية من هذه المصادر جميعها عبر التاريخ.
ولكن ساد بين الناس اليوم قصر لفظة “العلم” على العلوم البحتة والتطبيقية القائمة على الملاحظة والاستنتاج، أو على التجربة والملاحظة والاستنتاج والمطبقة على الكون ومكوناته وظواهره المتعلقة بمختلف صور المادة والطاقة والجمادات والأحياء فيه. و”العلم” بهذا التحديد بدأ مع الإنسان منذ اللحظة الأولى لوجوده على هذه الأرض، ثم تزايد بالتدريج في عمليات من المد والجزر، ولكنه نما في الحضارة الإسلامية نموّا متوازنا جمع بين وحي السماء والعلوم المكتسبة في تكامل وانسجام. ثم انتقل هذا العلم الإسلامي بمنهجه التجريـبي إلى الغرب عبر دولة الإسلام في الأندلس، وعبر الاحتكاك مع المسلمين في كل من صقلّية وجنوب إيطاليا وشمال أفريقيا وبلاد الشام خاصة خلال الحروب الصليبية. ولكن المنهج العلمي الإسلامي عندما انتقل إلى الغرب كانت الكنيسة مهيمنة على الحياة فيه هيمنة كاملة، فرضتْ خلالها سِفْر التكوين على المعارف الإنسانية. وعندما اصطدمت نتائج المنهج التجريـبي مع تفسيرات الكنيسة بدأ الصراع بين العلماء والكنيسة وحُسم لصالح العلوم المكتسبة. فبدأت تلك العلوم من منطلقات مادية بحتة منكرة كل ما هو غير مدرَك أو محسوس بما في ذلك الدين. فانطلقت كل المعارف المكتسبة في الغرب من منطلقات معادية للدين، منكرة للغيب، دائرة في حدود المادة وحدها متجاوزة لكل ما هو فوق ذلك.
من هنا آثر أهل القرآن الكريم وحفظته البعد عن هذه المعارف المعارضة للأصول الإسلامية الثابتة. فوصلنا إلى ما وصلنا إليه من تخلف علمي وتقني أفقر شعوبنا وجعلَنا في حاجة إلى عيرنا من الأمم. ولكن المعطيات الكلية للعلوم المكتسبة في العقود المتأخرة من القرن العشرين -وعلى الرغم من أصحابها- بدأتْ في تأييد كل ما جاءت به الهداية الربانية التي تكاملت في بعثة النبي والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. ومن مقومات استكمال البناء العلمي لجيل القرآن الكريم الإلمام بهذه المعطيات الكلية للعلوم.
من المعطيات الكلية للعلوم
بلغت المعارف بالكون المادي في هذه الأيام مستوى لم تبلغه البشرية من قبل، وأصبحت الاستنتاجات الكلية لتلك المعارف تؤكّد كل ما جاء به الدين من إيمان بالله الخالق البارئ المصور، وتنـزيه له سبحانه وتعالى عن الشريك والشبيه والمنازع والصاحبة والولد، وعن جميع صفات خلقه، وعن كل وصف لا يليق بجلاله، كما تؤكد ضرورة الإيمان بالغيب وبالوحي وبالبعث والحساب. ويمكن إيجاز المعطيات الكلية للعلوم فيما يلي:
• إن هذا الكون الذي نحيا فيه كون محدود، ولكنه كون متناه في أبعاده، مُذهل في دقة بنائه وانتظام حركاته، وإحكام ترابطه، مما يشهد لخالقه بالألوهية والربوبية، وبطلاقة القدرة وبداعة الصنعة وإحكام الخلق.
• إن هذا الكون مبني على زوجية واضحة من اللبِنات الأولية للمادة إلى الإنسان، ومبني في الوقت ذاته على نفس النظام من أدق دقائقه إلى أكبر وحداته مما يشهد لخالقه بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه.
• إن هذا الكون دائم الاتساع إلى نهاية لا تستطيع العلوم المكتسبة إدراكها وإن أمكنها قياس معدلات هذا التوسع.
• لكون على قِدَمه مستحدث مخلوق، كانت له بداية في الماضي السحيق تقدر بحوالي أربعة عشر بليون سنة مضت. وكل مستحدث عارض لا بد وأن تكون له في يوم من الأيام نهاية تؤكّدها كل الظواهر الكونية من حولنا، وإن عجز الإنسان عن تحديد وقتها.
• إن هذا الكون المادي لا يمكن أن يكون قد أوجد نفسه بنفسه، ولا يمكن لأي من مكوناته المادية أن تكون قد أوجدته، كذلك لا يمكن أن يكون قد وجد بمحض الصدفة، لأن العشوائية أو الصدفة لا يمكن لها أن تنتج كونا بهذا الاتساع ودقة البناء والانتظام في الحركة.
• إن الخليّة الحية التي لا يكاد قُطرها يزيد على 0.03 من المليمتر تبلغ من تعقيد البناء وكفاءة الأداء ما لم يبلغه أكبر المصانع التي أنشأها الإنسان، بل التي فكر في إنشائها ولم يتمكن من ذلك بعد. فقد أعطاها الله تعالى القدرة على إنتاج مئتَي ألف نوع من البروتين تعجز أكبر المصانع التي أنشأها الإنسان عن إنتاجها، ومن ثم فلا يمكن لها أن تكون قد وجدت بمحض المصادفة.
• إن الشيفرة الوراثية التي تشغل حيزا أقل من واحد من المليون من المليمتر المكعب في نواة الخلية الحية يصل طولها إذا فردت إلى قرابة المترين، وتحتوي على 18.6 بليون جُزيء كيميائي تترتب ترتيبا محكما، لو اختل وضع ذرة واحدة منه إما أن يشوه هذا المخلوق أو لا يكون. وإذا عرفنا أن جسد الفرد الواحد منا يتكون من تريليونات الخلايا وأنّ بنواة كل خلية مترين من جزيئات الشيفرة الوراثية، اتضح أن بجسد كل منا تريليونات الكيلومترات من هذه الجزئيات، وهو رقم يزيد في طوله عشرات المرات عن المسافة بين الأرض والشمس والمقدرة بحوالي 150 مليون كيلومتر، ولا يمكن لعاقل أن يتخيل جمع هذه التريليونات من الجزيئات الكيميائية الفائقة التعقيد والدقة وترتيبها هذا الترتيب المحكم بمحض الصدفة.
• إذا علمنا أن الخلية الحية بهذا التعقيد في البناء، والكفاءة في الأداء، فإنه يستحيل تخيل إيجادها بمحض الصدفة، وبالتالي إيجاد قرابة الخمسة ملايين نوع من أنواع الحياة الموجودة والبائدة بمحض الصدفة، وأن يمثل كل نوع منها ببلايين الأفراد بمحض الصدفة كذلك.
• إن لبنات بناء أجساد الكائنات الحية وهي الجزيئات البروتينية على قدر من الانتظام في الترابط والأداء والتعقيد في البناء ينفيان أي احتمال للعشوائية أو الصدفة، وكذلك لبنات بناء الجزيئات البروتينية وهي الأحماض الأمينية التي لا يمكن لعاقل أن يتخيل تكونها أو ترابطها بروابط محددة بمحض الصدفة. هذه المعطيات هي قليل من كثير ولكنها تفضي على الحقائق المنطقية التالية.
العلوم تؤكد حتمية القدرة الإلهية
• إذا كان الكون الحادث لا يمكن له أن يوجد نفسه بنفسه، أو أن يكون قد وجد بمحض الصدفة، فلابد له من موجد عظيم له من العلم والقدرة والحكمة ما يفوق جميع قدرات خلقه؛ ولا بد لهذا الخالق العظيم من الصفات ما يغاير صفات المخلوقين جميعا؛ فلا يحده أي من المكان أو الزمان، ولا تشكله قوالب المادة والطاقة، لأنه خالق ذلك وموجده، والمخلوق لا يحدّ خالقه أبدا. ولذلك وصف ربنا تبارك وتعالى ذاته العلية بقوله العزيز: ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (الأنعام:103). وبقوله سبحانه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾(الشورى:11).
• هذا الخالق العظيم الذي أوجد الكون بكل ما فيه ومن فيه هو وحده الذي يملك القدرة على إفنائه ثم إعادة خلقه وقتما شاء وكيفما شاء، وفي ذلك يقول وقوله الحق: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾(الأنبياء:104). ويقول: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾(يـس:82).
• إن بناء الكون في زوجية كاملة من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان تشير إلى وحدانية الخالق العظيم وإلى تفرده بهذه الوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. وتتّضح وحدة البناء الكوني في بناء مكوناته من الذرة إلى المجرة إلى بناء الكون كله، ومن الخلية الحية المفردة إلى الإنسان البالغ. كما تتضح في تأصل العناصر وردها كلِّها إلى أصل واحد هو “غاز الأيدروجين” أبسط العناصر بناء وأقلها مكونات، وحيث تتكون ذرّاته من بروتون واحد يحمل شحنة كهربائية موجبة يدور حوله إليكترون واحد يحمل شحنة كهربية سالبة. وتتضح في تواصل كل من مختلف صور الطاقة وتواصل كل من المادة والطاقة والمكان والزمان -وهو تواصل في تزاوج- وحدانية الخالق سبحانه وتعالى تفرُّده بتلك الوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه واستعلاؤه بمقام الألوهية الذي لا يشاركه فيه أحد ولا ينازعه منازع ولا يشبهه من خلقه شيء.
• إن العلوم الكونية المكتسبة -في تعاملها مع المدرَك المحسوس- توصلت إلى حقيقة الغيب، وإلى أن في الكون غيوبًا كثيرة لا يستطيع الإنسان الوصول إليها بجهده وحواسه وقدرات عقله. ولولا الجري وراء المجهول ما استمرت تلك العلوم في التطور والنماء. ومن الغيوب ما هو مَرحَلِيّ قد يصل الإنسان إليه، ومنها ما هو مطلق لا سبيل للإنسان إليه إلا عن طريق وحي السماء. ومن الغيوب المطلقة المحجوبة عنا حجبا كاملا: الذات الإلهية، الروح، الملائكة، حياة البرزخ، الآخرة، البعث، الحشر، الميزان، الصراط، الجنة، النار، وغيرها كثير كثير.
• تؤكد العلوم التجريبية أن بالأحياء أسرارًا لا نعرف كنهها، لأننا نعرف مكونات الخلية الحية كاملة، ومع ذلك لم يستطع العلماء بناء خلية حية واحدة. وأقصى ما أنتجته العلوم المكتسبة هو صناعة المورث (الجين)، وهو مركب كيميائي ميِّت لا ينشط إلا في داخل الخلية الحية مما يؤكد أن الحياة من الأسرار التي يعرف الإنسان ظواهرها ولا يعرف كنهها.
• إن إمعان النظر في الكون يؤكد حاجته بكل ما فيه ومن فيه إلى رعاية خالقه العظيم في كل لحظة من لحظات وجوده. ولولا هذه الرعاية الإلهية ما كان الكون ولا كان ما فيه ولا من فيه.
• إن العلوم المكتسبة إذ تقرر أن الكون والإنسان في شكليهما الحاليين ليسا أبديين فإنها -وعلى غير قصد منها- تؤكد حقيقة الآخرة، بل حتميتها، والموت يتراءى في مختلف جنبات الكون حاصدا الإنسان والحيوان والنبات والجماد وأجرام السماء على تباين هيئاتها في كل وقت.
• إن الإشارة الكونية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن فهمها فهما في إطار اللغة وحدها، بل لا بد من توظيف البعد العلمي لتحقيق ذلك.
• إن السبق العلمي لكل من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لا يمكن إثباته إلا بتوظيف الحقائق العلمية في شرح دلالة الإشارات العلمية في هذين المصدرين من مصادر الإسلام.