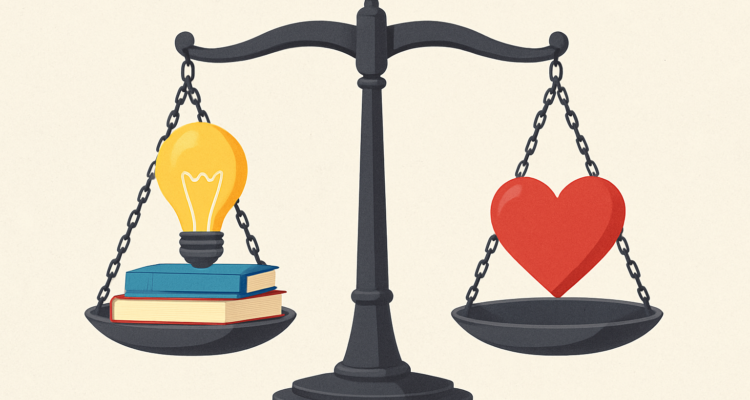ما من شك أن واضعي الكتب المدرسية يتغيون نشر المعرفة وتزويد المتعلم بالمعلومة الجديدة وفقًا لكفاياته الذهنية والنفسية، وتبعًا لمراحل بنائه. ولا بد أن هذا الاستهداف يعتمد نقل المعرفة العالِمة عبر وسائل النقل الديداكتيكي من أجل تمريرها كمعرفة مدرسية مبسطة قابلة للتلقي. فتجد المقررات ملأى بالمعارف من شتى الأصناف، مقدَّمة في أطباق متنوعة يتنقل بينها المتعلم كالنحلة ترتشف رحيق الزهور في حقل واسع. غير أن حماسة المشرع التربوي تبدو شديدة وزائدة عن حدها، مما جعله يُفيض من كأس المعرفة ما يزيد على حاجات المتعلم، فيُضطر المعلم في الممارسة الصفية إلى اعتماد نوع من الشحن المعرفي الذي يُحوِّل التلميذ إلى وعاء فارغ يُملأ معرفة ومعلومة كل يوم، دون أن يكون فاعلاً أو منتجًا للمعرفة نفسها، أو ناقدًا يمارس تفكيره ويطرح أسئلته القلقة بين الفينة والأخرى؛ إلى الحد الذي يألف فيه هذا الشحن غير المنقطع، فيُصاب بفتور مع مرور الزمن.
المقرر الدراسي بحر من المعارف
لا شك أن المادة المعرفية في الكتب المدرسية المقررة تُثقل كاهل المتعلم بما تزخر به من كثافة معرفية في شتى الأصناف. فبين لغة عربية تشتمل على النحو والصرف والإملاء والإنشاء والخط والنصوص نثرًا وشعرًا، ومواد علمية ملأى بالمعلومات والتجارب تتراوح بين الكيمياء والفيزياء والرياضيات وعلوم الحياة والأرض والجغرافيا والتاريخ والتربية المدنية وغيرها من المعارف المتنوعة، تُقدَّم للمتعلم وفق مراحل دراسية مبنية على أهداف وكفايات متوخّاة، واستنادًا إلى قدراته الذهنية وكفاياته الوجدانية.
غير أن هذا التنوع الهائل في المعارف سيف ذو حدين؛ فقد يكون طريقًا إلى إثقال الكاهل وإغراق الذهن بالمعلومات الزائدة، مما يسبب للمتعلم خلطًا بينها ويفقده القدرة على تثبيتها في ذهنه لتصير جزءًا من تكوينه المعرفي. وقد تتحول أحيانًا إلى نفور من المعرفة التي يحسّها المتعلم بعيدة عن التشويق والإثارة، ما دامت تستهدف شحن ذهنه بشكل مستمر وترديد ما تعلمه أو حفظه منها ليُثاب على ذلك بنقطة تعبر عن درجات تمكنه أو عدم تمكنه من اجترار المعرفة لا إنتاجها وبنائها.
ومع مرور الوقت والسنوات تتسبب هذه العملية في فقدان المتعلم قدراته المنطقية بما فيها من ميكانيزمات كالتحليل والاستقراء والاستنباط والاستنتاج والمقارنة والموازنة والقياس؛ وهي أدوات عقلية إذا فقدها المتعلم كان فقدانها طريقًا لضمور قدراته العقلية وكفّه عن التفكير والنقد والإبداع، مما يجعل المتعلمين نسخًا متشابهة تستنسخ المعرفة المتلقاة وتعيدها من باب “بضاعتنا رُدَّت إلينا”.
نحو ممارسة صفية فاعلة ومتفاعلة
إن هذه الممارسة التعليمية الغالبة على المنظومات التعليمية العربية – وإن كانت تتغيّى نقل المعرفة – تظل واهنة وعاجزة عن إقدار المتعلم على التفكير والمنطق اللذين ينبغي أن يطورهما عامًا بعد عام؛ بما يعزز قدراته وكفاياته ويؤهله معرفيًا للمرحلة اللاحقة بشكل سليم.
فالمدرس المحنَّك لا يعمد إلى شحن المتعلم بالمعارف طوال الزمن المدرسي، وإنما يسعى إلى كسر هذه الرتابة عبر تبني بيداغوجيات تفاعلية كبيداغوجيا اللعب، والعصف الذهني، والاعتماد على التنشيط الجماعي عبر نظام المجموعات، في إطار تفعيل بيداغوجيا الخطأ والبيداغوجيا الفارقية مثلاً.
ولا شك أن هذا التنويع في الممارسة البيداغوجية لا يجعل المعرفة صلب اهتمامه بالدرجة الأولى، بقدر ما يروم تحفيز التفكير لدى المتعلم ودفعه إلى البحث عن حلول للوضعيات المشكلة؛ ما يسهم إيجابيًّا في ممارسته للوعي بالمعرفة وإنتاجها وفق قدراته، وفي سياقات تعليمية متنوعة تهشّم الإيقاعات الرتيبة لفعل الشحن، وتخلق تفاعلاً بناءً بين المدرس والمتعلمين عبر الحوار العمودي – حيث يظل المدرس موجهًا ومرشدًا – وعبر الحوار الأفقي الذي ينتج فيه المتعلمون المعرفة بأنفسهم تحت إشرافه ومراقبته.
القيم والأخلاق في المقرر الدراسي
لا يمكن البتة الانتقاص من البعد القيمي والأخلاقي في المقررات الدراسية العربية؛ فهو حاضر في الكتب موزع عبر النصوص شعرًا ونثرًا، وفي مساحات أخرى يتيحها الكتاب المدرسي، وحاضر عبر مواد مختلفة خصوصًا تلك القادرة على استيعاب القيم واحتوائها، كالتربية الإسلامية والتربية المدنية والتاريخ واللغة العربية.
فإيمانًا من المشرع التربوي بقيمة غرس الأخلاق الفاضلة وزرع العقيدة الصحيحة في النفس منذ نعومة الأظفار، كان حريصًا على بث هذه القيم في الكتب المدرسية بنسب مقبولة وإن تفاوتت بين المراحل الدراسية. وقد توزعت على امتداد الكتب، وتنوعت مراعيةً مستويات المتعلمين وكفاياتهم الوجدانية والذوقية.
فحضرت القيم العقدية بشكل رئيسي باعتبارها دعامة أساسية في تكوين البعد العقدي للطفل العربي المسلم. كما بُثت قيم الوفاء والكرم وحسن الجوار ومساعدة المحتاج وحفظ الأمانة والصدق وحب الخير للناس والمواطنة الصادقة، وغيرها من القيم الجميلة التي تتشكل وجدانيًا في نفس المتعلم. وقد عمد المشرع عبر المراحل الدراسية إلى التدرج في بناء القيم مراعيًا البناء النفسي والعقلي للمتعلم، ناهيك عن خلق تكامل بين المواد من أجل تثبيت هذه القيم والأخلاق في العقل والنفس.
غير أن هذا التثبيت يظل نسبيًّا في الثقافة التعليمية بسبب مركزية المعرفة، ما يُصيب القيم بنوع من التهميش والإقصاء دون وعي من المدرس، في ظل ممارسة تقليدية تجعل المعرفة ضمن أولوياته.
هامشية القيم في الممارسة التعليمية
رغم الحضور القيمي البارز في الكتب المدرسية، فإن استراتيجية الشحن المعرفي المتبعة في النظام التعليمي العربي تؤدي – حتمًا ودون سابق إنذار – إلى تهميش القيم التي تغدو جزءًا من المكون النصي القابع في الهامش الضيق. وهذا ما يفقد المدرسة مكانتها التربوية باعتبارها محضنًا للتربية قبل التعليم، وهو ما يفسر الانهيار الأخلاقي للمنظومة القيمية لدى الجيل الجديد، خاصة أنه جيل يعيش أسوأ فتراته التاريخية في كنف عولمة جارفة تمارس فيها الرقميات بعوالمها الافتراضية ومواقعها وروابطها سلطتها المعرفية والقيمية.
وبذلك يصبح تمرير القيم عبر المعرفة واقفًا على قدم واحدة، لا يكاد يتجاوز حدود التلقي الصفي، وتغدو الممارسة السلوكية للمتعلم بعيدة كل البعد عن القيم المبثوثة في الكتب. ومن هنا يقتضي الأمر إعادة النظر في كيفيات التمرير التي يمارسها المدرس بمعية متعلميه، لنقل البعد النظري إلى واقع عملي يتجسد في الحياة ويصبح منهجًا ظاهرًا في سلوك الأفراد.
نحو بناء قيمي سليم
يبدو أن عجز المدرسة عن تشذيب شجرة الأخلاق راجع إلى التباعد بين القيم المبثوثة وغياب التحصين الثقافي والروحي للمتعلم، مما يجعله لقمة سائغة في فم العولمة النهمة.
فدور الأسرة المغيّب عبر انعدام الرقابة في غالب البيوت – بسبب ما أحدثته الرقميات من انعزال وتمزق داخلي – يمنح الطفل والشاب فرصة الانغماس في العوالم الافتراضية وما تبثه أغلبها من سموم قاتلة للقيم والأخلاق الفاضلة. وما يصنعه الإعلام بما يمتلكه من قوة خطابية وتأثيرية وحجاجية من خلال ما يقدمه من قيم مسمومة في كثير من برامجه التافهة ومسلسلاته وأفلامه الهابطة، مع غياب دور المجتمع المدني بجمعياته الثقافية ودور شبابه التي صارت في كثير من البلدان مجرد حيطان صماء تنتظر بكاء شاعر على أطلالها.
إن غياب التضافر بين هذه المكونات جميعها يضعف فعل المدرسة ويجعلها مجرد عارض أو ناقل للقيم في جوف المعرفة، دون تأثير كبير على وجدان المتعلم وتكوينه النفسي. فتصبح القيم بعيدة عن الترجمة الواقعية، وتظل رهينة النصوص وأسيرة شخصياتها ومضامينها.
ولذلك يستلزم الأمر – إلى جانب تضافر هذه القوى – تفعيل القيم الإيجابية في الواقع الحياتي، عبر حمل المتعلم على تبنّي سلوكات حقيقية داخل المؤسسة التعليمية مثل التشجير حفاظًا على الجمال والبيئة، وتنظيف الفصول الدراسية تعزيزًا لقيمة الطهارة في الإسلام، وتخصيص فضاءات للصلاة، وخلق أنشطة موازية كالمسرح والأنشودة وتجويد القرآن والحكي وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة الأخلاقية والعقدية الفاعلة.
كما يتحمل المجتمع المدني مسؤولية كبيرة في هذا الشأن، فجمعياته الثقافية والبيئية وغيرها من شأنها دعم فعل المدرسة في تثبيت التكوين القيمي والأخلاقي النبيل لدى المتعلم؛ ما يجعل التبني أمرًا مقبولاً لدى المتعلم يظهر في أخلاقه وسلوكاته داخل مجتمعه مع نفسه وغيره. وهو ما يسهم في بناء مجتمع سليم أخلاقيًّا قادر على مواجهة تيار العولمة وسيول الرقميات الجارفة، ما دام التحصين الثقافي والهوياتي والروحي موجودًا ليكون سدًّا رادعًا لكل موجة قادمة تتوخى تشويه منظومة القيم الإسلامية التي تربى عليها الإنسان المسلم وعاش تحت ظلال شجرتها الوارفة، وقطف من ثمارها اليانعة.