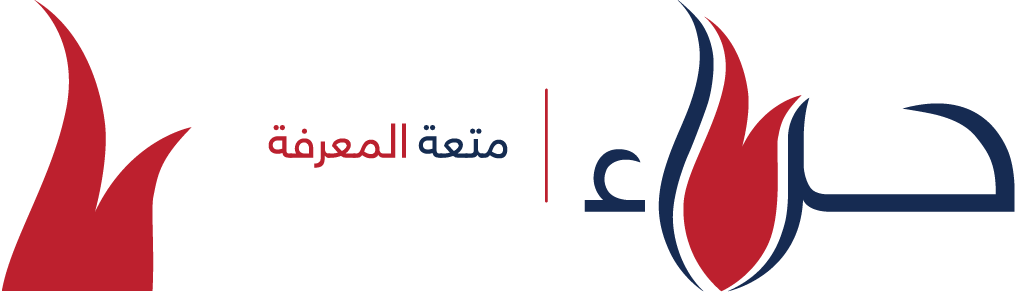في أسواق المدينة المنوّرة خلال العصر النبوي والراشدي، لم تكن التجارة مجرد نشاط اقتصادي، بل كانت مرآة تعكس القيم الإسلامية الأساسية مثل الأمانة، العدل، والشفافية. وللحفاظ على هذه القيم نشأ وتطور نظام الحِسبة حتى أصبح مؤسسة رسمية. فقد كان المحتسب يتجوّل في الأسواق، يتفقد الموازين، ويمنع الغش والاحتكار، مؤكدًا أن الأسواق يجب أن تكون عادلة (ابن عبدون، 2003). ولم يكن دور المحتسب مقتصرًا على الرقابة الاقتصادية فحسب، بل كان تجسيدًا لرؤية إسلامية شاملة تربط بين الأخلاق والاقتصاد. ويصف ابن تيمية الحِسبة بأنها “نظام لتحقيق المصلحة العامة من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأسواق والمجتمع” (ابن تيمية، 1987).
وفي القرن الحادي والعشرين، ومع التوسع السريع للاقتصاد الرقمي، أصبحت الحاجة إلى نظام رقابي أخلاقي أكثر إلحاحًا. فوفقًا لتقرير البنك الدولي (2024)، يُسهم الاقتصاد الرقمي بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، غير أن هذا النمو يصاحبه تحديات كبيرة، مثل الاحتيال الإلكتروني، الإعلانات المضللة، التلاعب بالأسعار، واستغلال البيانات الشخصية، وهي أمور تهدد ثقة المستهلكين واستقرار الأسواق. وتتنافى هذه الممارسات مع القيم الإسلامية التي حثت على العدالة والشفافية، كما في قوله تعالى: (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ)(الأنعام: 152)، وقوله تعالى: (وَلَا تَجَسَّسُوا)(الحجرات: 12).
وفي ظل هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى إحياء نظام الحِسبة كأداة إسلامية لتنظيم الأسواق الرقمية. وتتناول هذه الدراسة مفهوم الحِسبة ودورها التاريخي، وإمكانات تطبيقها في الأسواق الرقمية، كما تستعرض التحديات المعاصرة للاقتصاد الرقمي، وتقترح آليات مبتكرة لإحياء الحِسبة، مع التركيز على دورها في تعزيز العدالة والاستدامة الاقتصادية. وتُسهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات الفقهية حول الحِسبة من خلال ربطها بالتحديات المعاصرة للاقتصاد الرقمي، كما أنها تقدم حلولاً عملية لتنظيم الأسواق الرقمية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الإسلامي ويحمي المستهلكين.
أولاً: دور الحِسبة تاريخيًّا
الحِسبة، لغةً، مشتقة من “الحساب”، وتعني المراقبة والمحاسبة، وشرعًا هي وظيفة إسلامية تهدف إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأسواق والمجتمع. ويستند نظام الحِسبة إلى نصوص شرعية، مثل:
– قوله تعالى: (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)(آل عمران: 104).
– قوله تعالى: (وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ)(المطففين: 1-2).
– حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه) (صحيح مسلم، رقم 49).
– حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من احتكر طعامًا أربعين يومًا فقد برئ من الله وبرئ الله منه) (رواه أحمد).
ووفقًا لابن تيمية في كتابه الحسبة في الإسلام، تشمل وظائف المحتسب ما يلي:
1- مراقبة الأسواق: التأكد من صحة الموازين والمكاييل، كما في قوله تعالى: (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ)(الإسراء: 35).
2- منع الغش والاحتكار: ضمان الشفافية في المعاملات ومنع التلاعب بالأسعار.
3- حماية الأخلاق العامة: مراقبة السلوكيات في الأماكن العامة لضمان الالتزام بالآداب الإسلامية.
4- الصحة والبيئة: التأكد من نظافة الأسواق وجودة المنتجات.
ويصف الماوردي في الأحكام السلطانية المحتسب بأنه “حامي المجتمع”، إذ يجمع بين الرقابة الاقتصادية والإصلاح الأخلاقي. وهذا الدور يجعل الحِسبة أداة فريدة في الاقتصاد الإسلامي، إذ تربط بين الأخلاق والتجارة، وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقد ذكر العلماء والمؤلفون في موضوع الحِسبة أشكالاً متعددة من مسؤوليات المحتسب، وكيفية قيامه بها، سواء ما تعلّق منها بحياة الناس، أو طعامهم، أو صحتهم، أو تعليمهم، أو أخلاقهم، أو معاملاتهم.
وأول من احتسب في تاريخ الحضارة الإسلامية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ على صُبرة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشّ فليس مني).
وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقوم بوظيفة المحتسب بنفسه، فكان يتولّى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويوجّه الناس إلى الحق والصراط السوي، ويمنع الغش ويحذر منه. وكان رضي الله عنه يمرّ في السوق ومعه الدّرّة (العصا)، فيزجر بها غلاة الأسعار والغشّاشين.
وفي العصرين الأموي والعباسي، تطورت الحِسبة إلى مؤسسة منظمة، حيث كان المحتسبون يُعيّنون في مدن كبرى مثل بغداد، دمشق، والقاهرة. وفي الأندلس، وثّق ابن عبدون الإشبيلي تفاصيل دقيقة عن دور المحتسب في مراقبة جودة الأغذية، الأوزان، وحتى جودة البناء، مما أسهم في استقرار الأسواق.
ومنذ العصر العباسي بدأت وظيفة المحتسب تأخذ شكلاً إداريًّا منظمًا، فأصبحت معروفة منذ عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، الذي سعى لتيسير مهام المحتسبين وتنظيم المجتمع، فنقل أسواق بغداد إلى مناطق متخصصة بعيدة عن مركز المدينة ودواوينها، مثل باب الكرخ وباب الشعير، وعيّن لها محتسبين يراقبون شؤونها ويضبطون مخالفاتها.
وتوسّعت مهام المحتسب في ظل الخلافة العباسية لتشمل إلى جانب مراقبة المكاييل والموازين ومنع الاحتكار، الإشراف على نظافة الأسواق والمساجد، ومراقبة الموظفين في أداء أعمالهم، وحتى مراقبة المؤذن للتقيد بأوقات الصلاة.
وفي العصر المملوكي، كان المحتسب يُشرف على الأسعار ويمنع الممارسات الضارة مثل الاحتكار، فعلى سبيل المثال، في القاهرة المملوكية كان المحتسب يراقب أسعار الحبوب خلال الأزمات لمنع التجار من استغلال المستهلكين. ومن مهامه أيضًا أن ينادي في الناس بالخروج مع السلطان أو الأمراء لملاقاة الأعداء.
وتُظهر هذه النماذج التاريخية أن نظام الحِسبة كان نظامًا شاملاً يعزز الثقة في الأسواق، ويحمي الضعفاء من استغلال الأقوياء، مما يجعله نموذجًا قابلاً للتطبيق في العصر الحديث، خاصة في ظل تحديات الاقتصاد الرقمي، لتعود الحِسبة اليوم أداة توازن بين الأخلاق والتقنية، والإيمان والابتكار.
ثانيًا: تطبيق الحِسبة في الاقتصاد الرقمي
يظل نظام الحِسبة هو المنطلق الحضاري لأي تقدُّم معاصر، ويمكن تطويره لكي يؤدي الدور نفسه، بل وبحجم أكبر وبأسلوب أكثر دقّة من الدور الذي كان يؤديه قديمًا، كما يلي:
1- الحِسبة والاستدامة الاقتصادية: يمكن للحِسبة أن تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل ضمان الاستهلاك المسؤول من خلال تعزيز الشفافية في الأسواق. فعلى سبيل المثال، يمكن للحِسبة أن تراقب جودة المنتجات البيئية، مما يدعم الاقتصاد الأخضر.
2- الحِسبة والتجارة عبر الحدود: تتطلب التجارة الإلكترونية الدولية معايير موحدة لضمان الامتثال الشرعي، ويمكن للحِسبة أن تلعب دورًا في التحقق من المنتجات الحلال عبر الحدود.
3- دور المستهلك في الحِسبة الرقمية: تُسهم الحِسبة في تمكين المستهلكين من الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيقات رقمية، مما يعزّز الشفافية. فعلى سبيل المثال، يمكن تطوير تطبيق عالمي باسم “حِسبة” يتيح تقديم شكاوى مدعومة بالصور.
4- الحِسبة والأسواق الافتراضية: يمكن للحِسبة أن تراقب السلع الافتراضية لمنع الاحتيال، كما يمكن تطوير بروتوكولات شرعية للمعاملات الافتراضية استنادًا إلى مبادئ العقود الإسلامية.
5- الحِسبة والعملات الرقمية: يمكن للحِسبة أن تُشرف على شرعية معاملات العملات الرقمية باستخدام تقنية البلوك تشين لتتبّع الشفافية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحِسبة الرقمية قد تواجه عدّة تحديات؛ فعلى سبيل المثال، قد يثير جمع بيانات المعاملات مخاوف المستهلكين بشأن الخصوصية، كما قد ترى بعض المجتمعات الحِسبة تدخلاً في الحريات الشخصية، خصوصًا في الدول غير الإسلامية التي تستضيف أسواقًا رقمية.
كذلك تتطلب الحِسبة الرقمية كوادر تجمع بين الفقه الإسلامي والتكنولوجيا، وهو أمر يحتاج إلى برامج تدريبية متخصصة.
أضف إلى ذلك أن تطوير أنظمة رقابية رقمية يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية التقنية، مما قد يشكل عائقًا أمام الدول النامية.
ثالثًا: إحياء الحِسبة في الاقتصاد الرقمي
في ظل التطورات المتسارعة للاقتصاد الرقمي، يمكن إحياء نظام الحِسبة كأداة فعّالة لتنظيم الأسواق الإلكترونية وضمان العدالة الاقتصادية والأخلاقية. ويتطلب ذلك دمج مبادئ الحِسبة التقليدية مع التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين، والتحليلات البيانية، وذلك من خلال ما يلي:
1- إنشاء هيئات إقليمية ودولية تُشرف على الأسواق الإلكترونية، تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لمراقبة المعاملات والإعلانات. فعلى سبيل المثال، يمكن تطوير برمجيات تكتشف الإعلانات الكاذبة أو المنتجات غير الحلال من خلال تحليل النصوص والصور. ويمكن أن تضم هذه الهيئات فقهاء الشريعة وخبراء التكنولوجيا لضمان الامتثال للأحكام الشرعية.
2- إطلاق تطبيقات هاتفية تتيح للمستهلكين الإبلاغ عن الغش أو التلاعب بالأسعار بسهولة، ويمكن أن تستخدم هذه التطبيقات تقنيات مجهولة المصدر (مثل البلوك تشين) لحماية خصوصية المبلّغين، بما يتماشى مع مبدأ قوله تعالى: (وَلَا تَجَسَّسُوا)(الحجرات: 12).
فعلى سبيل المثال، يمكن إنشاء تطبيق عالمي يسمح للمستهلكين بتقديم شكاوى مدعومة بالصور أو الفيديوهات، مع ربطها بهيئات رقابية متخصصة.
3- تطوير نظام عالمي للتحقق من شهادات الحلال باستخدام تقنية البلوك تشين، التي تضمن شفافية وأمان البيانات. ويمكن استخدام هذا النظام للتحقق من المنتجات المباعة إلكترونيًّا، مثل الأغذية أو الأدوية.
4- إطلاق حملات إعلامية لتوعية المستهلكين بحقوقهم في الأسواق الرقمية، مستندة إلى مبادئ الحِسبة، مثل قوله تعالى: (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ)(الأنعام: 152).
ويمكن تنظيم هذه الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع التركيز على تعليم الشباب كيفية التعرّف على المنتجات المغشوشة أو الإعلانات المضلّلة.
5- تشجيع منظمة التعاون الإسلامي على إنشاء إطار عالمي للحِسبة الرقمية، يضم فقهاء، واقتصاديين، وخبراء تقنيين. يمكن لهذا الإطار أن يوحّد المعايير الشرعية للرقابة على الأسواق الرقمية، ويُسهم في بناء ثقة عالمية بالمنتجات الإسلامية.
6- تطوير أدوات تقنية لمراقبة التلاعب بالأسعار: مثل الزيادات غير المبرَّرة الناتجة عن تزايد الطلب. ويمكن أن تعتمد هذه الأدوات على تحليل البيانات الضخمة لتتبّع أنماط التسعير في المنصّات الإلكترونية، مما يضمن الامتثال لمبدأ العدل في المعاملات.
7- مراقبة الأسواق الافتراضية: مع ظهور الأسواق الافتراضية، يمكن للحِسبة الرقمية أن تراقبها لمنع الاحتيال أو التلاعب بالأسعار. فعلى سبيل المثال، يمكن تطوير بروتوكولات شرعية للمعاملات في هذه الأسواق، مستندة إلى مبادئ العقود الإسلامية مثل البيع والإجارة.
8- الرقابة على العملات الرقمية: مع تزايد استخدام العملات الرقمية مثل “البيتكوين”، يمكن للحِسبة أن تلعب دورًا في التأكد من شرعية المعاملات، كمنع غسيل الأموال أو استخدام العملات في أنشطة غير مشروعة. ويمكن توظيف تقنية البلوك تشين لتتبّع المعاملات بشفافية، انسجامًا مع قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)(التوبة: 119).
تُبرز هذه الآليات مرونة نظام الحِسبة وقدرته على التكيّف مع التحدّيات المعاصرة، مع الحفاظ على جوهره الأخلاقي والشرعي.
خاتمة
إن نظام الحِسبة يمثل رؤية إسلامية فريدة تجمع بين العدالة الاقتصادية والأخلاق الاجتماعية. وفي عصر الاقتصاد الرقمي، حيث تتزايد التحديات مثل الاحتيال الإلكتروني والتلاعب بالأسعار، يمكن للحِسبة أن تكون الحل الأمثل لضمان الشفافية والثقة. ومن خلال دمج مبادئ الحِسبة مع التكنولوجيا الحديثة، يمكن بناء أسواق رقمية تعكس قيم الأمانة والعدل التي دعا إليها الإسلام.
المراجع
– القرآن الكريم.
– صحيح مسلم، كتاب الإيمان (رقم 49)، كتاب البيوع (رقم 1526).
– الماوردي، أبو الحسن. (1996). الأحكام السلطانية. بيروت: دار الكتب العلمية.
– ابن تيمية. (1987). الحِسبة في الإسلام. دمشق: دار السلام.
– ابن عبدون الإشبيلي. (2003). رسالة في القضاء والحِسبة. الرياض: دار الوطن.
– الغزالي، أبو حامد. (1997). إحياء علوم الدين. بيروت: دار المعرفة.