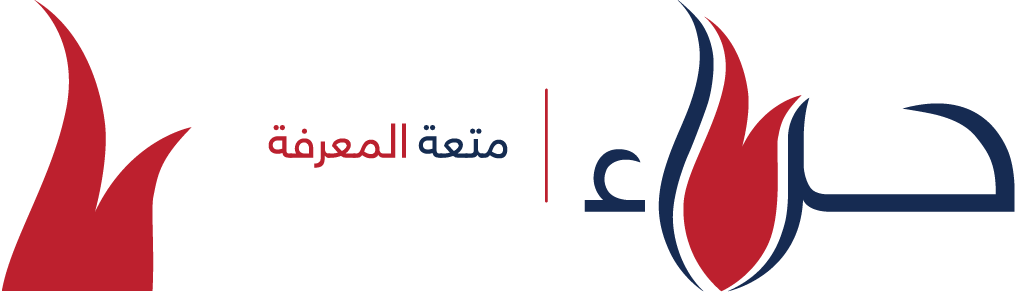أسهم الوقف بنصيب وافر في شتى مجالات الحياة في تاريخ الحضارة الإسلامية بخاصة، والحضارة الإنسانية بعامة، ذلك لأن الواقفين قد ضربوا بسهم في كل ما ينفع الناس؛ ومن ذلك تدبير موارد المياه وصيانتها، وهذا البحث يفصّل القول عن أثر الوقف في حل مشكلة المياه من خلال عرض نموذج من الوقف المائي للسيدة زبيدة بنت جعفر المنصور.
وقد عُرفت مكة بندرة مائها منذ عهد آدم، لذلك تسابق خلفاء المسلمين إلى حفر الآبار وإجرائها لتسد حاجة أهلها، وما يفد إليها من الحجاج والمعتمرين، لكن ذلك لم يكن ليستمر، فسرعان ما تنضب هذه الآبار، فتعود الأزمة إلى الظهور، فيلقى الناس في سبيل ذلك العنت والشدة من جراء انقطاع الماء، حتى إن الراوية من الماء لتبلغ قيمتها في المواسم عشرة دراهم، وهو مبلغ كبير بمقياس ذلك الزمن.
لم تخب مدينة إسلامية من مشاريع وقفية لنقل وتخزين وتوزيع المياه خلال عهود الاستقرار السياسي والاقتصادي التي أظلّت الدولة الإسلامية العظيمة. وكان ذلك للناس جميعًا بعامة، وللحجيج وفي طرق الحج بخاصة، فسقاية الحاج مما يتقرب المحسنون به إلى الله تعالى. وقد كانت قريش تتنافس عليها، ويعدونها من أفضل القربات.
وقد كان للمرأة المسلمة نصيب وافر في المشروعات الوقفية، ومن الأمثلة على ذلك: أوقفت رملة بنت عبد الله بن عبد الملك بن مروان دارًا بمكة يسقى فيها الشراب للحجيج. وأعمال زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر زوجة الرشيد ـ رحمهم الله ـ في هذا المجال أشهر من أن تذكر.
والسيدة زبيدة هي: زبيدة بنت جعفر المنصور الهاشمية العباسية (145 ـ 216 هـ)، زوجة هارون الرشيد وابنة عمه، وأم ولده الأمين. اسمها أم العزيز، وغلب عليها لقب زبيدة، وكانت أعظم نساء عصرها دينًا وأصالة ومعروفًا. وكانت وفاتها ببغداد سنة 216هـ/831م.
وتنبع عين زبيدة من وادي نعمان، وتقطع وادي عرنة إلى الخطم، ثم منى، ثم مكة، واستبدلت الآن بأنابيب ضخمة. وقد كانت السيدة زبيدة تتابع هذا الأمر وتوليه عنايتها، بالرغم من وجود العوائق الطبيعية التي تحول دون تحقيق هذا الهدف. وهذا الأثر لا زال قائمًا يستفيد منه حجاج بيت الله الحرام وأهالي مكة حتى اليوم.
ويبقى أثر السيدة زبيدة من أعظم الأعمال الخيرية التي تسابق إليها المسلمون، لا سيما في زمن عرف بمحدودية الآلة وضخامة النفقة التي يتطلبها مشروع مثل هذا.
ذكر الأمير شكيب أرسلان، صاحب كتاب الارتسامات اللطاف، أن السيدة زبيدة ما وجدت في حجّها من نقص المياه في مكة المكرمة، فاعتزمت أن تحفر لآل مكة وقصّاد بيت الله الحرام نهرًا جاريًا، يتّصل بمنابع الماء ومساقط المطر، فدعت خازن أموالها، وأمرته أن يدعو العرفاء والمهندسين والعمّال من أطراف الأرض وأقاصي البلاد، فعظم خازنها الأمر وما يستنفذ من المال فيه، فقالت: “اعمل ولو كلفتك ضربة الفأس دينارًا”. فاشترت “حائط حنين” وأبطلت المزارع والنخيل، وأمرت بأن تشق للمياه قناة في الجبال. وأثناء مرور القناة بالجبال، جعلت لها فتحات لأقنية فرعية أقامتها في المواضع التي تكون مظنة لاجتماع مياه السيول، لتكون هذه المياه روافد تزيد في حجم المياه المجرورة إلى مكة المكرمة عبر القناة الرئيسية.
ومن هذه الأقنية الفرعية التي خصصتها للمياه الإضافية السيلية في الطريق: “عين مشاش”، و”عين ميمون”، و”عين الزعفران”، و”عين البرود”، و”عين الطارقي”، و”عين تقبة”، و”الجرنيات”. وكل مياه هذه الأقنية الفرعية تصب في القناة الرئيسية، وبعضها يزيد سنويًا وبعضها ينقص بحسب الأمطار الواقعة على نواحيها من وادي نعمان إلى عرفة.
ثم إن السيدة زبيدة أمرت بإجراء “عين وادي نعمان إلى عرفة”، وهي مياه تنبع من ذيل جبل “كرا” بأرض الطائف أيضًا. وأمرت بجر هذه المياه في قناة إلى موضع يقال له “الأوجر” في وادي نعمان، وفيه إلى أرض عرفة. ثم أمرت أن تدار القناة على جبل “الرحمة” محل الموقف الشريف، وأن تجعل منها فروعًا إلى البرك التي في أرض عرفة ليشرب منها الحجاج يوم عرفة. ثم تمتد القناة من أرض عرفة إلى خلف الجبل، إلى منطقة يسميها أهل مكة “المظلمة”، ومنها تصل إلى “المزدلفة” إلى جبل خلف “منى”، ثم تصب في بئر عظيمة مرصوفة بأحجار كبيرة جدًّا تسمى “بئر زبيدة”. وقد بلغ طول هذه العين عشرة أميال.
قال الأزرقي: وأمرت بحفر الآبار الكبيرة الواسعة، وإقامة الأحواض وصهاريج الماء في كل مرحلة من المراحل الممتدة على طريق الحج من الكوفة إلى مكة والمدينة، على أن تبنى جميعها من قمتها إلى قاعها بالحجر والآجر المشوي والجبص والملاط لتوفير المياه للحجيج في الصحراء، التي كان يموت فيها عطشًا آلاف الحجاج سنويًّا. فحفرت الآبار وأقيمت الصهاريج. ويذكر مؤرخو مكة أنها أنفقت في سبيل ذلك من الأموال ما لم تكن تطيب به نفس كثير من الناس حتى أجراها الله.
قال المسعودي: إنّ زبيدة حفرت بالحجاز العين المعروفة بعين المشاش، ومهّدت الطريق لمائها في كل خفض ورفع، وسهل ووعر، حتى أخرجتها من مسافة اثني عشر ميلاً إلى مكة، فبلغ ما أنفقته عليها ألف ألف دينار، وهذه من الأعمال التي لم تباشرها امرأة في الإسلام إلا الخيزران أم الرشيد.
وقال ابن جبير في طريقه إلى مكة: “وهذه المصانع والبرك والآبار والمنازل التي من بغداد إلى مكة، هي آثار زبيدة ابنة جعفر، انتدبت لذلك مدة حياتها، فأبقت في هذا الطريق مرافق ومنافع تعم وفد الله تعالى كل سنة من لدن وفاتها حتى الآن، ولولا آثارها الكريمة في ذلك لما سلكت هذه الطريق”.
كما أشار إليها أيضًا ابن بطوطة، وهو يصف رحلته من مكة المكرمة إلى العراق، فقال: “وكل مصنع، صهريج أو بركة أو بئر بهذه الطريق التي تربط بين مكة وبغداد، فهي من كريم آثارها، جزاها الله خيرًا ووفى لها أجرها، ولولا عنايتها بهذا الطريق ما سلكها أحد”.
ولما تم عملها، اجتمع المباشرون لهذا المشروع ومعهم العمال لدى السيدة، وهي بقصرها المطل على دجلة، فأمرت بالدفاتر يلقى بها في دجلة، وقالت: “تركنا الحساب ليوم الحساب، فمن بقي عنده شيء من بقية المال فهو له، ومن بقي له عندنا شيء أعطيناه”. وألبستهم الخلع الثمينة.
يقول إبراهيم رفعت باشا في مرآة الحرمين: “وقيل إنه بلغ مجموع ما أنفقته السيدة زبيدة على هذا المشروع مليونًا وسبعمائة ألف مثقال من الذهب، أي ما يساوي خمسة آلاف وتسعمائة وخمسين كيلوغرامًا. ولما تم عملها اجتمع العمال لديها وأخرجوا دفاترهم ليؤدوا حساب ما صرفوه، وليبرئوا ذممهم من عهدة ما تسلموه من خزائن الأموال. وكانت السيدة زبيدة في قصر مطل على دجلة، فأخذت الدفاتر ورمتها في النهر، قائلة: “تركنا الحساب لليوم الحساب، فمن بقي عنده شيء من المال فهو له، ومن بقي له شيء عندنا أعطيناه”. وألبستهم الخلع والتشاريف، فخرجوا من عندها حامدين شاكرين”.
وبقي هذا الأثر العظيم على مر السنين شاهدًا على حب سلاطين المسلمين لفعل الخير والبذل في سبيله.
وبفعل العوامل الطبيعية فقد تعرضت عين زبيدة للانقطاع لقلة الأمطار، وطرأ في بعض الأحوال على قنواتها تخريب من أثر السيول وتوالي الأزمان. وكان الخلفاء والسلاطين الذين تعاقبوا على الحكم في الأقطار الإسلامية إذا بلغهم ذلك تحركت هممهم لإصلاح تلك العين التي تتمتع بتلك الهندسة الزبيدية.
وفي زمن السلطان سليمان العثماني، انقطعت عين زبيدة وتهدمت قنواتها، وصار أهل البلاد يستقون من آبار حول مكة، وصار الماء غاليًا جدًّا. وكان الحجاج يحملون الماء إلى عرفات من الأماكن البعيدة، وصار فقراء الحجاج يوم عرفة لا يطلبون شيئًا غير الماء لعزته. ولما عُرضت أحوال العين على السلطان، أمر بالفحص عنها ودراسة كيفية إعادة جريانها، فتألفت لجنة من قاضي مكة يومئذ الشيخ عبد الباقي بن علي الغربي، والأمير خير الدين خضر أمير جدة، وغيرهما من الأعيان. فقرروا أنه يمكن إعادة جريان الماء بكلفة خمسين ألف ليرة عثمانية ذهبًا، ظنًّا من غير تحقيق ولا تقدير لعواقب العمل الكبير.
ولما كانت صاحبة هذه الصدقة الجارية هي السيدة زبيدة العباسية، فقد رُئي أن تكون كريمة السلطان هي التي تتولى إصلاحه، وهكذا فقد عيّن الأمير إبراهيم بن بردي دارًا بمصر لإنجاز هذه المهمة، فحضر إلى مكة، وشرع في عمله، واستخدم من العمال أربعمائة مملوك، ومعهم ألف آخرون من العمال والبنائين والمهندسين والحفارين، وجلب من مصر والشام وحلب وإسطنبول واليمن طوائف بعد طوائف من المهندسين، ومن المختصين بجر المياه، وترتيب القنوات، وكثير من الحدادين والحجارين والبنائين، والقطاعين والنجارين.
وكان قد حمل معه من مصر بما لا حصر له من آلات العمارة والنقب والمكاتل، والمساحي، والمجاريف، والحديد، والفولاذ، والنحاس، والرصاص. وكان يظن أنه يستطيع أن يتم العمل في عام، لكنه علم بعد ذلك أن الخطب كبير والعمل كثير، إذ كان يحتاج لحفر ألفي ذراع بذراع البنائين في الصخر الصلب لإتمام الإصلاح وإيصال الماء إلى مكة، وكان الحفر المطلوب عميقًا في الحجر الصوان يصل أحيانًا إلى عمق خمسين ذراعًا. ولم يمكنه ترك العمل بعد الشروع فيه حفظًا لناموس السلطنة الشريفة.
وكلما فرغ المصروف طلب الأمير إبراهيم مصروفًا آخر، إلى أن أتى على خمسمائة ألف ليرة عثمانية ذهبية، إلى أن وافاه الأجل قبل إنجاز المهمة المستحيلة. فتولى الأمر من بعده أمير جدة، فمات أيضًا دون إنجازه، إلى أن أتمها القاضي السيد حسين الحسني، بعد أن استغرق العمل عشرة أعوام كاملة، وهلك دونه أمراء وخدام ومماليك، وأنفقت ثروة طائلة.
المصادر والمراجع:
– إبراهيم رفعت باشا (اللواء)، مرآة الحرمين، ط1، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1344هـ / 1925م.
– ابن النجار (الحافظ أبو عبد الله المتوفى 643هـ)، الدرة الثمينة في تاريخ المدينة، تحقيق محمد زينهم محمد عزب، مكتبة الثقافة الحديثة، القاهرة، 1416هـ.
– ابن بطوطة (محمد بن عبد الله الطنجي، ت 779هـ / 1377م)، رحلة ابن بطوطة: تحفة النظار في غريب الأمصار وعجائب الأسفار، دار الشرق العربي، بيروت، د.ت.
– ابن جبير (محمد بن أحمد، ت 614هـ / 1217م)، رحلة ابن جبير: رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك، مكتبة الهلال، بيروت، 1986م.
– الأزرقي (أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد)، أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، تحقيق رشدي الصالح ملحس، ط3، دار الأندلس، بيروت، 1402هـ / 1983م.
– الفاكهي (عبد الله بن محمد بن إسحاق)، أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ط2، خضر للطباعة والنشر، بيروت، 1414هـ / 1994م.
– المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسين بن علي، ت 346هـ / 957م)، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت، 1403هـ / 1982م.
– عاتق بن غيث البلادي، معالم مكة التاريخية، ط2، دار مكة، 1403هـ / 1983م.
– عبد العظيم أحمد عبد العظيم، عمارة الأرض، مكتبة الإسراء، الإسكندرية.