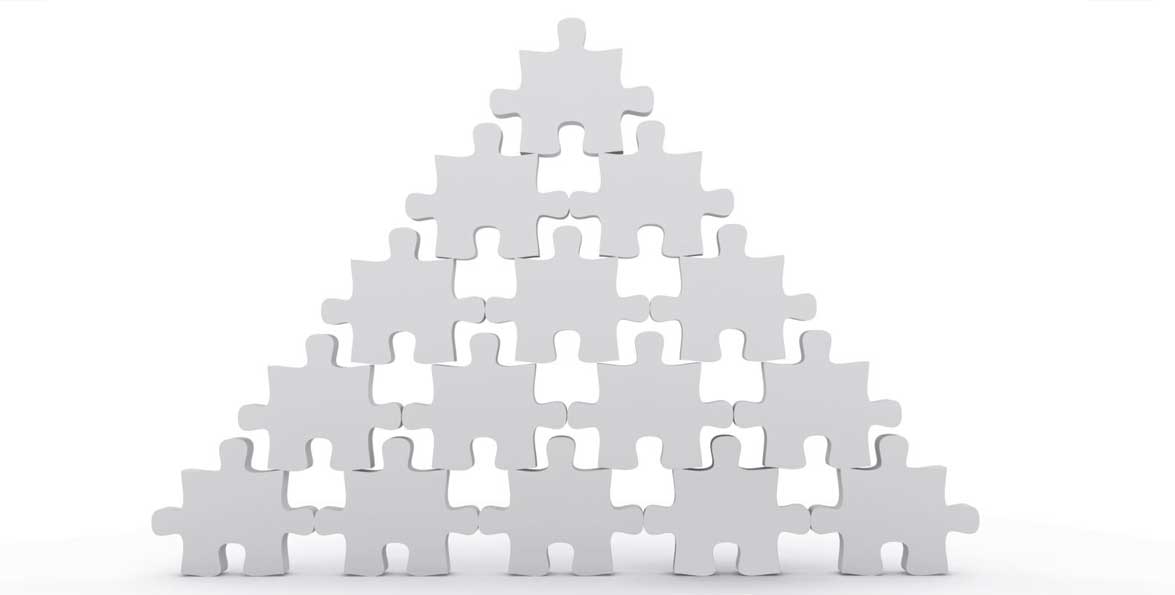عندما يكتب المرء عن الأستاذ فتح الله كولن، فهو يكتب عن الشخصية العلمية والتربوية المرموقة بين رموز الإصلاح في عالم المسلمين اليوم، لكن الأهم في تلك الشخصية ربما أنها استطاعت أن تنتج نموذجًا كامنة خصائصه في مدرسة تجديدية للنهوض والتغيير واستعادة المبادرة الحضارية.
معلوم أننا نكابد في عالم المسلمين مخاض النهوض وأسئلته الحارقة منذ أزيد من قرنين من الزمان، وهي أسئلة متعددة تتصل بالطريق الذي يخرج بمجتمعاتنا من التخلف ويمكنها من أسباب النهوض. غير أن جوهر تلك الأسئلة جميعًا، هو قضية مركزية جامعة تتلخص في السبيل إلى إنتاج نموذج حضاري خاص بديل. وشرط هذا النموذج المنشود، هو تحقيقه فاعلية الإنسان في أداء مهامه الكبرى في عالمه، تلك التي أجملها الوحي في أمانات الوراثة والاستخلاف والعمران.
والذي يعنينا في هذا المقال، هو محاولة الوقوف عند ذلك النموذج كما تأسس في اجتهادات وأفكار “خُوجَه أفندي” اللقب التركي للأستاذ كولن، الذي يعني “السيد الأستاذ”، وكما تبلور في الواقع -ولا يزال- من خلال مشروع “الخدمة”. والذي نزعم أنه نموذج حضاري ذو هوية مجتمعية، وهو أمر يقتضي توضيحات أولية حول المراد بهذا النموذج وعلاقته بنماذج أخرى مغايرة.
أولاً: ليس الحديث عن نموذج حضاري مجتمعي هنا، مقابلاً للنموذج السياسي للإصلاح؛ لأن النموذج المجتمعي معني بالشأن العام عنايته بالشأن الخاص بالإنسان الفرد بناء وتربية وإعدادًا، وحاضر في المجال العام على أكثر من مستوى، مما ينشأ مساحات التقاء وتقاطع بالضرورة بين النموذجين.
ثانيًا: ربما كان النموذج الأقرب إلى كونه مقابلاً للنموذج المجتمعي، هو “نموذج السلطة السياسية”، أي نموذج التغيير المتمركز حول السلطة السياسية، تنافسًا عليها واستخدامًا لأدواتها. وهو نموذج مخالف للنموذج المعرفي الحضاري الإسلامي للسياسية في معناها الأشمل بوصفها منظومة آليات للإصلاح، أي “القيام على الأمر بما يصلحه” كما يقرر العلامة ابن خلدون.
ومن المهم في هذا السياق، التأكيد على أن الأمر يتعلق -بالفعل- بنموذج كامل في مقابل نموذج كامل آخر، لكل منهما فلسفة ورؤية للتغيير، وأهداف ووسائل وإنْ اتحدا في الغاية النهائية التي ينشدانها؛ وهي تحقيق مقتضيات الاستخلاف في الأرض وعمرانها من خلال بعث النموذج الحضاري المؤسس على هدي الوحي، لكن الاتحاد في الغاية لا ينبغي أبدًا أن يصرف النظر عن أهمية النظر بعمق في النموذجين ورؤيتيهما، وفحص مستوى وعيهما بالحقائق الماثلة وفعاليتهما في تحقيق ما ينشدانها من غاية، والوسائل التي يستخدمانها من حيث الجدوى والآثار على الواقع.
لكن ليس معنى ذلك أننا نقدم هنا نقدًا لنموذج السلطة السياسية الحديثة والمعاصرة، وقوامه الآلية والقواعد الديمقراطية، فهو وإن كان قد تعرض لنقد واسع في الكتابات الفلسفية والسياسية الأحدث -ترد بعض الإشارات إليه دون أن يكون هذا مجال التفصيل فيه- إلا أن النقد مؤسس على التجاوز وهذا رهن بالاستيعاب؛ وهو ما لم يتم إلى الآن في مجتمعاتنا بالنسبة لآليات النموذج السياسي الحديث وتطبيقاتها المتعددة.
1– نموذجان للتغيير
يسعى نموذج التغيير الحضاري أو المجتمعي في رؤية “كولن”، إلى تحرير إرادة المجتمع وإكساب كافة وحداته الفعالية المطلوبة، لتتحرك ذاتيًّا نحو بناء المجتمع وشهود الأمة ورشاد الإنسانية، بمعنى أنه نموذج التغيير المنطلق من قاعدة المجتمع إلى قمته، مرورًا بكافة وحدات المجتمع بلا استثناء. وواضح في ضوء هذا النموذج -كما تجلى واقعيًّا في منظومة مشاريع ومؤسسات “الخدمة” منذ أزيد من أربعة عقود- أن منطلقه هو “بناء الإنسان” وإكسابه المواصفات اللازمة لوراثة الأرض، وهو هدف يفضي إلى الارتقاء به عبر نقلات نوعية، وتحرير إرادته، ومن ثم تحرير إرادة المجتمع كله، وإكسابه القدرة على أخذ زمام المبادرة بشكل يحقق أكبر قدر مستطاع من الاستقلالية عن أي إرادة، سواء كانت إرادة سلطة حاكمة -مهما كان لونها أو توجهها- أو قوة تأثير داخلية أو خارجية، فيعيد بذلك سلطة الدولة إلى حجمها الحقيقي الذي كان عليه قبل أن يتمدد باضطراد عبر الزمن؛ مما يعني أن تسير السلطة إلى جانب المجتمع، ميسرة أمامه سبل الفعل، ومذللة ما يواجهه من صعوبات، دون أدنى سعي للحلول محله في أداء وظائف لا يمكن أداؤها أصلاً، ولا تتسع بنيتها والتزاماتها وهامش حركتها لما تقتضيه تلك الأهداف من تحرر إرادة ومثال أخلاقي وطاقة فعل ومرونة حركة.
وليس معنى ذلك أن هذا النموذج لا يملك تصورًا لتدبير الشأن العام بما في ذلك السياسي، بل إنه من خلال رصيد الحركة في الواقع، يعيد تعريف العمل السياسي، ليخرج به من إسار الإطار الحزبي ومقتضياته التنافسية على سلطة الحكم، فيجعله قوة فعل عام قوامها النموذج الإنساني المؤهل والفاعل، والمجتمع الحي والمتحرك والمبادر، دون أن يظل أسير الهدف الحزبي المحدود في وسائل الممارسة السياسية التقليدية. بل إن هذا النموذج، هو استثمار إيجابي للوظائف الأهم والأشد تأثيرًا من بين تلك التي تقوم عليها علاقات الدولة الحديثة بالمواطن، من قبيل التعليم والاقتصاد والإعلام.
أما نموذج السلطة السياسية فقائم على مبدأ التغيير من خلال سلطة مؤسسة الحكم، أي امتلاك أداة السلطة السياسية طريقًا للتغيير. لذا فإنه من المهم الإشارة إلى أن ما يعانيه من أزمات حالية، مرتبطة أساسًا بسلامة الأداة الأساسية للتغيير وإمكانية تحقيقه بالاعتماد عليها، ذلك أنه فضلاً عن المحدودية الواضحة للسلطة السياسية في عملية تغيير تستهدف غايات كبرى ذات طابع حضاري، مؤسسة على القيم الشاملة للوحي؛ فإن المنظور السياسي يواجه معضلة الدولة الحديثة التي يتخذها مركبًا لبلوغ غايته مع ما هو معروف من الأزمات المستحكمة التي تئن تحت وطأتها هذه الدولة بإطلاق، سواء من حيث جوهرها العنيف، أو نزوعها التحكمي للسيطرة على مساحة الفعل على حساب المجتمع، أو صناعتها لآليات استبداد جديدة باسم الأغلبية والديمقراطية وشرعية الصندوق، أو ضربها لروح التوافق ومفهوم الجماعة، مع ما في ذلك من آفات التحكم اللاأخلاقي لمؤسسة الدولة نفسها وموازينها الداخلية وإكراهاتها بالأفراد ومجموعات الحكم مهما كانت مستوياتهم الفردية أو توجهاتهم الفكرية أو الأخلاقية الأصلية، نظرًا للطبيعة التحكمية لمؤسسة الدولة الحديثة نفسها، التي تكاد في بعض الأحيان تحكم الجالس على كرسيها بدل العكس مما يتوقعه الناس من الحاكم عادة، ويعلقونه على وجوده من آمال عراض، مستسلمين لذات الفكرة التبسيطية عن إمكانية التغيير الشامل بالأداة المفردة أو الفرد القائد المخلّص.
وغني عن التذكير هنا، أن السلطة السياسية في الدولة الحديثة، ليست قيامًا على الأمر بما يصلحه، لأسباب ترتبط بظروف تشكل هذه الدولة، وامتداد السلطة السياسية العضوي من حقل العنف أو احتكاره على الأقل كما يقول “ماكس فيبر”، وغيرها… مما يجعل أي إسقاط تاريخي على التجربة الإسلامية مثلاً في مجال تدبير السلطة السياسية المعاصرة، خاطئًا من الأساس، لأنه قياس مع وجود فوارق نوعية كبرى.
2– قوة المثال الإنساني
يبدو نموذج السلطة السياسية الحالي -الابن الشرعي للدولة الحديثة ونمطها في التحكم بغض النظر عن أيديولوجيته- قائمًا على منظور لمنظومة العلاقات داخل المجتمع مغاير تمامًا للمنظور الحضاري المجتمعي. فهو ينظر إلى القاعدة الاجتماعية العريضة من الناس بوصفها مجالاً للتوجيه، وأن مهمة الفاعل في هذا النموذج هو قيادتها وتوجيهها. وهي مهمة لا تتحقق إلا من خلال تركيز علاقات الإعجاب (الكاريزما)، بل الانبهار بين الحاكم (أو صاحب السلطة السياسية) وبين الناس، فلا بد حنئيذ من مد هذه العلاقة باستمرار بوقود من الخطاب الحماسي، وصناعة الصورة، والتمركز حول الشخصية القيادية؛ وهذه هي مهمات عمليات التواصل السياسي الذي يحيل ذلك الإنجاب إلى تفويض مطلق. وتزداد هذه السلطة في التوجيه، من خلال وسائط التأثير في عصرنا، الذي يعتبره كثير من المؤرخين وعلماء الاجتماع، عصر الجماهير (غوستاف لوبون)، أو عصر الجماهير الغفيرة (جلال أمين)، بعد أن تسيدت وسائط الاتصال عوامل التوجيه وصياغة القناعات وتشكيل الرأي العام.
ولأن الغاية في النموذج المجتمعي لا تنفصل عن وسيلة التغيير وأدائه التي يتبوأ الإنسان فيها منزلة الصدارة، فإن مقتضاه أن تكون شبكة علاقاته قائمة على معان أكثر عمقًا وأقوى تأثيرًا في بناء دافعية الإنسان نحو التغيير المنشود، هكذا تتصدر قيم التأسي والاقتداء بالرموز العلمية والمجتمعية في نسق تراحمي، والبذل في سبيل الفكرة إلى أقصى الحدود في كل مكان ومجال.
إن المقصود بالمثال الإنساني هنا، هو نوعية العنصر الذي يحرك هذه المنظومة فتعيد إنتاجه على امتداد الأمكنة والبيئات والظروف؛ المعلمون، المهاجرون، والمضحون بمصائرهم الشخصية والأسرية والمهنية، الأساتذة المتفانون في رسالتهم حد التماهي، الرجال والنساء الباذلون من أموالهم في تسابق عجيب تشهد عليه “مجالس الهمة” لبناء هذه المدارس والجامعات والمؤسسات ورعايتها في تركيا وعبر العالم، خريجوها من الطلاب الذين يعيدون إنتاج هذه الدائرة الصالحة من الخدمة والبذل، هؤلاء الذين يشكلون جميعًا “جزر سلام” حقيقية في عالم مضطرب، كلهم عنوان المثال، ومعيار دقيق في الحكم على قوة النموذج الكامن في المنظومة المؤسسية، الذي أنتج هذه التجربة الإنسانية الحية في عالمنا.
يمكن حقًّا لنموذج فكري أو تربوي أن يقدم نفسه للعالم اليوم معتمدًا على مؤشر قوي من مؤشرات الجودة، ويمكن لهذا النموذج أن يعرف الانتشار والقبول سعيًا للإفادة الجزئية من هذا المؤشر. وليس صعبًا أن نجد أمثلة عديدة على ذلك في زمن الإنتاج والاقتصاد والمعرفة المعولمة، لكن الصعب حقًّا هو أن يكون التحدي بالمثال الإنساني. أن تكون علامتك المسجلة موضع الثقة والفعالية إنسانًا مؤهلاً تتحدى به ظروف معقدة في بيئات صعبة عبر العالم، واثقًا من نجاعة مسلكه القيمي والتربوي، وكفاءته في التعامل معها في كل مكان.
3– معادلة الوعي التاريخي والرؤية المستقبلية
لم تكن هذه الروابط بما ينسجها من قيم ومعان لتؤتي أكلها فعالية تربوية ونماءً اجتماعيًّا وتغيرًا في أعماق المجتمع، وعلى صفحة التاريخ الممتد في النموذج المجتمعي دون وعي تاريخي حاد وموجِّه.
فليس غريبًا أن ترى الأستاذ “كولن” يبكي في درس من دروسه أو موعظة من مواعظه الدائمة، متأثرًا بحدث تاريخي وهو يقف عنده مفسرًا، ولا أن تسمع نبرات الحسرة في صوته وهو يحلل موقفًا تاريخيًّا، أو تقرأ له في كتبه استدراكًا على اختيار ما في لحظة تاريخية سالفة… سر ذلك هو الوعي التاريخي الذي يؤكد عليه، والذي يتخطى حواجز الزمن، بل يتجه إلى بعدي الزمن بنفس القوة والدقة، إلى الماضي المجسد سياق الواقع وجذوره ومحدداته، وإلى المستقبل الكامن في رحم الغيب مستودعًا للأهداف والغايات.
الحقيقة أن الواقع وفق ذلك النموذج إن هو إلا مستقبل نحيله ماضيًا بقوانين السعي في الأرض، ومن خلال إرادة الإنسان الواعية.
وإذا كان القائلون يقدمون الواقع تكرارًا للتاريخ يستحيل معه الإنسان إلى كتلة منفعلة، حين يرددون أن “التاريخ يعيد نفسه”، فإن الأستاذ كولن ينبهنا -بقولته “التاريخ يشبه نفسه”- إلى القوانين والسنن التي تتحد فيها وقائع التاريخ فتتشابه، دون أن تتجاوز أهميتها الإنسان أو الخليفة وسعيه بوصفه مسخر السنن، ومحور الكون، والفاعل الرئيس في مساحة التاريخ.
أما في المستقبل، البعد الثاني في خط الزمن الإنساني والاجتماعي فتوسيع لمدى الرؤية الإستراتيجية الحاكمة للأهداف الكامنة في كافة البرامج والمراحل.وهنا، حيث مفهومان مختلفان للمرحلية، تكمن أولى تجليات التقاطع بين النموذج المجتمعي ونموذج السلطة السياسية.
تعني المرحلية وفق النموذج المجتمعي، أن تكون الرؤية الإستراتيجية المتصلة بالغايات الحضارية الكبرى واضحة شديدة الوضوح، ثم تتعلق الأهداف المرحلية بها، وتدور البرامج والمهام والمناشط المختلفة حول تحقيق هذه الأهداف، بما يحقق الرؤية الإستراتيجية الكلية تدرّجًا ولا ينقضها أو يصادمها أبدًا. صحيح أنه لا يمكن تحقيق تلك الأهداف كافة، ولا تنزيلها على الواقع إلا في إطار الإمكان وظروفه وشروطه، لكن الأهم هو أن يظل السعي محكومًا بالغاية، منقادًا إلى تحقيق الأهداف حسب الإمكان في غير تثاقل يقصر بالسعي عن بلوغها، ولا تسرع يغفل الشرط الواقعي أو يقفز عليه. غير أن نموذجًا بهذا المستوى من الانضباط للشرط التاريخي، سواء في مداه الزماني ماضيًا ومستقبلاً أو في قانونه السنني واقعًا، ليس يسير التحقق، إذ ينضاف إلى المثال الإنساني في انتمائه وعلاقاته، الترفع الواعي والمنضبط عن الأهداف المرحلية المعلنة، مما لا علاقة له بالرؤية منطلقًا والغاية محددًا. ولعل هذا هو مكمن السبب فيما يبدو من مظاهر الاصطدام بين هذين النوعين من الأهداف.
فكثيرة هي الأهداف التي وإن لم يعوزها حسن الدافعية وسلامة القصد، فإنها تخضع لمؤثرات ظرفية من قبيل الموجات الاجتماعية وعواصف الجمهور، وردود الأفعال والحضور الطاغي في وسائط الاتصال. الفرق هنا ليس في مدى الاستيعاب للرؤية والصبر على مراحلها، بل في الوتيرة الخاصة بكلا النموذجين على خط الواقع الإنساني وامتداداته الحاضرة.
فكيف لوتيرة مقيدة إلى زمن السلطة السياسية المتسارع والقصير المدى، المنضبطة لمواعيده واستحقاقاته، المحكومة باتجاهات الجماهير وسلطة الرأي العام، أن تصبر على أهداف بسعة مواجهة الأعداء المزمنين؛ الجهل، والفقر، والفرقة.
فالنموذج الحضاري المجتمعي يعيد الاعتبار -بدأبٍ وإصرارٍ- لقيم الوحي في حياة الإنسان والجماعة، مركزًا على بناء الإنسان هدفًا مركزيًا، ليكون مؤهلاً لصياغة عالمه على مقتضى رسالته في الكون كما قررها الوحي بمقاصدها الكبرى في بناء العمران، فتصير تلك المقاصد الكلية محددًا لأهداف حركته في الواقع. لذا نجد أن أهداف كبرى بسعة نشر العلم مقابلاً للجهل، وتحقيق الكفاية مقابلاً للفقر، وإرساء أسس الحوار والتفاهم مقابلاً للفرقة والصراع، ظلت أهدافًا قارة لهذا النموذج، بل هي المؤهلة وحدها لتوجيه مساره في المستقبل المنظور كما يبدو، لأن المقاصد الكلية الحاكمة لها والكامنة في النموذج، واضحة ثابتة.
بكلمة؛ إذا كان نموذج السلطة السياسية معنيًّا بالفعل الآني ومدى تأثيره في رأي الجمهور، فإن النموذج المجتمعي مرتبط بمحددات ذلك الفعل وشروطه التاريخية والحضارية والمجتمعية، بما تقتضيه من تغيّرات دقيقة ومعقدة في منظومات القيم، ونمط التربية، والسلوك ومستويات المعرفة، ومؤشرات الفعالية الاجتماعية وتركيبة مؤسسات الاجتماع.
وسواء تعلق الأمر بشبكة علاقاته الداخلة أو مدى إدراكه التاريخي والحضاري وتدبيره لزمنه الخاص، فإن نموذج السلطة السياسية يظل غير قادر على تأسيس الفعالية المجتمعية في مستواها الحضاري بعيد المدى، والتي هي شرط الإصلاح العام وهو المعنى المجتمعي للسياسة، أو أنه على الأقل لا يتسع لها.
4– صراع النماذج وصياغة التمثلات
من التجليات الأليمة لمفارقة الغايات ومرحليتها، أن النموذج المجتمعي حين لا يولي لأداة السلطة السياسية (وليس العمل العام والشأن السياسي)، ولا لهوية الماسك بها، أهميةً محددة لمساره العام، كتجل لرؤية متسقة مع وعيه بخصائص الدولة الحديثة التي لم تُبقِ للماسك بزمام السلطة السياسية الدورَ الأساس في الإصلاح العام بمعناه الأعمق والأبقى؛ فإن البعض يعد هذا موقفًا من هوية المجتمع وتعبيراته في السلطة، مع أن بين الأمر (بين هوية المجتمع وهوية السلطة) اختلافًا واضحًا، بل تقابلاً من حيث طبيعته محددات كل منهما. فالمجتمع تعبير عن الأصل الثابت الذي يمثل الاستمرارية، بينما السلطة تجسيد للمرحلي الآني، وليس المهم في ما يصدر عنها من فعل -آني بطبيعته كذلك- أن يكون صائبًا في ذاته أو بمقاييسه دائمة التغيّر فحسب، بل الأهم أنه إن لم يخدم مقومات الاستمرارية وينميها، فلا أقل من أن ينسجم معها فلا يصادمها. والحقيقة أن ربط الهوية المجتمعية التي صاغها الإسلام في الأساس، بنموذج السلطة السياسية يثير آليات المقارنة المباشرة بين مكونين، أحدهما ثابت راسخ، والآخر مؤقت دائم التحول. وهو ربط سيؤدي إلى الإضرار بهما معًا؛ بالإسلام الذي هو لحمة المجتمع وسداه الراسخين بربطه بنموذج متحول، وبالنموذج ذاته بتحميله عبأ لا قِبَل له به، ومسؤولية لا طاقة له بها مهما ادعى أهليته لتمثيلها في مرحلة ما، لأنها في الواقع أعظم من أن تستوعبها قدراته.
ومن الواحب في هذا المقام، تأكيد مبدأ واضح في ذاته أولاً وفي علاقاته بالسياقات الراهنة كذلك، وهو أن سلامة المجتمع وأمانه الداخلي مقصد تقتضيه رؤية التغيير في النموذج الحضاري المجتمعي اقتضاء ملحًا، ذلك أن هذا النموذج يولي الأهمية الشديدة للمجتمع باعتباره مقصد التغيير ومادته الأساس، وما يستتبعه ذلك من أهمية الاستقرار والسلم الاجتماعيين والحفاظ عليهما في هذه الرؤية، واعتبار ذلك أولوية تقتضي التضحية بالمنجز الخاص أو المرحلي، كما هو واضح في أمثلة حية من تجربتها لا يتسع المجال للتفصيل فيها.
ولأن المنح تأتي دومًا في طي المحن، فإن الحال الراهنة فرصة هامة لإدراك أدق لمعالم النموذجين وأهم الفروق المميزة لكل منهما، فالتمايزات تكون آنئذ أكثر وضوحًا، وأظهر في لحظات الأزمة، بما يصاحبها من ردود فعل وتمثلات جماعية ومواقف ينتجها كلا النموذجان في تفاعله مع الواقع.
ولعلنا نقف عند أهم الدروس المتأتية إلى الآن، من واقع تلك الأزمة التي آن لها أن تُقرأ بأعمق من المستوى الظاهر الذي تطغى فيه الشخوص والأحداث وردود الأفعال… خاصة بالنسبة لنموذج حي وفاعل استطاع أن ينجز على الصعيد الإنساني في المجالات الأدق المتصلة ببناء الإنسان من خلال التربية والتعليم، وبحفظ حيوية بنيات المجتمع، بوصفها ضرورة حاسمة للحفاظ عليه، وضمان أكبر قدر من الاستقلالية له، في تجربة تعيد تعريف السياسة والعمل العام، بما يتجاوز سقف التنافس على السلطة.
ويبدو أن تناول النموذج الإصلاحي للأستاذ “فتح الله كولن”، بوصفه نموذجًا مجتمعيًّا، لا يتجلى في أبعاده الكاملة إلا من خلال المقارنة بين رؤيتين مركبتين للعالم وللتغيير فيه، ومقومات هذا التغيير ومداه وأولوياته. وهما الرؤيتان اللتان تجملان أكثر محاولات التغيير والإصلاح الجادة في عالم المسلمين اليوم، وهذا هو مكمن الأهمية في مجمل ما نشهده في عالمنا خلال هذه المرحلة من تجليات. أما الأمل من هذه الكلمات، فهو أن تكون ثمرتها هدية لكثير من ذوي النهى، المعانين واقعًا أليمًا؛ ثمرة قوامها نموذج حضاري حي وفاعل، يستمد الحياة من مصدر معنوي عميق الغور، والفعل من مكابدة واقع مركب ومتعدد المستويات رحب الآفاق.
(*) رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية – وجدة / المغرب.