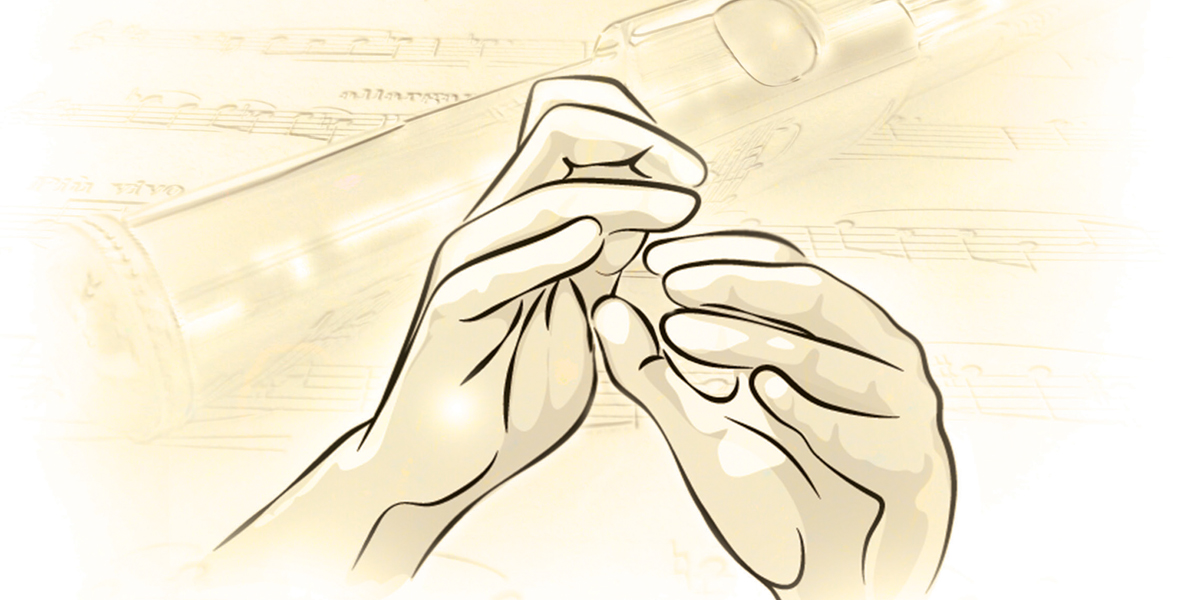ليس هناك في الحياة فزعٌ ورعبٌ أكثر مِن أن تواجه قوة مذهلة لشخصٍ يتحكّم في مصيرك؛ حيث يمكنه أن يُعدمك أو يسجنك أو يرسلك إلى المنفى أو حتى يتركك حرًّا طليقًا. فسِجْن مثل هذا الشخص إياك أو إخلاؤه سبيلك أمر مدمّر بالقدر نفسه، بغض النظر عن اختلاف النتائج. فأنت أمامه لا تملك أي حق في الكلام؛ بل الذين يتمتعون بهذا الحق أو تلك السلطة، هم أشخاص يرتدون عادة عباءة، ويجلسون على منصة مرتفعة، ويُطلق عليهم “قضاة”.
إن الشيء الوحيد الذي يسوّغ لأي أحد امتلاك مثل هذه القوة الخارقة، هو أن يستخدمها في محلها، بحيث يحقق بها العدل ويحفظ من خلالها الحقوق.
لكن فما بالكم إذا كانت مثل هذه القوة لا تبالي بأي معايير للحق أو العدالة؟
في رواية “وداعًا للسلاح” للكاتب الأمريكي “أرنست همنجواي” مشهدٌ يصف محاكمة قضاةٍ عسكريين لجنود إيطاليين بعد الهزيمة داخل كهفٍ، حيث يرتدي القضاة قبّعاتهم ويلقون التحية العسكرية، قبل أن يصدروا أحكامهم بالإعدام على الناس غير عابئين بشيء، تملؤهم الثقة بأن هذه الأحكام لن تؤثر قطعًا على مصيرهم هم أنفسهم.
لقد كان هذا المشهد مذهلاً أيضًا في الفيلم الذي مثّله كل من “روك هدسون” و”فيتوريو دي سيكا”، حيث كان القضاة يصدرون الأحكام، ويرسلون الأشخاص إلى فرقة الإعدام دون مبالاة.
لقد امتثلتُ أمام القضاة عدة مرات خلال فترة الحبس الطويلة، لم يعيروا سمعًا لما قلت في الدفاع عن نفسي، وكلما قدمت لهم أدلة براءتي استمروا في ترديد الاتهامات نفسها مرارًا وتكرارًا وكأنني لم أقل شيئًا. حكموا عليّ بالسجن المؤبد أولاً، ثم خفّفوا العقوبة إلى عشر سنوات ونصف، وأخيرًا أطلقوا سراحي.
وإذ أسطّر هذه السطور، أنتظر في الوقت ذاته قرارًا سيتخذه القاضي بناءً على استئناف المدعي العام بعد اعتراضه على قرار إطلاق سراحي، فقد يعيدونني إلى السجن مرة أخرى.
لقد سمعت الحُكم عليَّ بالسجن المؤبد، وسمعت بعد ذلك قرار إخلاء سبيلي من فم القاضي نفسه في أوقات مختلفة. والحق أقول لقد أعياني قرار إخلاء سبيلي بالقدر نفسه الذي أعياني فيه قرار الحكم عليّ بالمؤبَّد؛ لأنني أعلم أن قرار الإفراج عني صدر ممّن لا يتمتعون بالصلاحية التي تخوّل لهم اتخاذ قرار بحقي.
نعم لقد خرجت من السجن، لكن آلافًا من الأبرياء ما زالوا قابعين هناك.
خرجت من بين هذه القضبان الحديدية والجدران العريضة المظلمة، وتركت خلفي أناسًا ضعفاء لا حول لهم ولا قوة.
مكثت أكثر من ثلاث سنوات في زنزانة صغيرة مع اثنين من الأبرياء، لم يرتكبا أي جرم، لكن أحدًا لم يصغ إليهما رغم عرضهما أدلة براءتهما مرارًا وتكرارًا. لقد حَكم عليهما بالسجن قضاةٌ لا يختلفون شيئًا عن قضاةِ رواية “وداعًا للسلاح”.
كان أحد رفيقيّ في الزنزانة في نفس سنِّ ولدي، وكان حديث الزواج عندما تم القبض عليه. كان شابًّا متديّنًا، ومهتمًّا بالفلسفة والأبحاث العلمية في الوقت نفسه.
هذا الشاب لديه مهارات يدوية مذهلة، إذ يمكنه إنجاز أشياء مدهشة بأدوات لا تخطر على البال، في مكان خالٍ من الإمكانات. كان يستطيع تحويل أكياس الملح إلى دَمْبِلٍ (للتريض)، وشوكة الطعام إلى مشبك، والملعقة الصغيرة إلى ملقاط، وبإضافته مكونات مختلفة إلى وجبات السجن كان يبتكر أطباقًا جديدة. هذا الشاب اسمه “سلمان”، وكان يعتقد أن الشكوى والتذمر هو نوع من السخط وعدم الرضا بمشيئة الله وإرادته، فكان لا يشتكي قط، لم يكن لديه زوار لأسباب عديدة، ومع ذلك لم يكن يشكو من هذا أبدًا.
ذات يوم وبينما كنت أكتب روايتي الجديدة “Hayat Hanım” (السيدة حياة) على الطاولة البلاستيكية، سمعت عزفًا موسيقيًّا في الفناء.. إنه صوت مزمار!
خرجت إلى الفناء، فإذا بسلمان يستند إلى الجدار وبيده مزمار، يضمه إلى فيه ويعزف عليه وهو مغمض العينين. تلاشت -فجأة- الضوضاء في الزنازين المحيطة، وعمّ السكونُ أرجاء المكان، وأخذ الجميع يصغي إلى هذه الموسيقى المفاجئة. وبانتهاء سلمان من العزف دوَّى في المكان أصوات قوية متتالية، إنها أصوات قطع الحلوى التي اشتراها المساجين من كانتين السجن ترتطم بأرضية الفناء الذي نحن فيه، يلقيها النزلاء في الزنازين المجاورة تعبيرًا عن مدى إعجابهم، ورغبتهم في الاستزادة من العزف، وقد استجاب سلمان لهذه الرغبة فظل يعزف لساعات. وبعد أن أُغلق باب الفناء سألته “من أين أتيت بهذا المزمار؟”.
لقد صنع هذا المزمار من كرتون تقويم التاريخ الذي كان في الزنزانة. ولكونه لا يمتلك شريط قياس أخذ يقدِّر المسافة بين كل ثقب بأصابعه، واتخذ من عنق زجاجة بلاستيكية قَطَعَهُ فمًا لهذا المزمار.
كان العزف الذي يصدر من مزماره هذا لا يضاهيه أي عزف يصدر من أي أداة أخرى على وجه الأرض، كانت له نغمة غريبة وغليظة إلى حد ما، ومع ذلك لم يعجز سلمان عن عزف أية مقطوعة أو التعبير عن أي نغمة يريد.
لم يكتفِ سلمان بعزف المقطوعات الحزينة فحسب، بل عزف الألحان التي تبعث على السعادة والسرور أيضًا، رغم أن المزمار كان صوته يميل إلى الحزن بشكل عام.
كان مثل ولدي.. لا أحد يأتي لزيارته.. لكنه لم يشتكِ ولو مرة واحدة.
لقد صنع مزمارًا من الكرتون، وأخذ يعزف به وهو متكئ على الجدار.
تم إطلاق سراحي من السجن في منتصف إحدى الليالي وسألني الجميع عن شعوري، أرادوا أن يسمعوا مني كلمات تنمّ عن الفرح الذي يشعر به الشخص في أول لحظات الحرية بعد سنوات من الحبس، غير أنني أخبرتهم بأنني حزين بعض الشيء.
فقد تركت ورائي خلف القضبان الحديدية الآلاف من الأبرياء، منهم سلمان بمزماره الكرتوني.
كنت أعلم أنهم أبرياء، ولكن لم يكن بمقدوري إنقاذهم، ولم يكن أحد يصغي إليهم، ليس القضاة فحسب، بل ثلَّة كبيرة من المجتمع تحولوا إلى هؤلاء الرجال الذين يحكمون على الآخرين بالإعدام في الكهف بلا مبالاة، يرتدون قبعاتهم، ويحيُّون الجلوسَ، ثم يرسلون الشخص إلى فرقة الإعدام، وينتظرون بعد ذلك الضحايا الجدد.
لا يمكن أن تشعر بالفرح عند مغادرة السجن بعدما رأيتَ هذا الكهف، وشهدت معاناة الأبرياء، واستمعت إلى المزمار الكرتوني، بل يشعر الإنسان عندها وكأنه متواطئ مع الآخرين على جريمة شنعاء. إنك تشعر بأنك ضحية للظلم وأنت في داخل هذا السجن، وتشعر وكأنك أصبحت شريكًا في ظلمٍ أعظم بعد مغادرته.
إنني أعلم أنه ليس هناك في الحياة ما هو أكثر فزعًا ورعبًا مِنْ أن تواجه قوة مذهلة لشخص يتحكم في مصيرك؛ كما أعلم مدى العذاب والإذلال الذي تلقاه عندما يتجاهل صاحب هذه القوة ما تقول ولا يعبأ به.
أعلم أيضًا كيف كان صوت المزمار الكرتوني يعبّر عن نار شوق ضرمٍ لا يخبو.. أعلم كذلك أنه من المحتمل أن يقبضوا عليَّ مرة ثانية.. لكن الاعتقال ليس احتمالاً بالنسبة لسلمان، لأنه معتقل بالفعل.
إنه في عمر ولدي، يصنع الدَّمْبِل من أكياس الملح، والمزمار من الكرتون.. ليس لديه زوار.. لا يشكو أبدًا.
(*) كاتب وصحفي تركي. الترجمة عن التركية: خالد جمال عبد الناصر. التحرير: صابر عبد الفتاح المشرفي.