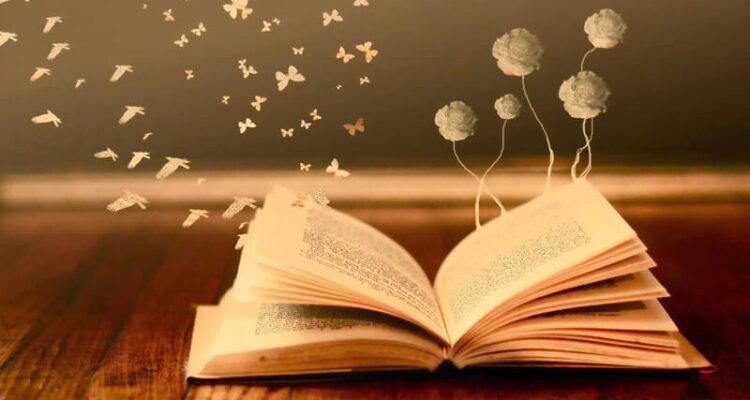لما كان الإسلام دين القراءة، ولما كانت أول آيات الوحي الإلهي نزلت داعية ومؤكدة على القراءة في قوله سبحانه “اقرأ” فقد عُلــم من ذلك أن فعل القراءة من الأفعال الواجبة (واجب كفائي) على أفراد هذه الأمة التي جعلها سبحانه خير أمة أخرجت للناس ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾(آل عمران 110)، وعُلم من ذلك أيضًا أن لا نهضة لهذه الأمة ما لم يوقظ فيها سراج القراءة ويتوهج فيها نور العلم، بيد أن الواقع يخبرنا ويشير لنا بأن مصباح القراءة فينا قد تعطل، وأن نور العلم في أفئدتنا قد انطفأ، وأن رائحة الجهل والتخلف عن ركب التقدم والإبداع قد لاحت في الآفاق لدرجة تزكم الأنوف وتُنبئ بوقوع كارثة عظمى.
إن خيرية الأمة التي أخبر بها الله سبحانه إنما تتأتى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما جاء في صريح الآية، ولا شك أن أكبر منكر يهدد الأمة ووجب عليها النهي عنه ومحاربته بكل ما أوتيت من قوة هو منكر (الجهل) ولا شك أيضًا أن أكبر معروف وجب على الأمة الأمر به والحث عليه بكل ما أُوتيت من قوة أيضًا هو معروف (العلم)، لكن الواقع يأبي مرة أخرى إلا أن يخبرنا بأن معالم الآية قد شوهت، وأن القاعدة قد عُكست، وأن أعلام الجد قد نُكست، ورفعت بدلها أعلام الخمول والكسل، لا لشيء إلا لأن الأمة في أغلبها صارت تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، وتشجع الجهل والجهلاء وتحبط العلم والعلماء، وتصرف الأموال الطـائلة في التفاهات وتبخل بالقليل عما يمكن أن ينفع الأمة ويخرجها من الظلمات.
إن بُعد الأمة عن الريادة وتخبطها في براثين الجهل والتخلف بعيدًا عن ركب الحضارة والتقدم، يجعلنا نتساءل بحرقة ونقول: ألسنا الأولى بالتقدم باعتبارنا أمة اقرأ؟ ألسنا نحن من ينبغي أن يحمل لواء العلم ومشعل النهضة باعتبارنا نملك مرجعًا مقدسًا يعتبر بمثابة خارطة الطريق لنا ولغيرنا وهو القرآن العظيم وسنة النبي الكريم؟
لا شك أن الإجابة عن هذين السؤالين العريضين تقتضي منا أن نعود لآية “اقرأ” لنقرأها القراءة الحقة بقلوبنا لا بألسنتنا، ولنفحصها ببصيرتنا لا ببصرنا، ولنستنبط منها أسس القراءة الصحيحة التي يمكن أن تنهض بنا من سباتنا وتجتثنا من غفلتنا، ذلك أنه ليست كل قراءة توصل صاحبها للعلا، وتمهد له الطريق نحو الاستعمار والاستخلاف الحسن في الأرض وتؤهله للفوز في الأخرة، بل إن القراءة التي توصل إلى كل ذلك هي تلك التي خُطت بمداد الوحي الإلهي راسمة معالم القراءة المثالية، ونموذج القارئ المثالي الذي يقرأ باسم ربه ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾(العلق:1) مُفتتحًا أقواله وأفعاله باسمه سبحانه، ملتمسًا العون والبركة منه عز وجل، موطنًا نفسه على غرس هذا الاسم في قلبه وجعله يجري على لسانه في كل وقت وحين مما يجعله في منأى عن عصيانه، وساعيًا بعلمه لإرضاءه وحده دون غيره، وشتان بين أن تسعي لإرضاء الخالق (الذي خلق) وبين أن تسعى لإرضاء المخلوق، فعن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ، رَضِيَ الله عَنْهُ وَأَرْضَى النَّاسَ عَنْهُ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ ، سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عليه الناس) (رواه ابن حبان)، ومن الحكم المأثورة أن “رضا الناس غاية لا تدرك ورضا الله غاية لا تترك فاترك ما لا يدرك وأدرك ما لا يترك”.
إضافة إلى ذلك فإن أحوج ما يحتاج إليه القارئ المثالي هو التزود بالقيم التي تشكل عصب وجدانه وتقوي الجانب النفسي فيه وتدفعه نحو السلوك الأفضل والفعل المثالـــــي، ولعل أعظم قيمة يحتاج إليها القارئ الذي يزيد الأمة إشعاعًا وتوهجًا هي التواضع، ولذ وجدنا الخالق سبحانه ينبهه إليها بقوله: ﴿خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾(العلق:2)، قاصدًا بذلك تذكيره بأصله حين كان قطعة دم عالقة بجدار الرحم لا حول لها ولا قوة، ليعرف قدره وفضل الله عليه فيحمله ذلك على التواضع والتذلل له سبحانه دون عجرفة أو كبر، وفي الحديث قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (مَنْ تَوَاضَعَ للهِ دَرَجَةً رَفَعَهُ اللهُ دَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَعْلَى عِلِّيِّيْنَ، وَمَنْ تكَبَّرَ عَلَى اللهِ دَرَجَةً وَضَعَهُ اللهُ دَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَسْفَلِ السَّافِلِيْنَ) (رَوَاهُ أَحْمَدُ).
فيزداد القارئ رفعة ومكانة بتواضعه فيتعلم أكثر ويعلم غيره ويكون ذلك مدعاة للمحبة والألفة والتعاون بين الجميع بعيدًا عن التكبر الذي لا محالة يكون سدًا منيعًا يحول بين صاحبه وبين التعلم الذي تضيق مسالكه وتقل فرصه وتتبخر بركته بالكبر، وفي الأثر: “اثنان لا يتعلمان: مستحي ومتكب”، فعلم من ذلك أن الكبر لا يزيد صاحبه إلا جهلاً وذلًّا وأن التواضع لا يزيد صاحبه إلا علمًا وعزًّا وكرامة له ولأمته، ولذلك قال سبحانه: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ﴾(العلق:3)، فكأن الله تعالى يصوغ لعبده القارئ معادلة الرقي والنهضة والإشعاع ويقول له: أنت ما عليك إلا القراءة الصحيحة الخالصة لوجي والتي تحملك على التواضع لجلالي وأنا ما علي إلا إكرامك بفتح مغاليق العلم أمامك ابتداءً وتيسير النهوض والرقي لك ولأمتك انتهاءً لتكونوا خير أمة أخرجت للناس.
وهي المعادلة التي لا يمكن أن تتحقق إلا بالأخذ بالأسباب والوسائل الموصلة لذلك وفي مقدمتها: القلــم ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾(العلق:4) الذي به تحصل الكتابة ويدون العلم وبه وصلت إلينا العلوم والتاريخ والأخبار والحكم، فهو الأداة المثلى التي بها يوقظ نور العلم ، وتشحذ العقول لتتوهج بالأفكار النيرة التي تبدد ظلمة الجهل الدامس وتخرج الأمة من براثين التخلف وتجعلها متلألأة في سماء التقدم والإحاطة بما لم تكن تعلم ﴿عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَم﴾(العلق:5).
وبعد إمعان النظر في هذه الآيات المباركات، وما زخرت به من حروف وكلمات حبلى بالمعاني العميقة والأسس الدقيقة، التي تعتبر بمثابة اللبنات الأساس للقراءة الصحيحة، التي تقود صاحبها نحو العلا والريادة، وتصنفه وأمته في مصاف الأمم الخيرية، فقد عرف موطن الداء وسبب الانتكاسة والشقاء التي نتخبط فيها رغم كوننا أمة اقرأ، وذلك لأننا بكل بساطة أهملنا القراءة الصحيحة، وسلكنا قراءات أُخر أخلصنا فيها لأطماعنا المادية ولأهدافنا الدنيوية الرخيصة، ومضينا في الأرض متكبرين متعجرفين مهملين للكتابة والقلم ومهتمين بالسهرات والنغم.